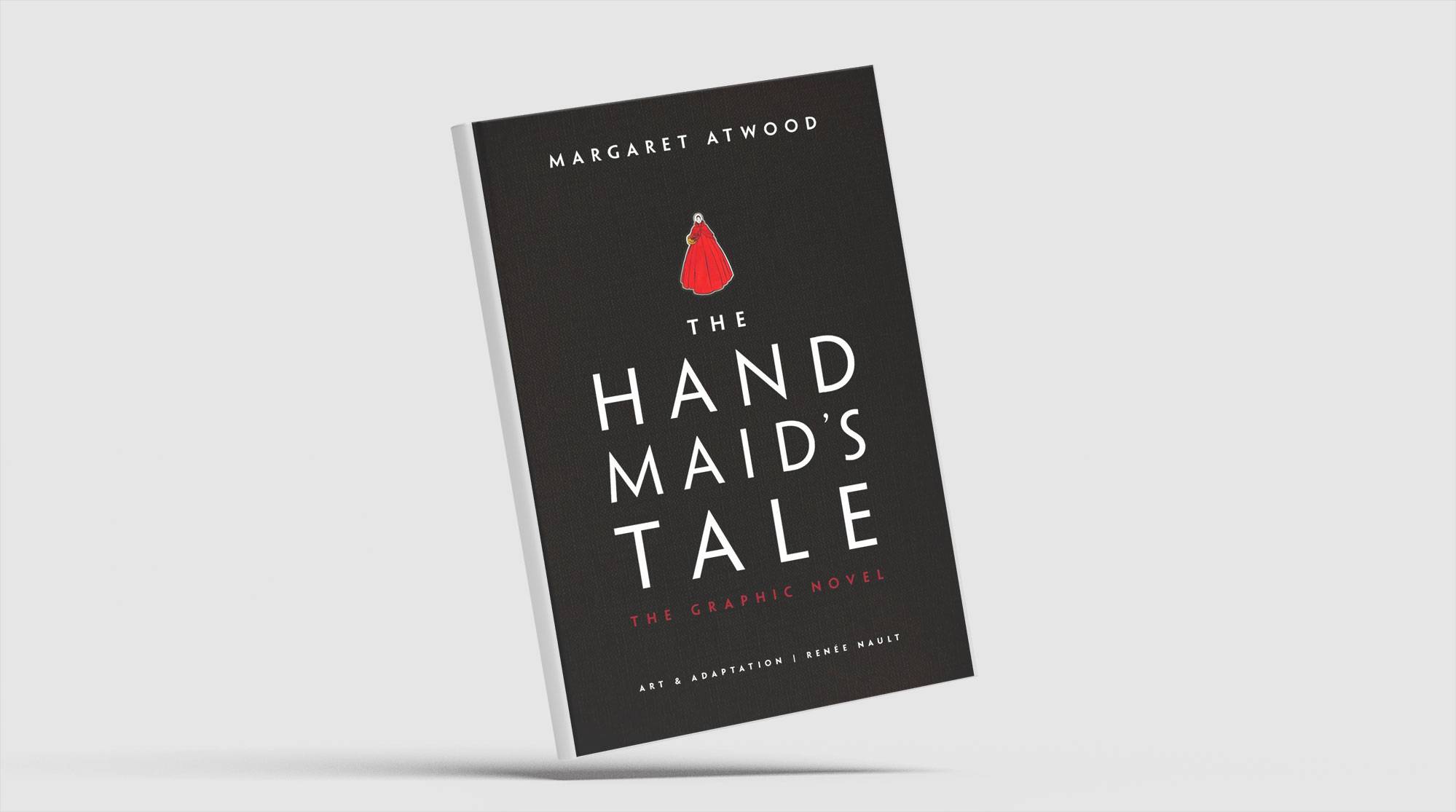للراحل جمال محمد أحمد، أول رئيسٍ لاتحاد الكتَّاب السودانيين، رأي طريفٌ حول الرواية والتاريخ؛ وطرافته ليست نابعةً من السَعَةِ والتحرُّرِ الناشئين من الانتقال المدهش من حرفيَّةِ التاريخ إلى بلاغةِ الرواية، وإنما مصدرُها ناجمٌ عن رأيِّهِ حول التاريخِ ذاتِه، فقد كان يرى في التاريخ، ما كان يراه الفيلسوفُ الإيطالي غيامباتيستا فيكو، وهو أن هناك احتمالاً قويًا بأن الناسَ في فتراتٍ تاريخية مختلفة يمتلكون أنظمة متباينة للفكر، مما يعني أن حرفيَّةَ التاريخِ ذاتِها خاضعةٌ لأنماط التفكير المتنوِّعة، الأمر الذي يضاعف من حريَّةِ الانتقالِ في مجالِ التعبيرِ الروائي.
من الجائز أن يكون جمال محمد أحمد قد توقَّف في مشوارِ التماسِه لقبسِ الحداثةِ الأوروبية، بحُكمِ السنِّ، عند فيكو؛ ولكنَّ شبابَ الكتَّابِ، في منتدياتهم التي غصَّت بها دارُهم في حي المقرن بالخرطوم، كانوا ينشدون فكاكًا من إسارِ التقليد، فينتهجون بنيويةً لهم ثم تفكيكًا، فينتقلون في سلاسةٍ ويُسر من فيكو إلى فوكو؛ فيتعلَّمون من الأخير حِرفة التنقيب، وكيفية إجراء حفرياتٍ عميقة في حقل المعرفة.
إلا أن أول رئيسٍ لاتحاد الكتاب السودانيين كانت له أيضا حفرياتُه المتميِّزة؛ فبينما كان الشبابُ يهرعون للانضواءِ تحت أسلوبيَّةٍ معاصرة، ظلَّ أستاذنا الكبير ينقِّب بصبر في بنيةِ اللغة العاميَّة السودانية، ويجد لها وشائجَ وارتباطاتٍ وصلاتِ نَسَبٍ وقُربى باللغةِ العربيةِ الكلاسيكية، فيُرفِدُ كتاباتِه بدفقاتِ مشاعرَ حيَّةٍ، نابعةٍ من وصلِ اللغةِ الشعبيَّةِ الحميمة برَحِمِ أمِّها الفُصحى، فيكون له بين جمهرةِ الكتَّاب جميعهم، صغيرهم وكبيرهم، أسلوبه الأدبي الخاص، ذو النكهةِ الجماليَّةِ المحبَّبة.
* قصاصو الثمانينات
في عام 1985، كان الكتَّابُ الكبار، من أمثال جمال محمد أحمد، قليلي العدد في الخرطوم؛ أما الكتاب صغار السن، على كثرتهم، فينقسمون، من منظور تجربتي الخاصة، إلى شقين: كان بشرى الفاضل يقفُ على قمَّةِ مجموعةٍ من القصَّاصين السودانيين؛ بينما كان عادل القصَّاص، يقفُ على قمَّةِ مجموعةٍ أخرى. ويأتي في طليعةِ المجموعة الأولى القاصُّ الشاب ذو الإحساس المرهف والنبوغِ المبكِّر سامي يوسف غبريال، يليه شابٌ تتَّقد عيناه ذكاءً وتفتُّحًا مبكِّرًا، هو القاصُّ من الله الطاهر من الله؛ وقد رافقتُ كليهما خلال أيام الطلبِ الباكرة إبان المرحلةِ المتوسطة، وكانت تضمُّنا جمعيَّةٌ أدبيَّة يرعاها القاصُّ عيسى الحلو، وكانت باكورة إنتاجه «ريش الببغاء» قد خرجت لتوِّها من المطابع، وما زالت رائحةُ الحبرِ عالقةً بأغلفةِ النُسَخِ المعروضة في المكتبات؛ وكنتُ أقف على هامشِ الجمعيَّة الأدبيَّة تحت رعاية المعلِّم شيخ مصطفى عبد المولى، خزانة الأدب العربي: أشعارُه، وأمثالُه، وحِكَمُه، وأقوالُه المأثورة؛ وكان لا يطرأ طارئٌ أثناء اليوم الدراسي إلا وقابله بما يُطابِقُه من خزانته التي لا يفلت من مظلَّةِ تفسيرِها حدثٌ عارضٌ أو قولٌ يومي ممجوج.
ويأتي ضمن المجموعة الأولى القاصُّ، ذو الرهافةِ والشفافيةِ العالية، هاشم محجوب، وكان يقابله في معالجةِ الكتابة شعرًا، والبحثِ عن بدائلَ للأطرِ الأدبيَّة المستقرة، الشاعر محجوب كبلو. رافقت كليهما إبان المرحلة الثانوية، وكانا على طرفي نقيضٍ في صياغةِ أحلامهما، وفي تخيِّر توسُّلهما لأجناسِ الأدب؛ لكنهما كانا مُتَحِدَيْن في رؤيتهما لمستقبله، وفي مناهضتهما للتيارِ العام الذي يُرسِي التقليدَ أساسًا لتجميدِ محاورِ الكتابة. وينضمُّ إلى المجموعةِ الأولى أيضا رجلٌ ذو حواشٍ رقيقة، ومناقيرَ مُعَدَّةٍ لالتقاطِ ما استدقَّ من تفاصيلِ الحياةِ اليوميَّة؛ وهو الكاتبُ جعفر طه حمزة. كرَّس لرواية «المداري» وقتًا طويلاً، حتى أصبحنا وكأننا لا ندري: أيكتبُ «المداري» أم أن روايته «المداري» تكتبه؛ ففي حضرةِ حمزة، يختلط الواقعُ بالخيال، وتمتزج الرؤى بالرؤيا، ويفوحُ في المكانِ عطرٌ صادرٌ من أعماقِ روحِه القصيَّة.
* شواغل الحياة
للدبلوماسيَّةِ سحرُها الذي لا تُخطئه العينُ الفاحِصة، كما أن للحياةِ الأكاديميَّةِ بريقُها وغواياتُها؛ وقد تعاون السحرُ والغواية في اختطافِ حمزة من محيطِه الروائي الأثير ليغطيانه بضبابيَّةِ الحياة الدبلوماسيَّة؛ مثلما تعاونت مهنةُ المحاماةِ والسياسةُ اليومية في اختطافِ ساحرٍ آخرَ من فنون القصِّ، وهو القاصُّ الذكي، ذو الروحِ المتأجِّجة على الدوام، عبد السلام حسن عبد السلام.
وينضافُ إلى هذه المجموعة باستحقاقٍ وجدارة قاصٌّ شاب متعدِّد المواهب، اشتُهر بترجماته لأقصوصاتٍ لكافكا، كما اشتُهر أيضا بتأليفه لمسرحية «حكاية تحت الشمس السخنة»، ولاحقًا رواية «سن الغزال»؛ إلا أن مواهبه لا تقفُ عند هذا الحد، فقد كان يعزف الكلارنيت منذ تتلمذِه على يد الصول حسن؛ والعود برفقة هاشم حبيب الله ومحمد إسماعيل الأزهري؛ والمزمار والهارمونيكا ليُذهب عن نفسه، وعنَّا وحشةَ الانعزال ومرارةَ العهدِ الديكتاتوري الثاني، وذلكم هو القاصُّ المبدع صلاح حسن أحمد.
لم ينقطع صلاح عن الكتابة، ولكن حرفة الصحافة أخذت جُلَّ وقتِه، منذ مجلة «سوداناو» (Sudan Now) وإلى صحيفة «الشرق الأوسط» بلندن. وأثناء فترة عملِه في إدارة تحرير المجلة، تقدَّمتُ إليه بأولِ نصٍّ أكتبه باللغة الإنجليزية، فقامت إدارة «سوداناو» بنشرِه في عام 1980؛ وكان النصُّ تحت عنوانٍ: «تحليقٌ انسيابي فوق حَرَمِ الجامعة». ولأن النصَّ كان مفارقًا لما عُهِد الناسُ عليه، فقد كتبت تقييمًا نقديًا للطريقة التي استحدثتها في الكتابة، وهي عبارة عن أسلمةٍ عفوية لنمطٍ ألماني معروفٍ في الكتابة. أما المجموعة الثانية، فقد كانت تضمُّ مجموعة متميِّزة من النقاد والقصَّاصين؛ كان أبرزهم في مجال النقد، الناقد الراحل أحمد الطيِّب عبد المكرَّم؛ وكان من ضمنهم الكاتب المثقَّف محمد خلف الله سليمان؛ وكان عادل القصَّاص، رغم التفافِه حول كوكبةٍ من الكتَّابِ السودانيين، ألمعهم شهرةً، وأكثرهم - توسُّلاً بالتعبيرِ الرشيق والوصفِ الحميمِ - قدرةً على جذبِ القارئِ العادي إلى فضاءِ النصِّ، وإغوائه على معايشته، واشتهائه. وتكبُر هذه الميزات عشراتِ المرات، إذا عرفنا أن المجموعة تشمل أساتذةً كبارًا ذوي خِلالٍ لا تجرح خليلاً، وأَرُومةٍ إبراهيميةٍ كريمة لا تُخْطِئُها العينُ الناظرةُ إلى أسمائهم التقليديَّةِ المحبَّبة: عبد القادر محمد إبراهيم، وعبد الله محمد إبراهيم، وإبراهيم جعفر. ليس صعبًا على الباحثِ الذكي أن يجد عادل القصَّاص في نصوصِه، ولكن الباحثَ الأكثر ذكاءً سيلتمسُه في فضاءاتٍ اجتماعيةٍ أرحبَ سَعَةً وأعمقَ غورًا: سيجدُه في جلساتِ الاستماعِ، والمنتديات؛ وسيلحظُه في المجالسِ العفوية، والسهراتِ، والمناسباتِ الاجتماعيَّة؛ مثلما سيلقاه ناشطًا متجلِّيًا في الروابطِ، والجمعياتِ، والاتحاداتِ الأهلية. ولم يكن يتخذ تلك الأطر مطيَّةً للوجاهةِ الاجتماعيَّة، أو سُلَّمًا للمناصبِ السياسيَّة؛ بل كان ينفُذ إلى عِظامِ الكلمات، ويتخللُ أبنيتها الصرفية، ويتسللُ إلى جذورها، لإيقاظِ دلالاتِ الارتباطِ، والإجماع، والوحدةِ الهاجعةِ في أحشائها العميقة.