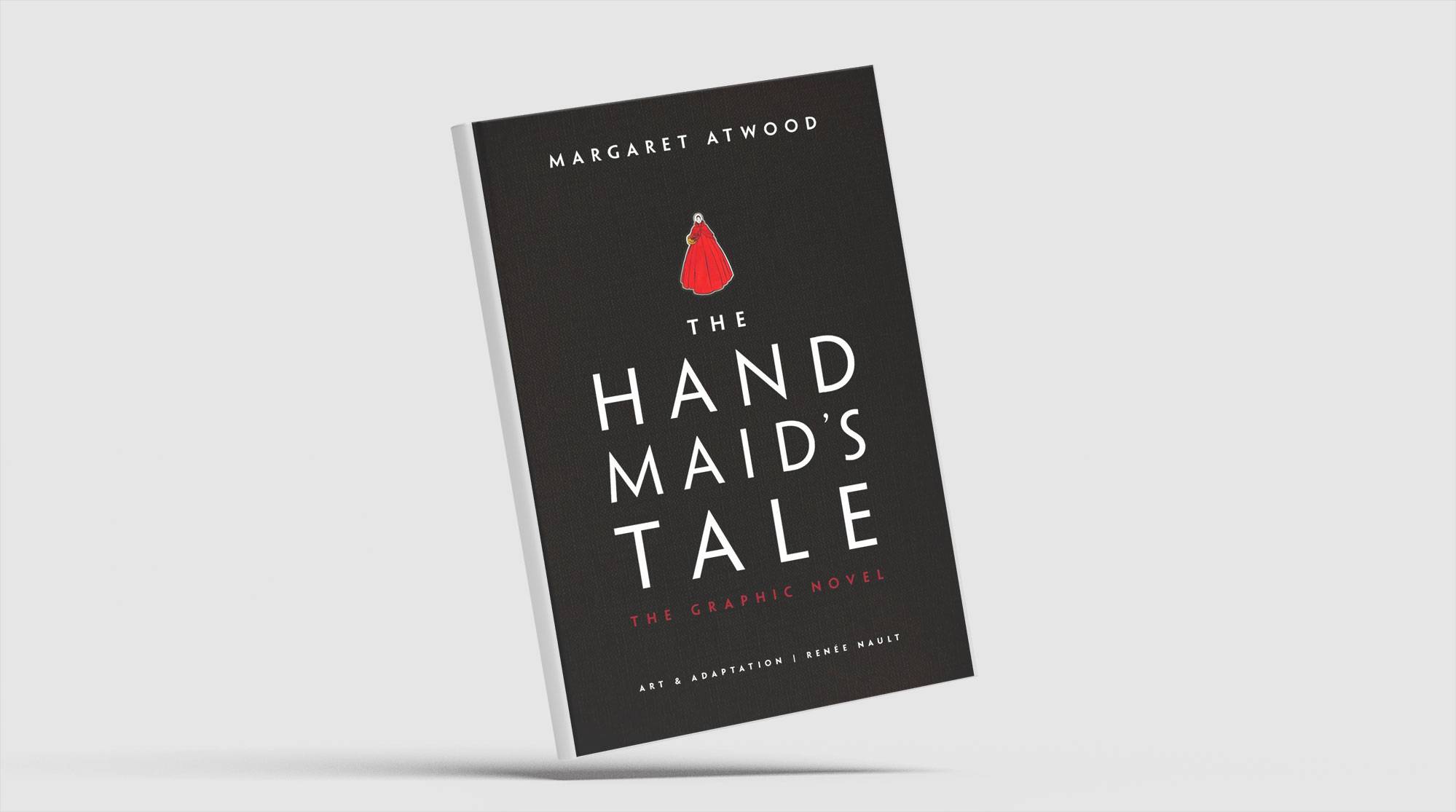ترددت كثيراً قبل أن أقرر الكتابة عن تجربة التحكيم في الدورة الأخيرة للجائزة العالمية للرواية العربية، والتي اصطلح على تسميتها بالبوكر العربية. ولم يكن التردد ناجماً عن افتقار الموضوع إلى ما يحتاجه من الأفكار والتفاصيل و«المواد الأولية» اللازمة للكتابة، بقدر ما كان وليد الحذر الشديد من الإفصاح عن المداولات الخاصة بلجنة التحكيم، وما شهدته اجتماعاتها من سجالات ووجهات نظر متباينة ينبغي وفق النظام الداخلي للجائزة أن تظل قيد الكتمان. على أن ذينك التردد والحذر ما لبث أن أعقبهما اعتقاد راسخ بأن مثل هذه التجربة المحفوفة بالمخاطر، تستحق أن يُكشف النقاب عن بعض وجوهها، لا من الزاوية المتعلقة بإفشاء الأسرار وخرق الأعراف المتبعة، بل من زاوية ما يتطلبه خوضها من جهود مضنية، ومن اختبار دقيق لملكات النزاهة والنقد الموضوعي والترفع عن الأهواء.
وما أود الإشارة إليه في هذا السياق، هو أن الغبطة المتولدة عن مثل هذا التكليف «التكريمي» كان يشلها على الدوام شعور موازٍ بالكف عن كتابة الشعر أو القيام بأي عمل جوهري مماثل، في ظل ما تتطلبه المهمة من تفرغ وتبتل كليين. صحيح أنني كنت وما زلت من المولعين بقراءة الروايات والمتمرسين بالنقد الروائي، الأمر الذي أخذه القيمون على الجائزة بعين الاعتبار عند تكليفي بترؤس لجنة التحكيم، وهي المهمة نفسها التي كُلّف بها قبل سنوات الشاعر الفلسطيني، الذي رحل مؤخراً، مريد البرغوثي، ولكن الأمور تختلف عن سابقاتها هذه المرة؛ حيث لم تعد القراءة هواية ممتعة أو خياراً طوعياً، بل باتت مسؤولية نقدية مضنية، يتطلب القيام بها أشهراً كثيرة من القراءة المتأنية وتدوين الملاحظات وعقد المقارنات المختلفة من جهة، والانقطاع عن كل ما يتصل بشؤون الحياة وشجونها، من جهة أخرى. على أن هذه المجازفة الصعبة لم تكن لتقع أوزارها على كاهل شخص بمفرده، بل كان العبء موزعاً بالتساوي بين سائر الأعضاء المحكمين، وهم الروائي اليمني علي المقري، والكاتبة والإعلامية الإماراتية عائشة سلطان، والكاتبة والمترجمة اللبنانية المقيمة في البرازيل صفاء جبران، والكاتب والمترجم المغربي محمد آيت حنا.
كنت أعرف بالطبع، كما هو حال زملائي المحكمين، بأن المعدل السنوي للأعمال المرشحة لا يقل وفق ما أظهرته الدورات السابقة عن 150 عملاً، خاصة بعد أن بدأت فنون السرد تحظى بمكانة استثنائية في الإطارين العربي والعالمي، بمقدار ما بات عدد قرائها في ازدياد مطرد، كما باتت تحظى بالجانب الأوفر من الترجمات إلى اللغات الحية، وتخصص لها معظم الجوائز والمكافآت المرموقة، بما جعلها تستقبل أعداداً غير قليلة من الوافدين و«النازحين» إليها من الفنون الأخرى. ومع أن الروايات التي تم ترشيحها للجائزة في دورتها الحالية بلغ 121 رواية لا أكثر، إلا أن أي عملية حسابية قائمة على المقارنة بين عدد الأعمال المرشحة، وعدد الأيام المتاحة للقراءة، لا بد أن توصلنا إلى الاستنتاج الصادم بأن على كلّ منا أن يقرأ رواية واحدة كل يومين اثنين، وهو ما لن نستطيع تحقيقه إلا بالإخلاد إلى القراءة بمعدل 10 ساعات على الأقل في اليوم الواحد. وما زاد من صعوبة الوضع هو الأحجام الكبيرة للأعمال المرشحة، والمتأتية على الأرجح من الحجر المنزلي الذي فرضه «كوفيد 19» على من كتبوا أعمالهم في ظل انتشاره المحفوف بالمخاطر، والذي وفر لهؤلاء أوقاتاً للكتابة لم تكن متاحة من قبل.
ولأن أحداً من البشر، ناقداً كان أم قارئاً عادياً، لا يستطيع الرهان على ذاكرته أو انطباعه المجرد للوصول إلى استنتاجات نقدية سديدة، فقد لزمنا أن ندون في تقارير منفصلة الخلاصات المتعلقة بكل عمل، سواء من حيث الموضوع ورسم الشخصيات ونمو الأحداث والفضاء التخييلي، أو من حيث الأسلوب والحبكة السردية ومستويات اللغة. ومع أننا وجدنا أنفسنا أمام مروحة من الأعمال السردية التي ينتمي كتابها إلى مختلف أصقاع العالم العربي، فقد آلينا على أنفسنا ألا نولي أي اهتمام يُذكر لبلد الكاتب، أو لاسمه وعمره ونجوميته وكتاباته السابقة، أو لنمط العلاقة التي تربطنا به. وأستطيع القول براحة تامة إن النصوص المجردة والبعيدة عن أي مؤثر خارجي هي من كان يقودنا إلى الهدف، ودون أن يفوتني التنويه بمجلس أمناء الجائزة ومنسقتها النشطة، الذين آثروا التواري بالكامل عن كل ما يتصل بشؤون التحكيم وآلياته ومسوغاته.
كانت الأعمال المرشحة تدور بمعظمها حول بؤس الواقع العربي الموغل في تصدعه وتخلفه وانهياره، وحول كياناته السياسية التي حوّلها الاستبداد والفقر والفساد المستشري إلى نسخ مشرقية من جمهوريات الموز، وحول المآلات المأساوية لثورات الربيع العربي، التي أثبتت على نحو ملموس بأن التغيير أمر متعذر، ما دامت القوى التي ترفع لواءه هي الوجه الآخر للعنف الذكوري ولاضطهاد المرأة واحتكار الحقيقة وتعطيل العقل. وفيما بدا واضحاً انصراف معظم الكتاب المصريين عن الاهتمام بأحداث بلدهم الأخيرة، وتركيزهم على الأعمال التاريخية المستلهمة من الحقب الفرعونية والعباسية والمملوكية، مع التركيز الخاص على حقبة محمد علي في القرن التاسع عشر، كان الكتّاب العرب الآخرون يمتحون بمعظمهم من تاريخ بلدانهم الحديث، وما رافقته من تحولات سياسية واجتماعية حاسمة، ومن حروب أهلية دامية، وصعود متسارع الوتائر للحركات الأصولية التكفيرية، ومن تعثر مأساوي لانتفاضات الربيع العربي، كما هو شأن الروايات المغربية والتونسية والأردنية والسودانية والجزائرية والعراقية واليمنية وغيرها. ولقد بدت بعض الأعمال المرشحة أشبه بالتاريخ – الظل الذي غالباً ما يسقط من حسابات التواريخ السلطوية الرسمية، أو بوثائق اجتماعية وسياسية ونفسية وإنسانية عن سكان «القيعان» الذين لا يلتفت أحد إلى حيواتهم الغفل ومصائرهم المنسية. وإلى تنوع الموضوعات والمقاربات السردية الموزعة بين التاريخ والسياسة والاجتماع، كان ثمة تنوع لافت في أساليب السرد وتقنياته ؛ حيث عمد كثيرون إلى الإفادة من فنون التوثيق والريبورتاج الصحافي، ومن التحليل النفسي والاستقصاء الجنائي والحبكة البوليسية المشوقة وغيرها من التقنيات السردية الحديثة.
لم يكن بالأمر المستغرب بالطبع أن يكون هناك تفاوت ملحوظ في مستوى الأعمال المرشحة، بحيث لم يكن عدد الأعمال الهابطة ليقل عن ثلثي هذه الأعمال، وهو ما سهّل على المحكمين أمر استبعادها من المنافسة دون أي شعور بالذنب أو الاجحاف. ولأن الأمور بدأت تتخذ بعد ذلك منحى أكثر دقة وتعقيداً؛ حيث بدأت الفوارق بين الأعمال المرشحة بالتضاؤل، فقد اقترحت على اللجنة ألا نكتفي بالاجتماعات التقليدية الثلاثة التي تفضي في العادة إلى اختيار القائمتين الطويلة والقصيرة، كما إلى اختيار الكاتب الفائز بالجائزة، بل أن نعمد إلى عقد اجتماعات إضافية يتم خلالها تقليص عدد المرشحين بشكل تدريجي، وصولاً إلى اختيار القائمتين الطويلة والقصيرة. ومع أن ما بذلناه من جهود مضافة قد جنّبنا مزالق التسرع وساعدنا في الوصول إلى نتائج مرْضية، فإن هذه النتائج لم تكن دائماً ثمرة التوافق أو التراضي، بل كانت تتم أحياناً بأكثرية الأصوات، وتعْقب ساعات طويلة من النقاشات المعمقة والمضنية. ومع أن احترام سرية المداولات يوجب على المحكمين تجنب ذكر الأسماء، فإن ذلك لا يمنع من الإقرار بأن ثمة 14 رواية إضافية على الأقل، كانت جديرة بالاستمرار في المنافسة، لو لم تكن قوانين الجائزة تحصر القائمة الطويلة بـ16 عملاً، والقائمة القصيرة بـ6 أعمال. وفيما كنا مكرهين على إخراج تلك الأعمال من دائرة المنافسة، كنا نفعل ذلك بقدْر غير قليل من المرارة والتردد والبلبلة الذهنية والنفسية. وهو ما حاولنا التقليل من وطأته، عبر القرار الذي اتخذناه بإعادة قراءة الأعمال المرشحة مع كل محطة من محطات الجائزة الثلاث، بحيث تكون الأحكام المستخلصة، وليدة الحدود القصوى من القراءة والتمحيص والمقارنات الدقيقة.
وما دام الحديث عن الرواية لا يستقيم بأي حال دون الحديث عن اللغة، باعتبارها مادة الكتابة وممرها الإلزامي وسبيلها إلى التحقق، فإن من غير الطبيعي التحدث عن الأعمال المرشحة دون التطرق إلى هذا الموضوع الحساس. فإذا كان من الخطأ أن تتحول لغة الرواية إلى استعراض متعسف للبلاغة المحْكمة والحذلقة الأسلوبية، بما يعيق تلقائية السرد وانسيابيته، فإن من الخطأ أيضاً الاستهتار بلغة الضاد، عن طريق الإمعان في الركاكة والهلهلة الأسلوبية والوقوع في شرك الأخطاء النحوية والصرفية والإملائية. وهو ما يتم اقترافه بالتراضي بين بعض الناشرين وبعض المؤلفين؛ حيث يصبح الارتجال وتلفيق الأعمال بغية ترشيحها إلى الجوائز، هو الهاجس المشترك بين طرفي «الصفقة». وهو الأمر الذي أشرت إليه في بيان الجائزة الختامي، والذي لا بد من وضع حد نهائي لتفاقمه واستفحاله، عبر آليات ووسائل مختلفة، وعد مجلس الأمناء بتدارسها في وقت قريب.
على أنني لن أتوانى في نهاية هذه المقاربة، ورغم كل ما تقدم، عن طرح السؤال التالي؛ هل النتائج التي تم التوصل إليها، بالإجماع حيناً وبالأكثرية حيناً آخر، كانت ستظل هي نفسها، لو كان أشخاص آخرون هم الذين أنيطت بهم مهمة التحكيم؟ والواقع أن مثل هذا السؤال الافتراضي يحتمل إجابات عدة قد يكون من بينها التطابق في بعض الأحكام، والتباين في بعضها الآخر. لكن توصّل لجنة أخرى إلى قراءات وخيارات ونتائج مختلفة، هو احتمال قائم وغير مستبعد، ما دامت الحقيقة الأدبية نسبية وحمالة أوجه، وما دام المحكمون المولجون بالمهمة لا يمثلون سوى أنفسهم، وسط كمّ لا يحصى من القراءات والآراء المتباينة. لذلك فإن على الذين لم يبلغوا القوائم النهائية أن يضعوا الأمور في نصابها الصحيح؛ حيث الحصول على الجائزة، أو أي جائزة مماثلة، ليس هو المعيار الوحيد والأهم للحكم على أي منجز إبداعي. لذلك فهم مطالبون أكثر من أي وقت، بمواصلة رفع الصخرة إلى قمة الجبل، حتى لو توجب عليهم أن يبذلوا في سبيل ذلك كثيراً من العناء والعزيمة والتصميم، ومن تدريب الإرادة على مقارعة الخذلان.
رحلتي مع «البوكر»... داخل اللغة خارج الحياة!
متعة القراءة اختلطت بصعوبة المهمة وجسامة المسؤولية


رحلتي مع «البوكر»... داخل اللغة خارج الحياة!

لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة