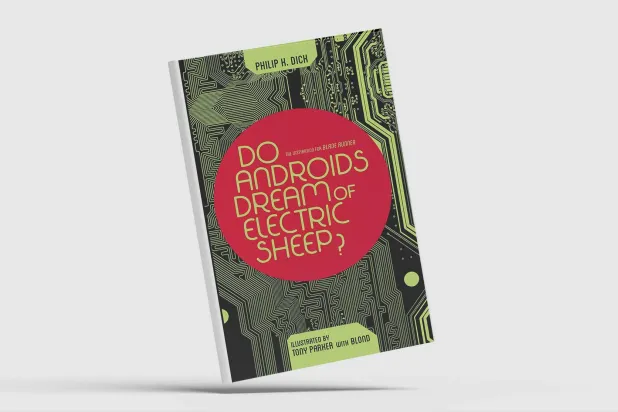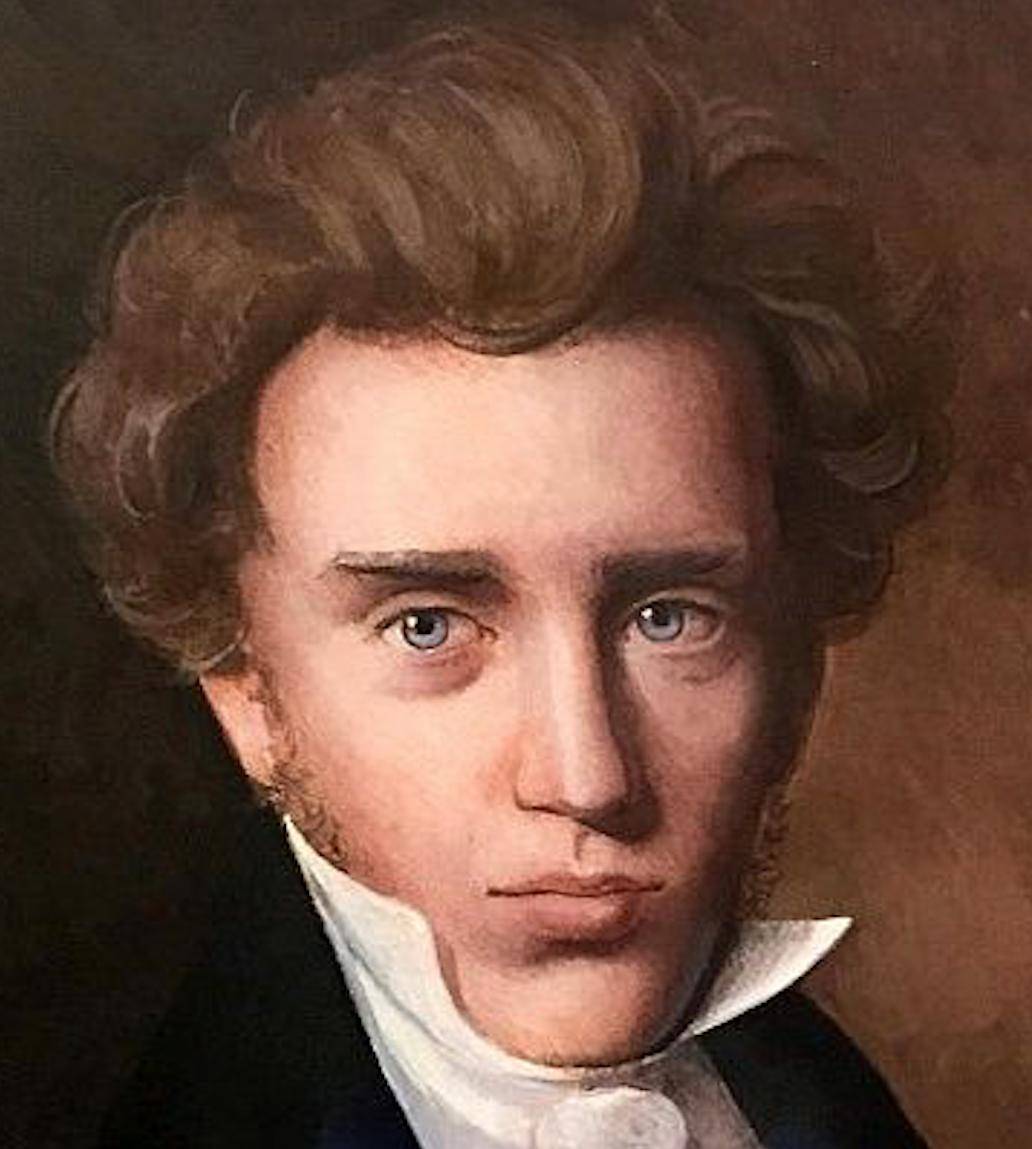«من طبخ العشاء الأخير؟» ليس العنوان الأصلي لكتاب روزاليند مايلز الذي صدر لأول مرة في 1988 بعنوان «تاريخ المرأة كما ترويه النساء»، ولسبب ما، اعتقد ناشره عند إعداده طبعة للولايات المتحدة أن الأميركيين قد يجذبهم تساؤل مثير أكثر من العنوان الأصلي الصريح، فكان «من طبخ العشاء الأخير؟»، ورغم أن النص لم يناقش مسألة من طبخ العشاء الأخير للسيد الناصري وحواريه، وفق التراث المسيحي، الذي حضره رجال فحسب، باستثناء تلميح عابر في أول سطرين من الافتتاحية؛ حيث الشكوى، الثيمة التي يتلفع بها النص؛ أن التاريخ وكل شيء آخر في هذا العالم مساحة ذكورية محضة، ولو كان طباخ العشاء رجلاً لخُصص له يوم بين أعياد القديسين، ولأصبح شفيع الطهاة المؤمنين، لكن النسوة اللواتي جهزن ذلك العشاء أُزحن إلى هامش التاريخ، ولم يسمع بهن مطلقاً.
ولكن مهما يكن من أمر العنوان، فالكتاب أصاب نجاحاً شاسعاً، وبيعت منه ملايين النسخ، وترجم إلى ما يقرب من 30 لغة، وألهم أعمالاً عدة وبرامج تلفزيونية، وأصبح في عرف الكلاسيكيات بما خصّ مجال النسويات والقراءات البديلة للتاريخ. ولم يفقد النص اليوم - والذي سيصدر قريباً بترجمة عربية رائقة (د. رشا صادق – دار المدى - بغداد) - شيئاً من ألقه الأول، تلك اللهجة الغاضبة المتحمسة، ومعمار السرد الواثق، والسخرية المريرة إلى حد الابتذال أحياناً من مفارقات تاريخية مفعمة بالألم واليأس.
مايلز كاتبة وإعلامية بريطانية (وُلِدت عام 1943) تحمل عدة شهادات عليا، بما فيها دكتوراه في الأدب الإنجليزي، وتوجت بعدة جوائز أدبية مرموقة على مساهماتها الكثيرة في الدراسات النقدية لأدب شكسبير، والنقد الاجتماعي والدراسات المتعلقة بالمرأة في التاريخ والسياسة والإبداع الأدبي، لكن هذا الكتاب حصراً صنع شهرتها من بين أكثر من 25 كتاباً نشرتها، وصار صنو اسمها، لا يذكر أحدهما دون الآخر.
يجيب «من طبخ العشاء الأخير؟» على التساؤل الذي يخطر في بال كثيرين حول سر انزواء النساء من كتب التاريخ. فالرجال، عند مايلز دائماً، يهيمنون على التاريخ، لأنهم يكتبونه، وهم عمدوا بقصد أو بحكم مرجعياتهم الآيديولوجية إلى تجاهل المساهمة الحيوية للمرأة في تشكيل العالم أو التهوين من شأنها.
وتأخذ المؤلفة على عاتقها تالياً مهمة تصحيح ذلك التقصير المتراكم، وتضع تأريخاً بديلاً للعالم يتحدى المسلمات وشطط البطريركيات، ويحطم مع تقدم سرديته بين الديانات الأمومية الأولى إلى عصرنا الحاضر أصناماً وأوهاماً عزيزة في كل صفحة، ويقلب أفكارنا المسبقة رأساً على عقب لاستعادة المرأة إلى مكانها المستحق في قلب قصة البشر عبر العالم في ثوراتهم وإمبراطورياتهم، وفي حروبهم وسلامهم، مع هامش من حكايات عن نسوة أفراد فرضن في مراحل مختلفة حضوراً بارزاً رغم كل شيء.
تبدأ سردية مايلز لتاريخ العالم بأول النساء ومساهمتهن في بصمة الجينات البشرية الأساسية، والقفزات التطورية العظيمة التي حققنها في بناء الإنسان (العاقل) كما نعرفه اليوم من خلال دورهن الحاسم في استمرارية النوع، والحفاظ على الجماعات البشرية الأولى بجمع الغذاء والمساعدة في الصيد كما إطلاق الزخم لتطوير التكنولوجيات البدائية الأولى؛ العصي للحفر، والحجارة لتقطيع الطعام، واللفافات لحمل الأطفال الرضع، كما اللغة والمعارف الأولى، كالتقويم القمري المرتبط بقياس دورات الحيض.
وبحسب اللقى الأثرية من غير مكان حول العالم، فإنه يبدو محسوماً أن الإلهة الأم كانت من أوائل معبودات البشر، وأن أول كاهن شاعر كان في الواقع أنثى. وتستعرض مايلز بسعادة ظاهرة في الربع الأول من الكتاب تلك الحقبة الذهبية للنساء المقدسات، وربما الطولى بما لا يقاس من تاريخ البشر، عندما لم يخطر ببال أحد وصفهن بأنهن ضعيفات جسدياً، أو غير مستقرات عاطفياً، أو أدنى فكرياً من الرجال.
لكن التأريخ للمرأة هو بالضرورة أيضاً تأريخ للرجال. وتدعي مايلز أن لحظة التحول التي أزاحت النساء من مكانتهن أتت مع اكتشاف البشر أن للرجال دوراً ضرورياً للإخصاب، وأنهم ليسوا مجرد أداة للمتعة ورفاقاً للصيد كما ظل الاعتقاد طويلاً، لتبدأ تالياً رحلة مؤلمة من قصة الاعتداء على أجساد النساء وقمع حياتهن، وكذلك المقاومة الباسلة التي أبدينها في الفترات المتعاقبة لتأكيد حضورهن من المجاهدات العربيات في الجاهلية والإسلام، إلى الطبيبة التي افتتحت أول عيادة لتحديد النسل. مايلز وهي تشيد معمار الرواية التاريخية البديلة تكشف عن الحقائق الهمجية وراء تسميات ملطفة مثل حزام العفة، والعروس الطفلة، والساحرات.
في الربع الثالث من الكتاب، تنقلنا مايلز إلى بدايات الرأسمالية، وكيف انطلقت الثورة الصناعية، تلك العملية الطويلة والمؤلمة التي فصلت عامة النساء في نهاية المطاف عن رجالهن، وحوّلتهن بلا رحمة إلى مخلوقات مدجنات، إما عاملات يقدحن سحابة يومهن بأجر زهيد لا يكاد يسد الرمق، وإما ربات منازل شأنهن الترفيه عن الرجل وإنجاب النسل الكثير له في أجواء اجتماعية وصحية وقانونية كابوسية.
تنهي المؤلفة كتابها باقتباس من نسوية سوداء شابة لم تذكر اسمها، يشير، في جملة واحدة، إلى التحدي الذي واجهته الناشطات النسويات الأميركيات من أصل أفريقي في مرحلة الستينات عندما أجبرن على الاختيار بين حركة الحقوق المدنية والموجة الثانية من الحركة النسائية.
هذا التناقض بين الطروحات النضالية ينعكس بشكل ما على الربع الأخير من الكتاب الذي يأتي أقل متانة واقتداراً نظرياً، وأفردت مساحة واسعة منه لمناقشة تأثير الاستعمار الإمبريالي الأوروبي على النساء الأوروبيات، وتحديداً الإنجليزيات اللواتي انتهين بطريقة أو أخرى إلى العوالم الجديدة والأملاك البريطانية في جنوب شرقي آسيا وأستراليا وأميركا الشمالية، مع شبه إهمال لعذابات نساء السكان الأصليين. وعلى الرغم من ذلك، فإن الفصول الأخيرة تلقي بالضوء على تشظي النظرية النسوية وراديكاليتها المفرطة في جوانب دون أخرى.
هناك في الغرب مثلاً اتجاه تعظيم للثقافة بوصفها السر في إعادة إنتاج البطريركيات، وأن تغيير المواقف الثقافية تجاه الجندر (أو النوع الجنسي) هو الطريق نحو ترجيح الكفة وتحقيق المساواة.
لكن هذا الاتجاه يعزل الثقافة عن حاضنتها، أي المنظومة الرأسمالية – وفي أيامنا بصيغتها المتأخرة الأكثر توحشاً - ويُسقط من حسابه تعدد الحلقات التي تتراكب لمنع الاقتراب من علاقة تعادلية إيجابية بين الجنسين، الأمر الذي يشرذم نضال الفئات المقهورة، وكثيراً ما يدخلها في معارك جانبية بعيداً عن مواجهة العقدة الأساس.
قد لا تكون مايلز مؤرخة محترفة، وفق المفهوم الأكاديمي البحت، ولا شك أن كتابها يعاني من ملمح استشراقي وأورومركزية لا يمكن تجاهلهما، أقله للقارئ العربي، وربما يكون منقطعاً على التطورات الكثيرة في النظريات النسوية والثقافية خلال العقود الثلاثة الأخيرة، وسيجد كثيرون قراءته قراءة مؤلمة أو مزعجة أو كليهما معاً، ومع ذلك فإن نص «من طبخ العشاء الأخير؟» يظل ممراً لا بد منه للرجال كما للنساء إن هم أرادوا كسر بعضٍ من هيمنة القوالب الفكرية الجامدة، والكليشيهات العقيمة التي تفرضها على أذهان الأغلبية هياكل التنشئة والتعليم والإعلام والتلقين - ولا سيما مجتمعات الشرق الشديدة المحافظة - حول مسألة الأدوار الجندرية، والسياقات التاريخية - سياسياً واقتصادياً وثقافياً - التي أنتجتها.
8:25 دقيقه
روزاليند مايلز تعيد كتابة تاريخ العالم كما ترويه النساء
https://aawsat.com/home/article/2994301/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%84%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%83%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1



روزاليند مايلز تعيد كتابة تاريخ العالم كما ترويه النساء
بيع من كتابها ملايين النسخ وترجم إلى ما يقرب من 30 لغة... ومنها العربية

روزاليند مايلز
- لندن: ندى حطيط
- لندن: ندى حطيط

روزاليند مايلز تعيد كتابة تاريخ العالم كما ترويه النساء

روزاليند مايلز
مواضيع
مقالات ذات صلة
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة