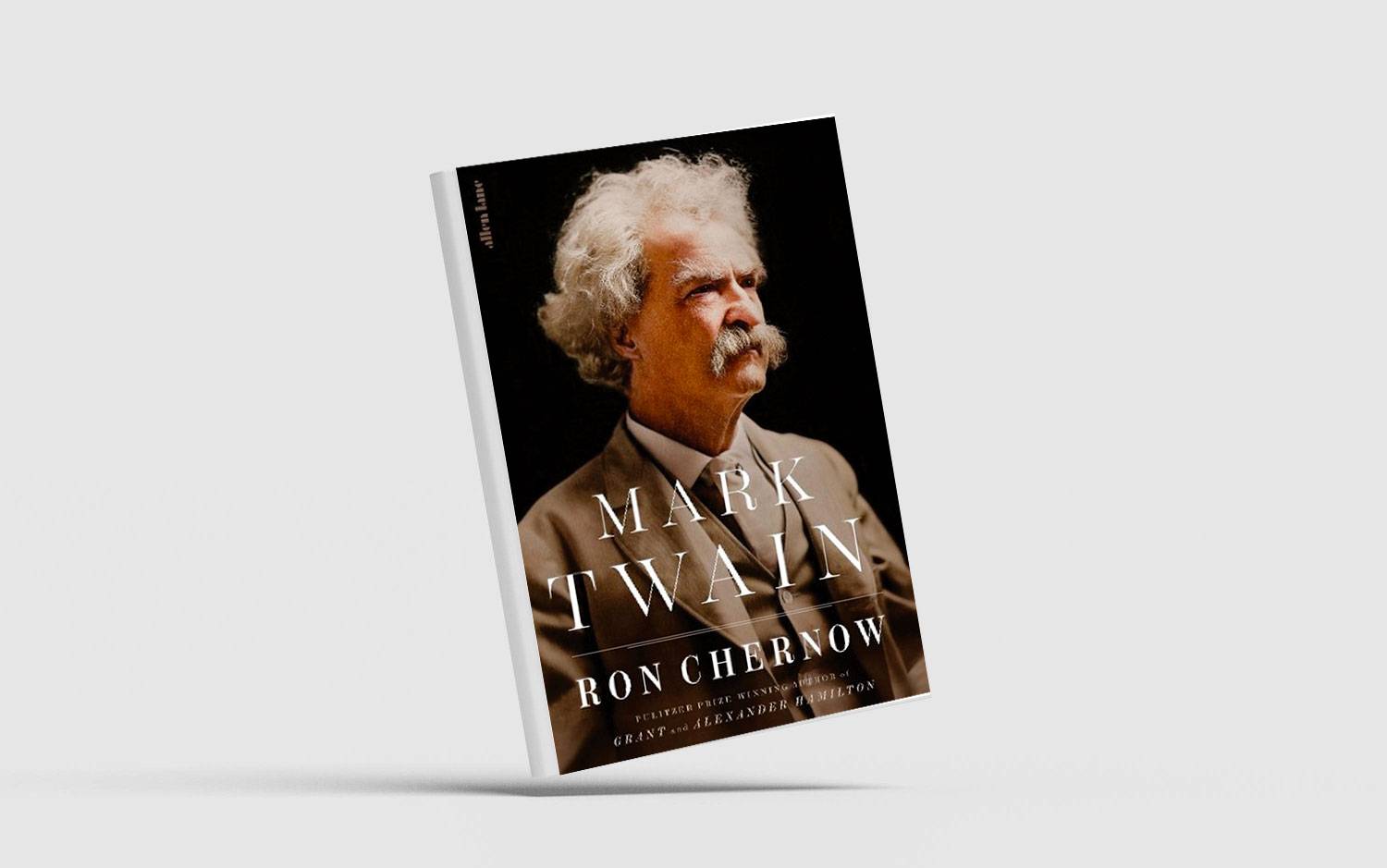شكلت بعضُ الأسماء الأدبية ما يمكن أن نطلق عليه لعنة الأجيال؛ بمعنى أن هناك أسماء شعرية وروائية وأدبية ظهرت في فترة من الفترات، فترسخت بشكل كبير، ولكنها في الوقت نفسه شكلت حاجزاً أمام الأجيال التي تليها، والحاجز المقصود منه هو الحاجز الدعائي، وليس الإبداعي، وهذه الظاهرة منتشرة في معظم الدول العربية، ولا يمكن أن نستثني منها أحداً إلا بنسب متفاوتة، كالعراق ومصر والشام، ذلك أنه على الرغم من وجود الجواهري والسياب، فإنهما لم يستطيعا أن يسحبا البساط من الأجيال اللاحقة، فظهرت بعدهما أسماء كبيرة راسخة في الشعر، فالسياب لم يمنع اسمه من ظهور وانتشار سعدي يوسف أو يوسف الصائغ وآخرين، وكذلك الجواهري لم تمنع سطوته الكبيرة من ظهور وانتشار عبد الرزاق عبد الواحد أو مصطفى جمال الدين أو عبد الأمير الحصيري، وكذلك في الرواية إذ لم يستطع غائب طعمة فرمان ولا فؤاد التكرلي أن يكونا الخيمة الوحيدة للرواية في العراق، فعلى أهمية اسميهما الرائدين، فإن الروائيين العراقيين واصلوا النتاج والحضور في الوقت نفسه، فظهر عبد الخالق الركابي ومحمد خضير وأحمد خلف وعشرات آخرين، ومن بعدهم ظهرت أجيال أخرى حققت حضوراً طيباً في المشهد الأدبي بشكل عام.
إنَّ ظاهرة اختصار إبداع بلد ما بشخصية من الشخصيات هي ظاهرة عامة على ما يبدو. فمن خلال فحص المشهد الثقافي لعدد من البلدان العربية، نجد أن محمود درويش يكاد أن يكون فلسطين كلها، فلا يُذكر الشعر في فلسطين إلا وكان درويش وجهه الأنصع، علماً بأن هناك شعراء لا يقلون جمالاً وإبداعاً عن درويش، كمريد البرغوثي أو طه محمد علي، والأخير يكبر درويش بعشرة أعوام، وحين قرأتُه كأنَّي أكتشف روح الشعر من جديد، فمثلاً قصيدته «انتقام» أحد أهم النصوص في شعرنا الحديث، كما أزعم، ولكنها مغيبة عن ثقافتنا ووعي أجيالنا. يقول فيها: «أحياناً/ أتمنى أن أبارز الشخص الذي قتل والدي/ وهدم بيتنا/ فشردني/ في بلاد الناس الضيقة/ فإذا قتلني/ أكون قد ارتحت/ وإنْ أجهزتُ عليه/ أكون قد انتقمتُ/ لكن.../ إذا تبيِّن أثناء المبارزة/ أن لغريمي أمَّاً تنتظره/ أو أباً يضع كفَّ يمينه/ على مكان القلب من صدره/ كلَّما تأخَّر ابنُه/ ولو ربع ساعة/ عن موعد عودته/ فأنا عندها/ لن أقتله إذا تمكنتُ منه/ كذلك أنا لن أفتك به/ إذا ظهر لي أن له إخوة وأخوات/ يحبَّونه/ ويديمون تشوقهم إليه/ أو إذا كان له زوجة ترحب به، وأطفال لا يطيقون غيابه/ ويفرحون بهداياه/ أو إذا كان له أصدقاء أو أقارب/ جيران أو معارف/ زملاء سجن/ رفاق مستشفى/ أو خدناء مدرسة/ يسألون عنه ويحرصون على تحيته/ أما إذا كان وحيداً/ مقطوعاً من شجرة/ لا أب ولا أم/ لا إخوة ولا أخوات/ لا زوجة ولا أطفال/ من دون أصدقاء ولا أقارب ولا جيران/ من غير معارف/ بلا زملاء أو رفقاء أو أخدان/ فأنا لن أضيف إلى شقاء وحدته/ ولا عذاب موت ولا أسى فناء/ بل سأكتفي بأن أغض الطرف عنه/ حين أمر في الطريق/ مقنعاً نفسي/ بأن الإهمال بحد ذاته هو أيضاً/ نوع من أنواع الانتقام». إن مثل هذا النص الهائل كان يجب أن يكون في كل مناهج الدراسة لطلابنا، وفي كل مدننا وبلداننا، لأن فيه روحاً كبيرة تدعو للتسامح والسلام، بطريقة مختلفة عن السائد، ومن دون ضجيج وعنتريات.
إنَّ مثل هذه النماذج العالية كثير في العالم العربي، إلا أن هناك أسماء -كما قلنا- ترسخت وأصبحت تابوهات لا يمكن المساس بها أو انتقادها، وأصبحت أشبه باللعنة على الأجيال التي تأتي بعدها.
أسوق هذا الحديث لأمرَّ على منطقة إبداعية غاية في الثراء والجمال، وهي السودان، كنت يوماً ضيفاً فيها على «بيت الشعر في الخرطوم»، ذلك أننا جميعاً حين نتذكر السودان، فإننا نذهب مباشرة باتجاه «محمد الفيتوري» في الشعر، وباتجاه «الطيب صالح» في الرواية. وهذه إشكالية كبيرة في أنْ تُختصر المدن والبلدان بأسماء محددة -على أهمية تلك الأسماء- وهذا الكلام ليس انتقاصاً لتجارب هؤلاء الكبار، قدر ما هو إضافة للمشهد الذي ترسخ بأذهاننا، فالشعر الحقيقي ربما ينزوي في مناطق معتمة بعيدة عن الضوء، ولكنها مناطق غاية في السحر غاية في التجاوز الجمالي، إلا أنها مناطق ينقصها الظهور، وربما كما يقول أدونيس «إن الشاعر كلما كثر جمهوره ضعفت شاعريته». أعود إلى السودان الذي ذهبت إليه في الزيارة الأولى وأنا محملٌ بـ«الفيتوري والطيب صالح»، ولكننَّي على أرض الواقع وجدت عشرات الفيتوريين وعشرات الطيبين الصالحين، غير أن الشهرة تكتفي دائماً بالقطارات التي تصل، وتغض الطرف عن القطارات التي لم تصل بعد. ففي السودان مثلاً، وجدتُ جيلاً كبيراً من الشعراء والشواعر مهمومين بالقصيدة وتحولاتها، منشغلين بشكل جاد بأهمية هذا التحول، وبوعي عالٍ بما يصنعون، أجيال مختلفة تفكر بشكل مختلف، متصالحة مع نفسها، وبالنتيجة هي متصالحة مع الأشكال الشعرية التي كانت في يوم من الأيام عقدة العقد، شعراء يقطعون عشرات ومئات الكيلومترات ليلتقوا، ويقرأوا الشعر تحت ظروف متعبة صعبة جداً، هل هناك جنون أكثر من هذا؟ وهل هناك انتماء للغة أكثر من هذا الانتماء؟
أجمل ما في الموضوع أنني وعدد من الشعراء كنا جالسين على منصة كبيرة في الجلسة الأولى لـ«ملتقى النيلين» والجلسة توشك على الانتهاء، وبلحظة دخل شيخ كبير ناحل جداً، بيده عصا والتعب بادٍ على وجهه، ولكن اللافت في الأمر أن الجالسين في السطر الأمامي نهضوا جميعاً له بإجلال وتقدير، فيما عريف الحفل توقف ليرحب به، وإذا به الشاعر الكبير «عبد الله شابو»، وإكراماً له لم ينهوا الأمسية، إذ استئنفت بقراءات جديدة، وحين أنهينا الأمسية بدأ يتلطف معه الشعراء الشباب، ويلتقطون الصور معه، ويرددون أشعاره بمرحٍ عالٍ وهو يلاطفهم ويمزح معهم، وحين سألت عنه واقتربتُ منه، وجدتُه أحد أكثر الأسماء الشعرية تأثيراً في السودان، أكثر ربما من الفيتوري، فهو القائل، وما أجمل قوله: «سيُكتب فوق الشواهد من بعدنا/ بأنا عشقنا طويلاً/ وأنا كتبنا بدمِّ الشغاف/ كأنْ لم يقل شاعرٌ قبلنا/ وأنا برغم الجفاف/ ملأنا البراري العجاف/ صهيلاً صهيلاً/ وأنا مشينا إلى حتفنا/ رعيلاً يباري رعيلاً/ وأنا وقفنا بوجه الردى/ وقوفاً جميلاً/ سيُكتبُ فوق الشواهد من بعدنا/ بأنا كذبنا قليلاً/ وأنا انحنينا قليلاً/ لتمضي الرياح إلى حتفها/ وأنا سقطنا سقوطاً نبيلاً». وحين سألت أكثر، وجدتُ التأثير الأكبر للتجاني يوسف بشير، ولمحمد المهدي المجذوب، ولصلاح أحمد إبراهيم، ولكن الفيتوري غطَّى بشهرته على هذه الأسماء، مثلما غطَّى أبو القاسم الشابي على شعراء تونس، وعرار على شعراء الأردن، ونزار قباني على سوريا.
السودان بلد ضاج بالشعر، صاخب بجنون أبنائه، ولادٌ للأجيال الشعرية، فهذا المتوكل زروق أحد شعراء جيل التسعينيات السوداني، إن صحت التسمية، هو وأسامة تاج السر وعشرات آخرون. يردد زروق نشيده مع الفقراء: «قلتُ ألا أكون مكانك/ كي لا تراك كما لا تريد/ فقيراً من الناس/ يحرسك اليأس من نوره المستطاب»، أو أسامة تاج السر الذي يؤمن بالشعر معبراً لروحه، حيث يردد: «بروحي وما روحي سوى خفقة الورى/ أعاصير هبت تبتغي الشعر معبراً»، أو الواثق يونس المفتون بروح الشعر: «من هنا يبدأ الصاعدون/ إلى الزرقة الأبدية رحلتهم فارهين/ تترقرق ذائبة في شفاه الكؤوس/ ابتسامتهم والشجون/ وتحرسهم نجمة عالية». والواثق على الرغم من جمالية ما يكتب، فإنه دائماً يرغب في أن ينادى عليه بالفيتوري الصغير، حباً وتعلقاً بمحمد مفتاح الفيتوري، حتى أن أصدقاءه دائماً ما يمازحونه بهذا الطرح. وهناك كثير من الشعراء السودانيين الذين انصهروا بالشعر، فشكلوا جيلاً صلداً مؤمناً بقضية الشعر وأهميته، ومنهم: إدريس نور الدين، وحاتم الكناني، والواثق يونس، وأسامة تاج السر، والسر مطر، ومحمد عبد الباري الذي يختط له اسماً كبيراً في الشعرية العربية. أما الظاهرة الأخرى، فهي الشواعر السودانيات، حيث وجدتُ عدداً بهياً منهن يحتل مكانة ممتازة في الشعرية السودانية، ويتحركن بحرية عالية في كتابة الشعر ونشره، وفي الحضور في الملتقيات العامة، وأنا أعتقد أن وجود الشواعر هو دليل عافية للثقافة في السودان، ذلك أنه كلما نبتت شاعرة في بلد ما، فإنَّها تشكل وخزة في بالون العادات المتحجرة. ومن الشواعر السودانيات اللواتي فرضن حضوراً رائعاً في الأوساط الثقافية ابتهال تريتر، ومنى حسن، وروضة الحاج، ومناهل فتحي، ودينا الشيخ، ووئام كمال الدين، وشيريهان الطيب. والأخيرة يعدونها آخر عنقود الشواعر السودانيات. ولو تمثلتُ بنصوص لتلك الشواعر المهمات لما اكتفينا بمقالة أو مقالتين، ولكني أورد هذه الأسماء -وقطعاً هناك أسماء أخرى أغفلتها سهواً- للتدليل على أهمية المشهد الشعري وحيوية عافيته في بلد ربما غفل الإعلام الثقافي أن يسلط عليه بعضاً من الضوء، ولهذا ضاعت علينا جواهر كثيرة.
ما لاحظته أيضاً أن بيت الشعر في السودان شكل رديفاً للمؤسسات الثقافية الرسمية هناك، فقد وجدته حاضنة لمعظم إبداعات السودانيين، ممتلئاً بورش عمل نقدية وجمالية.
لعنة الفيتوري على شعراء السودان
أسماء شعرية وروائية وأدبية شكلت حاجزاً أمام الأجيال التي تلتها


لعنة الفيتوري على شعراء السودان

لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة