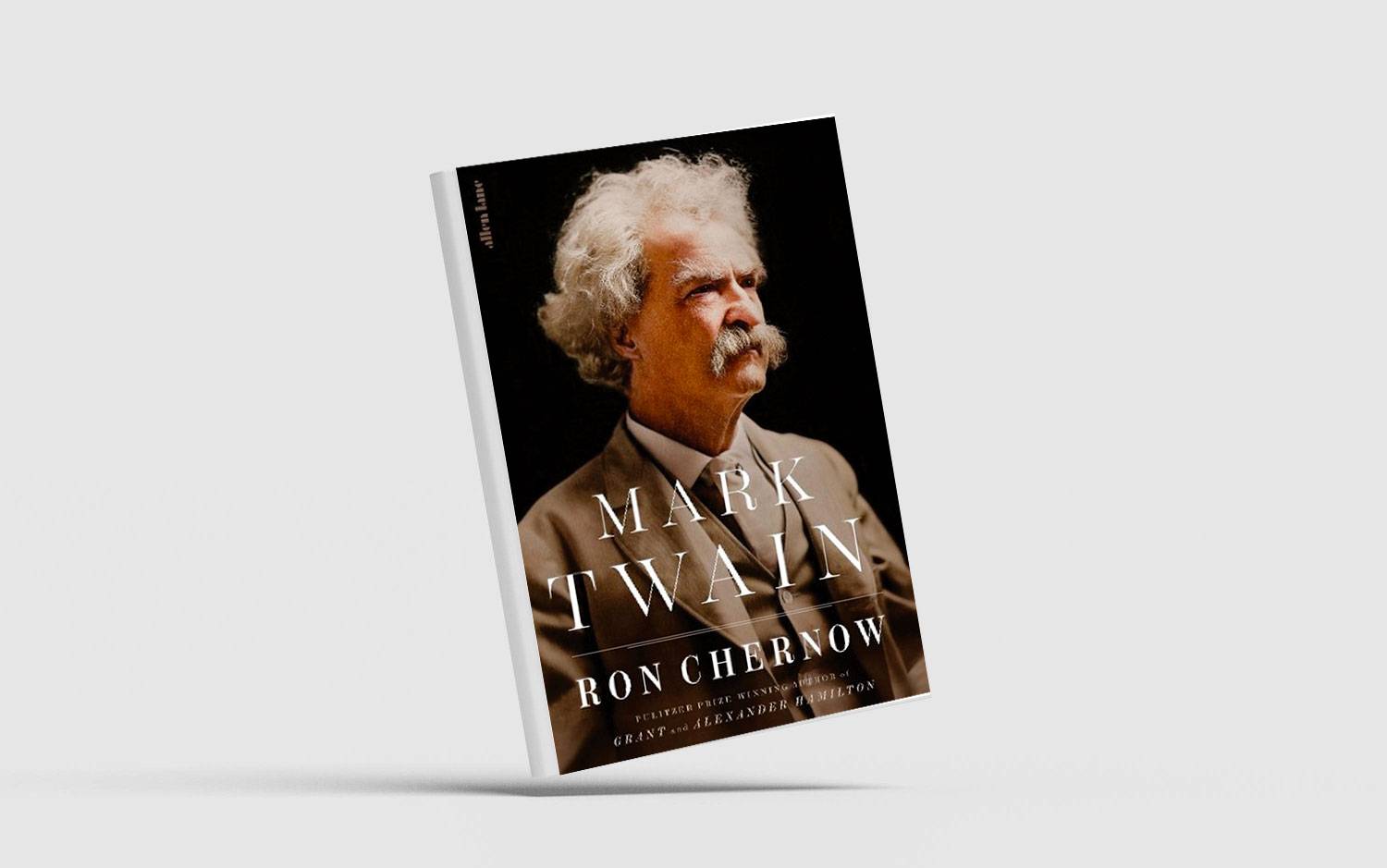يُروى أن أبا العلاء المعري كان له مجلسٌ أدبي في بغداد، يرتاده مئات الشعراء، وكل شاعر يتأبط ديوانه، ولكنما بعد سنوات طويلة لم تستطع الذاكرة الشعرية أن تحتفظ بشاعرٍ واحد من هذا المجلس، وبقي المعري وحده فيه، حيث لم يكن بمقدور غربال الزمن أن يغربل شعر المعري، أو اسمه، أو قلقه، فيسقط منسياً، إنما بقي على عناد الذاكرة الشعرية الصعبة، وقبل المعري هناك المتنبي العظيم، الذي يُروى أيضاً أن مجلس سيف الدولة الحمداني كان يغص بالشعراء، فالعشرات والمئات منهم كانوا يموجون ويروجون في مجلسه، ولكن بعد سنوات لم يبق غير المتنبي راسخاً في وجدان الذاكرة، وطرياً حتى هذه اللحظة.
إن هناك نماذج كثيرة في خارطة الشعر العربي تُشبه هذين النموذجين في البقاء والخلود ومقاومتهم للزمن، وبهذا المدخل أردت الحديث عن الشعرية العراقية، ومدى إمكانية الشعراء في الصمود والبقاء في محنة الشعر، منذ النصف الثاني من القرن العشرين على أقل تحديد، وظهور فكرة الأجيال الشعرية وصراعات الحداثة والتجاوز، فقد تخبرنا سرديات الأدب من خلال تفوهات الشعراء، ومن خلال المدونات الموجودة لدينا، ولدى كثيرين أن أعداداً كبيرة وكثيرة من الشعراء تظهر في كل حقبة زمنية، وتستمر لسنوات بسيطة، ولكنها تختفي فيما بعد، وما يتبقى من هذه الحقبة أو الجيل الشعري إلا شعراء لا يتجاوزون أصابع اليد، أو اليدين على أكبر تقدير، هذا الكلام أسوقه بعد أن جمعتني بالقاضي رحيم العكيلي سهرة مع أصدقاء مثقفين، فقرأنا شعراً، فيما سمعنا قصيدة لرحيم العكيلي، فاستغربنا أن القاضي الحاد الملامح، والصارم، كان يكتب شعراً، وشعراً حديثاً معتمداً التفعيلة، وفيه مستوى رائع من النضج، فقلتُ له متى كتبتَ هذه القصيدة؟ فقال في عام 1986 أيام دراسته القانون، ومن بعدها أخذته الدراسة، ومن ثم إكماله الدراسة في معهد القضاء العالي، وكذلك العمل في هذا السلك القضائي، فنسي، أو تناسى الشعر، لتأخذه الحياة إلى مسلك آخر بعيد كل البعد عن الشعر.
ماذا لو استمر رحيم العكيلي في كتابة الشعر؟ هل سنربحه شاعراً جيداً ونخسره قاضياً عادلاً؟ أم أن بقاءه في القضاء أفضل للعدالة من بقائه في الشعر؟ والسؤال الذي بقي يراودني كيف يستطيع الشاعر أن يقتل شيطان الشعر الصغير الذي ولد معه، واقترن به في لحظة من اللحظات؟ كيف يتخلى الشاعر عن كم الموسيقى التي تحتل رأسه في الليل والنهار؟ وكيف يمكن للقصيدة أن تنسحب بهدوء دون أن تثير ضجة حولها أو تصرخ عالياً حين يسحبونها من روح الشاعر، وإلى أين ستذهب هذه القصيدة؟ وكأنها جنين يُجهض في الليل، هذه الطريقة في التعامل مع الشعر ذكرتني بسلالة الشعر العراقي وحقبه الكثيرة، فقد ذكر لنا مرة الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد أن السياب جاء به إلى المقهى وكان ذلك بداية الخمسينيات، وقد كان من ضمن الشعراء الجالسين في المقهى رشيد ياسين وكاظم جواد، حيث عرف السياب بعبد الرزاق، إذ لم يكن معروفاً ككاظم أو رشيد، وطلبوا منه أن يقرأ شعراً، يقول عبد الرزاق إن الجالسين لم يتفاعلوا معي، وكان رشيد ياسين أكثرهم خشونة معي، ولكن بعد سنوات خمس أصدر عبد الرزاق ديوانين وعُرف في الأوساط الشعرية كشاعرٍ مكرس، وأصبح صديقاً حميماً لـرشيد ياسين، يقول عبد الرزاق إنهما كانا يتمشيان هو ورشيد على جسر الأحرار ببغداد، فقال له رشيد: تذكر يا عبد الرزاق يوم جاء بك السياب إلى المقهى قبل سنوات، وقرأتَ لنا شعراً، بعدها غادرت، كنتُ أقول للجميع إن هذا الشخص كان عليه أن يشتغل «قصاباً» أولى به من كتابة الشعر، لأنه لا يصلح أن يكون شاعراً، فضحك عبد الرزاق وقال لرشيد ياسين كما روى لنا عبد الرزاق: «كنتُ أركض فلا أراكم، أسرعتُ من ركضي فرأيتُ غبار خيولكم، وبعد أشهر بدأتُ أراكم بشكل جيد، ومرتْ سنتان، فإذا بي أركض معكم في نفس المضمار، أما الآن فإني ألتفتُ خلفي، فلا أرى أحداً منكم»، يقول عبد الرزاق ما إنْ أكملتُ جملتي الأخيرة حتى أمسك بي رشيد ياسين وأقسم أن يرميني من على جسر الأحرار بنهر دجلة، لولا تمسكي بالسياج الحديدي للجسر. وبالفعل استطاع عبد الرزاق أن يستمر شعرياً فيما اختفى صوت رشيد ياسين، وليس له تأثير بمجمل الشعرية العراقية رغم وعيه العالية وثقافته الموسوعية، وكذلك كاظم جواد، الصوت المثقف في جيله الخمسيني، الذي يصفه السياب بأنه سيكون من أكبر الشعراء، ولكنه للأسف لم يستطع أن يواصل المشوار، واكتفى بمجموعة شعرية واحدة (من أغاني الحرية) فيما كان صوته الأعلى بين أبناء جيله، شاعراً ومترجماً ومثقفاً.
إن أمثال كاظم جواد العشرات من الأسماء الشعرية التي تظهر في بداية حركة أي جيل، حيث يُعرفون على نطاق واسع، ولهم حضور فاعل في الوسط، وفي كتابة الشعر، ونشره، ولكن يبدو أن لهم صلاحية محددة تنتهي بسنوات قليلة جداً، رغم أن البعض منهم يمتلك موهبة ممتازة، وربما هناك أسباب موضوعية تمنع الشاعر من التواصل، كالسجن أو النفي، خصوصاً في فترة الصراعات الآيديولوجية، وتكميم الرأي، والبعض منهم من أكلته الحروب، وأنهكته الحياة، وهناك من أخذته متاعب الأيام فسلك طرقاً أخرى، وترك الشعر وراء ظهره، والبعض منهم عُرفوا بتوقيعهم على بيانات شعرية تدعو لحداثة القصيدة، كما حدث مع عبد الحسين صنكور، الذي اختفى اسمه شعرياً من الوسط الثقافي، فيما بقي توقيعه حياً على بيان القصيدة اليومية، فكيف من كان مهموماً بتحديث القصيدة أن يكتفي بالتلصص على التجارب الشعرية من بعيد وينظر لها وهي تتفتح دون أن تكون له يدٌ بسقي بعض منها، فأين يختفي ذلك الشغف من روح الشاعر في الكتابة؟ أو الحضور في مهرجان؟ أو السفر من بلد إلى بلد آخر لقراءة قصيدة واحدة؟
إن هذه الظاهرة تنتشر في معظم الأجيال والحقب الشعرية، أما جيلنا التسعيني فتبدو عليه بشكل واضح ربما لمعرفتنا المباشرة بالأسماء الشعرية، لأن هناك العشرات من الأسماء التي بدأت بالكتابة أوائل التسعينيات، وانهمكت بالشعر كثيراً، وبالكتابة، واللقاءات، والنشر، والمهرجانات، ولكنها فجأة تذوي (كما تذوي الزنابق في التراب) كما يقول عبد الوهاب البياتي، فمثلاً كان الشاعر عباس دعدوش واحداً من بين أكثر أبناء جيلنا ــ وهو يكبرنا بعشر سنوات تقريباً ــ ولكننا كنا معاً، وهو دائم الحركة والقراءة، وله علاقات مع كبار الشعراء في البلد، وطبع على ما أذكر عملاً واحداً، ولكنه اختفى فجأة من الشعر، وحين نسأل عنه يقولون إنه ترك الشعر نهائياً، أين ذهب صخب عباس دعدوش وجنونه؟ ومثله كثيرون من أبناء جيلنا كالشاعر علي محمد سعيد الذي بدأ شاعراً وانتهى مخرجاً أو عباس فاضل عبد الذي أخذه الإخراج والتلفزيون أيضاً، وكذلك الشاعر الطبيب فائز يعقوب الحمداني الذي كان شغوفاً بالشعر، ولكنه الآن مختفٍ تماماً عنه، وعن تجمعاته، ونشره، وكذلك كان معنا شاعر آخر، نصف صعلوك أحببنا فيه روحه، وتمرده، وشقاوته، وحين قرأ لنا بعضاً من نصوصه انبهرنا به وبها، فهو يقول قبل أكثر من عشرين عاماً:
منفي فيك
صيرتُ دماءك فردوساً
وزرعتُ الروح شبابيك
لم نصدق أن يخرج هذا الشعر من هذا الصعلوك، وهو بأعلى مناسيب العذوبة والحزن، إنه واثق البيك، الاسم الذي كنا نتوقع أن يكون نجماً في سماء الشعرية العراقية، ولكنه انسحب بعد سنوات قليلة، ولم يطبع أي عمل، واتجه للجامعة، ليكمل دراسته في علم الاجتماع، فأكلته الأكاديمية، وسحبت الوظيفة أقدامه، فروضت ذلك الصعلوك المتمرد وأطفأت قنديل الشعر في روحه، وحين نلتقي ــ بعض المرات ــ في المقاهي، ليس لنا حديثٌ معه إلا السؤال الأزلي: أين ذهب ذلك الشغف بالشعر؟ فيجيبنا بالضحك أو الندم أو الصمت.
حين ينسحب الشعراء من المسرح
عشرات من الأسماء بدأت بالكتابة لكنها ذوت فجأة

رشيد ياسين - بدر شاكر السياب - عبد الرزاق عبد الواحد - رحيم العكيلي

حين ينسحب الشعراء من المسرح

رشيد ياسين - بدر شاكر السياب - عبد الرزاق عبد الواحد - رحيم العكيلي
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة