في مجموعته القصصية الجديدة «مخاوف نهاية العمر»، يلعب الكاتب المصري عادل عصمت، على دراما الموت كمحور إيقاع خفي للسرد، خصوصاً أن أبطالها يقفون على مشارف موت يُغازلهم، أو موت يقتلعهم دون نذير، وآخرين يجدون من أحبوا في مرمى الغياب، تزورهم أطيافهم مُحملة بأمانات ورسائل وشذرات من حكايات لم تكتمل بموتهم.
تضم المجموعة القصصية الصادرة حديثاً عن دار «كتب خان» للنشر والتوزيع بالقاهرة، سبع قصص تتراوح من حيث طولها، ومسارح أمكنتها، بين ريف ومدينة وغربة ووطن، يجمع الموت بين شتاتها كخيط سحري له حضوره الذي يُشكل الخيالات والأفئدة ويطرح أسئلة شائكة يُجددها الغياب دائماً، فالموت ليس صيغة للحداد في قصص القصصية بقدر ما هو صيغة لتأمل الحياة، وهشاشتها، وأطماعها. في قصة «مخاوف نهاية العمر» التي تحمل المجموعة اسمها، تفزع سيدة عجوز من صوت غربان سارح في الليل، تُصاب بهلع يقودها للبحث عن مصدر أصوات نعيقها النذير بالشؤم، وفي مسار موازِ تتعثر في مخاوف وشكوك بسبب شعورها الدائم أن أهل بيتها من أبناء وأحفاد يترقبون موتها باعتبارها مالكة البيت الذي يتطلعون لبيعه وتقسيم ثمنه فيما بينهم، فيما ترفض هي هذا البيع، لتنتقل العجوز من دائرة الشك والخوف إلى حلقة أوسع من الجنون والوساوس الذي ظل يتجسد لها عبر صوت الغربان، ولعل الاستعانة بالأصوات هي أحد الأركان الفنية التي جنح عادل عصمت لتطعيم سرده بها، ليس فقط كاختيار لغوي جمالي، وإنما كوظيفة سردية دلالية، مثل «نعيق الغربان في الليل»، و«حفيف أقدام تنزل السلم»، و«صرير عجلات الكارو»، و«صياح ديك تخايل له الفجر»، فالأصوات في المجموعة ذات ملمس حسي يُعمق مشاعر أصحابها المُدججة بالخوف والترقب والشجن.
يستدرج الموت المعانِي، وأحياناً الغرائبيات التي تستقطر منه خلاصة الجمال وعذاباته، ففي قصة «زينب فخر الدين» تختفي زينب بعد أن تسللت من دارها في غشاوة الفجر دون أن يشعر بها أحد، عابرة الغيطان والترع حتى سلمت نفسها للنيل وغابت، يتعقب السرد الحكاية العلنية التي شاعت عن انتحار زينب، والأخرى الخفية، لتتأمل واحدة من عشرات الحكايات التي اندثرت تحت ركام الحياة، بعد أن تعددت تأويلاتها ما بين لعنات غيبية، وأخرى من ميراث الثأر الغالب في القرى، حتى يُسلم الكاتب أحد مفاتيح تأويلها لصوت راوٍ مغموس بالعاطفة، يُعانق روح البطلة التي ذابت في النهر، يقول إنها استسلمت للغرق «لكي تستعيد نفسها التي ضاعت منها، ذهبت لتُسلم زينب الحالية التي سكنتها كي تضيع في النهر وتتلقى الأخرى التي أضاعتها. لم تكن ذاهبة للموت وإنما إلى الخلاص»، يضع السرد تلك الكلمات على لسان أحد أقرباء زينب الذي ظل يحاول استجلاء مشاعره تجاه موتها الذي ترك فيه حيرة لا حدود لعمقها منذ صباه، محاولاً رسم ملامح لهذا الموت الذي يجري في النيل، فيتخيلها في مسحة أسطورية تنفض مرار ذكراها، وأنها «رحلت إلى أخوتها القديمات اللاتي نقاهن النيل من أسمائهن وملامحهن وأصبحن نسخاً مصفاة للجمال المبهر. رحلت لتتحول هي نفسها إلى جنية صغيرة تخرج للناس في ظهيرات الصيف».
يتدبر الأبطال الموت الذي يحيطهم، وذكريات من رحلوا ومتعلقاتهم ولو كانت على هيئة عبارات مُلغزة أرادوا بها أن تختصروا شيئاً من انطباعاتهم حيال الحياة، سواء كان هذا الرحيل بالموت المادي أو بالهجر، كما في حال بطل قصة «لن أتذكرك أبداً» الذي لم يستطع التعافي من هجر من أحبها له، وظلت آخر جملة باغتته بها: «لن أتذكرك أبداً» تشق قلبه مهما طال سفره وبُعده «كل تلك العلاقات والمتع والأبحاث والمحاضرات لم تكن قادرة على أن تعيد رتق روحه التي شقتها علياء ذات صباح»، يتساءل بطل تلك القصة: «لماذا يريد الإنسان أن يكون موجوداً أثناء غيابه؟ عليه أن يتوافق، بشكل ما، مع كونه لا شيء»، أحد الأسئلة المشربة بمسحة وجودية تبدو ملائمة لحضور الموت في فضاء المجموعة.
وكما لم يتمكن ذلك البطل من تجاوز قسوة عبارة من أحبها التي تمحق أي آمال لعودتها إليه، يستلب بطل «قصة الفجر» شعور ما بالذنب بعد موت «عم نسيم» الذي ظل يتحدث طيلة حياته عن سنوات سجنه، وأقسى لحظاته بها، وهي ساعة الفجر، ويتجاهل البطل سؤال عم نسيم عن سر استعذابه لساعة الفجر تلك بهذا الشجن والحنين، وما الذي كان يقصده منها، وبعدها يرحل عم نسيم ويواريه الموت تاركاً البطل في حيرة، تُطارده ذكرى عم نسيم ولغز ساعة الفجر التي كان يخشاها في السجن «لا يمكنني الآن، بعد رحيل عم نسيم، أن أحسم الأمر، وربما لم أتمكن أبداً، رغم أنني أخمن أحياناً، عندما أستعيد ملامحه وهو يحكي الحكاية، أنه كان يقصد أن الفجر يلوح جميلاً ومؤلماً من نافذة زنزانة، وأنه لولا السجن لما عرف المرء معنى الفجر».
فهكذا، في قصص المجموعة، الأحياء مشغولون بتخمين شفرات من غيبهم الموت أو الرحيل، وكأنهم في مهمة تنفيذ وصايا ضمنية، مفادها فهم رسائلهم والتعاطف معها، أحياناً يتراسلون في الأحلام، مثل بطل قصة «الوطن»، حيث يظل رغم ترحاله المستمر، يخشى من زيارة قبر أمه في قريته، تتداعى له قصة مرضها العضال، وتراجيديا استئصال جزء حميم من جسدها ليسبقها للموت، لتظل في أحلامه تعاتبه على أن موتها «ناقص»، لأن هذا الجزء لم يُدفن معها وظل في المستشفى، يؤلمه العتاب لدرجة تدفع البطل للهروب إلى حدود التلاشي، وأحياناً بالانغماس في صخب أصدقاء الصبا وأقاربه، لكنه يظل يفتقد شيئاً لا يجده، لا يُخلصه من ذنب وكابوس موتها الناقص، تقوده فكرة تبدلات الحياة، لمزيد من الشقاء والجنون، وترسخ لوحدته والشعور الدائم بالفقد. «يندهش من سخرية أصدقائه، فهم لا يرون مدى الألم الذي يشعر به من جراء هذه الفكرة. يقول إن فكرة التبدل مؤلمة مثل موت أمه أو وجع الكلى، لها حضور مادي مثل انشغالاتهم اليومية وحسابهم لمصروف الشهر، ويعود من حيث جاء، حزيناً، لأنهم يرون ألمه مجرد ترف، حياة بلا التزامات وهوى غريب أن يحقق لحظات شعرية على الأرض». إنهم بشر يحملون الموت كتعويذة أو لعنة، عيونهم دائماً مشدودة إلى ماضي من رحل، وكأنه حلم يطاردهم في خطواتهم المضطربة الكليلة.
أسئلة شائكة وشخوص على حافة الرحيل
عادل عصمت في مجموعته القصصية «مخاوف نهاية العمر»
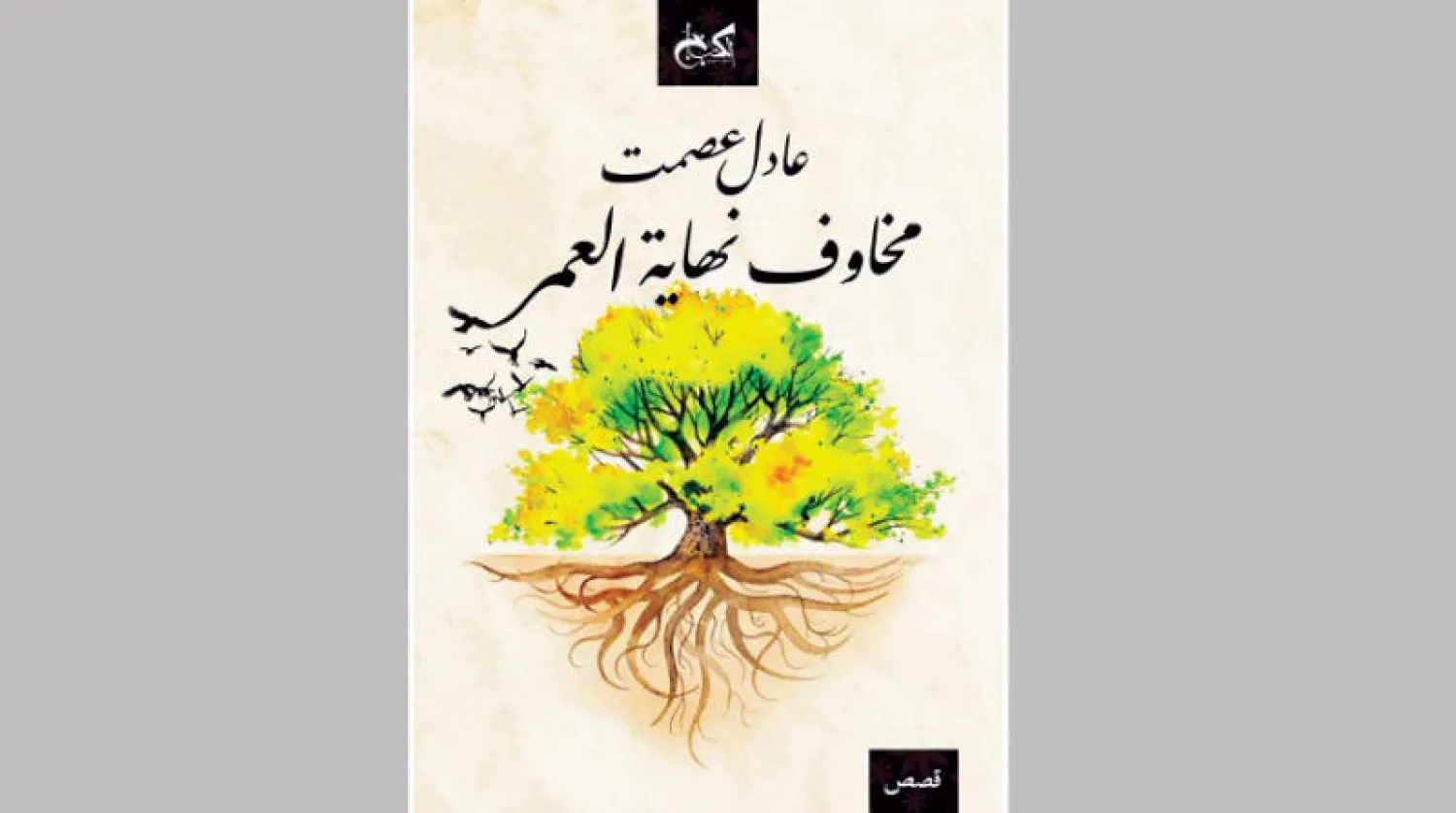

أسئلة شائكة وشخوص على حافة الرحيل
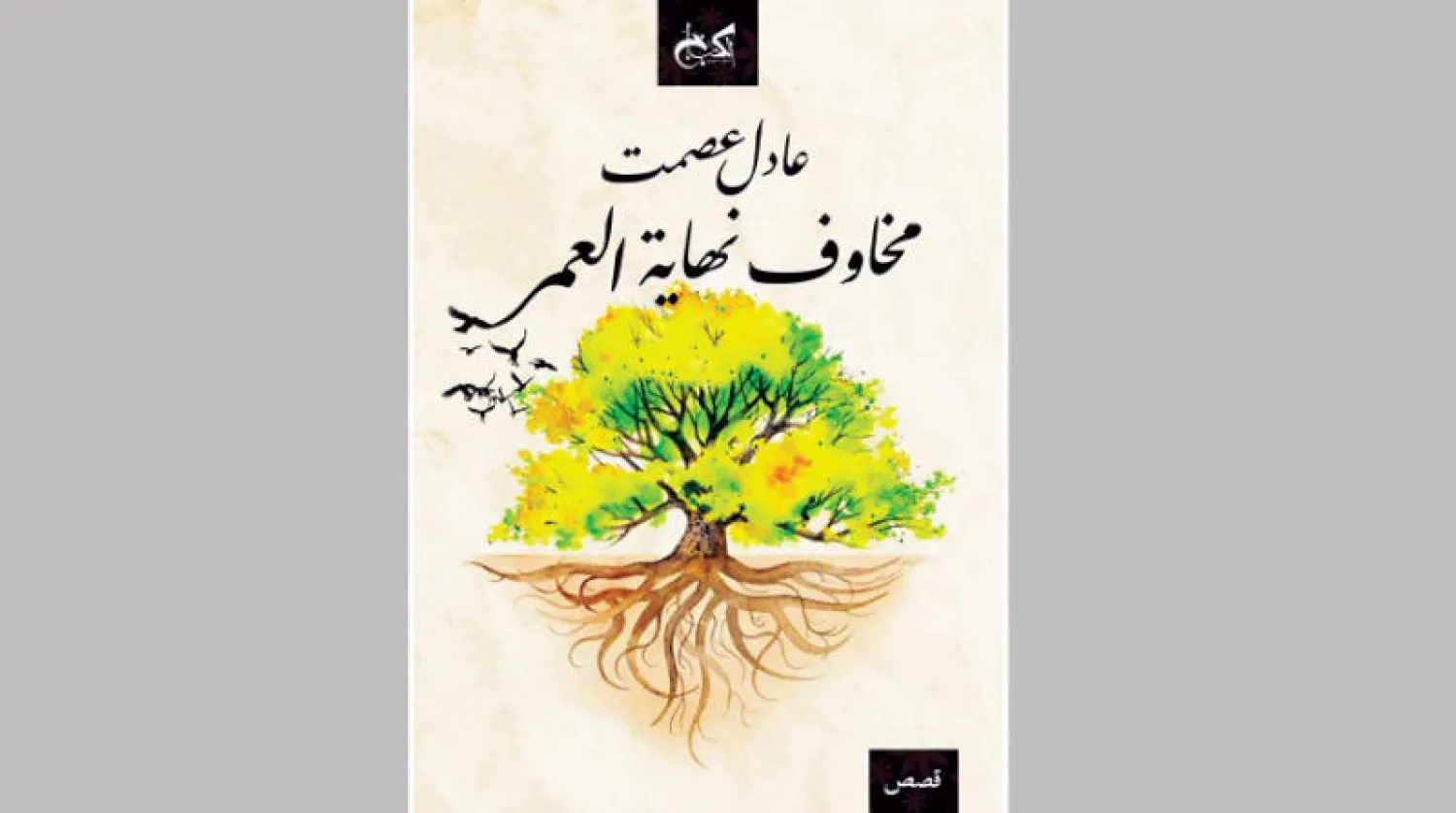
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة











