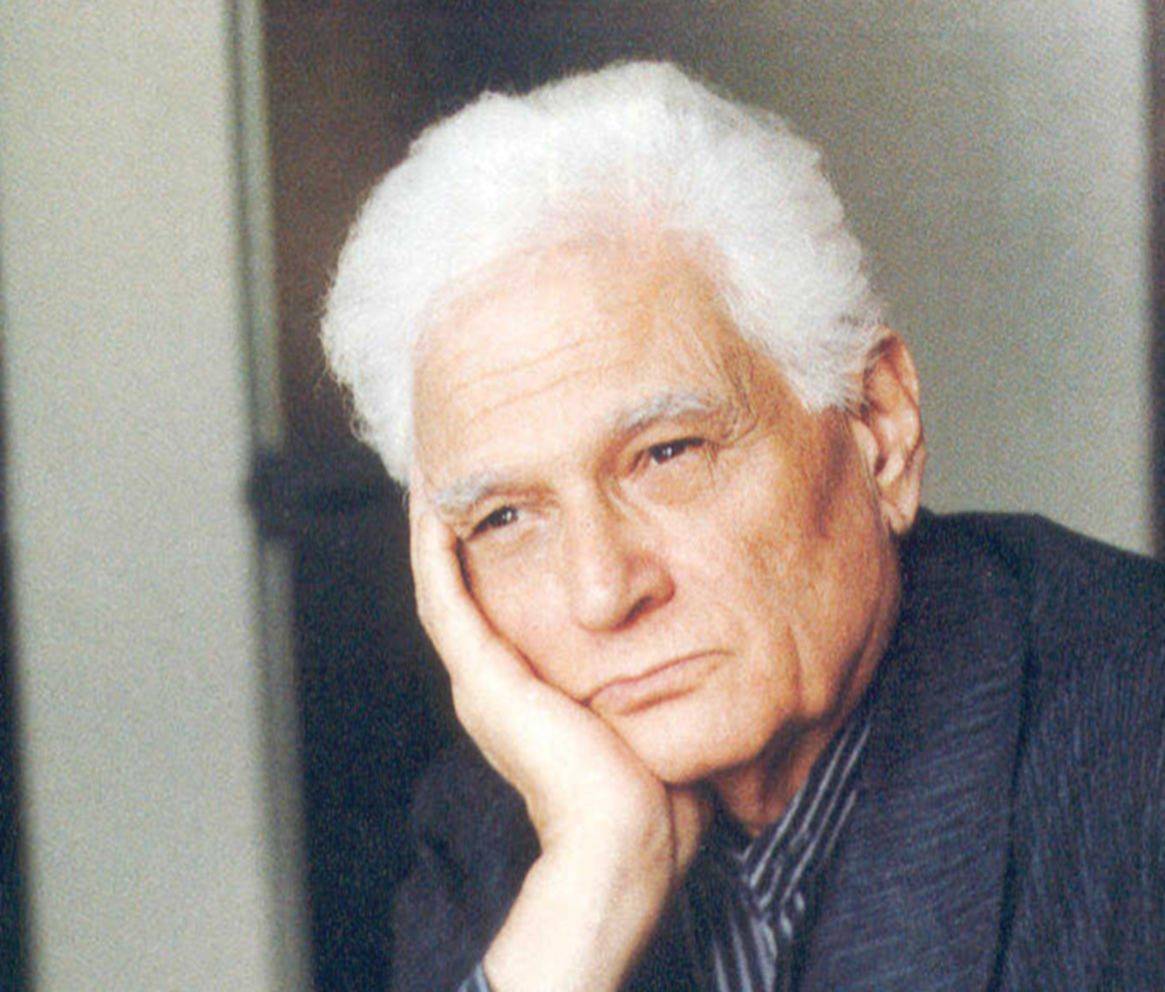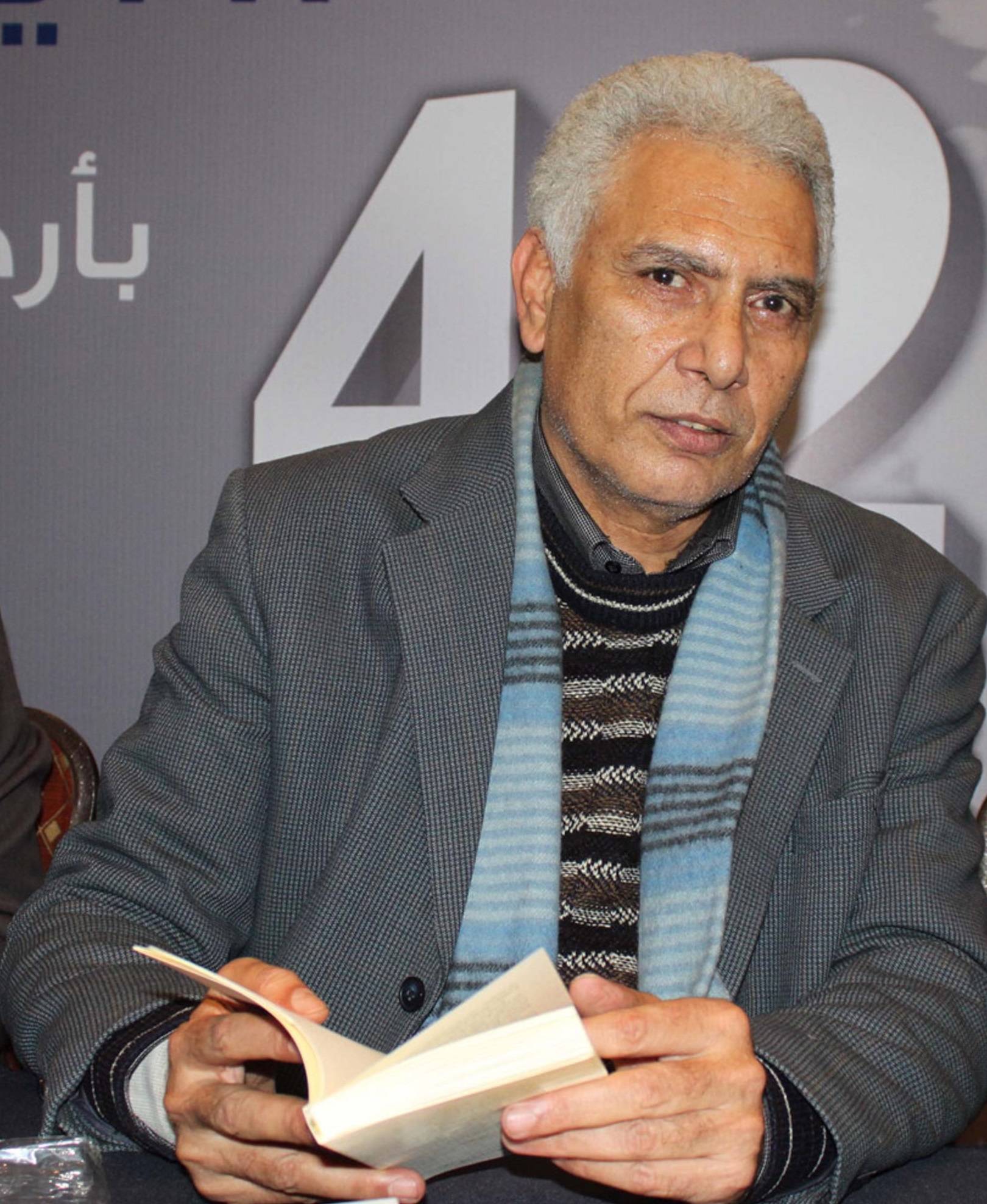لقّبه البعض بالمؤسّس الفعلي لعلم الاجتماع، وقيل عنه إنه يفكّر في القرن الرابع عشر بعقل أُعدّ للقرن العشرين. اهتمّ في كتاباته بقوانين العمران البشري، لذلك سمي مؤسّس علم العمران البشري، فكّك مفاهيم سيكولوجيا الشعوب والعصبية وأطوار انهيار الدولة، فكان من كبار المطوّرين للفكر السياسي، نظراً إلى حجم إسهاماته في فلسفة التاريخ والنظم السياسية. ذلك هو ابن خلدون الذي لا يزال يشغل الدنيا، وهذا يفسّر حجم المؤلّفات الصادرة حوله، من بينها كتاب «ابن خلدون وقرّاؤه» لأحمد عبد السلام، الصادر بالفرنسية وترجمه إلى العربية الصادق الميساوي، ونشره مؤخراً المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون «بيت الحكمة».
يشير المؤلّف في التمهيد إلى أنّ الكتاب يحتوي على دروس ألقاها في «الكوليج دي فرانس»، وهي تأتي في نظره ضمن تجديد الدراسات الخلدونية باعتبارها إشكالية الطابع وشديدة التنوع، فهي جامعة بين تعبيرية الفلاسفة ومصطلحات السوسيولوجيا ومفردات المؤرّخين. ومن هنا، استدعت أعمال ابن خلدون قراءات علمية متعدّدة المناهج، ومقاربات آيديولوجية مختلفة إلى حد التناقض التام، وهوما تجسّده الدراسات الاستشراقية للمقدمة، حيث تنسبها «حيناً إلى علم الاجتماع وحيناً آخر إلى فلسفة التاريخ»، بل أدّى الفكر الخلدوني إلى بروز مدارس مثل المدرسة الخلدونية في تركيا من أبرز رموزها حاجّي خليفة. كما اهتمّت بحوث استشراقية أوروبية بالمقدّمة أساساً «فقد لاحظ المستشرقون تشابهاً بين ما ورد فيها وأفكار أهل عصر الأنوار من أمثال مونتسكيو». وتكمن في هذا المجال النزعة التقدمية - التحررية والبعد الكوني لدى ابن خلدون، لذلك اعتبره جوزيف فون هامر برغستال مونتسكيو العرب، ويسميه آخرون مونتسكيو الشرق. كما يؤكّد صاحب «ابن خلدون وقرّاؤه» على أن اهتمام الاستشراق الأوروبي بابن خلدون لم يكن حكراً على بعض المؤرّخين والمهتمين بقضايا العمران البشري، بل خصّصت له مؤلّفات وحوليات وملتقيات على غرار ما نشره حوله الفيلسوف النمساوي فريديريك شولتر، المنبهر بعمق وعلميّة الأطروحات الخلدونية في المجالات السياسية والاجتماعية.
ومن حجج اعتناء الاستشراق الأوربي بابن خلدون في نظر الكاتب النقد المقارن بين صاحب المقدّمة وكبار الفلاسفة الغربيين، ففي هذا الصدد قارن المستشرق السويدي جاكوب غرابرغ دي همسو بين ابن خلدون ومكيافلي، مؤكّداً تأثير الفكر الخلدوني في صاحب الأمير، ومن تلك البراهين كذلك ترجمة المقدّمة إلى لغات عالمية، من بينها ترجمة كاملة إلى اللغة الفرنسية أنجزها دي سلان.
تلك هي القراءات الخلدونية متنوعة بتنوع القرّاء آيديولوجياً وإيبستيمولوجياً وسياقياً، ولا يمكن لأحد دحض مشروعية كل قراءة، بما في ذلك ابن خلدون نفسه، لأن النص ملك لقارئه، شريطة أن يمتلك الأدوات المعرفية الضرورية، فالمقدمة تحيل إلى تأمّلات فلسفية، وإن نفى ذلك بعض القراء، وفهمه للعمران البشري ينزّله البعض ضمن المبحث السوسيولوجي لكن يستوعبه بعضهم في سياقات معرفية مغايرة.
8:26 دقيقه
«ابن خلدون وقرّاؤه» مقاربات آيديولوجية متناقضة
https://aawsat.com/home/article/2417401/%C2%AB%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%82%D8%B1%D9%91%D8%A7%D8%A4%D9%87%C2%BB-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6%D8%A9



«ابن خلدون وقرّاؤه» مقاربات آيديولوجية متناقضة
نشره المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون «بيت الحكمة»


«ابن خلدون وقرّاؤه» مقاربات آيديولوجية متناقضة

لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة