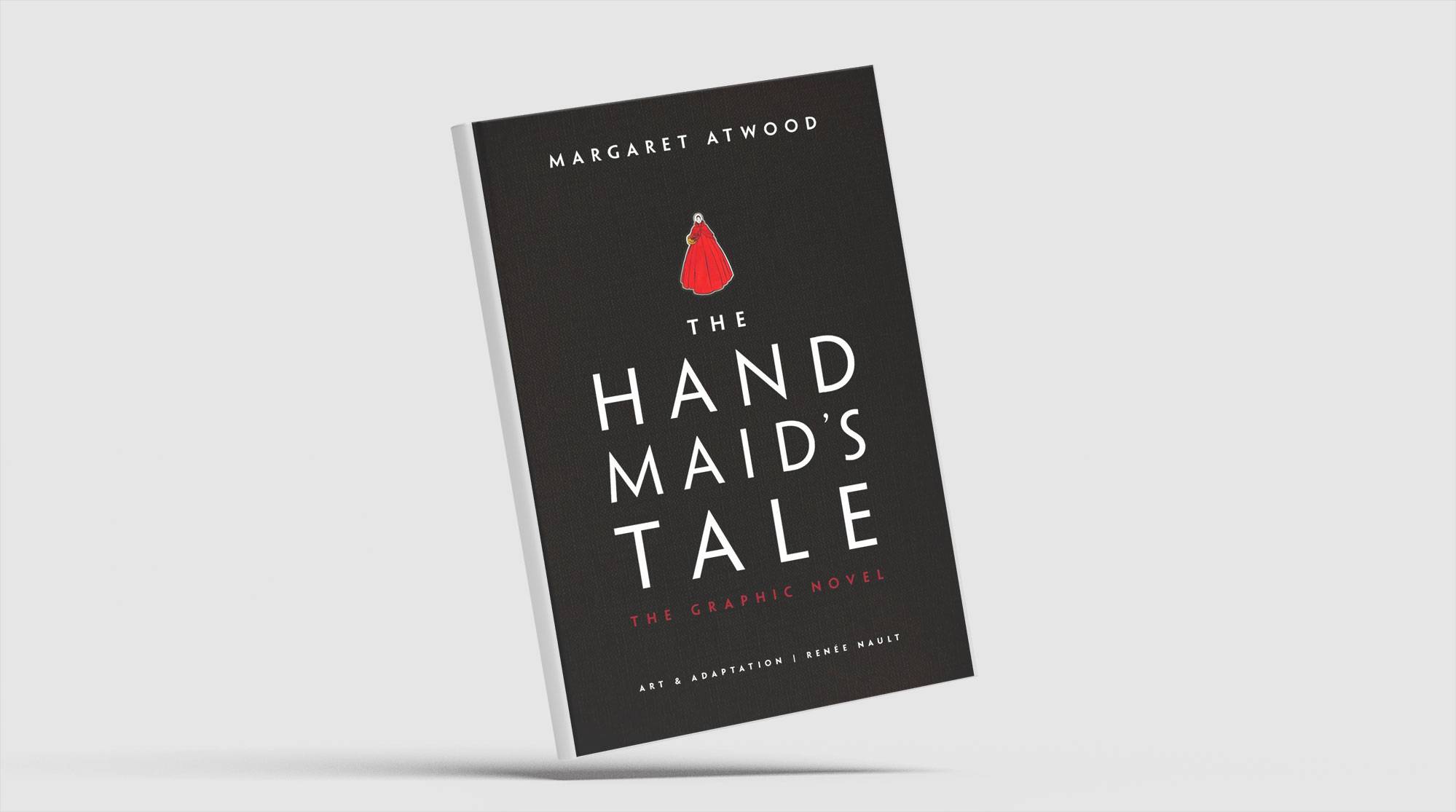يشكل هاجس التحول مرتكزاً جمالياً وفكرياً، يصعد منه الشعر ويهبط إليه، في ديوان «ألوان السيدة المتغيرة» للشاعر فاضل السلطاني، الذي صدرت نسخة مصرية منه حديثاً بالقاهرة، عن الهيئة المصرية العامة للكتاب. يتنوع هذا الهاجس في مناخات الديوان، مشتبكاً مع أزمنة وأساطير مسكونة برائحة الماضي والحاضر، وتقاطعات الأزمنة والأمكنة، بينما تدور الأشياء في فلكه بقوة الطبيعة والنص الشعري معاً.
بداية يتكشف هذا الهاجس في أضلاع المثلث التي وسمت عنوان الديوان، فالبصري والحسي يكونان ضلعيه في علاقة تجاور بين خطين يلتقيان في نقطة الذروة أعلى رأس المثلث بنسقه الهرمي، صانعة تفاصيل اللوحة شعرياً، بألوانها وخطوطها المفعمة بالأنوثة، بينما يرتكزان في الأسفل على قاعدة المثلث، الضلع الثالث الذي يتسم بالحركة في الثبات، حيث تكتسب القاعدة فعاليتها جمالياً من هذا التضافر بين الضلعين الآخرَين، ما يشي بالرغبة في التحول والخروج من أسر الإطار، كما أن الدال المضمر في مفردة «المتغيرة»، لا يأتي كتوصيف مجازي فحسب، بل يشتبك بصرياً وحسياً مع كل عناصر المثلث، ليمارس انزياحاً معرفياً، يقيه من الركون ليقين ما محدد، فالأشياء تمشي وراء الصمت والكلام، وفي الألوان والرائحة، وإيقاع الزمن الذي يجعل الذات دائماً قابعة في منطقة المنتصف، كحلقة وصل وقطع بين السابق واللاحق، بين البدايات والنهايات، بين الـ«هنا» والـ«هناك»، وهو ما يطالعنا في النص الذي يستهل به الشاعر القسم الأول «في منتصف الذاكرة» بعنوان صغير، كأنه برواز لـ«صورة»:
«هل تذكرين؟
كنتِ في وسط الصورة
وعلى جانبيك كانت الموسيقى تعزفُ
كأنها الموسيقى الأخيرة على الأرضِ،
وكنتُ أحار
كيف أميز العازفَ من العزفِ؟
والراقصَ من الرقصِ؟
كنتِ تجلسين وسط الصورة
لاهية عن الموسيقى،
عن لحظة ثبَّتتكِ إلى الأبد
صورة في إطار
وكنت أحار
كيف أدخلُ في الصورة؟
كيف أفصلُ النورَ عن الظلِّ؟
لكنكِ كنتِ تبتسمين
لاهية عن اللحظة
وهي تكبرُ خلف الإطار».
من هذا المنظور يمكن أن ننظر بعين العاطفة إلى حضور الأنثى في الديوان، ونرصد ملامحها وطبيعتها: هل ثمة أنثى خاصة مجبولة من طينة القلب والعشق، وهل هي مرادف للمنفى، أم لحضور الغياب، ورقرقة الحنين، وهل بدفقها تتجاوز الذات مراثي الفقد والغياب الحميمة لصورة الأم والأخت والأب، وبعض الأصدقاء في الكثير من القصائد... في قصيدته «عابرة في شارع دمشقي» يحسم الشاعر الإجابة عن هذا السؤال، الملتبس، بالتناص مع مقولة محي الدين بن عربي الشهيرة «شهوة الحب لا الحبّ». بينما ينكشف المعنى بشكل أوسع في قصيدة «ألوان السيدة المتغيرة»، حيث يصبح سؤال الأنثى مساءلة للزمن والذات:
«نحن في المنتصف الآنَ
أنسرعُ أم نعودُ؟
العشب الناهضُ يرقبُ أن ندخلهُ
والفجر الأبيضُ ينتظرُ أن نبلغهُ.
نحن في المنتصف الآن
وأنت تكبرين تحت ذراعي
مع الليل والعشبِ
كنت أريد أن أرى عينيكِ
بين الأزرق والأبيضِ
لكني رأيت دمعتين في عينيّ
تذكرتُ شاعراً وحيداً
أحب فقتلته الموسيقى.
...
كيف كبرتِ في لحظتين
والأرضُ لم تكمل دورتها
ونحن في منتصف الشارعِ؟».
ثمة حيرة مركبة للذات، تترى في النص، على شكل تساؤلات ومشاهد خاطفة، عن الصورة والإطار، بينما تدفق الألوان فوق السطح يعكس عقدة الزمن، فهو منقض، رهن زوال يجدد نفسه بشكل طبيعي في تعاقب الليل والنهار، لكن الصورة باقية، تمتلك القدرة على تثبيت الزمن في سقف الذاكرة والحلم، وعلى استحضاره بقوة العاطفة والحب في لحظة ما، كأنها الزمن كله، كأنها الحضور والغياب في قبضة النص.
اللافت في اللعب على جماليات الصورة في الديوان، قدرتها على الذهاب والإياب من وإلى الإطار ـ فلا تسعى إلى كسره، وبعثرته، وإنما تحتفظ به ولو ظل مجرد هيكل فارغ منها، فهو بمثابة حصن وملاذ لها من شرور العالم وآثامه، من صورة الطاغية والبشر المنساقين للحرب كرهاً حتى تظل الرايات المخادعة ترفرف في برك المجاري، كما أنها حصن من فراغ المنفى، ووحشة الظل والذكرى على ضفافه الآسنة، ومحاولة للتشبث بالصورة الأم في حضن الوطن، حيث ونس الروح والطفولة والصبا. ومن ثم يكسب هاجس التحول الصورة قوة الأثر، ويجعلها تعلو على تداعيات الحلم والذاكرة، وتصبح أفقاً مفتوحاً على احتمالات وحدوسات شتى، توسع من أفق النص ليستوعب فكرة التضايف بين الكائنات حتى في أقصى تناقضاتها شرهاً، في البشر والطبيعة والأشياء، وهو ما يطالعنا في قصيدة بعنوان «ليكن أحد/ لا أحد جنبي» يقول فيها:
«ليكن أحدٌ منكم جنبي
يحمل شيئاً عن كتفيّ،
يأخذ شيئاً من هذي الموسيقى
- تتسرب من أينَ؟ -
يدوّزنُ هذي النغمة حين تئنُ
كيلا ينهدّ جدارُ البيتْ.
ليكن أحدٌ منكم جنبي
يشغلُ عني هذا الموت
الواقفَ فوق الشرفة يرقبني
أن أدخلَ فيه،
يغلق عني هذا الباب
حيث يحوم طوال الليلْ
أحبابي الموتى،
يأخذ من قدمي رغبتها
أن تسعى في الأرضِ،
وينزع عن كتفيّ
وشمَ الكون المرسومَ
خطوطاً تتعرجُ
ثم تموجُ على الجسمِ،
تتلوى كالأفعى فوق العشبِ،
فلا يعرفها حتى الساحر.
ليكن أحدٌ منكم جنبي
يحرسُ هذا البيتَ
فلا تزحفُ نحوي قدمٌ
إلا قدمٌ خففت الوطءَ على الأرضِ،
ولا يتسرب صوتٌ
إلا صوتٌ نقّته النغمات».
إن هذا الرجاء المعلق بين الطلب كاحتياج وجود ويقين وحياة، ونفيه في الوقت نفسه، وتلويح الذات بالروغان منه يعكس في دلالته الأبعد محاولة للبحث عن يقين آخر، واحتياج آخر، يكمن فيما وراء اللغة، والنغمة والمعنى والصورة، إنه احتياج مسكون بضرورة توائم ما بين الحضور والتخفي، ما يجعل من الموسيقى حارسة للبيت والذات والوطن، والحضارة أيضاً.
ينعكس هاجس التحول على بنية الإيقاع في الديوان التي يهيمن عليها تراتبية نسق التفعيلة العروضي، بضرباته الواخزة عبر تواتر الحركة والسكون، لكن ما يحفف من هذه الترابية، خيط شفيف للموسيقى ينساب بسلاسة في تضاعيف الصورة الشعرية، نحسه في حدوسات أخرى للإيقاع كامنة في حركة البشر والحياة، في تماوج الظلال، ومساقط النور والعتمة، وكأننا إزاء حركيتين للإيقاع؛ إحداهما ظاهرة في بنية التفعيلة، بصدى رنينها فوق السطح، والأخرى خفية تجري في العمق، كأنه مصفاة موسيقية، تنقي الإيقاع من تراكمات النشاز، وتحفظ للصورة رقتها بعيداً عن صخب الحياة وضجيجها المفتعل.
للجغرافيا حضور بارز في بنية الصورة، بل إنها كثيراً ما تشكل الوعاء الذي يلملم ملامحها المتناثرة في شتات الزمن والتاريخ، وهو ما نجده في قصيدة «بابل.. بابيلون»، حيث يبرز الإيقاع كعلامة وشارة، متجسداً في اللعب بالذبذبة النغمية كجسر معلق يرفرف كفراشة في فضاء الذاكرة والطفولة، محض جناس مبتور يكمل بعضه بعضاً، بين بابل كجغرافيا حاضرة بقوة على شواطئ الفرات، وعشتار كأسطورة وصدى لأيقونة بابلية شكلت رمزاً للخصب والنماء، عشتار القابعة على سرير خشبي في متحف برلين، تنتظر من يخلصها من وطأة المنفى والاغتراب، ويردها إلى صدر الوطن الأم، وكأن فكرة المخلص تكمن في رحم الأسطورة التي ينفتح منها النص على الآخر في ومضات تناص خاطفة لشعراء مثل إليوت، ولوركا، وألكسندرا بلاستيرا، وجاك بيرل، يعلق في غبارها دبيب البشر في المكان، الذي يلوح أيضاً في إشارات نصية أخرى، تستحضر رائحته من نهري الفرات والتيمز، ولندن ونيويورك، وبابل، ويبني النص تفجره من جملة مفتاحية تتكرر بين فواصلة (وكان المغني يغني)، وكأن النص مرثية لماض يطل تحت قناع الحاضر، توسع من فجوة المفارقة بينهما، وتحاصره بحنين لم يزل طافراً في الروح، كما يقول النص في هذا المقتطف:
«.. وكان المغني يغني
أغاني مرمية في شريطٍ قديم
- أتذْكرُ ذات صباح
كم تدافعتَ والوحشَ فوق التيمز
لتشربَ قطرة ماء..
ورأيتَ الغرقى؟
- كأنهمُ مسحوا الآنَ بالزيتِ
أجسادهم
كم جميلين كانوا!
وهمُ يرفعون الرؤوسَ
لكي يحرسوا الشمسَ حتى تغيب
وتعودَ برائحة الوحشِ والطينِ
والنبتِ فوق الفرات».
وبعد... يسبح ديوان فاضل السلطاني في فضاءات متنوعة وشجية جمالياً وفنياً، ينسحب أحياناً إلى الداخل في زفرات ألم وحنين، لكن سرعان ما يحولها إلى نافذة خصبة، يطل منها على الحياة، ويخلق الشعر من فجواتها وعثراتها، متشبثاً بغد أفضل، مسكون بمعنى الجمال والحرية.