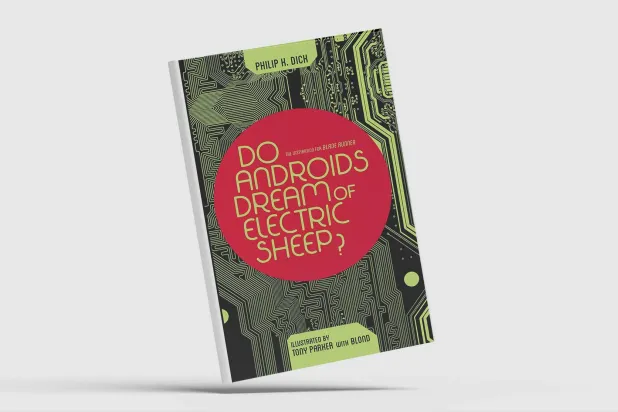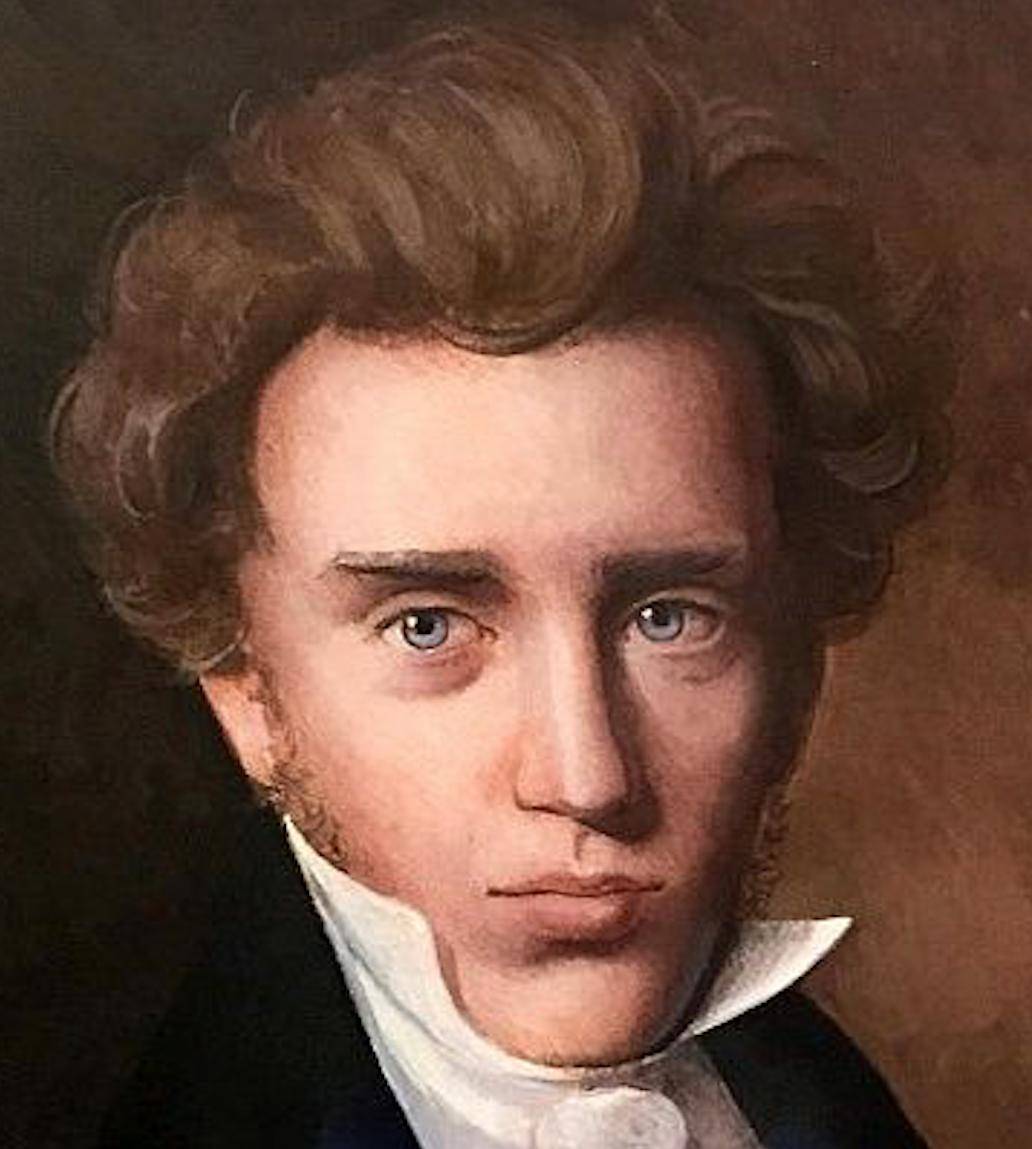كنا نتوقع من الكاتب الكبير أمين معلوف أن يرفع معنوياتنا ويعطينا جرعة تفاؤل في هذا الزمن العصيب فإذا به يزيدنا تشاؤماً على تشاؤم. كنا نتوقع منه أن يشد من أزرنا نحن سكان سوريا ولبنان والمشرق العرب (منطقته الأصلية العزيزة على قلبه) فإذا به يسد علينا كل النوافذ والأبواب ويقول لنا إننا سائرون نحو الهاوية. وقد ذكّرني ذلك بعبارة وردت في أواخر كتاب «الانحطاط» لميشيل أونفري: «قاربنا يغرق (المقصود قارب البشرية أو الحضارة الغربية على الأقل). ولم يبق لنا إلا أن نستسلم للأمور ونغرق معه بكل أناقة». فهل أصبح أمين معلوف من جماعة ميشيل أونفري يا ترى؟ أو من جماعة برنار هنري ليفي في كتابه «الإمبراطورية والملوك الخمسة»؟ (المقصود الإمبراطورية الغربية الأميركية العظمى، وملوك العرب والفرس والترك والصين وروسيا الذين يريدون أن ينهشوها ويحلّوا محلها). إذا كان الأمر كذلك فهذا يقلقني... ولكن المقلق أكثر هو قول كاتبنا اللبناني العربي الكبير بأن سفينة البشرية كلها سائرة نحو الغرق لا محالة تماماً كما حصل لسفينة «تيتانيك» الشهيرة عام 1912. هكذا تجدون أننا ما إن خرجنا من نظرية «صدام الحضارات» لصموئيل هانتنغتون حتى دخلنا في نظرية «غرق الحضارات» لأمين معلوف. سوف أركز نقدي على رأيه بمشكلة الأصولية التي تشغل العالم اليوم.
يعترف أمين معلوف بأن الأصولية الإخوانجية الداعشية هي المشكلة الأساسية ليس فقط للعالم العربي وإنما للبشرية كلها. بل ويصل به الأمر إلى حد القول بأن الظلمات عمّت العالم كله وغطّته عندما انطفأت أنوار لبنان والمشرق العربي. ولكن التفسير الذي يقدمه لظاهرة الأصولية الداعشية وغير الداعشية لا يرتفع إلى المستوى المطلوب. إنه تفسير صحافي، متسرع، أو سطحي أكثر من اللزوم. أحياناً وأنا أقرأه كان يُخيّل إليّ أني أقرأ لأحد المؤدلجين أو الحركيين السياسيين الذين لا يرون إلى أبعد من أنفهم. ولذا أقول: يلزمنا هيغل عربي أو كانط عربي يشرح لنا ماذا يحصل بالضبط، وفي العمق! وقد استنتجت بعد أن قرأت صفحاته عن الموضوع ما يلي: يمكن أن تكون كاتباً أدبياً كبيراً دون أن تكون مفكراً عميقاً. ليس كل الناس توكفيل أو ريمون آرون! الأدب شيء والفلسفة شيء آخر. فهو يعتقد أننا كنا نعيش عصر التنوير والتسامح أيام طفولته (وطفولتي أنا أيضاً لأنه يكبرني بعام واحد فقط مع الفارق في الطبقة الاجتماعية، فهو ينتمي إلى أعلى السلم في حين أنتمي أنا إلى أسفله). كنا نعيش العصر الذهبي إبان مصر الليبرالية حتى ظهور عبد الناصر، وإبان العهود اللبنانية المتعاقبة حتى انفجار الحرب الأهلية عام 1975. ولا ريب في أنه محق في ذلك عندما كان لبنان سويسرا الشرق. وعندما كانت بيروت مركز الثقافة والمثقفين ودور النشر والصحافة التعددية الحرة، إلخ. وعندما حلّت بيروت محل القاهرة كعاصمة للتنوير العربي. كل هذا صحيح. ولكنه أخطأ أو وقع في الأدلجة عندما استنتج أنه لم يكن للطائفية من وجود يُذكر آنذاك! فهو يقدم صورة وردية عن الواقع، إذ يقول ما معناه: كان الناس متعايشين آنذاك بكل وئام وسلام على الرغم من اختلافاتهم العرقية والدينية والمذهبية والطائفية. لقد أذهلني هذا الكلام بل وجعلني أخرج عن طوري. عندئذ عرفت أنه ليس مفكراً عميقاً أبداً. ولهذا السبب اعتبرت الكتاب سطحياً أكثر من اللزوم وأقلعت عن فكرة الكتابة عنه على الرغم من أني اشتريته بكل تلهف في اليوم التالي لصدوره وأنا أتوقع أني سأجد فيه الكشوفات الرائعة غير المسبوقة. كنت أتوقع أني سأجد فيه ضالّتي. ولكن خاب ظني! أقول ذلك على الرغم من أني من محبي أمين معلوف والمفتخرين به وبالمكانة المرموقة التي توصل إليها على المستوى الدولي. فقد رفع رأسنا نحن العرب وبخاصة السوريين واللبنانيين وعموم المشارقة. فهو العربي المشرقي الوحيد الذي وصل إلى الأكاديمية الفرنسية واحتل كرسي العالم الأنثربولوجي الشهير كلود ليفي ستروس. وقد قرأت له سابقاً عدة كتب واستمتعت بها كل الاستمتاع وبخاصة كتاب: أصول (عائلية). وهو عمل أدبي مكتوب بأسلوب رائع، جميل، أخّاذ، وأكاد أقول بوليسياً! وبالتالي فأمين معلوف فنان من الطراز الأول ولا يستهان به على الإطلاق. وإنها لَمتعة حقيقية أن تقرأ هذا الكتاب الجديد الذي يشبه المذكرات الشخصية ليس فقط له هو وإنما أيضاً للمنطقة كلها. ولكني أقول وأكرر القول: إنه ليس مفكراً كبيراً. وأنا أود فيما يخص تشخيصه للأزمة العميقة للعالم العربي والإسلامي كله أن أقول له ما يلي: لا ينبغي أن ننظر إلى المجتمع في قشرته الظاهرية السطحية يا أمين معلوف إذا ما أردنا أن نفهم ظاهرة كبرى كظاهرة الأصولية. وإنما ينبغي أن ننزل إلى الطبقات التحتية. ينبغي أن نحفر أركيولوجياً حتى نصل إلى أسفل طبقة، إلى أعمق نقطة. فهذه الظاهرة الأصولية الإخوانجية الداعشية خارجة من أعماق أعماقنا تماماً كالزلازل أو البراكين المتفجرة. ولهذا السبب كرّست لها كتاباً كاملاً بعنوان «العرب والبراكين التراثية». وبالتالي فإذا لم تكن الطائفية موجودة في عهد طفولتك وعصرك الذهبي الذي تحنّ إليه بكل حُرقة ولوعة، فهذا لا يعني أنها لم تكن كامنة في الأعماق أو نائمة تنتظر فقط الشرارة أو اللحظة المناسبة للانفجار. وهذا ما حصل لاحقاً بالفعل. وإذا كنت محظوظاً تنتمي إلى علية القوم والطبقة البورجوازية الثرية التي لا تشكل أكثر من عشرة في المائة، فهذا يعني أن بقية الشعب من فلاحين وعمال وموظفين وطبقات شعبية متواضعة كانت تشكّل تسعين في المائة. ولهذا السبب فشل العصر الليبرالي العربي الجميل ذو القاعدة الاجتماعية الصغيرة الضيقة. وحل محله العصر الاشتراكي الآيديولوجي على الطريقة الناصرية أو البعثية أو حتى الشيوعية الماركسية. ولكنّ ذلك لم يدم طويلاً. فبعد هزيمة 5 يونيو (حزيران) 1967 وموت زعيم القومية العربية جمال عبد الناصر عام 1970 حل محل الجميع التيار الجارف للإسلام السياسي والإخوان المسلمين. نقول ذلك على الرغم من أن هذا التيار الأخير أصبح مرشحاً بدوره للانحسار والزوال عما قريب...
ولكنّ هذا لا يكفي. وإنما ينبغي أن نضيف ما يلي: ينبغي العلم بأن الإسلام لم يمر بمرحلة الغربلة التنويرية الكبرى على عكس المسيحية في أوروبا. ولهذا السبب فإن الصيغة الأصولية التكفيرية المتحجرة للتدين لا تزال مهيمنة عليه. وسوف تظل مهيمنة ما دام تراثنا الإسلامي لم يخضع لمنهجية النقد التاريخي التي خضع لها التراث المسيحي والتي قاومها رجال الدين المسيحيون طيلة 300 سنة متواصلة (من أيام سبينوزا وريشار سيمون في القرن السابع عشر إلى وقت انعقاد المجمع الكنسي اللاهوتي التحريري الكبير المدعو بالفاتيكان الثاني عام 1962 - 1965). هذه أشياء ينبغي أن تقال لكي يفهم الناس ماذا يحصل بالضبط في مشرقنا العربي المنكوب بالويلات. الحروب المذهبية الكاثوليكية - البروتستانتية التي اكتسحت أوروبا بدءاً من القرن السادس عشر لا تختلف في شيء عن الحروب المذهبية السنية – الشيعية التي تكتسح مشرقنا العربي حالياً. الفرق الوحيد هو أن الأولى حصلت قبل ثلاثمائة أو أربعمائة سنة في حين أن الثانية تحصل تحت أعيننا في بدايات القرن الحادي والعشرين. وهي مسافة التفاوت التاريخي بين العرب والغرب، أو بين الإسلام - والمسيحية الأوروبية. كل هذا كنت أتوقع أن أجده في كتاب أمين معلوف. كل هذا يقوله جيل كيبل بل حتى لوك فيري على الرغم من أنه غير مختص بالدراسات العربية أو الإسلامية. ولكنه لا يخطر على بال أمين معلوف. هناك احتقانات تراثية متراكمة على مدار أكثر من ألف سنة متواصلة. وهي تنفجر في وجوهنا الآن كالقنابل الموقوتة. وأكاد أقول: حسناً تفعل! كل ما هو مكبوت ينبغي أن ينفجر ويشبع انفجاراً لكي يتنفس التاريخ الصعداء، لكي نتحرر من أنفسنا، من أثقالنا، من تراكماتنا، من طائفيتنا ومذهبيتنا. ثم لكي نتحرر بشكل خاص من مفهومنا القروسطي الإخوانجي الظلامي الداعشي القديم للدين والتدين. وهو مفهوم يسيطر على كل مناحي حياتنا من المهد إلى اللحد. كما أنه يسيطر على كل برامج التعليم العربية من المدرسة الابتدائية إلى الجامعات، ومن الجوامع إلى الفضائيات. كلنا غاطسون في ظلاميات القرون الوسطى وعقلية العصور الغابرة من أقصى العالم الإسلامي إلى أقصاه. وهنا تكمن المشكلة العالمية رقم واحد الآن. وسوف تهتز الأرض كلها قبل أن تنحلّ!
نحن ندفع الآن ثمن تصفية كل هذه الحسابات التاريخية دفعة واحدة. من هنا شراسة المرحلة الحالية وخطورتها. ولكن كل ذلك لا يخطر على بال أمين معلوف لحظة واحدة. ولهذا السبب أقول إنه ليس مفكراً عميقاً. «فسماء ملبدة بالغيوم السوداء لا يمكن أن تنجلي قبل هبوب الإعصار» كما يقول شكسبير. ولهذا السبب أقول إن اللحظة التي نعيشها الآن هي لحظة «تقدمية» في منظور فلسفة التاريخ وليست «تراجعية» على عكس ما توحي به المظاهر وعلى عكس ما يتصور معلوف. أقول ذلك على الرغم من فجائعيتها وكوارثها وضحاياها الذين يتساقطون بعشرات الآلاف وربما الملايين. فهذه هي الضريبة الكبرى التي ينبغي دفعها لكي يستيقظ العالم العربي يوماً ما ويخرج من ظلمات العصور الوسطى إلى أنوار العصور الحديثة.
أمامي الآن وأنا أدبّج هذه الكلمات كتب أخرى غير كتاب أمين معلوف. أمامي كتب مضادة له ولنظرته الكارثية والكابوسية للتاريخ. وقد وضعتها قصداً لكي أستضيء بها. فبضدها تتبيّن الأشياء. أمامي كتاب «الفوز المبين للأنوار» أو «الانتصار الكاسح للأنوار» لأستاذ الفلسفة وعلم النفس في جامعة هارفارد ستيفن بنكير. هذا الكتاب الذي هز الغرب هزاً أثلج صدري وأدخل الطمأنينة إلى قلبي. وهو يعد رداً مفحماً على جميع التيارات الأصولية والغوغائية والرجعية الكارهة للأنوار والحضارة الحديثة. ومنعاً لأي التباس أقول: أمين معلوف ليس من بينها أبداً. هذا شيء مفروغ منه. فهو يظل شعلة تنويرية عربية على الرغم من كل الأخطاء التي ارتكبها في تصوراته أو منظوراته لفلسفة التاريخ. إن أستاذ جامعة هارفارد ستيفن بنكير يبرهن بالدليل القاطع والإحصائيات الدقيقة على أن الأنوار نجحت في مهمتها وأسّست أعظم حضارة على وجه الأرض. كما يقول إننا نعيش الآن أجمل لحظات التاريخ بفضل انتصار الأنوار الفلسفية والعلمية والسياسية. فمعدل العمر تضاعف قياساً إلى الماضي من 40 سنة إلى 80 سنة، وتقدم الطب قضى على معظم الأوبئة التي كانت تكتسح البشرية اكتساحاً، والفقر المدقع نزل من 90%عام 1820 إلى 10% حالياً. وهذا أكبر تقدم حصل في التاريخ ولكن لا أحد يراه أو ينتبه إليه. والأمية تراجعت بنسبة هائلة حتى في مجتمعات العالم الثالث. فمثلاً في عام 1870 كانت نسبة التعليم في العالم العربي بمشرقه ومغربه (1%) فقط! والآن أصبحت ماذا؟ 75% مع تدرجات متفاوتة من بلد إلى آخر. لاحِظوا الفرق. وموت الأطفال في عمر الزنابق كان عام 1950: 33% والآن أصبح 5% فقط. وأما في أوروبا وأميركا الشمالية فقد نزل إلى الصفر عموماً. وكل ذلك بفضل تقدم الطب والمعالجات وانتشار العيادات الطبية والمستشفيات في كل مكان. ثم يقولون لك إن التنوير لا معنى له! وقِسْ على ذلك كثيراً... فهل هذه حضارة تغرق؟ وكل ذلك تحقق بفضل انتصار الأنوار التي ابتدأت في القرن الثامن عشر على يد فولتير وديدرو وكوندورسيه وكانط، إلخ... والمثل العليا للأنوار في رأي المؤلف تتمثل في ثلاث كلمات فقط: العقل، والعلم، والنزعة الإنسانية. فكل الدول التي اعتمدت العقل والعلم أداةً أساسية للتخطيط وتطوير المجتمع نجحت نجاحاً باهراً في تحقيق التنمية والسعادة لشعوبها.
للمزيد من الاطلاع على هذه الثورة التنويرية الكبرى التي غيّرت وجه العالم انظر الكتاب في ترجمته الفرنسية:
Steven Pinker: Le triomphe des Lumieres.Les Arenes.Paris.2018
ولكن من الأفضل بالطبع الاطلاع عليه في نسخته الأصلية الإنجليزية:
Steven Pinker: Enlightenment Now: The case for Reason ; Science,Humanism, and Progress.Viking.2018
لا أعتقد أن أمين معلوف يجهل كل هذه الفتوحات الفكرية. فهو مفكر مستنير وأديب كبير. نقول ذلك وبخاصة أن زميله في مجمع الخالدين (أو الأكاديمية الفرنسية) الفيلسوف العظيم ميشيل سير الذي غادرنا قبل يومين يمشي في هذا الاتجاه المتفائل بحركة التاريخ مثل ستيفن بنكير. فلماذا لم يتأثر به أمين معلوف؟ في الواقع إنه يذكره بشكل غير مباشر في الكتاب ويعترف بإنجازات الحداثة ولكنه مع ذلك يظل مصراً على فلسفة التاريخ السوداوية المتشائمة. وهذا شيء يحيّرني ولا أجد له جواباً. والشيء الذي يحيّرني أيضاً ولا أجد له جواباً هو أنه يقول أكثر من مرة على مدار الكتاب إنه يعيش أواخر عمره أو «مساء حياته» وهو لم يتجاوز السبعين بعد (من مواليد 1949). هذا في حين أن ميشيل سير رحل عن 88 سنة بالتمام والكمال. فلماذا يقول ذلك؟ هل هو مريض مثلاً؟ أقصد مرضاً خطيراً لا سمح الله. بصراحة لا أعرف. على أي حال فتحت تصرفه كل الطب الفرنسي وهو من أرقى أنواع الطب في العالم وأكثرها تقدماً. أما إدغار موران فقد بلغ الثامنة والتسعين وهو يرفض أن يعترف بأنه يعيش مساء حياته! ومؤخراً صرح بأن الموت قد يباغته في أي لحظة ولكنه ليس مهيئاً له بعد ولا مستعداً لاستقباله والترحيب به. وقد كدت أموت من الضحك عندما قرأت هذا التصريح. ولكني لا أملك إلا الإعجاب بمدى شجاعته وتفاؤله... والشيء العجيب الغريب هو أنه ألقى مؤخراً محاضرة عصماء أمام أساتذة جامعة مونبلييه وطلبتها وظل يناقشهم لمدة ساعتين دون توقف! وبالتالي فرجاءً، قليلاً من التفاؤل يا أمين معلوف! لا تزال أمامك إن شاء الله سنوات عديدة لكي تتحفنا بإبداعات جديدة نحن في أمسّ الحاجة إليها.
حضارات العالم... هل هي حقاً على وشك الغرق؟
أمين معلوف يدق ناقوس الخطر

أمين معلوف وغلاف كتابه

حضارات العالم... هل هي حقاً على وشك الغرق؟

أمين معلوف وغلاف كتابه
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة