في 27 يناير (كانون الثاني) 2009 رحل عن عالمنا الروائي والشاعر والناقد الأميركي جون أبدايك John Updike عن سبعة وسبعين عاما. وصدرت حديثا ترجمة لحياته في 558 صفحة عن دار «هاربر كولنز» للنشر بنيويورك. والكتاب من تأليف آدم بجلي Adam Begley وهو صحافي وناقد كان مشرفا على صفحة الكتب في جريدة «ذا نيويورك أوبزرفر» في الفترة من 1996 - 2009 ويعيش الآن في إنجلترا.
ولد أبدايك في 18 مارس (آذار) 1932 في ولاية بنسلفانيا. التحق بجامعة هارفارد ومدرسة رسكين للرسم والفنون الجميلة بأكسفورد في إنجلترا حيث قضى عاما بمنحة دراسية. اشتغل بالصحافة من 1955 إلى 1957 حيث نشر في «ذا نيويوركر» الكثير من القصائد والقصص القصيرة ومراجعات الكتب. ومنذ 1957 عاش في ولاية ماساشوستس كاتبا متفرغا للكتابة.
نشرت أول رواية لأبدايك في 1959 ثم أتبعها برواية عنوانها «اجر أيها الأرنب» (رابيت، وهو اسم البطل هاري أنجستروم). ومن رواياته الأخرى: «القنطور» (وهو مخلوق أسطوري، نصفه إنسان ونصفه جواد)، «أزواج»، «عن المزرعة»، «الانقلاب»، «تزوجني»، «ساحرات إيستويك» (التي تحولت إلى فيلم كبير)، «في جمال الزنابق»، «نحو نهاية الزمن»، «جرترود وكلاوديوس» (وهي إعادة صياغة لقصة هاملت)، «أبحث عن وجهي»، «البرازيل»، «الإرهابي» إلخ...
وله عدد من مجاميع القصص القصيرة، وستة كتب في النقد الأدبي تجمع شمل مقالاته ومراجعاته، و«مجموعة القصائد 1953 - 1993» وقد أعقبها بديوان عنوانه «أميركيات»، وسيرة ذاتية عنوانها «الخجل» (1989). وبعد موته صدرت له «دموع أبي» (مجموعة قصصية)، «ثرثرة أعلى» (مقالات)، «ناظر دائما» (مقالات عن الفن).
يرسم آدم بجلي صورة آسرة لهذا الروائي غزير الإنتاج (أصدر نحو 60 كتابا في 51 سنة) وكان يعد نفسه «جاسوسا أدبيا» على حياة البلدات الصغيرة والضواحي في منتصف غرب الولايات المتحدة الأميركية.
يتتبع الكتاب مراحل رحلة أبدايك: من بيت طفولته في ولاية بنسلفانيا، التحاقه بجامعة هارفارد، عمله اللامع - وإن كان قصير الأمد - في هيئة تحرير «ذا نيويوركر»، سنواته العائلية - زوجا ورب أسرة - في إيسوتش بولاية ماساشوستس، أسفاره الواسعة في الخارج، انتقاله إلى بلدة أخرى في ماساشوستس هي مزارع بيفرلي التي ظل مقيما بها حتى وفاته بسرطان في الرئة من الدرجة الرابعة.
استخدم المؤلف مواد أرشيفية، وأجرى مقابلات مع أسرة الروائي وأصدقائه وزملائه، مبينا كيف أن أعماله القصصية قد شكلتها حياته الخاصة الحافلة: إيمانه الديني الذي لم يزايله قط، معرفته الحميمة ﺒ«مجتمع الخيانات الزوجية» الذي كشف عنه في روايته المسماة «أزواج» وهي من أكثر الكتب مبيعا، كلفه بلعبة الغولف، النساء اللواتي دخلن حياته (يفخر أبدايك بأنه جامع ثلاث نساء مختلفات في يوم واحد!)، رفضه أن يدين تدخل بلاده في فيتنام، علاقاته بمعاصريه من الأدباء مثل فيليب روث، وجويس كارول أوتس، وتوم ولف.
ويخصص بجلي الفصل السابع من كتابه لأسفار أبدايك الواسعة. لقد شملت الصين والهند وكمبوديا وغانا وأستراليا وروسيا وإسبانيا وتشيكوسلوفاكيا والبرازيل وبريطانيا وإثيوبيا ومصر (حيث حاضر في الجامعة الأميركية بالقاهرة) وفنزويلا وهولندا والنمسا والدنمارك وإيطاليا والمغرب وفرنسا واليابان وكوريا وكندا وجمهوريات البلطيق. وقد أفادته هذه الزيارات في كتاباته: فروايته «الانقلاب» مثلا تدور أحداثها في جمهورية أفريقية متخيلة، وروايته «البرازيل» - كما هو واضح من عنوانها - مسرحها ذلك البلد.
ويرد الكتاب كثيرا من شخصيات أبدايك القصصية إلى أصولها في الواقع مع ملاحظة أن أبدايك كان كثيرا ما يغير اسم الشخصية الواقعية - حين يضعها في أعماله - حفاظا على خصوصيتها.
وفي تتبعه لعلاقة الطفل أبدايك بأمه ليندا، يسوق بجلي مقولة سيغموند فرويد: «إن الرجل الذي سيكون، بلا نزاع، الأثير عند أمه يظل بقية حياته محتفظا بشعور الفاتح الظافر».
كان أبدايك في طفولته مولعا بقراءة الكاتب الفكاهي الإنجليزي ب.ج. ودهاوس (قرأ له الخمسين كتابا التي وجدها في المكتبة العامة) كما أولع بقراءة القصص البوليسية (إيرل ستانلي جاردنر، أجاثا كريستي) والكتاب الفكاهيين (جيمز ثيربر، ستفن ليكوك). ويقول عن المكتبة: «لقد انفتح ضرب من السماوات لي هناك». وحاولت أمه (التي كانت حاصلة على درجة الماجستير من جامعة كورنيل برسالة عن السير ولتر سكوت) أن تغريه بقراءة فلوبير وغيره من الكلاسيات، ولكنه لم يستجب وظل يقرأ قصصا بوليسية وفكاهية. وفي سن الرابعة عشرة وقع على قصيدة ت.س. إليوت «الأرض الخراب» وأحبها. وفي العام التالي، حين كان في زيارة لعمته، قرأ بضع صفحات من رواية جويس «يوليسيز» ولكنه لم يشعر برغبة في مواصلة القراءة.
وإلى جانب القراءة كان يمارس الرسم، وينسخ الصور الكاريكاتورية، ويستمع إلى الإذاعة، ثم بدأ يكتب. وفي فبراير (شباط) 1945 - قبل أن يتم الثالثة عشرة بشهر - نشر أول مقالة له في مجلة «الثرثار» وهي مجلة مدرسته الثانوية، وقد نشرت له فيما بعد قصائد وقصصا قصيرة ونقدا سينمائيا ومقالات ورسوما. وفي الصيف بعد أتم السادسة عشرة، حاول أن يكتب رواية بوليسية. وفي سن السادسة عشرة قبلت أول قصيدة له للنشر في مجلة تحمل اسم «انعكاسات».. هكذا بدأت حياته الأدبية.
وخلال سنواته الأربع بجامعة هارفارد حضر محاضرات هاري ليفين عن شكسبير. كان ليفين ينتمي إلى مدرسة «النقد الجديد» التي تعمد إلى فحص النص فحصا تقنيا دقيقا. وفي ذلك يقول أبدايك: «أما أن العمل الأدبي يمكن أن تكون له حياة مزدوجة، في صوره كما في حبكته وشخصياته، فأمر لم يكن يدور لي بخلد». ولم ينس قط هذا الدرس بل أفاد منه في أعماله القصصية حيث يندمج المجاز الشعري بالسرد القصصي.
وعلى الرغم من أن اهتمامه كان مركزا على شعر عصر النهضة في إنجلترا (شكسبير ومعاصريه) فإنه درس أيضا الشعر الأنجلو - سكسوني (الإنجليزي القديم) والشعراء الميتافيزقيين الإنجليز في القرن السابع عشر، وإدموند سبنسر وجون ميلتون، والدكتور صمويل جونسون. كما حضر محاضرات ولتر جاكسون بيت عن تولستوي ودوستويفسكي وبرنارد شو. وتعرف من أساتذته على همنجواي (وبه تأثر في مطلع حياته الأدبية) وعلى ج.د. سالنجر صاحب رواية «الحارس في حقل الشيلم» مما فتح أمامه آفاقا جديدة.
وفي روايات أبدايك ملامح وجودية، تشي بأسلوب الفيلسوف الدانمركي المسيحي كيركجارد. لقد وصف أبدايك بطله (أو بطله - الضد) رابيت آنجستروم الذي يعاود الظهور في رباعية روائية بأنه «نموذج للإنسان الكيركجاردي» فهو «الإنسان في حالة خوف ورعدة، منفصلا عن الله، يطارده الفزع، تلويه المطالب المتصارعة لتكوينه البيولوجي الحيواني وذكائه الإنساني، للعقد الاجتماعي والمطالب الداخلية».
برع أبدايك في كتابة المحاكاة الساخرة (بارودي) لكبار الكتاب مثل ت.س. إليوت وصمويل بكيت وغيرهم. واتسمت أعماله - خاصة رواية «أزواج» بالصراحة الجريئة في معالجة الجنس. وقد مهد له الطريق في ذلك كتاب مثل د.ھ. لورانس («عشيق الليدي تشاترلي») وإدموند ويلسن («ذكريات من مقاطعة هيكيت») وفلاديمير نابوكوف («لوليتا») وهنري ميللر («مدار السرطان»). وقال أبدايك عن رواية ويلسون إنها قدمت له «أول لمحة عن الجنس، من نافذة القصة، على أكثر الأنحاء حيوية».
كذلك كتب للأطفال «المزمار السحري» (1962) و«حلم بوتوم» (1969 - وبوتوم شخصية تظهر في ملهاة شكسبير «حلم ليلة صيف»).
وكما نال أبدايك تقديرا واسعا من جانب النقاد والجمهور على السواء، حتى لقد عده البعض أهم روائي أميركي في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، نال نصيبه من سهام النقاد. قال عنه جون ألدردج: «ليس ذهنه شائقا». وقال نورمان بودهوتنر: «عندي أنه كاتب ليس لديه ما يقوله سوى النزر القليل». وقال هارولد بلوم: «إنه روائي صغير ذو أسلوب كبير». وقال جور فيدال: «إن أوصافه بلا هدف». ووجدت دوروثي رابينويتزر «خواء» في قلب قصصه.
ومما يزيد من قيمة كتاب بجلي ما يحتويه من صور لأبدايك في مختلف مراحله العمرية: طفلا، وصبيا يقف بين أبيه وأمه، وتلميذا في المرحلة الثانوية، وطالبا في جامعة هارفارد، وأبا يحمل ابنته بين ذراعيه، وجالسا يؤلف على آلته الكاتبة، ولاعبا التنس والكرة الطائرة والغولف، وجدا مع أحفاده - ثم صورة شاهد قبره.
جون أبدايك.. الجاسوس الأدبي
كتاب شامل عن سيرة الروائي الذي شغل أميركا
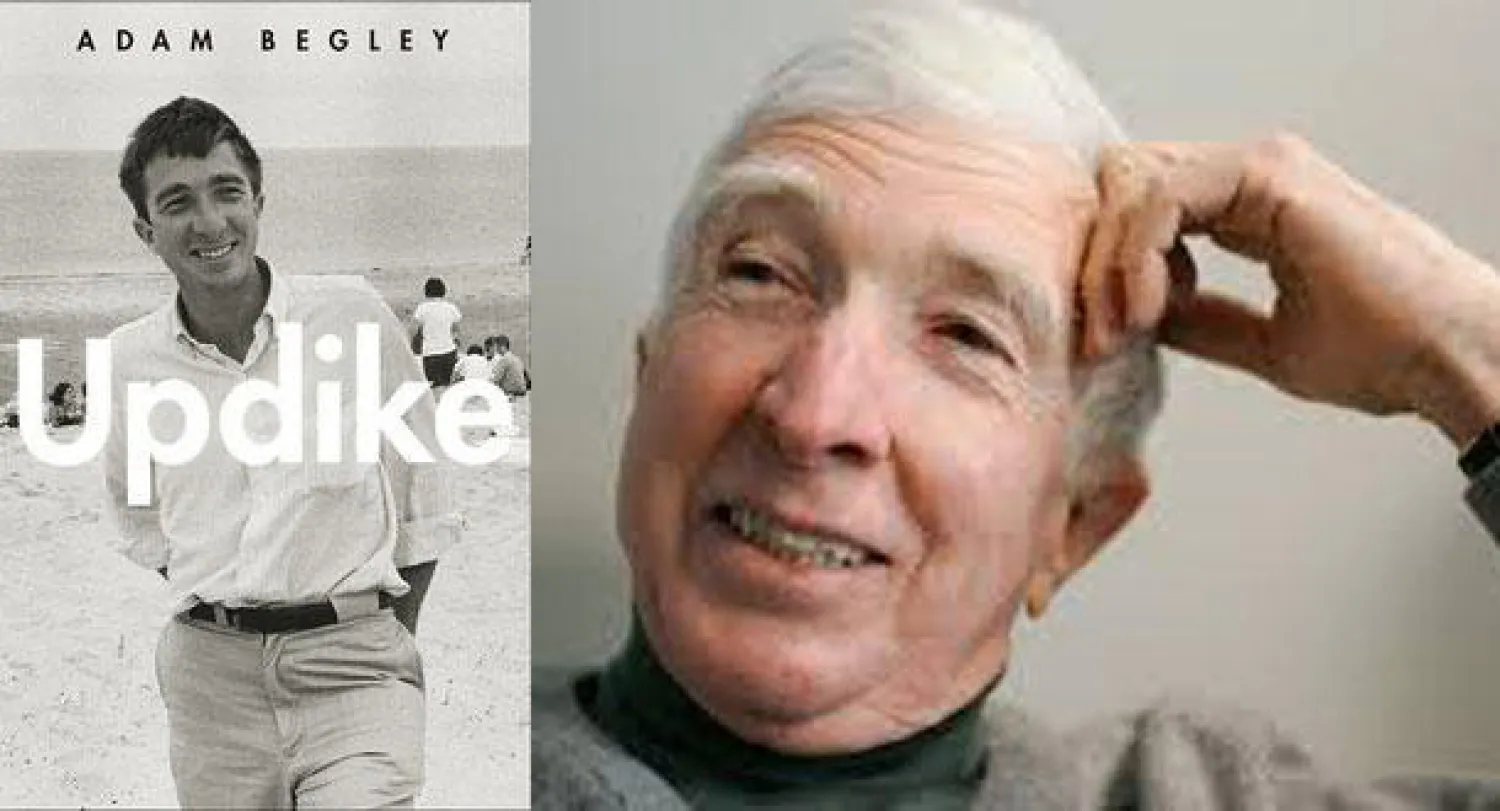
جون أبدايك

جون أبدايك.. الجاسوس الأدبي
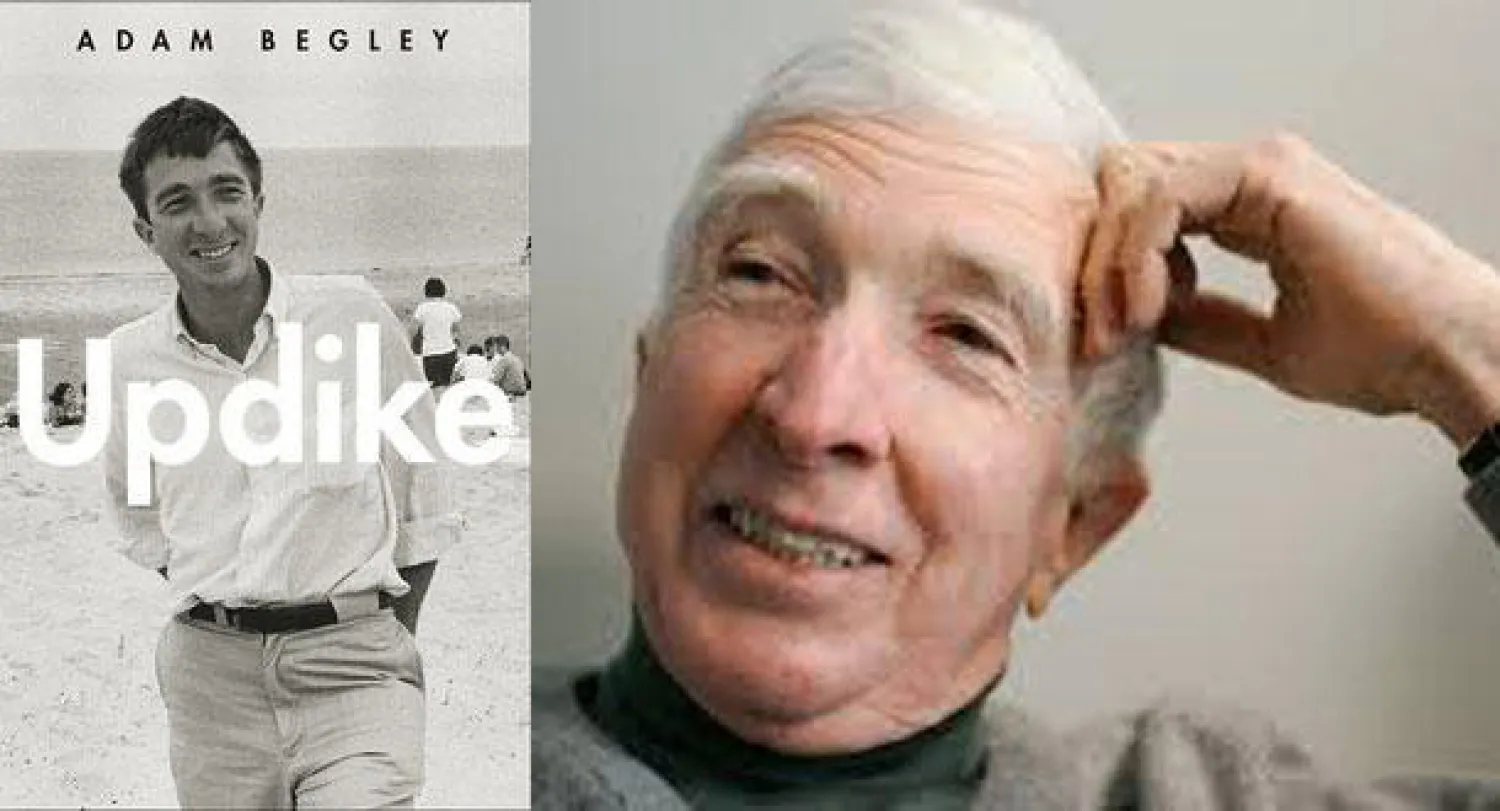
جون أبدايك
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة












