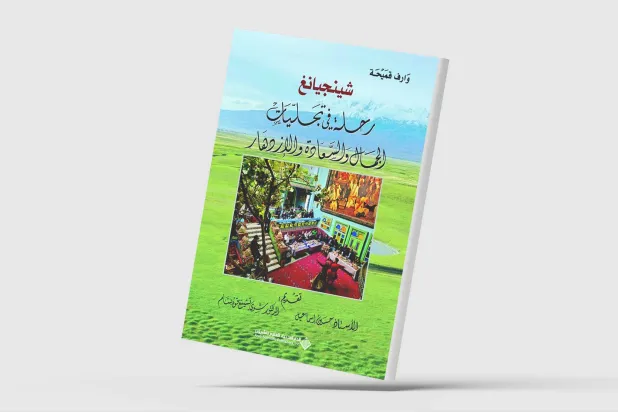«المدن رائحة»، كتب محمود درويش في كتابه «في حضرة الغياب»، مشددا على أن «كل مدينة لا تُعرفُ من رائحتها لا يُعوَّل على ذكراها».
«المدن مثل الكتب»، يكتب ياسين عدنان في تقديمه لـ«مراكش التي كانت»، الكتاب الجماعي الذي يقترح علينا «ترميمات» في «استعادة مراكش الدارسة»، الصادر عن «منشورات مرسم» بالرباط، وشارك فيه 33 كاتبا، راود كل واحد منهم ذاكرته عن مخزونها وبدأ لعبة الاسترجاع متذكراً بعض معالم المدينة الحمراء.
يرى ياسين عدنان، في تقديمه الذي حمل عنوان «عن ترميم المدينة، وتطريس الكتاب»، أن المدن «متونٌ مخطوطة بحبرٍ سمْحٍ يجعلها لا تتبرّم من الحواشي، ولا تزعجها تعليقات القرّاء على الهوامش»، وبالتالي فهي «كتبٌ مفتوحة للقراءة المُتفاعلة، للإضافة وللتعليق، للاستطراد والحشو، كما للشطب والتنقيح والمحو»؛ قبل أن يتحدث عن مراكش، فيقول: «كانت كتاباً فاتناً مهيباً كلما فتحتُ دفتيه أجدني أقرأ فأعيد وأستزيد. مراكش متنٌ أصيلٌ لا تُرهِقُه الهوامش والحواشي ولا يشبع من الشروح والتعاليق».
ويضيف عدنان، الذي استدرج فيه عدنان أصدقاء للمشاركة في عملية ترميمٌ رمزي للمدينة: «نحن مجرد أدباء بالنهاية، لا قدرة لنا على التدخل الحازم والحاسم لحماية هذه الصفحة أو تلك من المحو، أو لإيقاف هذا المتعسِّف أو ذاك ومنعه من ارتجال تطريسه الشنيع في هذا الموضع أو ذاك من المدينة - الطرس. لذلك اخترنا أن ننبِّه بشكل جماعي إلى أنّ مدينتنا، وهي تكبر وتتجدّد، فقدَت الكثير من معالمها، وكثيرا ما حلّت محلّ هذه المعالم بناياتٌ فظّة تُخاصِم الجمال وتخون روح الحاضرة وتناقض خصوصيتها المعمارية».
وكتب أحمد بلحاج آيت وارهام، تحت عنوان «مقهى السوربون... جامعة في قلب جامع الفنا»، أن «مراكش هذه الحاضرة التي كانت فكرة ومثالا في وجدان الأميرة الأغماتية زينب النفزاوية، وتجسدت حقيقة عمرانية حضارية على يد يوسف بن تاشفين، موشومة بالأبهة العلمية والروحية والأسطورية والإنسانية، هي اليوم تعاني تحولات ماسخة، وجراحا لاهبة، وبهرجة معتمة في كثير من أعضاء جسدها الحميمة، وفضاءاتها الحاضنة لروح الإنسان وجوهره».
من جهته، استعاد رشيد منسوم جانبا من طفولته، في نص تحت عنوان «جامع الفنا... غابة السرد»، يقول فيه: «كانت جامع الفنا نهاية السباق والجغرافيا في آن. صورة معكوسة للجنّة في آخر العالم سوّاها العابرون. هناك، نتحلق حول نار الحكاية لنستعيد دهشة لحظة التكوين. كانت الساحة مفترقا للطرق تقود إليه معظم الأحياء المراكشية عبر ممرات، أقواس ودروب ضيقة بكل ما تحمله الكلمة من دلالات أسطورية ملغزة. (...) أين تبدأ الساحة وأين تنتهي؟ (...) كانت الحلقة مرآة مقعرة تعكس تلك السخرية اللاذعة التي تستهوينا. فغالبا ما تعشق الشعوب من يعرّي هشاشتها».
وتحت عنوان «مكتبة الوفاء... كتب ونقانق»، كتب عبد الصمد الكباص: «حل عقد التسعينات من القرن العشرين. فتشابهت أيامنا. وصرنا نختزل العالم في دفتر إلكتروني. وفتح التلفزيون في جباهنا عينا ثالثة للعماء: لا ظل ولا حركة ولا دهشة. فأغلقت مكتبة الوفاء، بعد أن انفض حشد القراء من حول الكِتاب، وتحولت إلى مطعم للفاصولياء والعدس وأحشاء الغنم. وتحولت سلسلة المكتبات الصغيرة الموجودة بطريق سيدي عبد العزيز إلى محلات لبيع النقانق والأواني البلاستيكية ومنتوجات الصين الرخيصة، وتوسلت مكتبة الشعب الكتب السياحية للحفاظ على وجودها، وطرد الكتبيون قبل ذلك من جامع الفنا وشردوا في صحبة الموتى بمقبرة سيدي غريب قبل أن يدفنوا في سوق الازدهار بباب دكالة، ومات جلهم أسى على ما ألم بهم وبالكِتاب. وتحولت مكتبة الجامعة بالرميلة إلى وكالة بنكية، واستحالت مكتبة الوعي إلى متجر كبير، وتمددت مراكش خارج حدودها صناديق إسمنتية بلا روح. وتناسل الكُتاب وانقرض القراء... وغدا جيلنا الذي كان يفتخر بالصباحات المراكشية الجميلة التي تليق بقصيدة عذبة وقهوة أرابيكا وأغنية لفيروز، منفيا في مقاه يملأها صياح معلقي مقابلات البارسا والريال».
واختار سعد سرحان أن يكتب عن «مقهى الزهور»، حيث نقرأ: «في الدليل الأزرق لمدينة مراكش، كان السائح، حتى ثمانينات القرن الماضي، يجد الساحة والصومعة، الصهريج والعرصة، المتحف والفندق، الجبل والوادي، القصور والقبور... ومقهى الزهور. أما الأجانب المقيمون، ومعظمهم من ذوي اللسان الفرنسي، أولئك الذين كانوا متعاونين أو متعاقدين مع قطاعي الصحة والتعليم على الخصوص، فلم يكونوا في حاجة إلى دليل من أي لون، ليس فقط لأن ضالتهم كانت في مكان معلوم، بل أيضا لأن دليلهم الفصيح إلى مقهى الزهور كان عبارة عن باقات زهور من مختلف الألوان والروائح، تلك التي كانت تُعرض كل صباح عند أبواب السوق المركزية، الجار الأنيق للمقهى ولعل الشَّعر الأشقر وعُجْمة اللسان واللباس الجريء لرواد الزهور من مختلف الجنسيات، ما كان يعطي لزبائنه المغاربة الإحساس بوضعهم المتقدم. فهم، وبلا تأشيرة تشهر، كانوا يشاطرون النصارى حداثة المكان، ويأخذون عنهم غير ما تقليد».
وفيما كتب جمال أماش، تحت عنوان «عرصات مراكش... جنائن يتهددها الغبار»، عن الطيور التي لا تغادر أعشاشها، إلا مرغمة، إلى بيت في قصيدة أو إلى جنائن يتهددها الغبار، ختم محمد آيت العميم، تحت عنوان: «ساقية دوار العسكر... الماء لن يجري فيها ثانية»، بالقول: «بعد أن ضج حيّنا بالبشر وبالسيارات ولم يعد حيا هادئا ولا محدودا إذ نبتت في أحراشه أحياء وأحياء مكدسة بالبشر والحجر، وطمست الساقية وفوقها الإسفلت ولم يعد يذكرها إلا الذين كبروا معها، تحولت المزارع والضيعات إلى منازل وبيوت تكاد تخنق ذاكرة البصر؛ وجعل الجشعون من الإسمنت كل شيء ميتا».
أما محمد الصالحي، فنقرأ له تحت عنوان: «مكتبة عليلي... تعال أيها الصديق، وانظر»: «إلهي. لو أستطيع. لأعدت كل شيء إلى حاله. إلى طبعه. إلى طبيعته. أثير زوبعة سريعة. أطفئ الشمس قليلا. أجعل للمساء بابا مواربة. أنبت نباتا وحشيا على مقربة. أجري ريحا. (..) حينما فاتحني الصديق ياسين عدنان في أمر الكتاب، وأنا في مراكش، قدرا وصدفة، رحت هناك، إلى حيث «مكتبة عليلي». إلى حيث «مقهى النخلة». يا الله! المكتبة صارت مطعما رخيصا. عدس. فاصولياء. بخار. أدخنة. تدافُعُ سابلة. كؤوس شاي. المقهى غير اسمه وكان اسمه بعضا كثيرا من بهائه. صار مزاحَما ومُزاحِما. مكتظا كحشر. تعال، أيها الصديق، وانظر».
9:48 دقيقه
«مراكش التي كانت»... ترميمٌ رمزي للمدينة الحمراء
https://aawsat.com/home/article/1703766/%C2%AB%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA%C2%BB-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%8C-%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1



«مراكش التي كانت»... ترميمٌ رمزي للمدينة الحمراء
مؤلف جماعي بمشاركة 33 من أدباء مراكش ومبدعيها

- مراكش: عبد الكبير الميناوي
- مراكش: عبد الكبير الميناوي

«مراكش التي كانت»... ترميمٌ رمزي للمدينة الحمراء

مقالات ذات صلة
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة