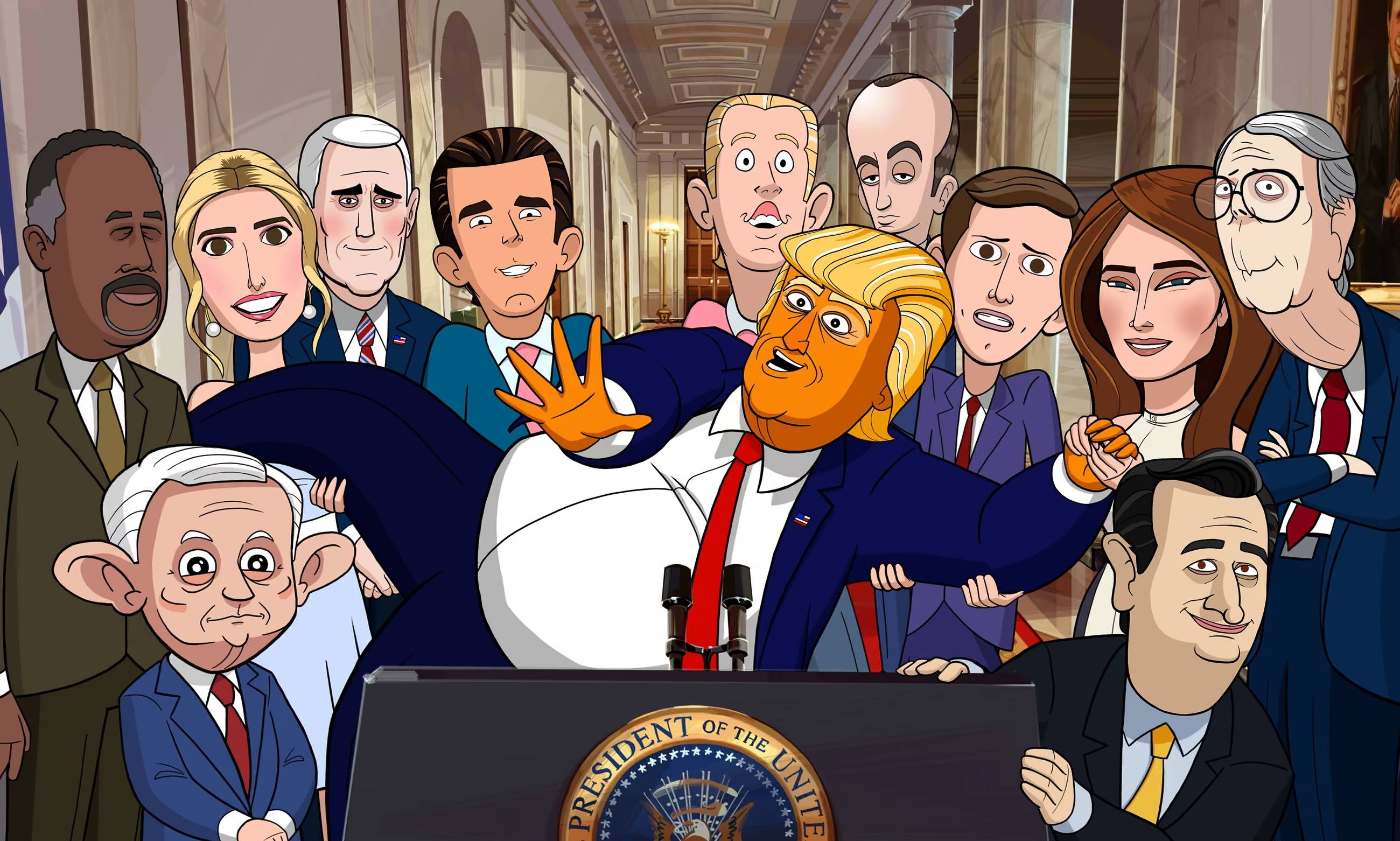قريتي الظاّلمة تحفلُ بالكلاب.
تجمَدُ حركَتُها كُلّما أدرْتُ المقبضَ في الصباح. تلفتتُ أعناقُ الحي نحوي، والنّظراتُ تصوّبني حالما أتجاوزُ ظلّ بيتي على عتبة الباب. أمشي في الحيِّ، والعيونُ خلال مشربيّاتِ النّوافذِ تلاحقُ خطوتي، وكُلّما مررتُ بنساءٍ على الأبواب، خفضْنَ هذرتهنّ، والتقطتُ مِنَ الهمسِ حروفَ اسمي وشيئاً عن الكلاب.
إنّي أموتُ كلَّ ليلة، أعودُ فيها إلى بيتي فيصافِحُني شخيرُ زوجي على أريكة مِنْ خيزران، أنفُه محمرّ وكرشتُه منفوخة من الخَمْر، بينَ قدميْه قنّينة طريحة، انسكَبَ آخرُها على حصيرة بالية، وبقُرْبِها عِظامُ عشائه في طبقٍ أعدتْهُ له ابنتنا قبْل النّوم. لا يخشى أبوها علَي الليل، ليس لأنّ الكلابَ تسْتَنْكفُ أن تهاجِمَ امرأة في الخَمْسين مثلي، بلْ لأنّ الحياة تمضي بهِ ثملاً على أريكتِه ليلاً، أو مترنّحاً بينَ حاناتِ القرية في النّهار.
أخبرتُه يوماً، على مسمعِ ابنتِنا، بأمر كلبٍ تعقّبَ عودَتي مِن بيتٍ عاونتُ فيهِ قابلة القرية الحدباء بولادة تعسَّرت، كلماتُه تمغّطتْ سكْرانة بلسانٍ مُرتخٍ «كلابُ القرية لا تتعقّبُ العجائز».
لكنّ الكلبَ الذي اقتفى أثري بأنفِه ظلَّ يتبعُني كلَّ ليلة. تشعُّ عيناهُ حين التفتُ ورائي، يكشِّرُ عن أنيابه مزمجراً ويسيلُ لعابُه، فتَتَّسِعُ خطوَتي محاذرِة انقضاضَه. حتّى إذا بلغتُ مشارفَ الحي انقطعتْ زمجرتُه واختفى مثلَ عفريتٍ يلتحمُ بالظّلام. حينَ استجرتُ منهُ بزوجي ثانية، همَدَ على أريكة الخيزرانِ يعبُّ من زجاجته، مسَحَ فمَه بكمِّه، وأشارَ نحوي بقاعِ القنّينة قابضاً على عنقِها «أخْبريني أيّتها المُتصابية، بمَ أغويتهِ؟»
فتوليّتُ عنْه. كان محقاً بشأنِ الكلاب. يعلمُ الأهالي كلُّهم أنّها من الغرابة أن تمّيزَ رائحة الشّاباتِ مِن إناثنا عنْ غيرِهنّ. اختلطَتْ على كلبِ اللّيلِ رائحتي؟ أخبرتْني ابنتي بالأمس عن بضعة كلابٍ حاصرَتْ بنتَ الخيّاطة وهي تحمِلُ على رأسِها صرّة ثيابٍ إلى بيتٍ مُجاور. مزّقتِ الأنيابُ الصرّة لمّا وقعتْ أرضاً ونهشَتْ ساقَ الفتاة، فتكَتْ بها لوْلا أدركتْها أمُّها بجذْوة مِن نار، فرّقتْ بها الكلابَ وهي تجْأر.
لكنّ القرية لمْ تكترِث، حتّى عندما هاجمَ قطيعٌ ضالّ أغناماً ترعى في المروج، عجَزَ راعيها عَن دفعِها بعصاه، واكتفى بتصويرِها بعدسة هاتفه وهي تبقرُ بطنَ شاة وتجرُّها من أحشائِها. تصويرُ الرّاعي الذي انتشَرَ مثلَ عدوى بينَ الأهالي، بلغ هاتفي مساءَ اليومِ نفسِه. شغّلتُ المقطعَ؛ كان مِن الشّناعة أنّي لَمْ أكمِلْ مُشاهدَتَه. وفي كآبِة غَسَقِ المَغيب، كان الأهالي يُعيدون تشغيلَ المشهدِ في بيوتِهم، وخوارُ الشّاة المذْبوحة وهي تُسحلُ بينَ نُباحِ الكلابِ يرتفعُ بصخبٍ كريهٍ من بيوت القرية متفاوتاً دونَ انسجام. تداوَلَ الناسُ المقطعَ بهوسٍ محموم، رغْمَ البَشاعة.
ثمّ أتتْ ليلة اتخذَ القمرُ فيها هيئة ظهرِ القابلة العجوز، وتخلّفَ كلبُ الليلِ عَن ملاحَقتي. كنتُ عائدة من تطعيمِ صغارِ حي بعيد. وحين اقتربتُ مِن حارتِنا وحاذيتُ حقلَ المانجا، أفزَعَني وثوبُ ثلاثة أشباحٍ من الأحراشِ اعترَضوا طريقي، أوسطُهم يحمِلُ فانوساً شاحبَ الضّوءِ من زجاجة كدَّرَها السّخام. ضمَّني واحدٌ منهم مِن خلفي وفحَّ بأذُني «لا جدوى مِن استغاثة لا يسمعُها أحد». حاولتُ التخلّصَ مِنه. لكنّه تعاونَ والآخرُ على حمْلي، رفعاني من يدي ورجلي إلى الحقل وأنا أنتفض، سارا يحملاني كالذّبيحة في الأحراشِ خلفَ حاملِ الفانوسِ الأسخم. علّقَه على جذْعِ شجرة طرحاني تحتَها، وَكمَن باغَتَهُم مسٌّ جَماعيّ، شرَعوا بتمزيقِ ملابسي. كِسرُ الأغصانِ اليابسة آذتْ بشْرة ظهري لمّا سحقوهُ على التراب. قاومتُهم حتى خارتْ قواي. استسْلمتُ. لم يحفلوا بتوسّلاتي. استرحامي تحوّل خواراً لمّا ثبّتوني، وصرتُ تحتهم أختضُ مثل جُثة باردة تغزُّها أسياخُ النّار، فروعُ الشّجرة فوقي ظلالُ أشواكٍ تعتَرِضُ حدبة القمَر. شعرْتُ بسخونة دمْعي أسفلَ صدغي يَسُحُ إلى أُذُنيّ. حتّى إذا فرِغوا منّي، قاموا يبصقون على عُرْيي. لمْلمتُ مزقَ ثيابي المُعَفّرة بالطّين، بينما شبكوا أزرارَ قُمصانِهم مُنْتَشين. تناولَ أوسطُهُم فانوسَه المعّلقَ على الجِذْع، وغارَ في ظُلمة الحَقْل مع صاحبيه، تلاشتْ ضَحَكاتُهُم بعيداً حوْلَ نقطَة الضّوْء.
إنّي أعرفُ سرَّها الآن، تلكَ النّظراتِ الطاّفِحَة بالرّيبة، وَوَشْوَشة نساءِ الحي وراءَ ظهري. كانَ زوجي في الحانة يومَ جاءتْني القابلة العجوزُ عصراً تطرقُ الباب. جلسَتْ وهمَسَتْ كي لا تسمع ابنتي. واسودتِ الدّنيا حينَ قالت إن المقطَعَ بدَأَ ينتشِرُ في القَرية. «ملامِحُكِ في ضوْءِ الفانوسِ الأصْفر، يا ابنتي، لا يُخطِئُها أحد». بيدي واريتُ وَجْهي. وَدَدْتُ الموتَ لحظتها. عانقَتْني. بكَيْتُ على كتْفِها. بكفِّها مسَحَتْ دمْعَتي. شجَّعَتْني «اذْهبي إلى عُمْدة القرية. نالي مِنهُم».
وَها أنا ذا، ما برِحْتُ مَنزلي لأربعة أيّام، مذُ خرجتُ مُتَلَفِّعَة إلى مقرِّ العُمدة، رفعتُ خِماري عندَه، وأخبَرْتَهُ بكلِّ شيء. لنْ أنسى نهوضَهُ وراءَ مكتبِهِ الخشبي المسوّس، وسبّابَتُه التي انتصبَتْ أمام شفَتَيْه:
«عودي إلى بيتِك يا امرأة. والتزِمي الصّمت»
فعدتُ خائبة إلى بيتي، حبيسة حجْرَتي وَخَبري يتفَشّى. أطلُّ مِن الكوّة وقت الغروب، أرى أمّهات حيّنا على العتباتِ ينادينَ فَتياتهنّ، فإذا حَلَّ الظَّلامُ ضَجَّتِ المزالجُ خلْفَ الأبْواب الموصدة، واقْفرّتِ السّكَكُ إلاّ مِن أخيلة تذوي سريعاً في امْتدادِ الحارة. غاراتُ الكلابِ لَمْ تُهادِنْ. وخوْفي على القرية يستحيلُ مقتاً.
إنّي أموتُ كلّ ليلة. لا أمسُّ زاداً تدفَعُهُ إلى بُنَيَّتي. تُقَرْفِصُ المسْكينة أمامي تُكلِّمُني فأَعْرِضُ عنْها. تقومُ عنّي، تُلقي علَي نظرة تقْطِرُ حَسرة، قَبْلَ أنْ تُغلِقَ دوني الباب.
وَقَدْ ارتأيتُ الخَلاص. سامِحيني يا ابْنَتي. لَنْ أموتَ ذبولاً بينَ الجُدران. وَغداً قبْلَ الشّروق، أَخْرُجُ إلى الحَقْل. ثمّ لَنْ يراني أحد».
كانَ ذلكَ آخر ما كتَبَتْهُ أُمّي في أوراقٍ عثرْتُ عليْها مُبَعْثَرة في حُجرتِها. شهدَتْ القرية أياماً عصيبة بعدَ رحيلِ أمّي. أضْربَتْ زميلاتُها تتزَعَّمَهُنَّ القابلة العجوزُ عَن العمَلِ خوفاً مِن الكِلاب. مُديريَّة أمْنِ المقاطَعَة أرسَلَتْ إليْنا مُخبِريها لّمّا بلغها الأمْر. تعَقَّبوا أصحابَ مقطَعِ أمّي. وشنّوا حمْلَة مُداهماتٍ أسْفَرَتْ عَن ْاصطيادِ الثلاثة كالجِرْذان، واحداً تِلْوَ آخر.
لكِنَّ القابلة العجوزَ لم تكتَفِ: «الكلاب».
فَما كانَ مِن راعي الغَنَمِ إلاّ أنْ ساقَ شاة إلى قَصّابِ القرية يشَحَذُ سِكّينَه. في ساحتنا أهْرَقَ دَمَها، وحَشا لَحْمَها بالذّعاف، ثمَّ ألْقى بِهِ في السِّكَكِ َمع عِظامِها المَغْموسَة بِالسُّمّ. ظلّتِ الأيامُ التي تَلَتْ عُثورَ راعي الغَنَمِ على أمّي مَشْنوقة في الحقلِ تحت شَجَرة المانجا، تُصَبِّحُنا بكلابٍ مصروعة علَى الطُّرُقات، فاغِرة أَعْيُنها وألْسِنتها تَتَدَلّى بينَ أنيابِها. لكنَّ نباحاً لم يزلْ يضجُّ من أماكن بعيدة في الليالي المُظْلِمَة. وَأيّامُنا العَصيبة بعد لَمْ تَنْتَهِ.
- كاتب كويتي
أيّامُنا العَصيبَة

أيّامُنا العَصيبَة
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة