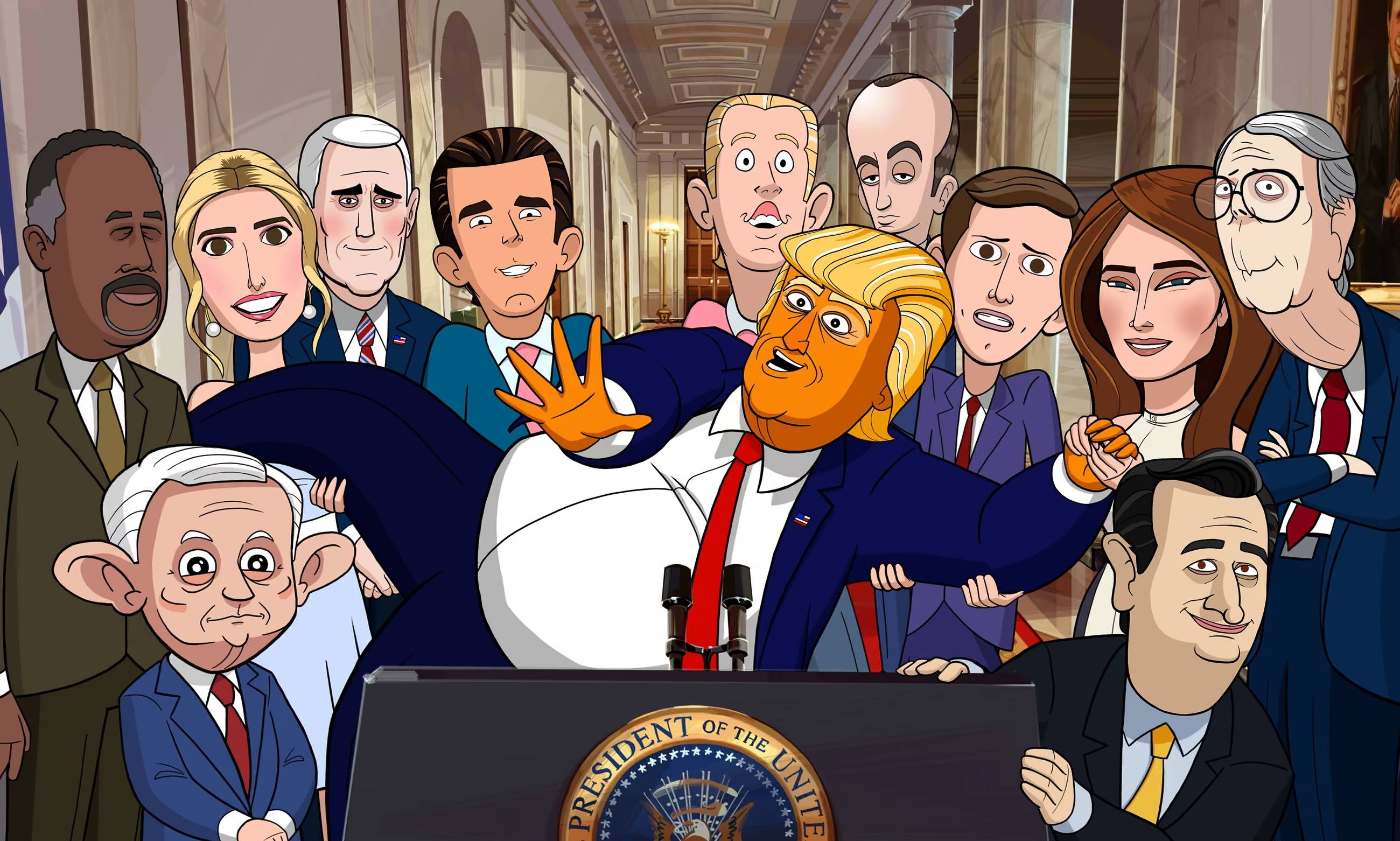«الثقافة المصرية لا تقدم ولا تؤخر»... عبارة تطالعك في الوسط الثقافي، وتستنسخ نفسها من عام إلى آخر. هذا في الأقل ما يراه الكثيرون من المثقفين، الذي يقولون: إن القطاعات الثقافية، لا تزال قاصرة عن دفع الفعل الثقافي لينفتح بحيوية على هموم المجتمع والمستقبل، وألا يكون، كما هو الآن، مجرد وظيفة أو أداة تصبّ في خدمة هذه القطاعات؛ من أجل المحافظة على كياناتها الهشة، بدل السعي إلى إعادة نظر وهيكلة لطبيعتها والأدوار المنوطة بها.
«ثقافة» استطلعت في هذا التحقيق آراء عدد من الكتاب والمبدعين المصريين حول تقييمهم ثقافتهم، ورؤيتهم لـ«ثوابتها» وسلبياتها، والدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسة الثقافية الرسمية، ممثلة بوزارة الثقافة، في تجاوز الواقع القائم.
في البداية، يقول الشاعر والمترجم أسامة جاد: «إن مفهوم (الثوابت) الثقافية مسألة خلافية إلى حد كبير، تأسيساً على أن مسألة (الثبوت) هي مسألة ضد (الحركة) أو (الدينامية) التي هي في ذاتها أهم مركزيات الحياة، والمعنى أن مفهوم الثبوت مفهوم (ضد) الحياة، أولاً، وهو ضد فكرة الثقافة، في جدليتها، باعتبارها سؤال البحث الدائم والمراجعة المستمرة لأسئلة الوجود والحياة، ويمكنني طبعاً أن أتحدث عن (ثوابت) وطنية، أو تاريخية، أو دينية، أو حتى (جينية) كما قد يزعم البعض، لكن حتى تلك الـ(ثوابت) إن سلمنا بفكرة وجودها، تظل ذات طبيعة نسبية سوف تختلف من مثقف مصري إلى مثقف مصري آخر.
إنني يمكن أن أتحدث عن ملامح ثقافية، أو عن هوية ثقافية، في لحظة ما من الزمن، وهذا لا يعني محاولة (تثبيت) تلك الملامح، فهو أمر ضد التطور، يظهر تجسده الكبير في فكرة (المجاز) بمفهوميها، الأدبي والاجتماعي. وتأسيساً على ذلك، فالهوية الثقافية بهذا المعنى يمكن تلمسها في عناصر مركزية عدة، أهمها اللغة، والتاريخ الجمعي، والهوية الشعبية، التي تسم كل إقليم في مصر، كما في العالم، بسمات مميزة وفارقة، بشكل مرحلي، تماماً كما يمكننا الحديث عن صعايدة وفلاحين، وعن سواحلية ونوبيين، وعن بدو وحضر. إن العنصر الجامع في الثقافة المصرية، وفق هذا المعنى، هو القدرة على دمج التمايزات المتنوعة في هوية واحدة، مرنة، قادرة على تطوير ذاتها والانتقال من لحظة تاريخية إلى لحظة تاريخية أخرى، تتأثر دائماً، وتؤثر بالضرورة في الحراك الإنساني كاملاً، وبخاصة في زمننا هذا، زمن القرية الإلكترونية الصغيرة».
وعن دور المؤسسة الثقافية، يرى جاد أن الدور الأهم المنوط بها هو «دعم وتشجيع الملامح الثقافية والتمايزات الإبداعية والفنية، وتوثيقها في ظرفياتها المختلفة، والاستفادة من التطور التقني والرقمنة المعاصرة لإتاحتها للمهتمين بصور توثيقية شتى. إن دور المؤسسة الثقافية بالأساس هو (الإتاحة)، وأقصد به وضع المصادر الثقافية المتنوعة في متناول من يطلبها، وبتيسيرات تسمح بنوع من الحراك الاستعادي للتراث المصري وفق رؤى متنوعة تستفيد من مكتشفات النقد الحديث، والدراسات التراثية والاجتماعية المتنوعة». لافتاً إلى أن فكرة «سلبيات الثقافة»، والتدخل الفوقي لضبطها أو تغييرها أمر لا بد من تقنينه والحذر في استعماله، بما لا يصل قط إلى الراديكالية الحدية التي تسعى لتنميط الواقع الثقافي وفق نموذج واحد. والخطورة هنا تكمن في تبني مواقف قيمية مسبقة قد تؤدي بنا إلى التعديل في تراثنا الأدبي والتاريخي وفق أهواء اجتماعية وظرفية من طبيعتها التغير الدائم. وربما كان المثال الصارخ على ذلك ما حدث في مصادرة طبعة (ألف ليلة وليلة) الأصلية لصالح طبعة (مهذبة) أشرف عليها الشاعر طاهر أبو فاشا، وهو الأمر الذي أعدّه واحداً من أفدح القرارات التي تمس نظرتنا للتراث، وتعاملنا معه. المهمة الثقافية المنوطة بالمؤسسة لا ينبغي أن تتجاوز حدود دعم المشروعات الإبداعية والبحثية المتنوعة، وإتاحة المعرفة، دون التدخل الصريح في طبيعة ونوع المنتج الثقافي، بما هو نتاج جماعي من جهة، ونتاج يعبر عن مرحلته وظروفه التي لا يصح إخضاعها لظروف وقيم مرحلة أخرى مختلفة».
أما الروائية والقاصة سعاد سليمان، فتقول: «تشوهت صورة المثقف في الخمسين سنة الأخيرة، بداية من وصف الرئيس السادات لهم بأنهم مجموعة من الأرزال، ثم الاستهانة بهم في عهد مبارك لدرجة أن يطلق على وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني أنه أدخلهم الحظيرة باعتبارهم حيوانات مدجنة، وذلك بالتوازي مع إصرار الفنان عادل إمام على تصويرهم شكلاً ومضموناً «حنجوريين»: «ريحتهم وحشة» وعالة على المجتمع. وفي المقابل إعلاء قيمة شخصيات تم تجسيدها في السينما مثل «الهلفوت والحريف»... وغيرهم.
وتضيف سعاد سليمان: «من هنا نصل إلى كيفية نظر المثقفين إلى ثقافتهم، أعتقد أنها عبء عليهم أن يبتلوا به... لكن الثقافة، في الوقت نفسه، لا يجب أن تكون وقفاً على فئة بعينها، وإنما هي ملك للجميع، غير أنه في ظل الحرب الشرسة الخفية والمعلنة تاهت فكرة ومعنى الثقافة، وماذا نريد منها؟ فأصبحت معنى هلامياً غامضاً ليس مفهوماً لدى العامة، وارتبط جانب كبير منها بالسخرية».
وتتابع صاحبة «شال أحمر يحمل خطيئة» قائلة: «إن الثوابت الثقافية التي نتحدث عنها لن تصنعها المؤسسة الثقافية الرسمية، بل هي دور أصيل من أدوار المؤسسة التعليمية فمن المستحيل أن تتأسس أي ثقافة على جهل. المؤسسة الثقافية تستكمل ما زرعه التعليم، وحينها ستشكل الثقافة ملامحها الخاصة بها، أما ما يمكن أن تقدمه وزارة الثقافة في الفترة الحالية، وليتها تستطيع، هو أن تنزل للناس في الشوارع والميادين وتقدم الحفلات الموسيقية، خصوصاً في المناطق الشعبية، ومهرجانات شعر ومسرح ورسم، وتعيد حضور المسارح والسينما إلى دورها الحقيقي الذي اختفى».
ويشبّه الروائي والقاص عصام حسين الثقافة المصرية بالعقل المصري، كلاهما ينقل وينسخ عن الآخر، دون مساءلة، ودون أن يكون للعقل الناقد دور في التجديد وفي النفاذ إلى العمق الثقافي وهو عصبها وقضيتها المركزية، فالمفروض، كما يقول، أن تهدف الثقافة أساساً إلى تحرير العقل وفك قيوده بالتغلب على الفكر الماضوي المعطل لحركة الحياة.
ويضيف صاحب «سرير عنكبوت»: «ليس خفياً على أحد تغلغل أصحاب الفكر الظلامي في أغلب إدارات ومواقع وزارة الثقافة، ورغم أن الثقافة تنهض بتوفير مناخ من حرية الفكر والتعبير، فإن هؤلاء دائماً ما ينثرون الغبار ويشوشون على الحريات تحت ذريعة الادعاء بأنهم يملكون وحدهم الحقيقة المطلقة، ويتحالفون دائماً مع قوى الفساد الأخرى ضد أي مشروع تنويري قائم علي تحرير العقل من كل هذه الخرافات والأوهام. أهم سلبيات ثقافتنا - من وجهة نظري - تنحصر أساساً في تلك الرؤية الباهتة التقليدية والتي تظل متجمدة؛ لأنها لا تسعى للتجديد ومن ثم تحرير العقول كي تكسر كل القوالب الجاهزة، وعلى المؤسسة الثقافية أن تتبناها بصفتها مشروعاً تنويرياً لتخرج للناس بعيداً عن القوالب. نحلم باليوم الذي تنال فيه الثقافة الدرجة الأولى من الاهتمام بأسلوب وآليات جديدة ومتجددة، أبرزها توفير مناخ حقيقي من حرية الفكر والتعبير، ثم التخلص من التبعية الثقافية الغربية باستدعاء كل مقومات الثقافة الوطنية والتركيز علي هويتنا المصرية أولا وقيل أي شيء آخر».
ويحذر الباحث والروائي عمار علي حسن من مخاطر جمة تحيط بالثقافة المصرية، قائلاً: «يرى المثقفون المصريون أن ثقافتهم باتت في خطر، وأن الدور الطليعي والريادي أو القيادي للثقافة المصرية في الإقليم أو الوطن العربي بات موضع مساءلة، وهناك كثيرون يرون تراجعه، ليس لخلو مصر من مثقفين كبار، لكن لأن المشروع السياسي للدولة المصرية لم يعد موجوداً، كما أن المؤسسات الرسمية لا تقدم إلى الواجهة أصحاب القدرات الثقافية الرفيعة، إنما الموالون لها، وأغلب هؤلاء ليسوا على شيء من ثقافة. إن الثقافة المصرية تنبني على الكثير من الثوابت أو الأوتاد تتعلق بطبقات مصر الحضارية، ودورها القديم في العالم القديم والأوسط، ثم طموحها الدائم، رغم التراجع الحالي، إلى استعادة مكانتها، وهي مسألة تتعلق بالتجدد الحضاري، أو القدرة على النهوض بعض قعود، والاستيقاظ بعد غفلة.
وخلص أستاذ علم الاجتماع صاحب كتاب «الخيال السياسي» إلى القول: هناك أيضاً ثابت التنوع الديني والجهوي والثقافي، والعمل الدائم على أن تصب الثقافات الفرعية لسكان الصحراء والصعيد والنوبة والأقباط في الثقافة الأصلية، والتي يمثلها الجميع أيضاً. وهناك جذر يتمثل في هوية مصر، التي صنعت ونمت عبر تاريخ طويل. واستعادة الدور الثقافي، أو الحفاظ على ثوابتها، والعمل على تجددها، ليس مسؤولية وزارة الثقافة فحسب، بل هي مسؤولية المجتمع المدني وقوى المثقفين من الكتاب والفنانين والخبراء والمتعلمين.
مثقفون مصريون يدقون أجراس الخطر
يقولون إن مؤسستهم الرسمية تراكم أخطاءها دون مساءلة


مثقفون مصريون يدقون أجراس الخطر

لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة