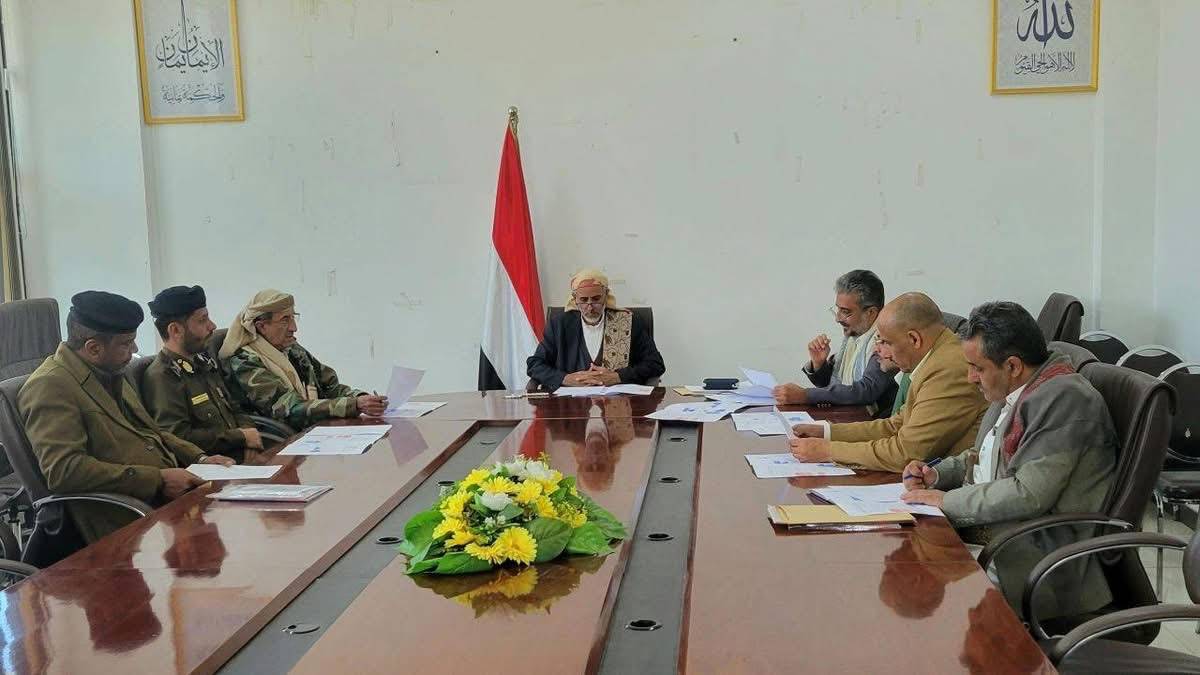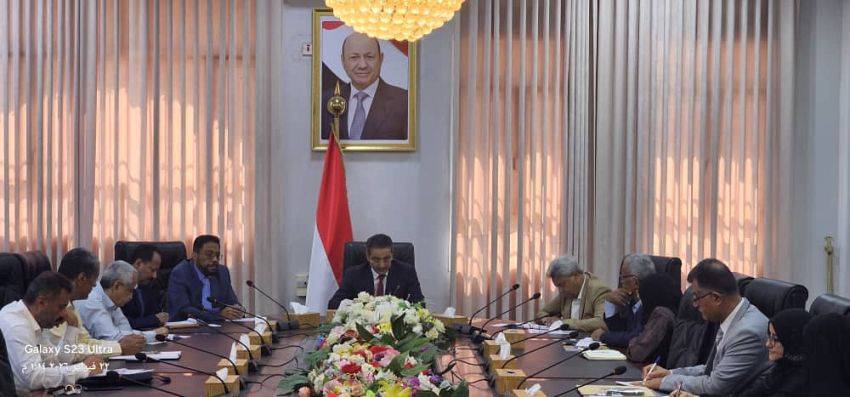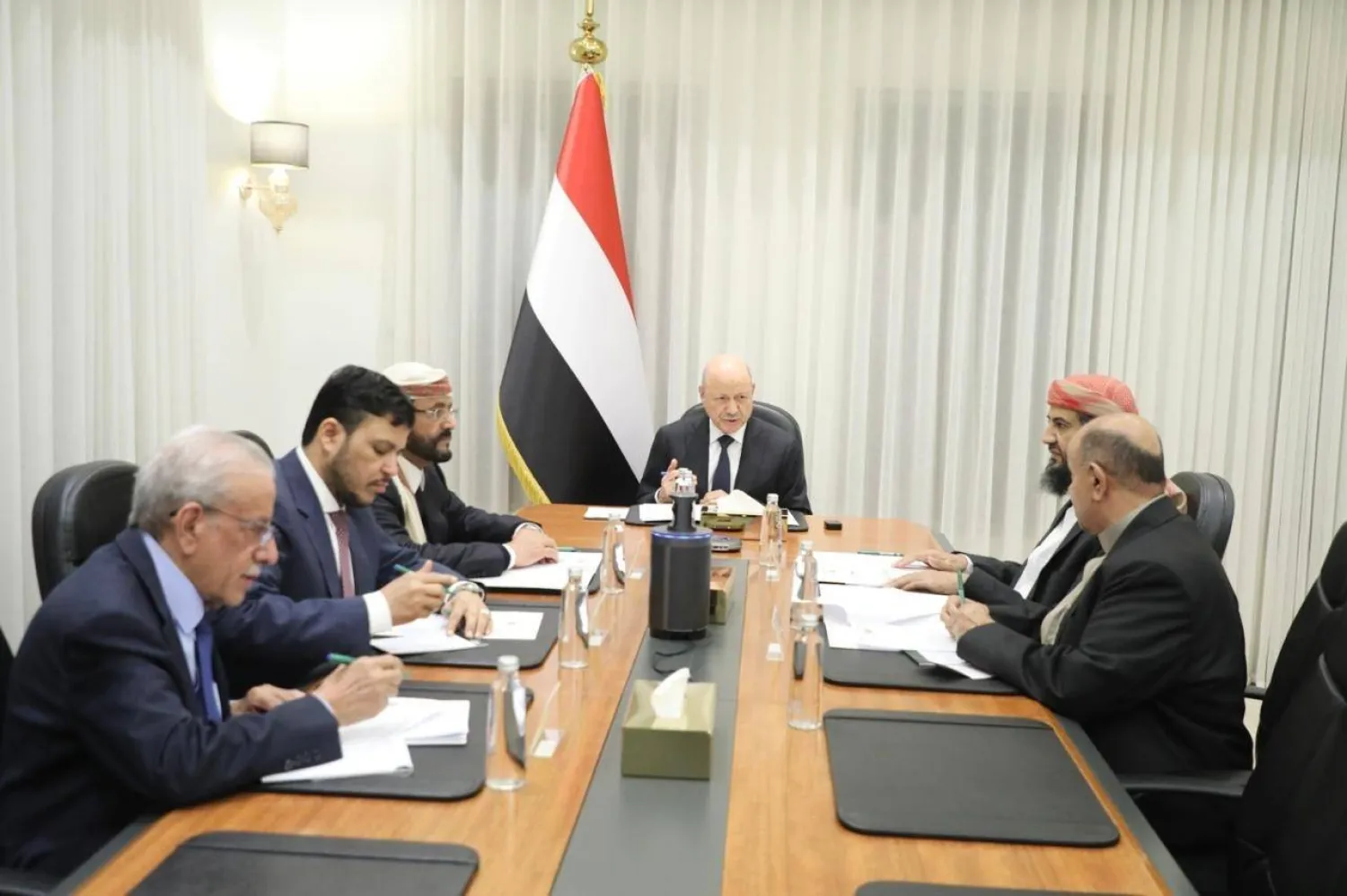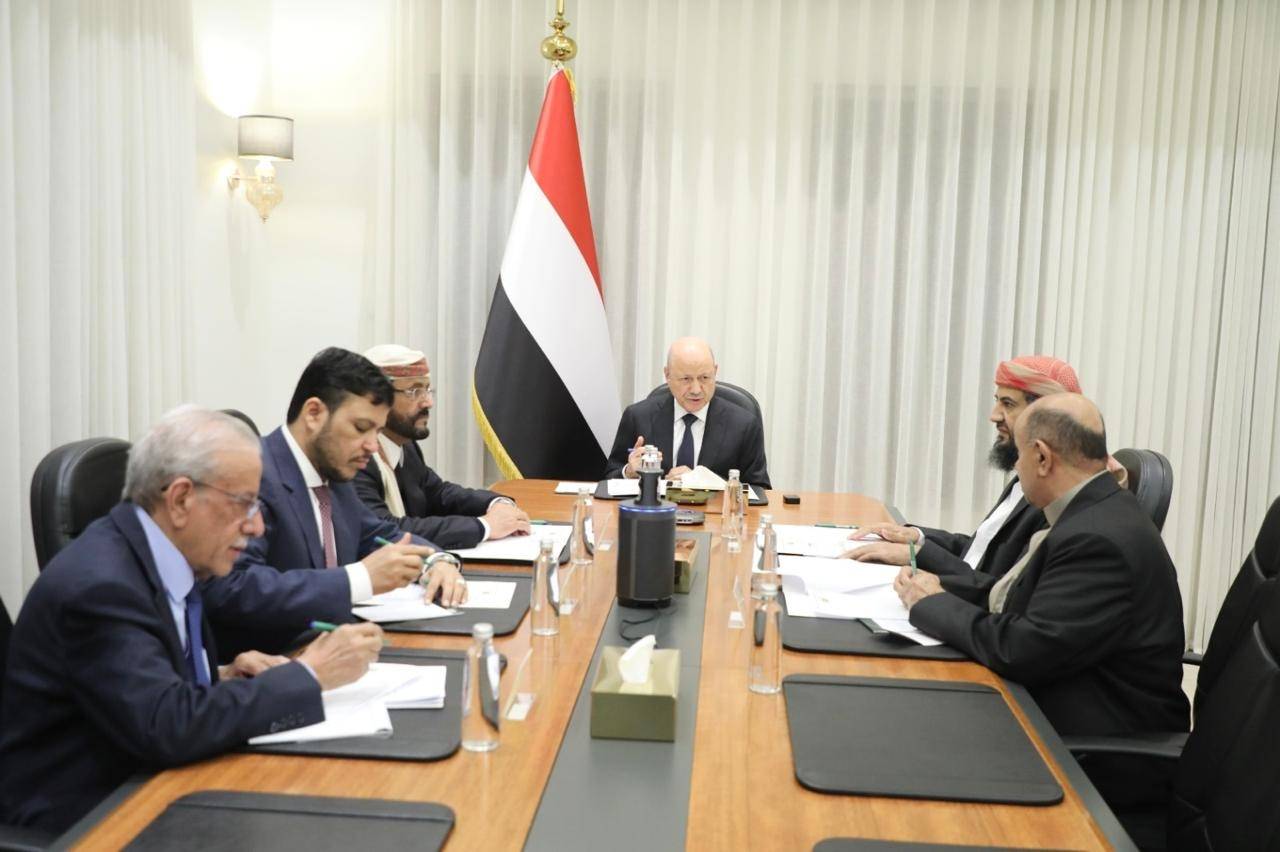بالنسبة للفلسطينيين، يوجد الكثير كي يتفاضلوا عليه مع الإسرائيليين بعد 50 عاما على احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. إنهم ببساطة يريدون استعادة ما ضيعوه آنذاك، ورفضوه ضمن مقترحات لاحقة: دولة على حدود 67 لا أكثر ولا أقل، ولكن ماذا تبقى من هذه الدولة المرجوة بعد عقدين من الحرب طويلة الأمد، ومثلها من المفاوضات المتجددة.
يجيب عن ذلك كبير المفاوضين الفلسطيني صائب عريقات، فيقول في بيان رسمي أمس، في ذكرى 50 عاما على الاحتلال، إن القيادة الفلسطينية سترفض وتحارب «محاولات سلطة الاحتلال فرض واقع الدولة الواحدة بنظامين (الأبارتايد) الذي ترسخه على الأرض، من خلال فرض وقائع غير قانونية وأحادية، من استيطان استعماري، وعمليات مكثفة من التطهير العرقي والعقاب الجماعي، تستبق فيها الوصول إلى تسوية سياسية.
إن ما تبقى باختصار، هو أراض مقسمة تحتلها أو تحاصرها دولة واحدة وتقيم فيها نظامين.
وليس سرا أنه في مراحل كثيرة بعد الاحتلال الإسرائيلي وقبله وبعد سنوات طويلة منه، كان يمكن إقامة الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافيا، ولها حدود واضحة وذات سيادة. لكن الأمر يبدو الآن مختلفا، إذ يعيش الفلسطينيون تحت سلطات ثلاث في ثلاث مناطق مقسمة: الضفة الغربية وتحكمها السلطة الفلسطينية، والقدس الشرقية وتحكمها إسرائيل، وقطاع غزة وتحكمه حماس.
الضفة الغربية: الكيان المحتل والمقسم
تبلغ مساحة الضفة الغربية المحتلة (5.655 كيلومتر مربع)، وتقع شرق إسرائيل وغرب الأردن.
احتلت الضفة عام 1967 مع قطاع غزة والقدس الشرقية، وهضبة الجولان السوري وشبه جزيرة سيناء المصرية.
تشكل الضفة الغربية نحو 21 في المائة من مساحة فلسطين التاريخية، لكن إسرائيل بعد 50 عاما على احتلالها، لا تعطي الفلسطينيين من الضفة سوى 40 في المائة، مزروعة بالمستوطنات والجنود والشوارع المحمية، وبذلك يصبح من الصعب حساب المساحة التي يسيطر عليها الفلسطينيون، إذا عرفنا أن إسرائيل تستبيح أي منطقة تابعة للسلطة في أي وقت.
ويعيش في الضفة اليوم نحو 2.9 مليون فلسطيني، ونحو 430 ألف مستوطن في المستوطنات، ناهيك عن 200 ألف آخرين في القدس الشرقية.
وهذه المستوطنات تجعل تواصل الدولة المقسمة أصلا شبه مستحيل.
تقسيم المقسم
أفرز اتفاق أوسلو الذي وقع في واشنطن عام 1993 وقامت بموجبه السلطة الوطنية الفلسطينية، واقعا معقدا في الضفة الغربية، إذ قسمها إلى 3 مناطق: «أ» و«ب» و«ج»، بحيث تتبع المنطقة ألف للسلطة الفلسطينية أمنيا وإداريا، وتتبع المنطقة «ب» لإسرائيل أمنيا وللسلطة إداريا، فيما تتبع المنطقة «ج» لإسرائيل أمنيا وإداريا.
وتشكل الأخيرة التي تسيطر عليها إسرائيل في قلب الضفة الغربية ثلثي مساحتها. وكان من المفترض نقل المنطقة «بشكل تدريجي»، لتصبح تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، ولكنها لا تزال تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة.
وتأخذ الحرب على الفلسطينيين الآن، في ثلثي مساحة الضفة الغربية، أشكالا مختلفة، عسكرية وقانونية وعبر قطعان المستوطنين وإرهابهم. وهي تستهدف مثلما كانت قبل 70 عاما، السيطرة على الأرض والتخلص من سكانها.
وتختلف أساليب إسرائيل باختلاف المنطقة المستهدفة. ففي منطقة حدودية مثل الأغوار، تستخدم إسرائيل كل الإمكانيات، جنودا واستيطانا ومياها وقوانين وقضاء للسيطرة على المنطقة. وفي أراضٍ وقرى استراتيجية قريبة من المستوطنات، تستخدم إسرائيل قوانين قديمة وأخرى حديثة ومسوغات عسكرية لطرد الناس. وفي قرى أقل قيمة، ترسل قطعان المستوطنين لترهيب وتخويف الناس.
وبحسب تقرير لمكتب الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، يخضع الفلسطينيون في الضفة الغربية لنظام معقد من السيطرة، منها معيقات مادية (الجدار، والحواجز والمتاريس) ومعيقات بيروقراطية (التصاريح، وإغلاق المناطق) التي تحد من حقهم في حرية التنقل. فيما يستمر توسيع المستوطنات، والقيود المفروضة على الوصول إلى الأراضي والموارد الطبيعية والتهجير المستمر بسبب عمليات الهدم بشكل خاص. هذا وتحدّ السياسات الإسرائيلية من قدرة الفلسطينيين في المنطقة (ج) والقدس الشرقية، على التخطيط لتجمّعاتهم وبناء المنازل والبنية التحتية. والنتيجة هي مزيد من تجزئة الضفة الغربية.
والضفة اليوم بكل مناطقها، أغوار و«أ» و«ب» و«ج»، محاصرة بجدار كبير بشع مؤلف من كتل من الإسمنت بارتفاع أمتار عدة. لقد حولها الإسرائيليون إلى سجن كبير فيه سجون صغيرة.
قطاع غزة: الكيان المحاصر المعزول
يقع قطاع غزة جنوب غربي إسرائيل، تحده مصر جنوبا والبحر الأبيض المتوسط غربا.
ويعيش في هذا الشريط الساحلي الضيق، الذي تبلغ مساحته 362 كلم مربعا، وطوله 45 كلما وعرضه بين ستة و12 كيلومترا، مليونا فلسطيني، ما يجعله أكثر مناطق العالم اكتظاظا بالسكان.
كان قطاع غزة قبل احتلاله عام 1967 تحت حكم الإدارة المصرية، وفي 1967 كان وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه ديان الذي دخل «فاتحا» للقدس، مترددا في شأن القطاع، لكنه قرر احتلاله في النهاية، وهذا ما تم في حملة انتهت أيضا باحتلال شبه جزيرة سيناء.
في 1987. أطلقت غزة شرارة الانتفاضة الشعبية الأولى، وعندما وقعت إسرائيل اتفاقية السلام مع منظمة التحرير عام 1993 هربت أولا من غزة، وسلمت الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات القطاع كاملا إلى جانب مدينة واحدة في الضفة وهي أريحا.
شنت إسرائيل سلسلة عمليات متلاحقة ضد غزة، وكان على أهلها في 2007، أن يجربوا حكما جديدا بخلاف مصر وإسرائيل والسلطة، حكم حركة حماس التي سيطرت على القطاع بقوة السلاح.
يعيش القطاع وسط حصار شديد يمكن وصفه بحصار إسرائيلي مصري فلسطيني أيضا، يستهدف في معظمه حكم حماس هناك وضمان الوضع الأمني كذلك.
جرب الفلسطينيون المحاصرون هناك 3 حروب طاحنة بين العامين 2008 و2014. حولت جزءا كبيرا من غزة إلى ركام، وشردت آلافا من السكان وأعادت القطاع سنوات طويلة إلى الوراء.
يفتقر قطاع غزة إلى الموارد الطبيعية، ويعاني من نقص مزمن في المياه والوقود والكهرباء. وارتفعت فيه نسبة البطالة إلى 45 في المائة.
تتهم السلطة حركة حماس بمحاولة إقامة إمارة خاصة بها هناك منفصلة عن الدولة الفلسطينية، وتنفي حماس الأمر، لكن إسرائيل تحاول جاهدة الإبقاء على الوضع القائم، شبه دولتين، واحدة محاصرة في غزة والثانية فيها سلطة بلا سلطة.
القدس الشرقية والاستيطان
يتطلع الفلسطينيون لأن تكون عاصمة الدولة العتيدة، لكن إسرائيل تقول: إن القدس هي موحدة بشقيها الشرقي والغربي.
فشلت كل المفاوضات السابقة في إيجاد حلول للمدينة التي أعلنها الكنيست عام 1980 «العاصمة الأبدية والموحدة لإسرائيل»، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
وحتى اقتراحات تحويلها إلى عاصمة دولية دينية مفتوحة لجميع الأديان لم تر النور.
وللقدس مكانة دينية كبيرة لدى المسلمين بسبب وجود الحرم القدسي الذي يضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة، وللمسيحيين بسبب وجود كنيسة القيامة، وفيها ضريح يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر، وبني على الموقع الذي يعتقد أنه قبر المسيح. ولليهود كذلك، بسبب وجود حائط البراق الذي يسميه جميع اليهود «حائط المبكى»، ويقع أسفل باحة الأقصى. ويعتبره اليهود «آخر بقايا المعبد اليهودي (الهيكل)» الذي يزعمون أن الأقصى بني على أنقاضه.
يوجد في القدس الشرقية فقط 200 ألف مستوطن، يعيشون بين نحو 423 ألف فسلطيني.
الواقع المر
وجاء في تقرير رسمي لجهاز الإحصاء الفلسطيني: «تستغل إسرائيل أكثر من 85 في المائة من مساحة فلسطين التاريخية، والبالغة نحو 27,000 كم، ولم يتبقَ للفلسطينيين سوى نحو 15 في المائة فقط من مساحة الأراضي، وبلغت نسبة الفلسطينيين 48 في المائة من إجمالي السكان في فلسطين التاريخية، وقد أقام الاحتلال منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة، بعرض يزيد عن 1,500م على طول الحدود الشرقية للقطاع، وبهذا يسيطر على نحو 24 في المائة من مساحة القطاع البالغة 365 كم²، كما تسيطر إسرائيل على أكثر من 90 في المائة من مساحة غور الأردن، الذي يشكل ما نسبته 29 في المائة من إجمالي مساحة الضفة الغربية».
وتشكل نسبة المستوطنين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية، نحو 21 مستوطنا مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغت أعلاها في محافظة القدس، نحو 69 مستوطنا مقابل كل 100 فلسطيني.