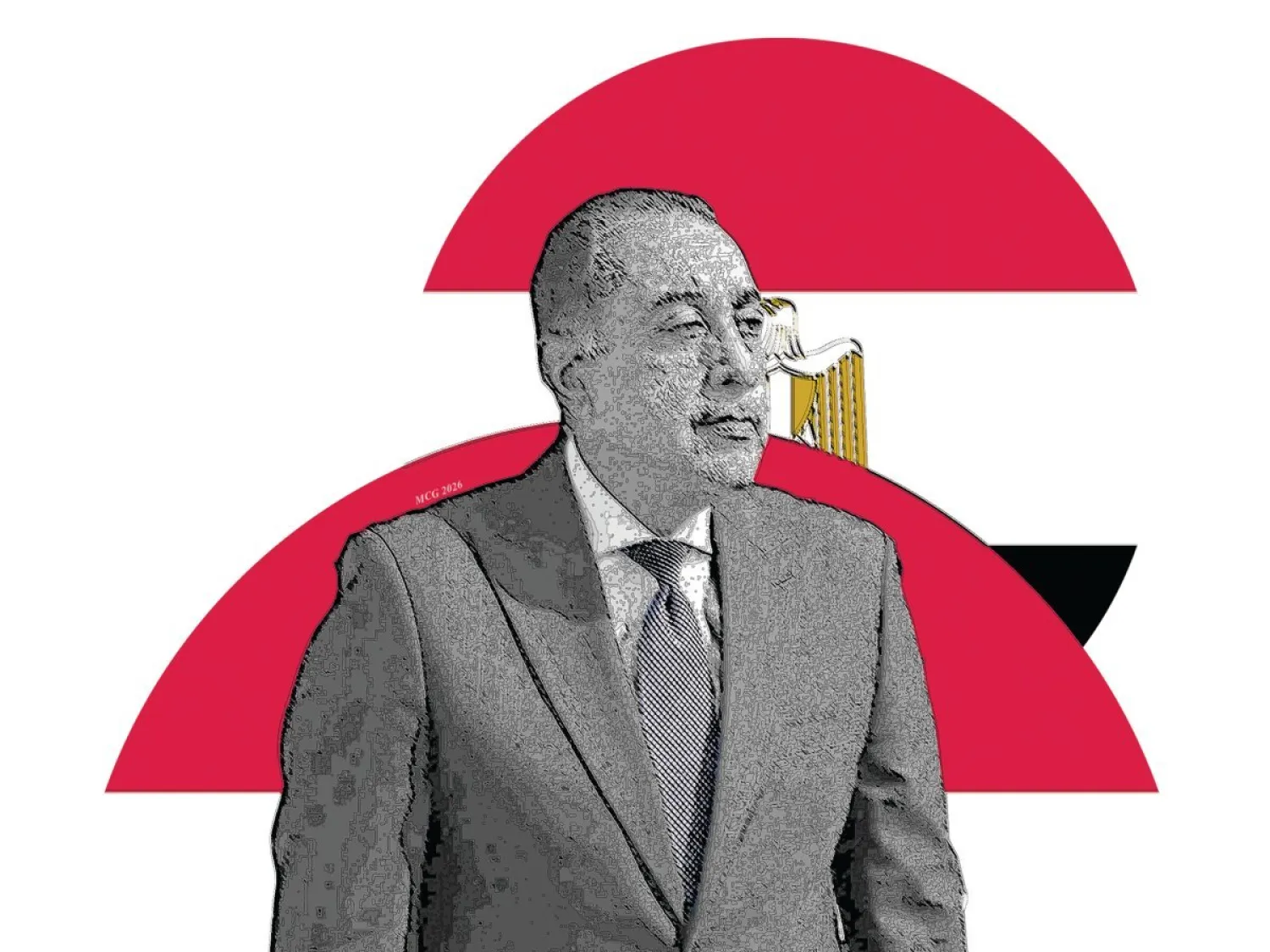لم تسرق حتى الساعة أي جبهة الضوء من جبهة البادية السورية التي شهدت قبل أكثر من أسبوع حركة أميركية لافتة بإطار التصدي لدفع إيران بمجموعة من الميليشيات للسيطرة على معبر التنف والوصول إلى الحدود العراقية وبالتالي تأمين ممر بغداد - دمشق ومن خلفه بيروت - طهران. ولعل ما نتج عن القمة العربية - الإسلامية - الأميركية التي شهدتها الرياض نهاية الأسبوع الماضي، لجهة القرار المشترك بالتصدي لتوسع إيران في المنطقة، جعل الأنظار تتركز أكثر على البادية السورية التي قد تتحول مسرحا لمواجهة أميركية - إيرانية مفتوحة، خاصة في ظل المعلومات عن تعزيزات وصلت إلى قاعدة التنف العسكرية بالتزامن مع استكمال الميليشيات التابعة لطهران تقدمها باتجاه «الخطوط الحمراء» التي رسمتها واشنطن وأبلغت بها موسكو.
في جنوب شرقي سوريا، استنفار متواصل منذ أكثر من 10 أيام. الفصائل المدعومة أميركيا تتحضر لمعركة «بركان البادية» لطرد الميليشيات الموالية لطهران من المناطق التي تقدمت إليها مؤخرا في بادية الشام، في حين تواصل عناصر هذه الميليشيات محاولات التقدم، ولقد باتت بالفعل على مشارف «الخط الأحمر» الذي رسمته واشنطن، وهو يبعد 40 كلم عن القاعدة العسكرية في التنف؛ حيث تتحصن قوات أميركية وبريطانية ونرويجية تدرّب مقاتلين معارضين ينضوون بشكل رئيسي ضمن إطار «جيش مغاوير الثورة».
ويبدو أن هذه الميليشيات ستكون وفق خبراء، في حال قررت خرق «الخطوط الأميركية الحمراء»، على موعد مع ضربات جوية جديدة تنفذها واشنطن، على غرار الضربة التي استهدفت قبل 10 أيام قافلة لمقاتلين تقودهم طهران، كانوا في طريقهم إلى قاعدة التنف العسكرية في جنوب سوريا قرب الحدود مع العراق والأردن.
ومن جانب آخر، وعلى الرغم من إعلان نظام دمشق في حينه أن القصف الجوي الذي نفذته طائرات التحالف الدولي قرب الحدود الأردنية استهدف «إحدى النقاط العسكرية للجيش (النظامي) السوري» في شرق البلاد، أكّد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» مقتل ثمانية أشخاص «معظمهم غير سوريين». كذلك نقلت شبكة «سي إن إن» عن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية قوله إن واشنطن أرسلت طائرتين «استعراضا للقوة» لإرغام المركبات السورية على العودة، وأضاف: «لكن المركبات لم تتوقف، ما أدى إلى التصعيد من استعراض للقوة إلى غارة جوية». ووفقاً للمسؤول الأميركي، اخترقت ثلاث عشرة مركبة «منطقة نزع السلاح» حول قاعدة التنف، وهي المنطقة التي أبلغ التحالف الروس بضرورة الابتعاد عنها. وقال المسؤول إن 5 من المركبات كانت على بعد 29 كيلومتراً من القاعدة عند منتصف ليلة الخميس عندما تم إرسال الطائرات الأميركية.
في هذه الأثناء، يترقّب خبراء بالملف السوري وبسياسة واشنطن الخطوة الأميركية. ويتوقع هؤلاء أن تنخرط الولايات المتحدة أكثر في ميدان العمليات السوري من خلال تأمين الدعم الجوي للمجموعات السورية البرّية التي تدعمها، وكذلك زيادة أعداد عناصرها من خبراء ومستشارين وقوات خاصة، المنشورين في المنطقة. وفي هذا السياق، يقول رياض قهوجي، رئيس مركز «الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري» (إنيغما): «تشهد سياسة واشنطن تجاه الشرق الأوسط تغييرات كبيرة على عدة صعد، على أن تبقى سرعة هذه التغييرات ومدى دراماتيكيتها رهن حنكة الإدارة ونجاحها في تسويقها وتنفيذها داخلياً وخارجياً».
ويؤكد قهوجي، في مقال بموقع «منتدى الأمن والدفاع العربي» أن هذا ما خلصت إليه اجتماعات وحلقات حوار مع مسؤولين في الخارجية الأميركية ووزارة الدفاع (البنتاغون) ومراكز الأبحاث في واشنطن. وهو ينقل عن مسؤول رفيع في الخارجية الأميركية أن «سياسة أميركا نحو إيران ودول الخليج ستشهد تحولاً بنسبة 180 درجة». ويلفت الخبير الاستراتيجي اللبناني - الذي يتخذ مركزه من دبي مقراً له - إلى أن «أهم هدفين للإدارة الأميركية الجديدة فيما يخص طهران هما إيقاف أو الحدّ من تطور برنامج الصواريخ الباليستية، وحصر الانفلاش الإيراني في المنطقة، وتحديداً عبر منعها من فتح ممر برّي يصل حدود إيران الغربية بالبحر المتوسط عبر العراق وسوريا، وهذا مع التركيز على إنهاء وجود إيران وحلفائها من المناطق المحاذية للجولان».
* القضاء على «داعش»
من جهة ثانية، حسب مسؤولين عسكريين أميركيين سيبقى موضوع القضاء على تنظيم داعش الإرهابي المتطرف على قمة أولويات الإدارة الأميركية الجديدة، ولكن من منطلق آخر وغايات مختلفة عن تلك التي كانت تبنّتها إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما. وفي هذا الإطار، يوضح قهوجي: «هدف محاربة (داعش) والمجموعات المرتبطة بتنظيم القاعدة سيكون ضمن سياسة الحد من نفوذ إيران والنظام السوري اللذين يستغلان الحرب ضد هذه الجماعات لتوسيع مناطق نفوذهما في سوريا والعراق». وعليه، فهدف الحرب على «داعش» وأتباعه، حسب الإدارة الجديدة في واشنطن، لن يكون للقضاء عليه فحسب، إنما السيطرة على أراضيه ومنع إيران وحلفائها من احتلالها واستخدامها في بناء الممر البري نحو الساحل السوري.
ويرجّح قهوجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تكون المعركة الكبيرة والرئيسية في محيط مدينة البوكمال ثاني كبرى مدن محافظة دير الزور، المتاخمة للحدود العراقية، «حيث سيسعى الإيرانيون لتلاقي القوات التابعة لهم والآتية من الحدود العراقية مع تلك المقاتلة داخل الحدود السورية»، ويضيف أنه «إذا نجحت القوات المدعومة أميركياً بالوصول إلى هذه المنطقة وقطع الطريق على تلاقي الميليشيات الإيرانية، فستكون قد أفسدت الخطة والطموحات الإيرانية، وسنشهد عندها فرض واقع جديد وتدخل أكبر من الجانب الأميركي». ويتابع قهوجي: «الأمور ستتبلور وتتحرك في بداية الشهر المقبل، بعيد انتهاء جولة الرئيس الأميركي في منطقة الشرق الأوسط واجتماعات حلف شمال الأطلسي (ناتو) وقمة مجموعة الدول السبع (G7)».
* «جيش مغاوير الثورة»
على صعيد آخر، برز في الآونة الأخيرة دور «جيش مغاوير الثورة» بقيادة العقيد مهند الطلاع كذراع أساسية لواشنطن في المنطقة الشرقية من سوريا، على غرار اتخاذها في الشمال السوري ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) - ذات الغالبية الكردية - حليفا أساسيا لها، على الرغم من كون الأول لا يزال متواضعاً من حيث العدد والإعداد والقدرات إذا ما قورن بـ«قسد». وأظهرت دراسة حديثة أعدها مركز «جسور» للدراسات أن «جيش مغاوير الثورة»، الذي من المتوقع أن يخوض معركة دير الزور هو الفصيل المعارض الذي يسيطر على أكبر مساحة جغرافية، تتمثل بشكل رئيسي في منطقة البادية (بادية الشام)، وهو ما اعترض عليه مسؤولون في فصيل «أسود الشرقية» الذي يقاتل في المنطقة أيضاً ويعمل ضمن مشروع غرفة «الموك» (مقرها الأردن).
حالياً، تتركز وجهة «مغاوير الثورة» على مدينة دير الزور على طول الحدود الشرقية الممتدة من التنف على مثلث الحدود السورية - الأردنية - العراقية، وشمالاً باتجاه دير الزور. وقد تطوّرت من ميليشيا «جيش سوريا الجديد» التي أُعلن عنها في الصيف الماضي وتعرّضت لانتكاسة إثر ضربة جوية يُعتقد أنها روسية استهدفت معسكراً لهم في المنطقة، إلى «جيش مغاوير الثورة»، ولم يسجل لها أي احتكاك مع قوات النظام. أما ميليشيا «أسود الشرقية» المدعومة من غرفة «الموك»، فيقتصر دعم الغرفة لها على الدعم اللوجيستي والتسليحي، من غير مشاركة في القتال إلى جانبها. وتنتشر هذه القوة في بادية جنوب شرقي السويداء وتمتد شمالاً حتى القلمون الشرقي، ولقد استطاعت أن تحرز تقدماً كبيراً منذ مارس (آذار) الماضي على حساب «داعش».
ووفق الباحث الاستراتيجي والخبير العسكري الأردني الدكتور فايز الدويري، فإن ما تشهده منطقة البادية ليس مواجهة إيرانية - أميركية مباشرة بل أشبه بـ«حرب بالوكالة» تخوضها ميليشيات محسوبة على طهران وفصائل مدعومة أميركياً.
* «حرب بالوكالة»
ويؤكد الدويري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات التي تتقدم باتجاه التنف محصورة بـ«كتائب الإمام» و«سيد الشهداء» وهي ميليشيات عراقية، نافياً انضمام ميليشيا «حزب الله» أو ميليشيات فلسطينية للقتال على هذه الجبهة. ويضيف: «في المقابل يقاتل (مغاوير الثورة) و(أسود الشرقية) و(أحرار العشائر) وقوات (أحمد العبدو) بطرف الفصائل المحلية المدعومة أميركياً». ويشير الدويري إلى أن واشنطن «تتدخل بشكل مباشر عند الضرورة وهو ما شهدناه قبل 10 أيام حين استهدفت قافلة لكتائب (سيد الشهداء) كانت تقترب من معبر التنف»، مستبعداً أن «تلعب إيران أي دور مباشر في المعركة هناك، فتكتفي بإرسال الميليشيات العراقية التي تقحمها في سياسة حافة الهاوية».
وفي السياق ذاته، تردد في الأيام القليلة الماضية، أن مجموعات من «لواء القدس الفلسطيني»، التي كانت موجودة في حلب، انتقلت للمشاركة في معارك بادية تدمر وفي العملية العسكرية التي تهدف قوات النظام السوري من خلالها إلى التقدم نحو الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور. ويُعتبر «لواء القدس الفلسطيني» الذي أسس عام 2013 من أبرز المجموعات الفلسطينية التي ساندت نظام الأسد في مدينة حلب وريف محافظتها، ومعظم مقاتليه من مخيمي النيرب وحندرات. وكانت ميليشيات شيعية عراقية جديدة يطلق عليها اسم «الأبدال» قد نشرت صوراً لعناصرها الأسبوع الماضي على الطريق المؤدية إلى معبر التنف، وقالت إنها سيطرت على نقطة مهمة في المنطقة. أما وكالة «فارس» الإيرانية التابعة لـ«الحرس الثوري»، فقد أعلنت أن طهران سترسل 3000 مقاتل من «حزب الله» إلى معبر التنف «لإحباط» ما سمتها «المؤامرة الأميركية»، وذلك بعد الضربة العسكرية التي استهدفت رتلا لقوات النظام في المنطقة، الأسبوع الماضي.
يذكر أن النظام السوري وحلفاءه أعلنوا في الثامن من مايو (أيار) الحالي فتح معركة الوصول إلى الحدود العراقية، وبالتالي تأمين ممرّ بغداد - دمشق، ثم ممر بيروت - طهران، وذلك بالتزامن مع ما سبق تداوله عن حشود عسكرية على الحدود الأردنية مع سوريا تمهيدا لعملية تدعمها واشنطن في الجنوب.
وتجنّدت وسائل الإعلام التابعة للنظام و«حزب الله»، في حينه، للتحذير من «تحركات لقوات أميركية وبريطانية وأردنية باتجاه الأراضي السورية». بل إن «الإعلام الحربي» التابع لـ«حزب الله» وجه يومذاك على لسان مصدر فيه «تهديداً مباشراً» لواشنطن قائلا: «ليعلم الأميركيون وحلفاؤهم أنهم سيدفعون الثمن غالياً، وسيكونون أهدافاً جراء استباحتهم الأرض السورية».
أما قناة «الميادين» اللبنانية، المقربة من النظام السوري و«حزب الله»، فتحدثت بدورها عن «رصد تحرّكات عسكرية ضخمة تشير إلى اقتراب ساعة الصفر على الحدود السورية مع الأردن». ولفتت إلى «تجمّع حشود عسكرية أميركية وبريطانية وأردنية على الحدود الجنوبية لمحافظتي السويداء ودرعا من تل شهاب إلى معبر نصيب، وإلى منطقة الرمثا وانتهاءً في خربة عواد (بأقصى جنوب محافظة السويداء) ووجود كتائب دبابات بريطانية ثقيلة من نوع (تشالنجر) مع 2300 مسلح وعدد من طائرات الهليكوبتر العسكرية من طرازي (كوبرا) و(بلاك هوك)». ووفق ادعاءات القناة فإن «قرابة 4000 مسلح ممن دُرِّبوا في الأردن موجودون في منطقة التنف داخل الحدود السورية». ولكن في مقابل ذلك، لم يصدر أي تعليق رسمي أردني أو أميركي بخصوص أي تحضيرات لعملية عسكرية مرتقبة في الجنوب السوري. والأرجح أن التعزيزات اقتصرت على المشاركة في مناورات «الأسد المتأهب» لعام 2017 التي شاركت فيها 23 دولة خلال الفترة الواقعة من 7 حتى 18 مايو. وهو ما أكّده الدويري، مشددا على أن كل ما تم تداوله عن حشود على الحدود الأردنية - السورية للمشاركة في معركة كبيرة في الداخل السوري، تبين أنّه لا يعدو «زوبعة في فنجان»، باعتبار الأردن لا يجد نفسه معنياً أبدا بفتح جبهة مع سوريا وإن كان لن يتردد في دعم فصائل معارضة في معركتها لتأمين حماية حدوده.
* إيران... وأميركا
وفق المعطيات الراهنة، لا يبدو أن الطرف الإيراني بصدد الاستسلام قريباً للإرادة الأميركية بما يتعلق بممر التنف الذي يُعتبر غاية في الأهمية لطهران. وهذا ما يشدد عليه الباحث المتخصص بشؤون الجماعات المتشددة عبد الرحمن الحاج، الذي يشير إلى أن «الإيرانيين لن يتوقفوا عن المحاولة للسيطرة عليه، لكن هل سيسمح لهم الأميركيون بذلك؟ ليس هناك ما يؤشر إلى أي تهاون مع تقدم قوات موالية للإيرانيين».
ويرى الحاج في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا سيكون في الواقع أول امتحان لصدق النيّات الأميركية بخصوص ما أعلنه ترمب في قمة الرياض، علما بأن للمسؤولين الرئيسيين في إدارة الرئيس دونالد ترمب تجربة سيئة في العراق مع إيران، كما أن وزير الدفاع الجنرال جيمس ماتيس يحمل تصورا متشددا تجاه طهران... وإذ كان قد استقال في عهد أوباما على خلفية الاختلاف معه في هذا الموضوع تحديدا».
ويعتبر الحاج أنه «ليس من مصلحة أي دولة في المنطقة وجود ممرات عسكرية لإيران نحو البحر المتوسط عبر سوريا، كما يمكن الحديث عن مصلحة مشتركة إقليمية - دولية في إغلاق ممرات الإرهاب من إيران والعراق مصلحة إقليمية ودولية». ويستبعد الحاج أن تقرر إيران الدخول في مواجهة مباشرة مع الأميركيين لتأمين هذا الممر، من منطلق ألا قدرة لها أساسا على ذلك، وإن كانت ستستمر بالمحاولة ما لم تظهر الولايات المتحدة ردا حاسما.
كذلك يستبعد الحاج أن تلجأ الولايات المتحدة للاعتماد على قوات أميركية برّية للقتال في الشرق السوري، لافتا إلى أنها «مضطرة للاعتماد على مقاتلين محليين حيث يصعب أن يكون لدى الأكراد إمكانية بشرية للقتال هناك». ويتابع: «لهذا تقوم الولايات المتحدة بدعم وتجهيز قوات محلية بالتعاون مع الأردن وبريطانيا ليقوموا بهذا الدور فيطردوا (داعش)... بدءا من الحدود الجنوبية لسوريا ووصولا لدير الزور والرقة وشرقا نحو الحدود العراقية».
* أين الدور الروسي؟
هنا، اللافت أن الدور الروسي يبدو شبه منعدم في معركة التنف، إذ اقتصر رد فعل موسكو على الضربة الجوية التي نفذها التحالف الدولي في المنطقة بوقت سابق على الاستنكار. فلقد حذّر غينادي غاتيلوف، نائب وزير الخارجية الروسي، من أن أي عمليات عسكرية تؤدي إلى تصعيد الوضع في سوريا، تؤثر حتما على سير العملية السياسية في آستانة وجنيف. وأردف: «لا سيما مثل هذه الخطوة التي استهدفت القوات المسلحة السورية».
إلا أن الدور الروسي يتفعل في المعركة المتوازية التي يخوضها النظام عبر خط تدمر - السخنة - دير الزور، على الرغم من تأكيد خبراء أن موسكو ليست بصدد الدخول في مواجهة مع واشنطن «في الوقت الحالي»، وإن كانت لن تتردد في مسابقتها إلى دير الزور.
ومن جهتها، تتابع المعارضة السياسية عن كثب التطورات في المنطقتين الجنوبية والشرقية، وتعوّل على «متغيّرات كبيرة» بعد القمة الإسلامية - العربية - الأميركية التي عقدت في الرياض، لجهة تعاظم الدور الأميركي في التصدي للتمدد الإيراني. وفي هذا الإطار، يتحدث أحمد رمضان، رئيس الدائرة الإعلامية وعضو الهيئة السياسية في «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» عن «محاولة إيرانية مستمرة للتمدد نحو الحدود السورية مع العراق، وإبقاء خط الإمداد من بغداد مفتوحاً لحساب نقل الأسلحة والذخائر والإمداد لنظام الأسد»، ويقول في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه بات «من المعروف أن نظام بغداد وقّع في زمن نوري المالكي عام 2012 اتفاقاً مع النظام الإيراني يقضي بعبور الشاحنات من إيران إلى سوريا مروراً بأرض العراق من دون تفتيش، وهذه كانت مخصّصة لنقل الإمدادات العسكرية والمرتزقة، أما الآن فهناك قرار من التحالف الدولي بقطع هذا الطريق، وفرض رقابة على عمليات النقل الجوي، ما يعني محاصرة الميليشيات الإيرانية في سوريا والتضييق عليها». ويرجّح رمضان أن «يواصل الحرس الثوري الإيراني محاولة فتح طرف الإمداد الخاص به عبر أكثر من وسيلة»، مستدركاً «لكنني أعتقد أن تلك المحاولات لن تنجح، لأن ميليشيات إيران في سوريا ستكون هدفاً في المرحلة المقبلة».
بادية الشام... مسرح مواجهة واشنطن وطهران
في ضوء القرار المشترك بالتصدي لتوسع إيران في المنطقة


بادية الشام... مسرح مواجهة واشنطن وطهران

لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة