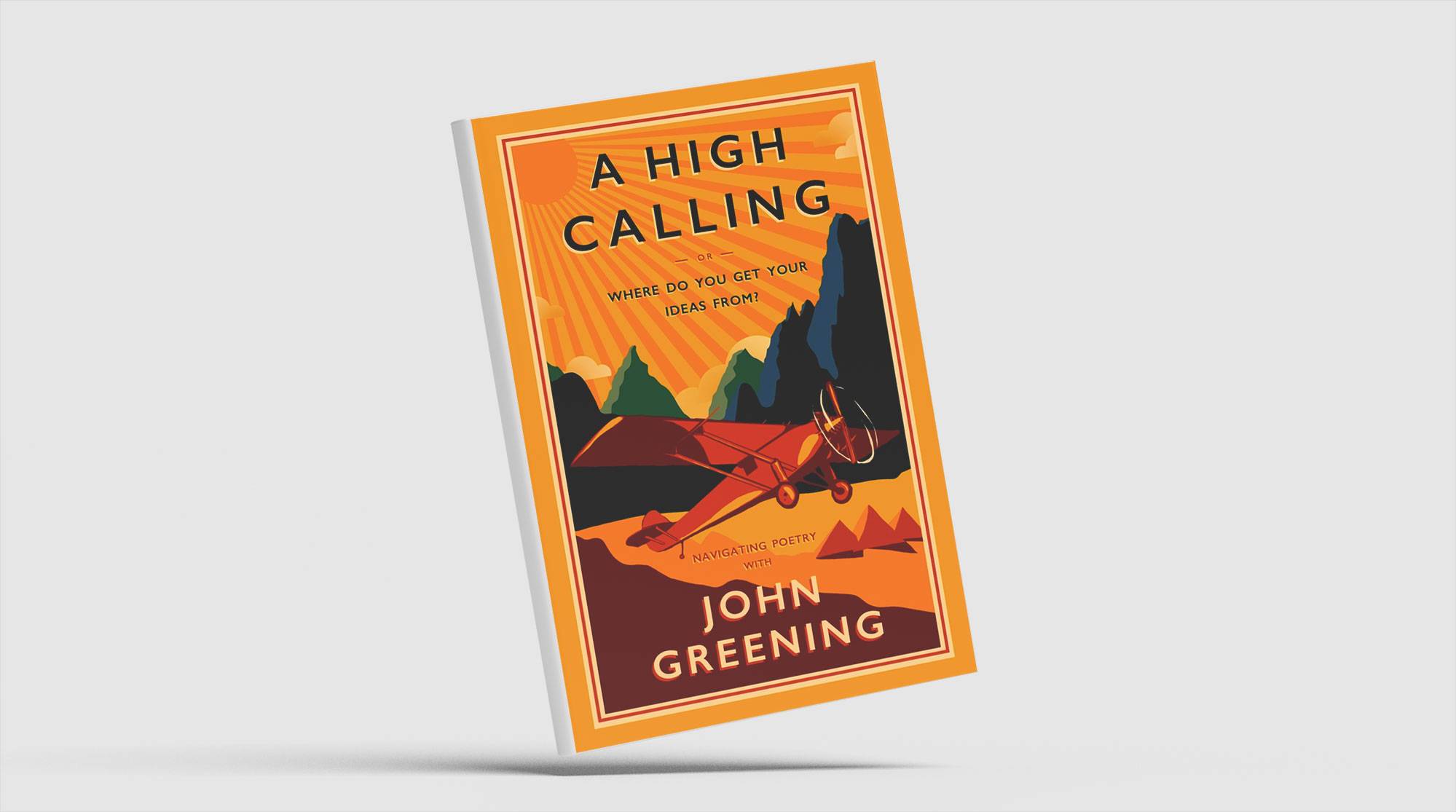بعد إصداره لكتابه «دين الحياء» بأجزائه الثلاثة، صدر للدكتور طه عبد الرحمن، عن المؤسسة العربية للفكر والإبداع في بيروت، كتاب جديد بعنوان «سؤال العنف». ميزة هذا المنجز الجديد المخصص لدراسة «العنف»، تكمن في أن قسمه الأكبر جاء في شكل حوار أجرته معه المؤسسة الناشرة، ما أعطاه حيوية، بالإضافة إلى ما فيه من تشويق ومتعة. فالحوار كما نعلم، قد يفضح بعضا من نيات الكاتب، نظرا لما تنطوي عليه الأسئلة من عنصر المفاجأة، التي تجعل الباحث يطرق مواضيع، قد لا يعيرها اهتماما، إن كان يكتب في غياب محاور. ينطلق طه عبد الرحمن في تمهيد كتابه، من ذكر حيرته الدائمة من عنف الإنسان وقسوته تجاه أخيه الإنسان، وهو العاقل. عنف يتجاوز، أحيانا، مستوى الحيوان وهو الأعجم. والأخطر عنده، هو فتك المسلم بأخيه المسلم، على الرغم من أن دينه يحرم ذلك، ويجعل قتل الواحد كقتل الناس جميعا، ويجعل القاتل مخلدا في النار أبدا.
هذا ما دفع بطه عبد الرحمن، إلى التفكير في الموضوع بإلحاح، بحثا عن الأسباب الداعية إلى الوقوع في العنف والسير بعكس ما يمليه روح الدين، من دون أن ينسى تذكيرنا بأن قراءة التاريخ تبرز أن العنف قائم في البشر، منذ تسلط «قابيل» على «هابيل» وسفك دمه. على الرغم من ذلك، يبدي طه تفاؤلا وأملا كبيرين في قدرة البشرية على الخلاص، وتجفيف منابع العنف وقطع دابره، بل الإطاحة به «بضربة قاضية». وحتى لو سار التاريخ في اتجاه يعاكس هذا الطموح، وأبرز عنفا بعد عنف، فإن الإمكان البشري يظل أوسع من التاريخ، والخروج من «العالم القابيلي»، الذي يرمز لعالم الشر، نحو «العالم الهابيلي» الذي يرمز لعالم الخير، يظل أمرا متاحا، بشرط أن يتم اتباع روح الدين الذي يدعو الإنسان إلى الاشتغال بعيدا عن حب التملك، وبعيدا عن كل تسيد.
هذا الكتاب - الحوار، غني جدا، ويجد فيه القارئ معطيات كثيرة. ففيه يقدم طه محاولة لتعريف العنف مثلا، والفرق بينه وبين القوة. كما ينقاش ما يسمى «العنف المشروع» المروج في المرجعيات الغربية، الذي جرى نقله إلى تربتنا من عالم الاجتماع «ماكس فيبر»، وأفكار أخرى بالطبع. وسنحاول الوقوف بالضبط عند الوصفة التي يقدمها طه عبد الرحمن، لمواجهة ظاهرة العنف باسم الدين.
المطلع على عموم مشروع طه عبد الرحمن، سيكتشف أن توجهه الفكري بدأ يأخذ طابعا مستقلا، ويتخذ لنفسه اسما خاصا هو «الفلسفة الائتمانية»، خصوصا في كتبه الأخيرة، ونقصد، روح الدين وبؤس الدهرانية، وشرود ما بعد الدهرانية، ودين الحياء، وسؤال العنف، الكتاب الذي نقدمه للقارئ.
يحصر طه عبد الرحمن منطلقات أو مسلمات هذا النظر الائتماني، في ثلاثة عناصر هي:
- إنه فكر أخلاقي بالأساس، والأخلاق يجب أن تعمم في كل تفاصيل الأفعال من دون استثناء، على عكس الفلسفة المعاصرة التي تجعله حكرا على بعض الأفعال.
- التسليم بـ«عالمية الإسلام». فالفلسفة الائتمانية تجتهد في إبراز الجوانب التي تشترك فيها البشرية جمعاء. وبالحديث عن واقعة العنف، موضوع الكتاب، فهي تعود إلى الحدث الفاصل والكوني الذي أخبرت به كل الأديان السماوية، وهو «قتل قابيل لهابيل». بل نظيرا لهذه القصة، وجد لدى الشعوب القديمة، الأمر الذي شرحته بحوث «التحليل النفسي» و«الأنثربولوجيا».
- التسليم بـ«خاتمية الإسلام». فطه عبد الرحمن، يعتبر أن القيم الإسلامية تصدق أبد الدهر، فهي الأفق المتبقي للبشرية.
والآن، وبعد ذكر المنطلقات التي يستند إليها طه من أجل بناء معمار فلسفته الائتمانية، لنقف عند بعض الحجج التي يقدمها لإبراز أن العنف هو عملية قلب للأصل الديني، فالعنيف يقلب الدين رأسا على عقب.
يعود طه عبد الرحمن إلى الواقعة الأصلية لـ«مقتل هابيل»، ويركز عليها بشكل أساسي لفهم العنف من جهة، وإيجاد الخلاص أيضا من جهة أخرى. فالعنيف يدخل البشرية إلى «عالم قابيلي»، حيث يشبه سلوكه تلك الجريمة الأولى التي تمس الفاعل والمفعول به معا. فالقاتل يجعل من مورس عليه العنف، مجرد شيء، نظرا لإرادة تملكه عن طريق إتلاف جسده، ومن ثم ينزع عنه لباس الإنسانية أي لباس الأخلاق. لكن وفي الوقت نفسه، ينقلب الأمر على العنيف بإيذاء أسوأ، إذ ينسلخ عن إنسانيته، ليس إلى درك «البهيمية» أو درك «الشيئية»، بل إلى درك «الإبليسية»، على أساس أن إبليس اتخذ من الإنسان عدوا له وأقسم بغوايته ونزع لباسه عنه، لهذا فالعنيف يحتذي حذوه تماما. وهنا نتذكر «الخيار الهابيلي» المخالف تماما، فهابيل قرر الإبقاء على لباس الإنسانية (الأخلاق) بعدم بسط يده للقتل.
ولا يفوت طه عبد الرحمن، التأكيد على أن العنف نوعان: فقد يكون بالقول وهو «التطرف»، وقد يكون بالفعل وهو «الإرهاب». فالمتطرف يعمل على نشر ثقافة العنف، ويعمل على تهييج العواطف وشحن الصدور. لهذا فالتطرف إرهاب، ولا ينتظر إلا الظروف المواتية لينقلب إلى عنف مادي بالفعل. فما هو مزروع في الذهن لا محالة يجد طريقه إلى الأرض. يتوقف طه عبد الرحمن في إحدى محطات حواره المطول، عند «العنف الديني»، ليبين أنه يتجاوز تعدي الحدود وظلم الخلق، إلى ظلم الخالق سبحانه. لأن العنيف ببساطة، ينسب بعض الكمالات الإلهية إلى نفسه. فحين يجبر الناس على الاعتقاد والفعل، فهو يتصف بصفة «الجبار». وهنا يذكر طه عبد الرحمن، بأن لفظ (جبار) قد جاء في القرآن الكريم، في مقابل ثلاثة ألفاظ أخرى، وهي «الإصلاح» في قوله تعالى: «إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين». وأيضا في مقابل «المذكر»، أي «المبلغ» في قوله تعالى: «وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد». وكذلك جاءت لفظة جبار، في مقابل «البر» بالوالدين، في قوله تعالى: «وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا».
فالملاحظ مما ورد في الذكر الحكيم إذن، هو أن لفظة «جبار» جاءت في مقابل «الإصلاح» و«التذكير» و«البر»، وهي أفعال لن تتم إلا بالرأفة وليونة الجانب، والابتعاد عن الإكراه والقسوة والغلظة، وتحتاج من الفاعل الصبر والتأني في المعاملة.
إن «الجبار» اسم من أسماء الله الحسنى، ولا ينبغي أبدا منازعته في ذلك. فحين يؤتي العنيف أعمالا، كالتربب، أو التسيد، وحين يكفّر ويعذب ويقتل، فهو يكون بذلك، قد تحلى بمظاهر التجبر.
وهو بذلك يتطاول على صفة من صفة الله. وهو ما يتنافى والميثاق الأصلي، الذي وجد بين الله والإنسان في عالم الملكوت، والذي ينقسم إلى قسمين هما: ميثاق الإشهاد المرتبط بالاعتقاد، الذي تم فيه إعلان أن الربوبية والتوحيد خالص لله وحده، وميثاق الائتمان المرتبط بالأعمال، الذي تم فيه وضع العالم كأمانة في يد الإنسان، وإعلان أن التصرف فيه يجب أن يكون بإبعاد الذات عن كل حيازة أو تملك، ليصبح كل شيء فيه مجرد وديعة.
إن العنيف يقلب الأمور جملة وتفصيلا، ويخرج عن الميثاق الأولي، بل يخونه تماما، فهو لا ينازع الله في صفة «الجبار»، بل ينازعه في ميثاقه، وكأنه بعنفه، يعترض على ربوبية الله، وكون أن من مورس عليه العنف هو أصلا قد تم إشهاده وائتمانه في عالم الملكوت. باختصار نقول، إن العنيف ينصب نفسه في مرتبة الله سبحانه، فهو يعطي لنفسه صلاحيات التربب والتكفير، وهو قد أشهد نفسه بتركها لله وحده. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فهو حين يسعى إلى تملك الآخرين، بتعذيبهم وقتلهم، يهمل تماما الأمانة التي تحملها بأن تكون الأمور وديعة بين يديه وليست حيازة يعبث بها.
إن الشخص العنيف، كما يلح طه عبد الرحمن، يعتقد في داخله، أنه يخدم الدين بأعماله. بينما يرتكب، في الحقيقة، خطيئة وزلة فظيعة، لأنه بتشدده وإيذائه المسرف، يعطي لنفسه الحق في الإشهاد ويجعله معه وحده، ويسمح لنفسه أيضا، بأن يكون العدل في الائتمان بيده وحده. وهو بذلك يدخل في منازعة واضحة لله واعتداء صارخ عليه. وهذه خيانة كبرى وقلب لروح الدين الأصلي.
إضافة إلى هذا كله، يرى طه عبد الرحمن، أن عجز أهل العلم عن ردع العنيف باسم الدين، يرجع بالأساس، إلى زعم العنيف بأنه مالك لزمام الفقه والاجتهاد والإفتاء، وأنه ليس في حاجة إليهم. لهذا لا يتوقف طه عبد الرحمن، عن التأكيد على ضرورة تغيير مقاربة الاشتغال، والخروج من النموذج التقليدي «الأمري»، الذي يهتم بالأوامر في جانبها القانوني لا في جانبها الأخلاقي، والانتقال رأسا إلى النظرة الائتمانية التي تذكر المرء بالميثاق الملكوتي الأصلي إشهادا وائتمانا. فالاستشهاد بالآيات والأحاديث وأقوال العلماء، لن يصرف أبدا العنيف عن اعتقاده وأعماله. لأن العنيف ببساطة، سيؤوّل الشواهد لصالحه، وسيرى في تشدده معيارا وميزانا للتقوى في عالم يراه في ضلال وفساد. بل سيعلن هذا العنيف، أن أهل العلم هم متساهلون جدا، بل سيتهمهم بالتواطؤ مع أهل السلطة. أما لجوء أهل السلطة إلى القوة والتهديد، فهو طريق لن يصح أيضا، بل سيزيد العنيف تطرفا واقتناعا أنه محق.
نخلص إلى أن العنيف قد تشرب الآلية «الأمرية»، وأصبح بارعا فيها إلى درجة العمى والغرور، والادعاء بأن الصواب المحض هو إلى جانبه. لهذا فالتصدي له، من وجهة نظر طه عبد الرحمن، يتطلب استراتيجية أخرى تواجهه بخطاب يخالف خطابه، ولغة جديدة لا يعرفها، تذكره بانزلاقاته وهو ما سيجعله ينصت ويصغي. هذه الاستراتيجية تقدم الجانب الأخلاقي على الجانب القانوني، وتذكر على الدوام، أن الامتثال للأوامر التي أصبحت ميكانيكية، يجب إعادة وصلها بحضرة الآمر سبحانه، الذي بيده فقط الإشهاد والائتمان.
العنف يخون ميثاق الإشهاد والائتمان
طه عبد الرحمن يعرّي العنيف ويفكك خطابه في كتاب جديد


العنف يخون ميثاق الإشهاد والائتمان

لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة