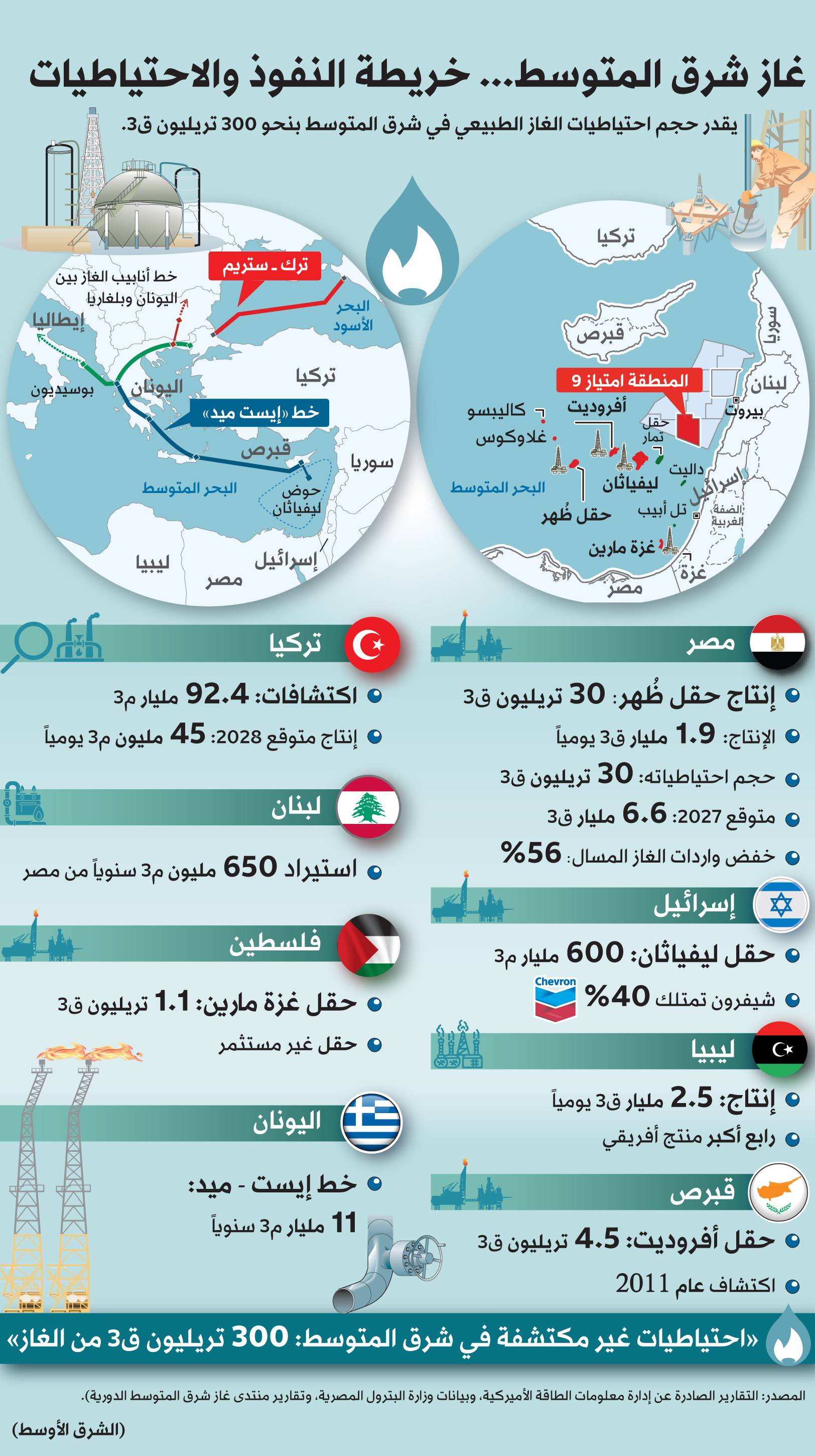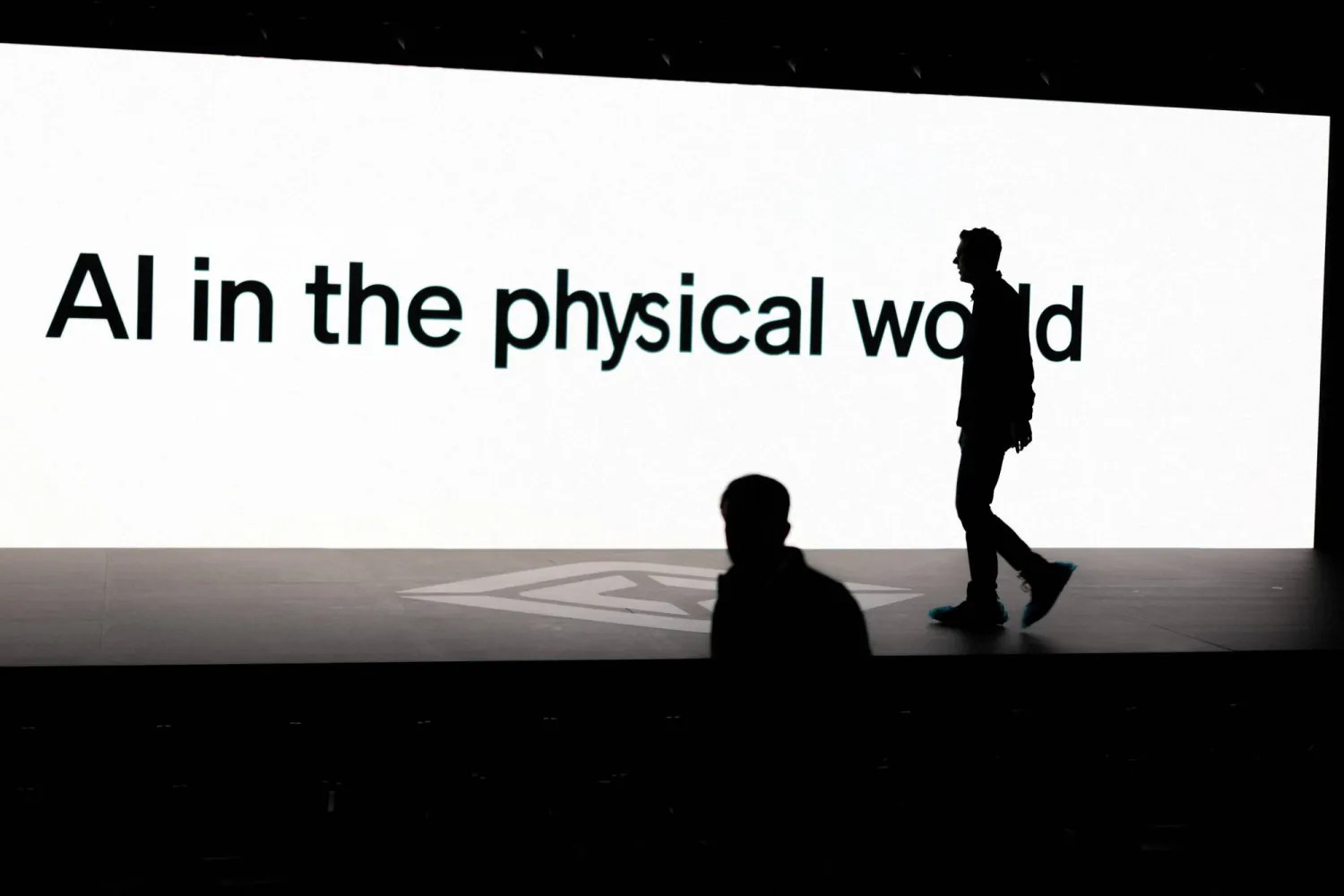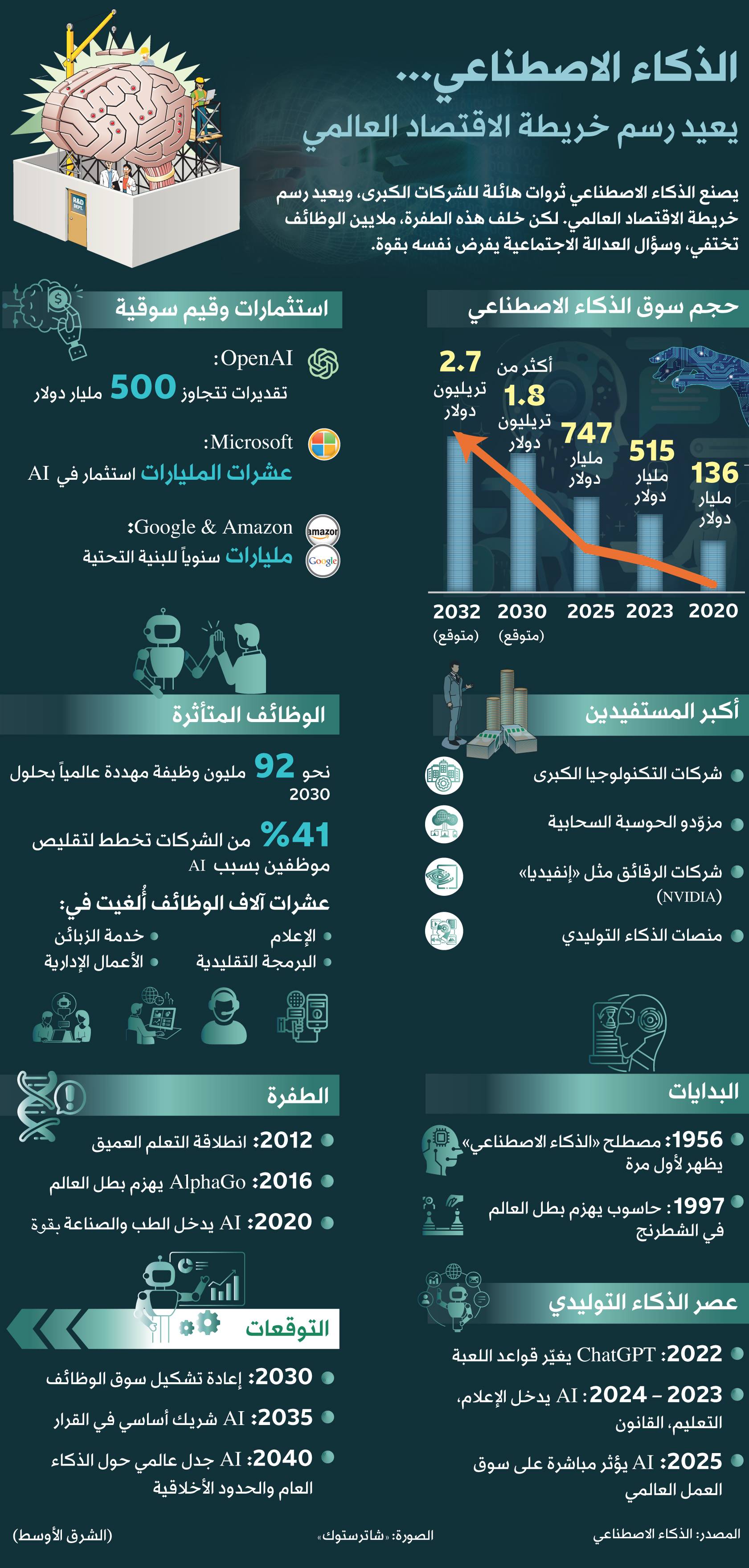غير مسموح للجنود والضباط العاملين في القواعد العسكرية الأجنبية في جيبوتي الاختلاط بعامة الناس.
لديهم كل شيء داخل معسكراتهم وفنادقهم، مطاعم، مقاهٍ، نوادٍ وملاعب ترفيهية. لكن يمكن ارتداء ملابس مدنية والتجول في البلدة الفقيرة والهادئة، في بعض الأوقات، كما فعل المسؤول في الجيش الأميركي العقيد جون، الذي يدير فريقا متخصصا في إصلاح آليات في قواعد عسكرية تابعة لبلاده في المنطقة.
وتجولت {الشرق الأوسط} في أنحاء الدولة الأفريقية الواقعة في القرن الإفريقي.. وتساءلت عن القواعد والاستقرار والاستثمار وجاءت الإجابات في ثلاث حلقات تنشر تباعاً.
يتزايد عدد القواعد العسكرية في القرن الأفريقي بالقرب من مضيق باب المندب الذي تعبر منه سنويا نحو 12 مليون حاوية من البضائع، إضافة لناقلات النفط، ويعد أحد أهم منافذ التجارة الدولية. طلائع القادة العسكريين الذين حطوا هنا قبل 15 سنة، لم يكن اهتمامهم، في البداية، حماية التجارة، وإنما ملاحقة الإرهابيين ومراقبة بؤر التوتر في أفريقيا والشرق الأوسط. وتعد جيبوتي، متعددة العرقيات واللغات، واحدة من أكثر دول المنطقة استقرارا مقارنة بدول مجاورة مثل الصومال وجنوب السودان واليمن. وتقع ضمن القرن الأفريقي على الساحل الشرقي للقارة السمراء. وتتحكم، مع اليمن في الجهة الآسيوية المقابلة، بمضيق باب المندب. ومن هنا كانت تعبر، قبل مئات السنين، قوافل تجار جلود الحيوانات من أفريقيا إلى الصين، ومبادلتها بالأقمشة. اليوم تعود الأهمية التجارية إلى المنطقة باستثمارات تقدر بمئات المليارات من الدولارات.
يقول الرئيس الجيبوتي، إسماعيل عمر غيلة، لـ«الشرق الأوسط»: إن كل هذه الاستثمارات وحركة التجارة تحتاج إلى قوة تحميها، مشيرا إلى أن الأزمة الصومالية، والحرب في اليمن، والقرصنة البحرية، والإرهاب، والجفاف المتكرر، يعد من التحديات الرئيسية التي تعانيها هذه المنطقة الحيوية من العالم، على الصعيدين الأمني والتنموي. ويضيف الرئيس غيلة: إن بلاده تضطلع بدور طليعي في الجهود المبذولة لمواجهة هذه التحديات وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة؛ لينعكس ذلك إيجابا على التكامل والتضامن الاقتصادي، وتعزيز فرص العيش الكريم لشعوبها.
وتوجد قاعدة عسكرية فرنسية داخل أسوار ضخمة يعود معظمها إلى حقبة الاحتلال الفرنسي لجيبوتي قبل مائة سنة. وهي أكبر مساحة، لكنها، في الوقت الرهن، أقل عتادا وجنودا مما كانت عليه في الماضي، مقارنة بالقاعدة الأميركية المعروفة باسم «لامنيار (Lemonnier)» التي تدير علاقات مع عشرات الدول في المنطقة. وتتعاون مع الفرنسيين في تسيير دوريات في البحر.
بدأ التفكير في إقامة القاعدة الأميركية، الأكبر في أفريقيا داخل جيبوتي، عقب هجمات سبتمبر (أيلول) 2001 بالولايات المتحدة؛ وذلك في محاولة للحد من نشاط الجماعات المتطرفة وتقديم الخدمات الإنسانية والعمل عن قرب مع الحكومات المحلية.
وفيما بعد أدى تفاقم الفوضى على الساحل الصومالي واستهداف جماعات متشددة وقراصنة للسفن العابرة، إلى تزايد أهمية القرن الأفريقي. ثم زاد الاهتمام بالمنطقة عقب التمرد الذي قام به الانقلابيون الحوثيون في اليمن، ومحاولات إيران الداعمة للانقلابيين، التواجد في المضيق الذي تمر منه الناقلات عبر البحر الأحمر وقناة السويس إلى الدول الغربية.
وتمتد القاعدة الأميركية، ومركزها في ضاحية آمبولييه، بجوار سور مطار جيبوتي بطول نحو 4 آلاف متر. وفيها مدرج لانطلاق الطائرات من دون طيار والطائرات الحربية والمروحيات. ويبلغ عدد الجنود فيها نحو 2000 جندي وضابط، ويرتفع العدد إلى نحو 3700 بحساب العاملين المدنيين الأميركيين والمحليين. وتغص القاعدة بحظائر للطائرات وهناجر لتخزين الآليات والأسلحة. وتملأ أركانها بعدد من المطاعم والمقاهي ذات الماركات العالمية المعروفة، ومنها مطاعم البيتزا.
وتنتشر في القاعدة ملاعب كرة القدم والكرة الطائرة وصالات الاحتفالات وحمامات السباحة وصالات رفع الأثقال وغيرها. ويتردد عليها مسؤولون من جيش الولايات المتحدة بين حين وآخر، مثل العقيد جون الذي التقت به «الشرق الأوسط» أثناء رحلة بالطائرة في المنطقة. وهو مثل غالبية الأميركيين، تتملكه الغيرة كلما رأى لافتة من لافتات الشركات الصينية التي تعمل هنا.
ومن المقرر أن تبدأ الصين في إنشاء قاعدة عسكرية لها، هي الأخرى، على بعد كيلومترات عدة من القاعدة الأميركية خلال عام 2017. وبينما تسعى المملكة العربية السعودية إلى إقامة قاعدة في مكان مجاور، من المقترح أن يكون قرب العاصمة، تحاول إيران أن تجد لها موضع قدم، ليس في جيبوتي التي قطعت علاقتها مع طهران قبل أشهر عدة بسبب سياساتها المريبة، ولكن في مناطق أخرى لم تتضح بعد.
وفتحت جيبوتي التي تعد من أهم دول القرن الأفريقي، الباب لدول كبرى وصديقة لتأسيس قواعد عسكرية، لكن، كما يقول المسؤولون هنا، بشروط خاصة لا تتعارض مع الأمن القومي الجيبوتي، ولا مع توجهات الدولة. والهدف مواجهة الإرهاب وحماية التجارة الضخمة العابرة من باب المندب، إضافة إلى حماية الاستثمارات الكبيرة التي تستقطبها جيبوتي من دول العالم لخدمة باقي دول القارة الأفريقية، وبخاصة تجمع دول «الإيغاد» و«الكوميسا». وحين وافقت جيبوتي للصين على إقامة قاعدة عسكرية، سألهم الأميركيون عن أنه ربما لا ينبغي الموافقة للجيش الصيني على التواجد هنا، لكن الجيبوتيين ردوا قائلين إن الصين تريد أن تحمي معنا تجارتها، وبخاصة أن ثلث الحاويات التي تعبر من باب المندب قادمة أساسا من الصين.
في مطلع العام الماضي اعتقد الأميركيون أن القاعدة الصينية التي سيتم تأسيسها ستكون قرب مدينة «أُبخ» التاريخية والمطلة مباشرة على باب المندب، في شمال جيبوتي. وجاء هذا الظن، على ما يبدو، بسبب قيام طلائع من الجيش الصيني بالتدريب في صحراء «أُبخ» ذات الطابع الاستراتيجي. ويقول أحد المسؤولين في جيبوتي: إن كل من تقدموا بطلبات لإقامة قواعد عسكرية في «أُبخ» في السنوات الأخيرة تم رفضها لأسباب تتعلق بالأمن القومي الجيبوتي، و«لم نسمح بأي تواجد عسكري أجنبي في أُبخ». ويوضح قائلا: «إذا وافقنا على أي إقامة عسكرية دائمة في أُبخ، لأي دولة، فهذا يعني أننا ربما سنخسر، مستقبلا، مضيق باب المندب الذي يمثل حجر الزاوية في سيادة جيبوتي».
وفيما بعد اتضح أن قطعة الأرض، التي شرعت الصين في إقامة قاعدتها العسكرية عليها، تقع قرب منطقة تاجورة، جنوب مدينة جيبوتي، على مسافة تبلغ نحو 10 كيلومترات من مقر القاعدة الأميركية. أي في النطاق الصحراوي للعاصمة. وتبلغ مساحة القاعدة الصينية نحو 80 فدانا، وهي أقل من مساحة نظيرتها الأميركية بكثير.
الغيرة الأميركية، والغربية عموما، من وجود الصينيين في جيبوتي، وهو الوجود العسكري الأول لها خارج أراضيها، لا يتعلق ببناء قاعدة لها في تاجورة فقط، ولكنه يتعلق كذلك بالاستثمارات الصينية الضخمة التي بدأت تتدفق على هذا البلد باعتباره منفذا بحريا مهما لدول وسط أفريقيا. ويقول مسؤول جيبوتي: «مع ذلك ستكون القاعدة الصينية أقل حجما من قاعدة ليمونييه، لكن قيمة تأجير أرض القاعدة الصينية، أكثر من القيمة التي تسددها القاعدة الأميركية».
ووفقا لمركز مقديشو للبحوث والدراسات، تجني جيبوتي نحو ربع مليار دولار سنويا مقابل تأجير أراض لقواعد عسكرية. وبحسب مصادر أخرى، تبلغ قيمة التأجير السنوية للولايات المتحدة نحو 70 مليونا، وللصين نحو 100 مليون، ولليابان ما يقارب من 35 مليونا، ولفرنسا (القاعدة الأقدم) نحو 30 مليونا، بالإضافة إلى مبالغ أخرى من دول لها تواجد عسكري محدود مثل ألمانيا وإسبانيا. هذا إلى جانب مساعدات ومشروعات تقوم بها هذه الدول لتنمية دول القرن الأفريقي وبلدان وسط القارة انطلاقا من جيبوتي.
الصين، على سبيل المثال، تعتزم ضخ استثمارات جديدة في هذه المنطقة تبلغ أكثر من 60 مليار دولار، بينما تسعى اليابان إلى افتتاح مشروعات إضافية تصل قيمتها إلى نحو 30 مليار دولار. وفي المقابل، يبدو أن العبء الأكبر في عملية بسط الاستقرار والأمن في المنطقة عموما، حتى الآن، يقع على عاتق القاعدة الأميركية التي تشمل عملياتها، حاليا، محاولة الحد من الاضطرابات في دولة جنوب السودان ومكافحة الإرهاب في الصومال والمشاركة في التصدي لمحاولات الحوثيين، ومن يدعمهم، تهديد الملاحة في البحر الأحمر.
ويعود تاريخ الوجود العسكري الياباني في جيبوتي إلى عام 2009، وهو أول وجود عسكري لليابان خارج حدودها منذ الحرب العالمية الثانية. وحين جاءوا إلى هنا قالوا: نريد أن يكون مكاننا قرب القاعدة الأميركية. والآن استقر الأمر إلى حد كبير. وفي كثير من الأحيان يقضي الجنود السهرات الليلية في النوادي التابعة للأميركيين.
وبينما يتزايد انتشار لافتات عليها كتابة باللغة الصينية، وتحمل أسماء لشركات قادمة من بكين إلى جيبوتي لتوسيع الموانئ البحرية، ومد خطوط السكك الحديدية إلى الداخل الأفريقي، بدأت اليابان في التخطيط لتوسيع قاعدتها العسكرية بالتزامن مع محاولة لزيادة استثماراتها في أفريقيا أيضا. وبدلا من الاعتماد على منشآت عدة مستأجرة من القوات الأميركية، تسعى اليابان إلى الحصول على مزيد من الأراضي للتوسع.
وخلال السنوات الخمس الأخيرة، ارتفع عدد الجنود اليابانيين في جيبوتي، الذين يطلق عليهم اسم «قوات الدفاع المدني»، من نحو 150 عنصرا إلى 400 عنصر. ويقيمون في منشآت على مساحة تبلغ نحو 30 فدانا، ويتنقلون، عبر أربع طائرات من طراز «بي 3 سي» بين القاعدة، واثنتين على الأقل من المدمرات البحرية اليابانية التي تشارك في تأمين مئات السفن التجارية وتراقب نشاط القراصنة والعناصر المشبوهة في خليج عدن.
وتعد أقدم قاعدة عسكرية في جيبوتي هي القاعدة الفرنسية التي تحمل اسم «فورس فرانسيس جيبوتي (ffdj)». وهي محاطة بأسوار عتيقة عليها أسلاك شائكة. ويمكن رؤيتها من طريق «دودا» المتفرع من شارع المطار. والقاعدة تتكون من جزأين.. مقر الإدارة على اليمين، ومقر القوات والآليات الحربية على اليسار. ويقع بينهما ميدان صغير تعبر منه سيارات سكان المدينة. ولا يفصل القاعدة الفرنسية عن أختها الأميركية إلا قاعدة أخرى تابعة لجيبوتي. ولا توجد قواعد عسكرية ثابتة للإسبان والألمان، لكن لديهم مئات عدة من الجنود والضباط ممن يديرون سفنا حربية عدة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وهم يترددون على فنادق جيبوتي الكبيرة ويقيمون فيها أياما عدة في بعض الأحيان. وحين تكون لديهم حاجة إلى المساعدة من على الأرض؛ فهم يلجأون عادة لطلب العون من القاعدة الأميركية أو الفرنسية.
وخلال الشهور القليلة الماضية، بدأت مشاورات وزيارات بين القيادتين العسكريتين في كل من جيبوتي والسعودية، تمخضت عن وضع مشروع مسودة اتفاق أمني وعسكري واستراتيجي، يتضمن استضافة جيبوتي لقاعدة عسكرية سعودية. ووفقا لوزير خارجية جيبوتي، محمود علي يوسف، فقد جرى تحديد بعض المواقع على الساحل الجيبوتي لهذا الغرض. ويضيف: وافقنا، بل شجعنا أن يكون للمملكة، ولأي دولة عربية، تواجد عسكري في جيبوتي؛ نظرا لما يحدث هنا في المنطقة.
وتسعى إيران منذ سنوات عدة إلى التواجد في باب المندب من خلال دعم الحوثيين في اليمن، ومحاولة إغراء دول في القرن الأفريقي بتقديم قروض ومساعدات، إلا أن الوزير يوسف يقول إن جيبوتي، عندما شعرت بأن التعاون مع إيران «كان دائما فيه كثير من اللبس، وفيه كثير من الأمور التي ربما تدخلنا في متاهات معها، ابتعدنا عنها شيئا فشيئا، إلى أن جاء الاعتداء على اليمن، وعلى المصالح العربية، فقررت جيبوتي أن تقطع علاقاتها مع إيران».
ومن جانبه، يبدو الرئيس غيلة من الزعماء الذين يسعون بجدية إلى مسايرة تغير المفاهيم في العالم فيما يتعلق بوجود قواعد عسكرية في بلاده التي لا تتعدى مساحتها 23 ألف كيلومتر مربع. فبعد أن كانت مسألة القواعد تثير الحساسية لدى بعض الدول، يرى الرئيس أن العالم تغير ويحتاج إلى تعاون أمني شامل من أجل التنمية.
ويقول غيلة إن «العالم شهد، خلال السنوات العشر الأخيرة، أزمات معقدة أدت إلى تبلور الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية الحرجة التي تسود في الكثير من أنحاء العالم، في الظرف الراهن. وكجزء من هذه الانعكاسات الخطيرة للأوضاع الدولية، فإن الإرهاب والعنف والتطرف سجل انتشارا واسع النطاق على نحو لم يسبق له مثيل»، مشيرا إلى أن «المجتمع الدولي يبذل جهودا متواصلة لمحاربة هذه الظاهرة وتجفيف منابعها».
ويضيف أنه، في هذا السياق، من الأهمية بمكان الإشارة إلى التصدي بفاعلية للإرهاب والعنف والتطرف، وأن هذا يتطلب تعاونا دوليا وثيقا، كما يتطلب مقاربة شاملة لا تقتصر فقط على الجانب الأمني والعسكري، بل تتعامل أيضا مع الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تسمح بتنامي الإرهاب.
وفي الماضي، وبخاصة في فترتي الستينات والسبعينات، ارتبط موضوع القواعد العسكرية الأجنبية بالاستعمار والهيمنة، لكن بعض الخبراء العسكريين في الوقت الراهن يقولون إن «الذراع العسكرية أصبحت أطول. ودون الحاجة إلى قاعدة عسكرية، من الممكن أن تطلق صاروخا من دولة إلى دولة أخرى على بعد آلاف الأميال. وبالتالي؛ فإن القواعد العسكرية أصبحت ترتبط بالأمن الدولي وحماية المصالح المشتركة للدول، وليس الاحتلال».
ويقول الوزير يوسف، إنه أصبحت توجد بالفعل «عولمة للأمن»، مشيرا إلى أن خليج عدن ومضيق باب المندب «هما عنق الزجاجة بالنسبة لهذا الأمن الجماعي». و«نحن نؤمن إيمانا راسخا بأن أمن مضيق باب المندب هو لمصلحة الجميع. وإذا كانت هناك قواعد عسكرية تستضيفها جيبوتي، فهي لحماية هذا الأمن الدولي»، مشددا على أنه لا علاقة لهذه المواقع أو القواعد العسكرية بالسياسة الداخلية لجيبوتي «لا من قريب ولا من بعيد».
غدًا في الحلقة الثانية:
* فتحت الباب لدخول استثمارات بمليارات الدولارات
* جيبوتي تسعى للتحول إلى «دبي اقتصاديًا» و«شرم الشيخ» سياحيًا