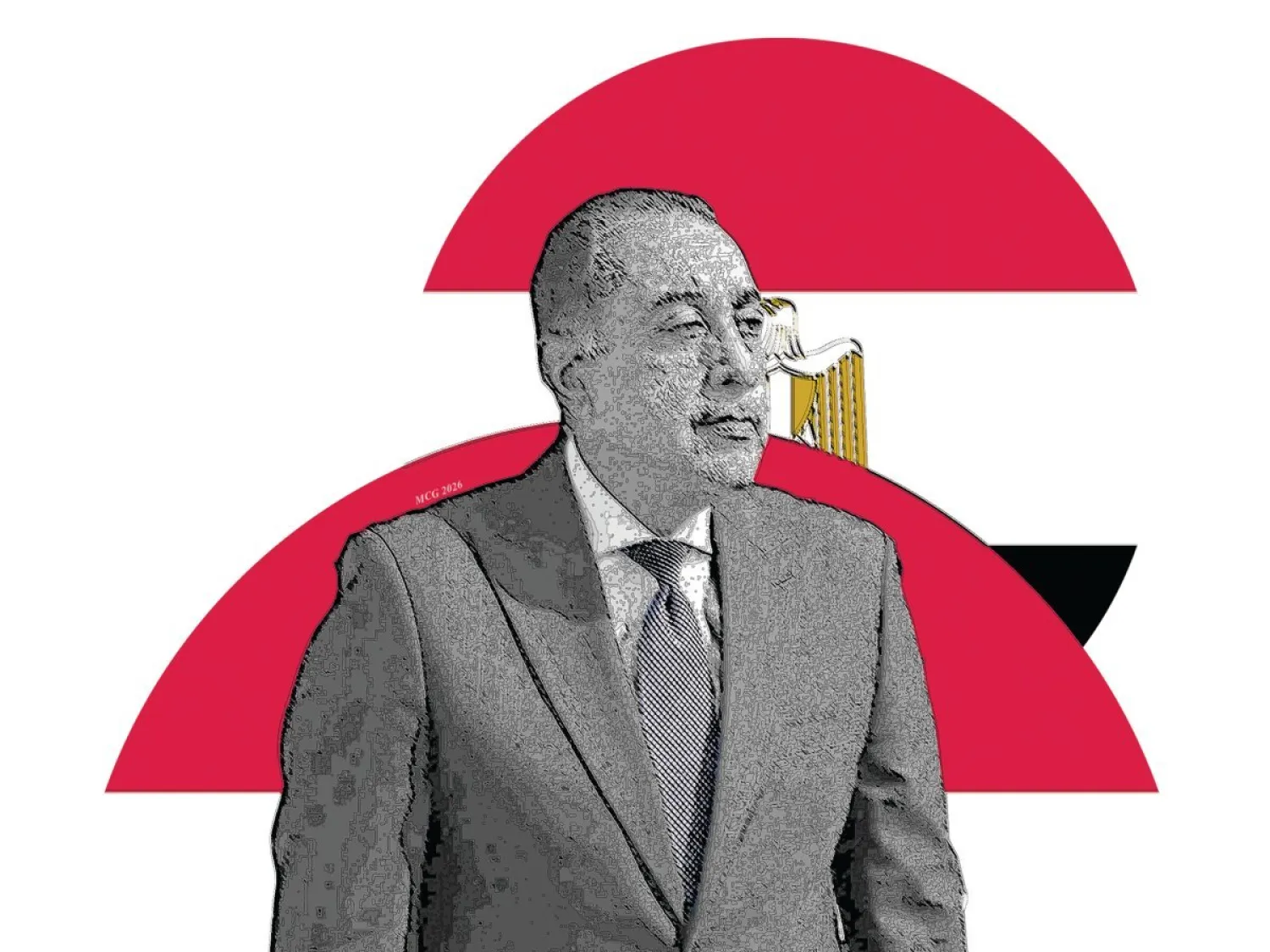لقد فتحت مدينة القسطنطينية في عام 1453 على أيدي السلطان العثماني محمد (الثاني) الفاتح، مزيلاً بهذه الخطوة الإمبراطورية البيزنطية التي عاشت لمدة تزيد على 11 قرنًا من الزمان - كما تابعنا في الأسبوع الماضي - بعد حصار طال قرابة شهرين استخدمت فيه المدافع الحديثة وتكتيكات الحصار الشهيرة. وسقطت المدينة في أيدي القوة العثمانية البازغة، محققًا بذلك حلمًا كان يداعب الدول الإسلامية الممتدة عبر التاريخ.
واقع الأمر أن فتح القسطنطينية يمثل رمزًا هامًا في التطور التاريخي للعلاقات الدولية وتاريخ الدولة العثمانية أكثر منه حدثًا تاريخيًا. فالدولة العثمانية قبيل حصار القسطنطينية كانت بالفعل قد تمكنت من محاصرة المدينة من كل الاتجاهات، وغدا سقوطها مسألة وقت لا غير. ذلك أن الدولة البيزنطية تراجعت كثيرًا عما كانت عليه لقرون وكانت أقوى إمبراطورية فاقت في حجمها وقوتها الإمبراطورية الرومانية الشهيرة. ولكن منذ الحملات الصليبية بدأ تراجعها السياسي حتى صارت في حالة يرثى لها. وعندما دخلت القرن الخامس عشر كانت قد باتت شبحًا لما كانت عليه من قبل، أو كما وصفها أحد المؤرخين بكلماته الثاقبة: «... فإن البيزنطيين عظموا اسم الرومان والتزموا بنظام إمبريالي دون القوة العسكرية، واعتنقوا القانون الروماني دون أي تطبيق إداري لمفهوم العدالة، وتفاخروا بأرثوذكسية كنيستهم في الوقت الذي كان الإكليريوس خدامًا للبلاط الملكي.. إن مثل هذا المجتمع كان لا بد له أن يتفتت حتى لو جاء هذا التفتت ببطء شديد».
هذه العبارة كانت تجسيدًا للدولة البيزنطية. لقد كانت في انتظار رصاصة الرحمة السياسية والعسكرية التي أتت من العثمانيين، بينما لم تستطع أوروبا المسيحية الوقوف بجانبها، لأن مراكز الثقل السياسي الأساسية كانت منشغلة بهمومها: فالبابوية خارجة من أزمة «الانشطار الكبير» بوجود مقرّين للبابوية وتفتت سلطتها الدينية، والإمبراطورية الرومانية المقدسة في حالة سياسية بائسة، وفرنسا وإنجلترا في حرب ضروس.. كل هذه كانت إرهاصات مرحلة ما قبل تغيير الجلد السياسي والاجتماعي في أوروبا الذي جاء في القرن التالي لسقوط القسطنطينية. ومن ثم فإن سقوط هذه المدينة لم يكن إلا جزءًا من تغيير النسيج السياسي الذي كانت تمر به أوروبا والمسيحية فيها، والذي تزامن من حيث الصدفة مع ظهور المارد العثماني الجديد.
يمكن التأكيد أن فتح القسطنطينية كان أمرًا متوقعًا بل حتميًا من الناحية العملية. إذ كانت الدولة البيزنطية في أضعف حالاتها، ويكفي أن القوة المدافعة عن المدينة لم تتعدَّ 10 آلاف رجل فقط، وهو أقل من عُشر الجيش البيزنطي الذي أرسله الإمبراطور هرقل لمواجهة المسلمين واستعادة الشام منهم في معركة اليرموك الشهيرة. ومن ثم جاء فتح القسطنطينية عملاً معنويًا أكثر منه معجزة عسكرية، غير أنه مثّل في واقع الأمر حلمًا داعب المسلمين لما يقرب من 8 قرون. وزاد من قيمته السياسية أنه محا رسميًا الإمبراطورية البيزنطية من الخريطة السياسية بعد عمر طال أكثر من ألف ومائة سنة، وأقر رسميًا الخارطة الجديدة لصراعات القوى على الساحة الدولية.
وبمجرد أن سقطت القسطنطينية، فإن شعار الدولة العثمانية المتمثل في العقاب (Eagle) ذي الرأسين أصبح واقعًا. والرأسان هنا هما تعبير عن المشرق والمغرب، والبحرين؛ الأسود والمتوسط، وهو ما لم يتأخر السلطان محمد الفاتح في تطبيقه عمليًا من خلال توسيع مملكته الفتية بالاستيلاء على ما تبقى من البلقان تقريبًا، بعد شد وجذب عسكري مع القيادات السياسية الحاكمة لهذه المنطقة.
كذلك فإنه توجه مباشرة إلى الشمال، حيث سعى لمواجهة عدوه التقليدي في والاخيا (قلب رومانيا الحالية والمجر، حيث استطاع أن يهزم الكونت دراكول الشهير، الذي نسجت حوله شخصية «دراكولا» الشهيرة في العصر الحديث، بسبب دمويته وتنكيله بأعدائه)، ولهذا حديث آخر لاحقًا.
كما أن السلطان الفاتح ثبت أقدامه في اليونان وتوسع شرقًا وطبق نظامًا عنيفًا للسيطرة على هذه المناطق، وبهذا ثبتت الدولة العثمانية بنهاية عصره نفسها على اعتبارها القوة الدولية العظمى أمام إمبراطوريات ودول غربية وشرقية أقل منها تنظيمًا وتماسكًا من الناحية السياسية والعسكرية. ومهّد السلطان محمد الطريق أمام الدولة الفتية من أجل أن تلعب دور القوة العظمى الحقيقية في أوروبا، لتصبح مصدر الخطر الكبير على الهوية الأوروبية المتصاعدة، كما سنرى خلال الأسابيع المقبلة.
وحقيقة الأمر، أن فتح القسطنطينية كانت له آثاره السياسية الأخرى. إذ سقط مركز الكنيسة الأرثوذكسية في العالم المسيحي، وبمجرد أن دخل السلطان المدينة حوّل كاتدرائية «أجيا صوفيا» إلى جامع «آية صوفيا» العظيم، الذي يعد أحد أهم معالم مدينة إسطنبول اليوم، إلا أنه منح البطريركية الأرثوذكسية مقرًا جديدًا وفتح معها حوارًا دينيًا كبيرًا إلى الحد الذي دعا بعض المؤرخين الغربيين للظن بأن محمد الفاتح كان مستعدًا لاعتناق المسيحية، وهو أمر مستبعد تمامًا في ظل نشأته الإسلامية رغم كبواته السلوكية الواردة في بعض الكتب التاريخية، ورغم تطبيقه لنظام من التسامح الديني لم تعرفه كثير من الدول آنذاك بما في ذلك تعيين الراهب جيناديوس بطريركًا. غير أن ما حصل أثار حفيظة كثرة من الأرثوذكس، وهو ما سمح لدولة روسيا البازغة بعد سلسلة من الخطوات منها بترتيب زواج واحدة من البيت البيزنطي بالقيصر الروسي، لتثبيت الكنيسة الروسية، باعتبارها الوريث الشرعي للأرثوذكسية. وهو اللقب الذي لا تزال الكنيسة الروسية تعتبره واقعًا، ولقد لعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على الهوية والتراث الأرثوذكسي في مواجهة البابوية الكاثوليكية في روما، التي كانت تسعى جاهدة لضم هذه الكنيسة إلى سلطانها.
من ناحية أخرى، أضاف سقوط القسطنطينية بشكل عكسي زخمًا ملحوظًا للحضارة الأوروبية، إذ أدى الاحتلال العثماني إلى هروب كثير من العلماء والفنانين والمفكرين من القسطنطينية. ولقد قصد هؤلاء مركز الجذب الجديد والمتمثل في المدن الإيطالية البازغة، وعلى رأسها البندقية وفلورنسا وجنوى، وأدخلوا معهم كثيرًا من كتب التراثين الهيليني والعربي على حد سواء. وساهم هروب العلماء والمفكرين هذا مساهمة حاسمة في ظهور حركة إعادة النهضة (Renaissance) في أوروبا، وهي الحركة التي كانت أساس التطور الفكري والفني، بل وبدرجة أقل، الرأسمالي في أوروبا.
ولعل من أهم النتائج على المستوى الدولي سيطرة العثمانيين على أحد أهم شرايين التجارة الدولية سيطرة كاملة بين الشرق والغرب، بعد إخضاع القسطنطينية لسلطانهم، وهو ما دفع الدول الغربية لسرعة البحث عن بدائل لهذا الخط الجديد. وهذا أدى بدوره إلى التعجيل بظهور عصر الاستكشافات الجغرافية في محاولة للالتفاف حول الطريق البري ثم البحري عبر الأراضي العثمانية. وأسفر هذا العصر عن اكتشاف القارة الأميركية على أيدي الإيطالي كريستوفر كولومبوس (كريستوفورو كولومبو بالإيطالية)، ثم طريق رأس الرجاء الصالح لتحويل التجارة حول القارة الأفريقية إلى آسيا. وسعت الدولة العثمانية بالتعاون مع الدولة المملوكية في مصر للسيطرة على هذا الطريق، لكنها فشلت بعد الهزيمة المشتركة لأسطولهما في معركة «ديو البحرية» في 1509، ومن بعدها معركة «ليبانتو» الشهيرة في 1572، التي كسرت الذراع البحرية العثمانية، وأضعفت الإمبراطورية العثمانية كقوة دولية بحرية.
من ناحية أخرى، أدى فتح القسطنطينية إلى الإعلان الرسمي لتدشين النظام الدولي الجديد الذي كانت معطياته قائمة بالفعل قبل السقوط، ولكنها تثبتت على نحو واضح المعالم بعد هذا الحدث، فهو نظام مبني على صراع بين القوة العثمانية الجديدة البازغة في الشرق والعالم الأوروبي الأقل تماسكًا في الغرب. ويسعى بعض الكتاب والمؤرخين إلى محاولة تفسير هذه الخطوة على اعتبارها الجولة الثالثة في الصراع الإسلامي - المسيحي لتسيد العالم، مع أن البعض لا يميل لهذا التفسير، ذلك أن الصراعات بين الشرق والغرب كانت دينية الشكل، سياسية واقتصادية الطابع. ولو افترضنا أن الدولة العثمانية كانت قوة مسيحية الهوية، فإن هذا ما كان ليمنع من نشوب الصراع بينها وبين الغرب للتوسع السياسي والاقتصادي، وهو أمر طبيعي بل نمط ممتد في كتب التاريخ ودهاليز السياسة عبر الزمن.
وهكذا طويت صفحة الإمبراطورية البيزنطية أو أطول إمبراطورية في التاريخ الإنساني على أيدي السلطان محمد الفاتح، ولكن هذا لا يمنعنا أن نتابع خلال الأسابيع القليلة المقبلة الجذور التاريخية لكلتا الإمبراطوريتين اللتين يمثل تاريخهما جزءًا لا يتجزأ من التاريخ البشري.
من التاريخ: تأملات سياسية بعد فتح القسطنطينية

كولومبوس

من التاريخ: تأملات سياسية بعد فتح القسطنطينية

كولومبوس
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة