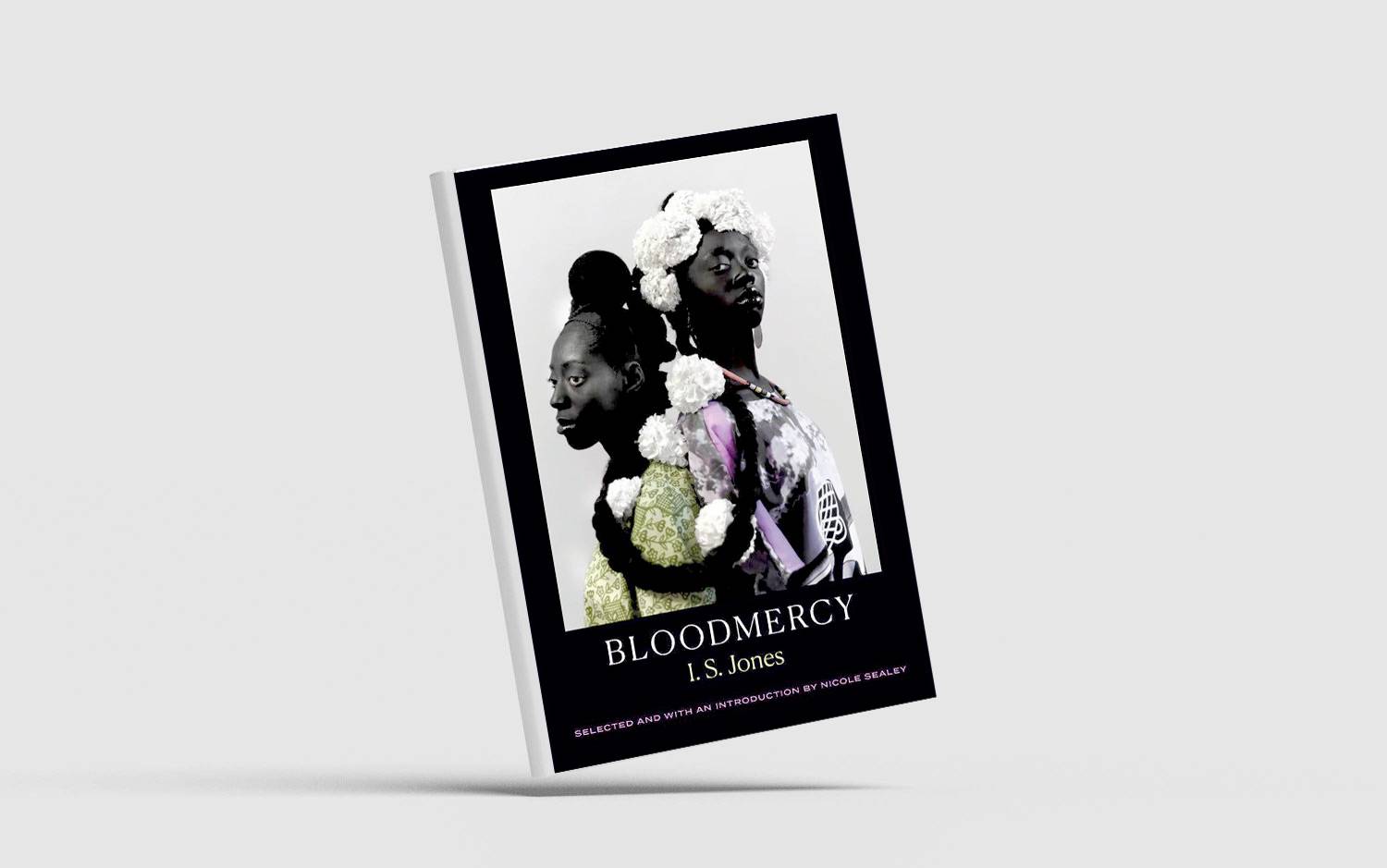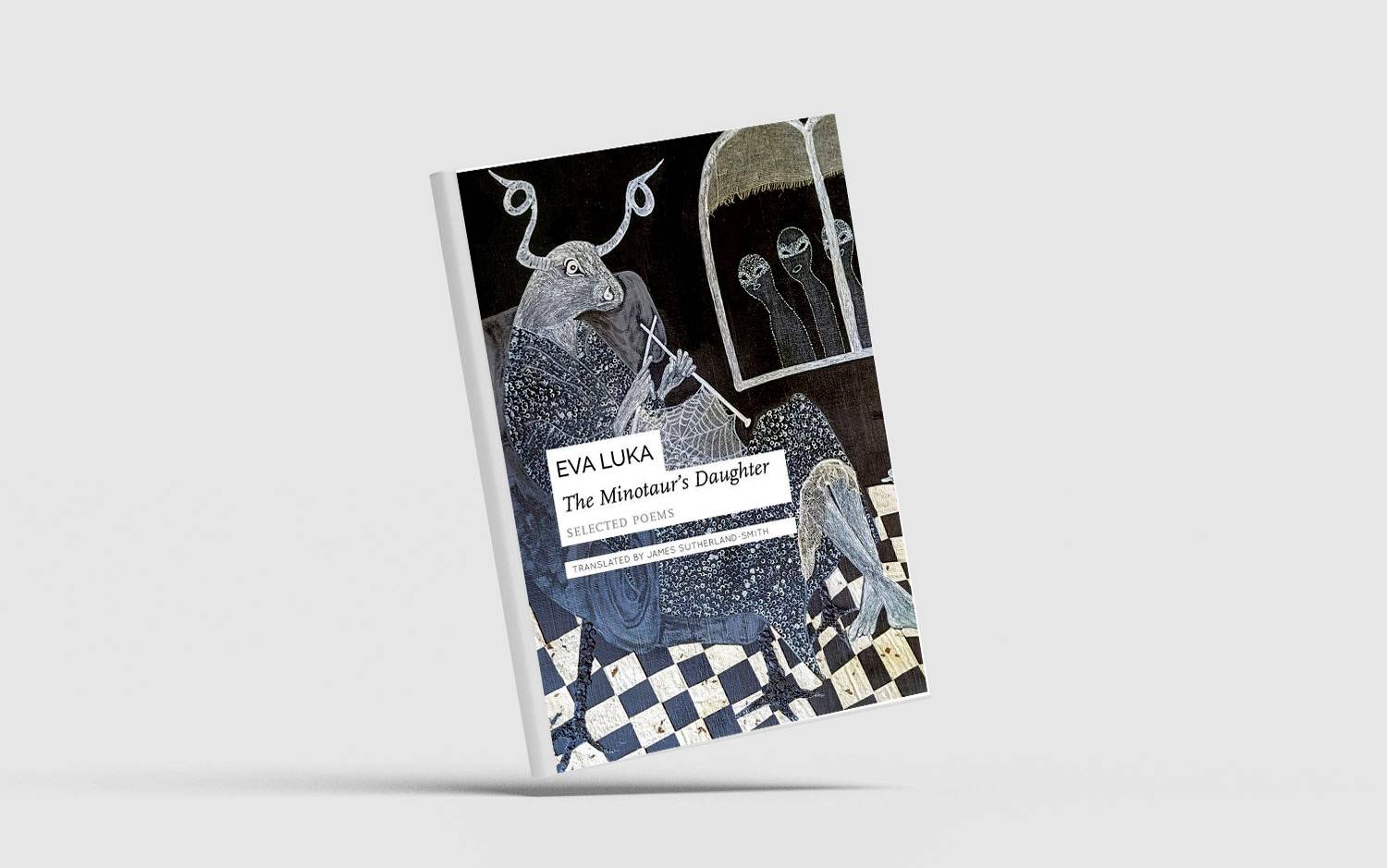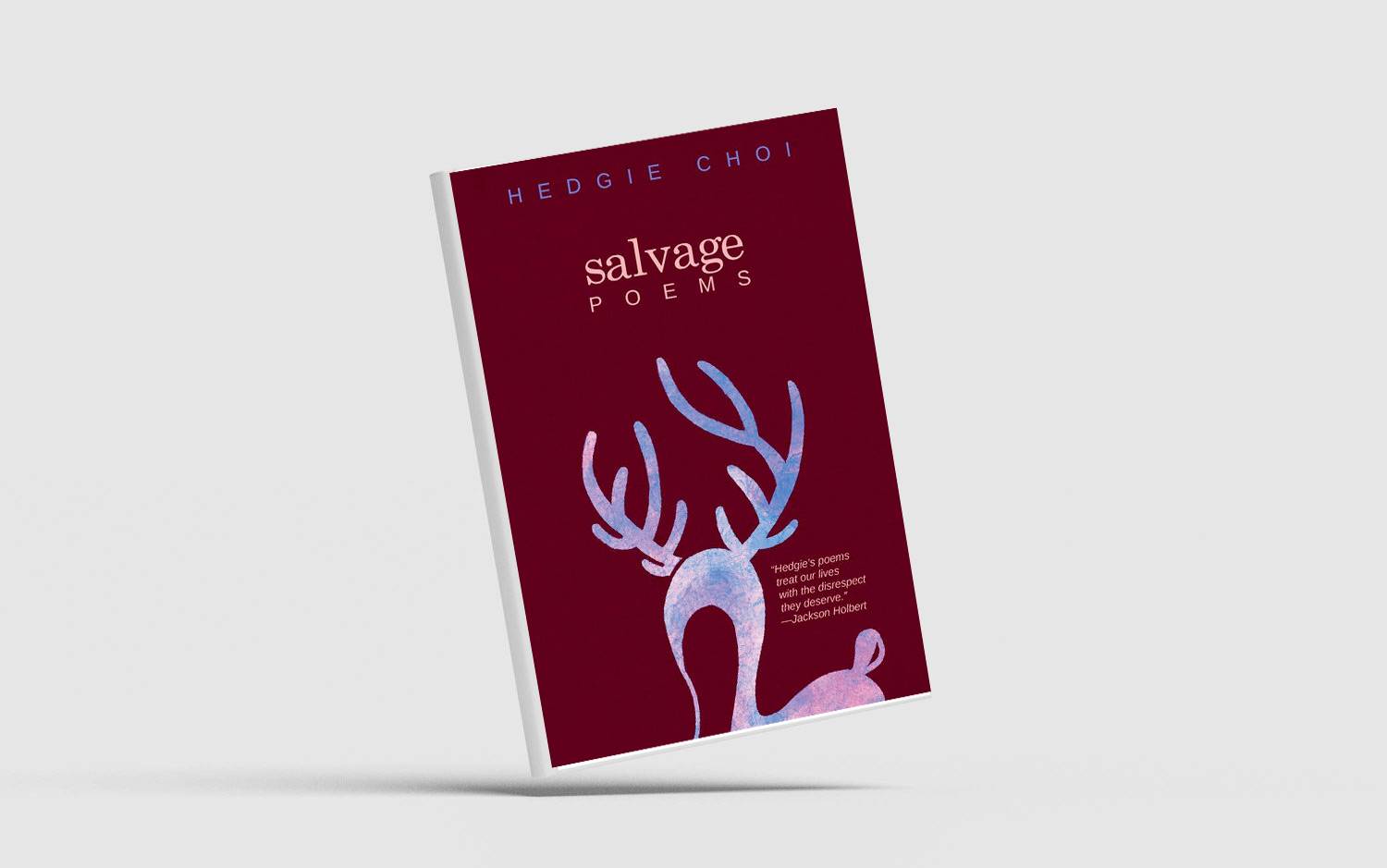لا يمكن أن نجادل في فائدة الضحك؛ فهو مفتاح الفرح والاستمتاع، لما له من قدرات فائقة في مساعدة الإنسان على مواجهة دراما الحياة. والإنسان يظل في حاجة ماسة إلى الضحك، وبخاصة في الفترات الحالكة التي يمر بها. لهذا؛ فالضحك يزداد بالتوازي مع اشتداد الحروب والأزمات. وبالتالي، فلا عجب أن يصبح الضحك في زمننا، ممارسة علاجية نفسية، تطرد الألم أو تساعد على الحد منه، وأن تنتشر في العالم نوادي الضحك، حيث لم يعد الفرد قادرا على تحمل ضغوط الحياة ورتابتها. لكن الضحك لما نقاربه بصفته موضوعا فلسفيا، فقد لا ننظر إليه بهذه الطريقة الإيجابية؛ لأن الفلسفة حين تقارب الموضوع، فهي تهدف، بالأساس، إلى فهمه بصفته سلوكا وإحساسا ودوافع. وتفعل ذلك، من طريق طرح الأسئلة المحرجة عليه، لاستجلاء معانيه ودوافعه الخفية، بقصد فهمه واستيعابه، حتى نكون جديرين بأن نعيش متعته، ونتجنب خطورته وضرره في الوقت عينه. وبالتالي، يكون الهدف الأخير من المقاربة الفلسفية لموضوع الضحك، ليس الاستمرار فيه، وإنما، أن نضحك بهدوء ووعي وتهذيب، وأن نفكر كثيرا قبل أن نضحك، فيكون ضحكا ممزوجا بتفكير وحكمة، ولا يكون الهدف من ورائه التسلية فقط.
تختلط في الضحك، مشاعر وانفعالات شديدة التناقض والتنوع، ليست كلها بريئة، جوهرها الحب والفرح والتفكه. فقد أورد الدكتور أحمد أبو زيد، في كتابه «الضحك تاريخ وفن»، أن «الناس في ظل حضارة أوغاريت الأولى في شمال سوريا، وفي بلاد النيل والرافدين، وآسيا الصغرى، كانوا يبكون وينوحون بسبب موت الآلهة، ثم يفرحون ويضحكون توقعا منهم لانبعاث هذه الآلهة في النهاية. فقد كان هدف الاحتفالات، تأكيد الوحدة والتناغم وزواج الأضداد أو تآلفها». كما أننا لو نظرنا إلى الضحك من وجهة نظر جسمية وبيولوجية، وجدناه يعمل على حدوث زيادة في ضغط الدم، وضربات القلب، والتقلصات العضلية، وزيادة إفراز هرمون الأدرينالين. وهي التغيرات نفسها التي تحدث حتى في لحظات القلق والعدوان والخوف، على الرغم من الفرق في المدة بطبيعة الحال. وبالتالي، فالتأمل في موضوع الضحك، قد يجعل الحدود الفاصلة بينه وبين الحزن والبكاء، وحتى الاستهزاء والغرور والتحدي، مجرد حدود منهجية غير واقعية. وهذا ما تنبهت له الفلسفة منذ زمن بعيد. فقد قال الدكتور شاكر عبد الحميد، في كتاب فريد بعنوان «الفكاهة والضحك، رؤية جديدة»، في فصل كامل بعنوان «ضحك الفلاسفة»: «إن أفلاطون، حذر من الوقوع في فخ الضحك؛ لأنه لا يأتي إلا نتيجة الحقد اتجاه من هم أكثر قوة منا. بمعنى أننا نتلذذ برؤية من هم أقوى منا في موضع مضحك. إلا أنها لذة ممزوجة بألم، وناتجة من وهم أننا نعرف أنفسنا جيدا، في حين أن العكس هو الصحيح؛ إذ نعتقد بأننا نرتفع فوق من نضحك عليهم في المنزلة الاجتماعية». وقد ضحكنا جميعا من منظر الرئيس الأميركي جورج بوش وهو يتجنب الحذاءين المقذوفين إلى وجهه من طرف صحافي عراقي. وهذا ضحك عربي ممزوج بألم الإهانة الأميركية التي لا تنتهي. كما أن الاستجابات التي يولدها الضحك، غالبا ما تؤدي إلى العنف. فيتحول الإنسان العادي أو المواطن الصالح، إلى واحد من أقل الشخصيات جاذبية وأكثرها إثارة للسخرية والاستهجان. فيهتز الوقار والاحترام. ويتحول المرء إلى عامي مبتذل في سلوكه، يسلك في الشارع سلوك السوقة والدهماء. وهو سلوك لا يليق البتة بمواطني الجمهورية. لهذا؛ «على حراس الجمهورية، أن يواجهوا كل اندفاعات العامة، وأن يراقبوا سلوكهم ويضبطوه ضد العبث والطيش والابتذال». إلا أن أفلاطون، الذي حذر من الضحك، يعود، من خلال سقراط، إلى الضحك الساخر «من أجل عرض أفكاره، وشحذ حججه تجاه خصومه، عن طريق طرح الأسئلة المخادعة». فالضحك السقراطي، هو ضحك بيداغوجي، من أجل تمرير أفكار جديدة بطعم حلو يسهل قبوله، شبيه بأخذ دواء مر ممزوج بغلاف من السكر، يجعله يسرّ ولا يضرّ؛ لأنه ليس عدوانيا، ويستطيع أن يمزج بين اللعب والجدية، ويجد المتهكم من خلاله، تربة خصبة ينمو فيها اتجاهه، مع تزايد مقدار المعرفة والثقافة والفكر لديه وقلته لدى خصومه.
توقف أرسطو بدوره، عند مفهوم الضحك واعترف بأهميته، لكنه دعا مثل أفلاطون، إلى «ضرورة أن يبقى في حدود اللياقة والاعتدال». بمعنى آخر، «في حدود الفضيل، حيث لا إفراط ولا تفريط، حتى لا يصير الضحك أمرا مستهجنا شائنا». لهذا؛ كان التهكم أكثر قربا من الكرماء، لارتباطه بالأخلاق واللياقة والترويح والاسترخاء. وهو انفعال إيجابي، يسعى الإنسان، من خلاله، إلى البحث عن السعادة. كما لم يفت أرسطو أيضا، الإشارة إلى قدرة الضحك على القضاء على جدية الخصوم من خلال الضحك والهزل.
أما في العصر الحديث، فقد تحدث الفيلسوف الفرنسي الشهير، توماس هوبز، في كتابه «اللوفيتان»، عن أنواع المسرات واللذات، واعتبر أن الضحك يرجع إلى تلك الأحاسيس المرتبطة بالفخر أو التباهي، أو التشامخ والعظمة، حيث يحس المرء بوجود قدرة أو قوة خاصة لديه، فيشعر الضاحكون بإعجاب مفاجئ بأنفسهم، لاعتقادهم بأن الآخرين لا يملكون ما يملكونه هم، وفي هذا نوع من الخسة ودناءة الأخلاق. وهو هنا لا يختلف كثيرا عن أفلاطون. أما كانط، فقد أرجع الضحك، إلى ذلك التناقض بين ما كان متوقعا وما أصبح واقعا، بصفته رجاءً خائبا؛ ما يعطي للجسد صدمة شبه كلية. فبعد التوقع المضطرب المتوتر، يسترخي الجسم وينتقل إلى راحة مفاجئة تسبب الضحك، فيتعلق المرء هنا بتلك الدهشة أو العبثية التي يقوم على أساسها الموقف المضحك، الذي يجعل الفهم العقلي في حيرة مؤقتة من أمره. لكنه لا ينهزم بفعل الأمر المضحك؛ لأنه يدرك فجأة أنه أفضى به إلى لا شيء، وأنهى التوتر المصاحب للتوقع الشديد المميز له بالضحك. وهو ما يعبر عنه حتى آرثر شوبنهاور، وإن بصيغة مختلفة، حين اعتبر الضحك يحدث نتيجة الافتقار إلى التجانس، أو حدوث التناقض بين الموجة العقلية المجردة وبين تمثل الإدراك، أي أن الضحك ببساطة، هو محصلة لذلك الصراع أو التفاوت المعرفي الذي لا يمكن اجتنابه بين المتصور العقلي العام، والمدرك الحسي الخاص. والضحك نفسه هو مجرد التعبير عن هذا التناقض، ويشبه ذلك بالقياس المنطقي الذي تكون القضية الكبرى فيه مؤكدة، ويتم الوصول إلى القضية الصغرى من خلال الحيلة أو المغالطة. وباختصار تنقسم المواقف المثيرة للضحك في رأي شوبنهاور، إلى الدعابة أو الحماقة، حيث تبرز الأفعال اللامعقولة، مثلا قصة ذلك الملك الذي يضحك من فلاح متباه يلبس ملابس الصيف الخفيفة خلال طقس شتائي، فقال للملك، ستشعر بالدفء لو لبست ما ألبسه. فقال له الملك: وماذا تلبس؟ ألبس خزانتي كاملة. أما الفيلسوف الفرنسي هنري برغسون، فقد خصص كتابا بأكمله للموضوع بعنوان «الضحك le rire»، (من ترجمة أ.د.علي مقلد)، يتحدث فيه عن نظريته في الضحك متأملا في الكوميديا الفرنسية. فنحن نضحك من تصلب الجسد أو الطبع أو الفكر. ونضحك من أوضاع الجسم الإنساني وحركاته وإشاراته، حيث يذكرنا هذا الجسم بمجرد آلة تتحرك «شارلي شابلن نموذجا». ومن شروط الضحك في نظره، أن يكون الموضوع إنسانيا، فلا ضحك إلا مما يحمل بصمة إنسانية، وإن ضحكنا من قرد أو قبعة أو رسم، فلا نضحك منه إلا بمقدار ما يحمل داخله معاني إنسانية. فالطبيعة مهما كانت جميلة، لا تضحك. والشرط الثاني للضحك، هو غياب الانفعال أو الشعور العاطفي. فالخصم الأعظم للضحك هو الانفعال، فيتوجب أن يتوقف القلب عن الشعور ليحدث الضحك، حيث يجب أن تكون الروح هادئة تماما. كما اعتبر أن الضحك يبعث اللين في كل الجسم الاجتماعي، على الرغم من أنه ليس طيبا في كل الأحوال، فيه حفنة من الشر، والغرور والأنانية والخبث، مع أن وظيفته هي إزالة القيود، وإعادة تكييف كل فرد كي يتلاءم مع الجميع، وإصلاح العيوب الاجتماعية المرتبطة بالجمود والتصلب ونقصان المرونة والانعزال والغرور.
قال فولتير عن الضحك، إنه «شيطاني الطابع، وإنساني في الوقت نفسه»، ما يعني أنه يحمل في طياته معاني الخير والشر، ولغة اجتماعية رمزية حاملة لمعاني ودلالات متنوعة. إنه سلوك تتناقض في داخله كل المعاني والصور والتبريرات. هناك من القدماء من اعتبره حتى أصل العالم، وأن العالم قد نشأ عن ضحكة إلهية، أو ضحكات إلهية متتالية. وبالتالي، كان الضحك عالما إنسانيا لا يشاركه فيه أي كائن آخر، دلالة على حريته، وقدرته على الخلق والصنع، وإضفاء المعنى على الذات والعالم، على الرغم من أنه يقوم بالسلوك نفسه.
*أستاذ فلسفة