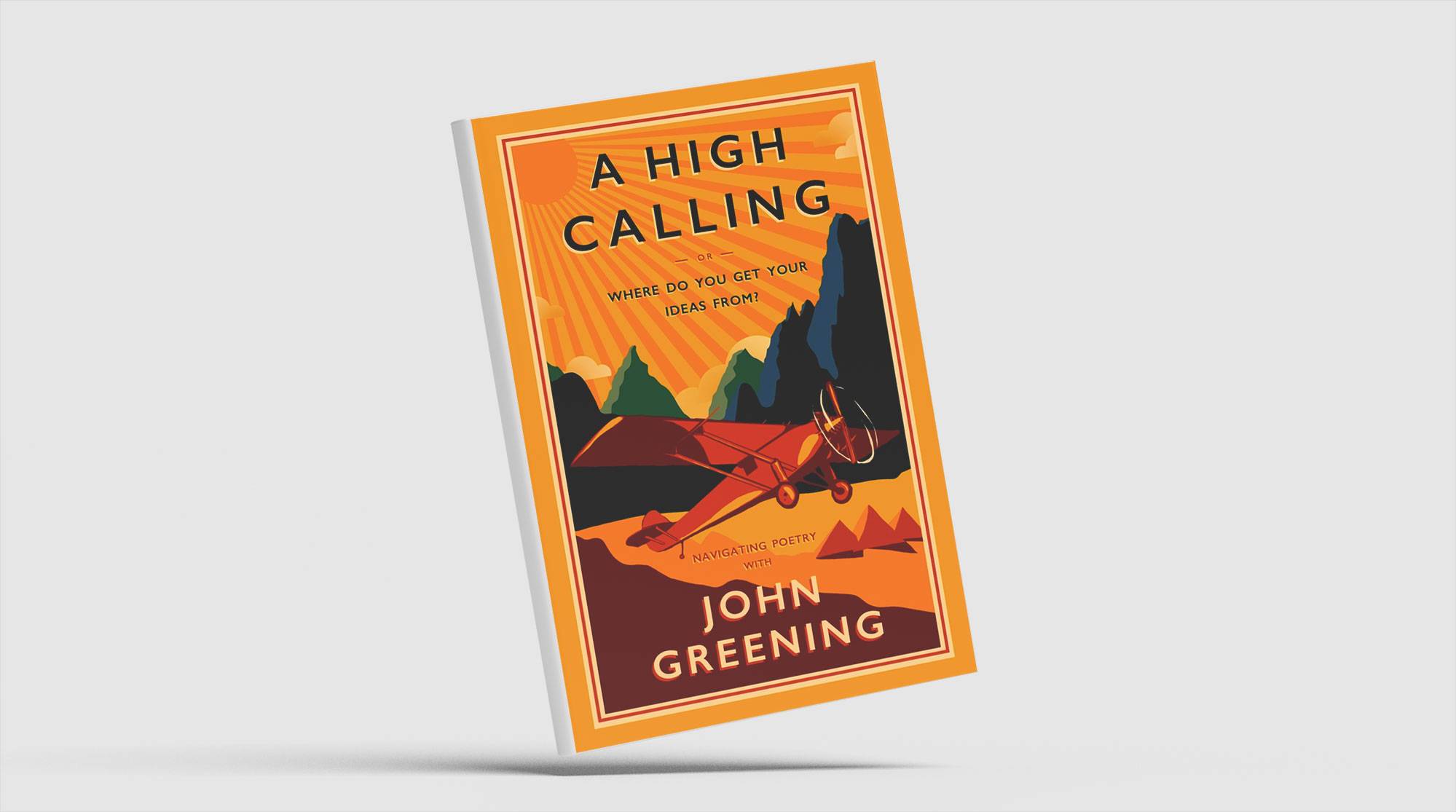تجمع الآراء على أن «العالم قبل الإنترنت هو غير العالم بعد الإنترنت»، وأن «الزمن لم يعد الزمن نفسه، والجغرافيا لم تعد الجغرافيا نفسها، والناس لم يعودوا الناس أنفسهم». حقائق يؤكدها المفكر الفرنسي إدغار موران، بقوله إنه «يستعمل الإنترنت ليس، فقط، من أجل البريد الإلكتروني، ولكن للحصول على المعلومة ومتابعة نشرات الأخبار»، ملاحظا أن «الإنترنت متعدّدة الاستعمالات مثل اللغة، فبالإمكان استعمالها لكتابة الأشعار، كما يمكن أن تستعملها المافيات والمجرمون». غير أن أهم استعمال للإنترنت، برأي موران، يبقى «دمقرَطة الثقافة»، قبل أن يتقدم، أكثر، ليرى أن «للإنترنت قوة تحريرية رائعة تخدم بعض الحركات، مثلا في إيران والصين وتونس ومصر كانت وسيلة للتواصل، سمحت للشباب والجماهير بالتحرك فورا. وعندما ننظر لقضية (ويكيليكس) فهي مهمة، حيث تم الكشف عن ملفات سرية في غاية الأهمية. فثمة أشياء نكتشفها وأخرى تغيب عنا.
على مستوى مفهوم وفعل القراءة، وكيف صارت القراءة في زمن الإنترنت، في منطقتنا العربية، يرى الباحث والناقد المغربي محمد تنفو، أن «فعل القراءة الحقيقي غائب في مجتمعنا العربي. فالشاب العربي عازف عن القراءة، ويقرأ ما يقارب حجم قصة قصيرة جدا في السنة. لذلك؛ صار هذا الشاب يفتقر إلى قدرات تسعفه على الفهم والبناء والتأويل والنقد والتقويم».
وفي مقابل رصده هذا العزوف عن القراءة الفاعلة والفعالة، يتحدث تنفو عن «انشغال الشاب العربي بالشبكة العنكبوتية، وهو انشغال يصل إلى درجة الإدمان والهوس. وما دام هذا الشاب غير محصن بشكل كبير، ويفتقر إلى مناعة حقيقية تمكنه من الإبحار في العوالم الافتراضية المفيدة، فإنه يصير ضحية لهذه الشبكة؛ إذ يقوم بدور (حاطب ليل) لا يكتفي بجمع الحطب المفيد القادر على الإنارة الحقيقية، بل يحمل المفيد وغير المفيد».
يرى تنفو، أن «المواقع الإلكترونية التي تحتل قصب السبق، بالنسبة لاهتمام الشاب العربي، هي المواقع الإباحية، ومواقع تبادل الصداقات، والمواقع الشخصية للفنانين والفنانات.... فداخلها لا يمل ولا يكل. أما دخول المواقع الثقافية المفيدة فيكون من باب الواجبات المنزلية التي يصدرها الأستاذ مدججا بسلاح النقطة». لذلك؛ يتحدث تنفو، بمرارة، عن الشاب العربي الذي صار «ضحية التكنولوجيا وكبش فدائها»، ملاحظا أنه «بدلا من أن ترفع التكنولوجيا من معدل القراءة، أسهمت في إقبارها وتسطيحها. ومن ثم، دقت هذه التكنولوجيا، بفعل فاعل، مسمارا قاتلا في جسد الكتاب الورقي».
في المقابل، لاحظ تنفو كيف أن مجموعة من المجلات، في العالمين العربي والغربي «انتقلت من مرحلة الولادة الحقيقية الورقية إلى مرحلة الولادة الافتراضية»، مشيرا إلى أن «العالم الغربي ما زال يهتم بالفعل القرائي الحقيقي، بخلاف العالم العربي الذي يعاني داء فقدان مناعة القراءة، بسبب تحول الفعل القرائي إلى فعل يماثل الولادة القيصرية. لذلك؛ فتوجيه أصابع الاتهام إلى التكنولوجيا يعد ضربا من الجنون وسوء الفهم».
من جهته، يرى الشاعر والمترجم المغربي رشيد منسوم، أنه «على مجرى التاريخ، كانت القراءة، بصفتها محاولة لفهم وتأويل العالم الغامض ولترميم العزلة المتجذرة في صقيع الكينونة، ثابتا من ثوابت المتخيل الإنساني، أكد من خلالها الإنسان أنه ليس مجرد خطوات بلا أقدام في صحراء، أو مجرد عابر بلا أثر في الوجود». ولأن «الكائن هش لا يحتمل فكرة الوجود، هكذا منفصلا عن الطبيعة وعن التاريخ»، فقد كانت القراءة، يضيف منسوم: «السبيل لمنح الإنسان عمق امتداداته وظلاله وكان العالم ككتاب ضخم ومفتوح يؤسس لفكرة المرآة التي تربط بين السماء والأرض، والتي تحدث عنها ميشال فوكو في كتابه (الكلمات والأشياء). كان الفهم والتحليل والتأويل والتركيب والنقد والإبداع عمليات ذهنية تجعل من القراءة نشاطا حقيقيا معقدا وعميقا. غير أن ظهور وسائل التكنولوجيا الحديثة، وما رافقها من تعاط سلبي، خصوصا من لدن الشباب، لحوامل جديدة، قد أفرز لنا نوعا جديدا من القراءة يمكن أن نطلق عليه (القراءة الزائفة)».
يشدد منسوم على أن ما ينتهي إليه من أحكام «ليس حكم قيمة اعتباطيا بقدر ما هو نحت في اللغة. فثمة، فعلا، استعارات شعرية أزهرت في اللغة لتوصيف فعل التصفح الذي يميز هذا النوع من القراءة الزائفة كـ(ركوب الأمواج) و(الإبحار)، نكاية في العمق وانتقاما من التأويل. هو إذن انتصار السطح على حلم بورخيس الذي طالما تخيل الجنة على هيئة مكتبة. فعالم اليوم يبدو أنه غير معني لا بجاك ديريدا ولا بهانز جورج غادامير أو جيل دولوز، فهو يقدم لنا ذاته، هكذا: «أنا أتسـَـــلفــَـن إذن أنا موجود». صورة طازجة وأشباح من دون ظلال. لا وجود لأثر يفضي إلى شيء. ثمة، فقط، دروب ودروب ومتاهة من دون طعم».
ينتهي منسوم إلى القول بأن «تصور فعل القراءة كما تصوغه العولمة بعين التكنولوجيا الحديثة يروم إفراغ العالم مما تبقى من المعنى لتفقد التفاحة كل استعاراتها وظلالها الأنطولوجية والجمالية، لتصير تلك الفاكهة الطازجة الملفوفة بلا ذاكرة في قطع من البلاستيك في (سوبر ماركت). إنها قراءة توحي بأننا، من خلال موت الكتاب الورقي، لم نعد امتدادات للغابة، كمعبد للرموز والدلالات. حقا إنه لمن سحر العولمة أن تمنحنا (أيفونات) بشاشات ذكية، وتحوّل معظمنا إلى شاشات مسطحة أحادية البعد، من دون أن يتعدى امتدادنا في الوجود تلك المادة اللزجة الذي تسري في أحشائها وتشدنا إليها، تماما، كالحبل السري».
وفي سياق رصد هذه التحولات التي يعرفها العالم، على مستوى وسائط التواصل، يرى الباحث والناقد المغربي سعيد يقطين، أن العصر الحالي يمكن وصفه بتسميات كثيرة، فهو «عصر المعلومات» و«عصر الصورة» و«عصر التكنولوجيا الجديدة للإعلام والتواصل» و«العصر الرقمي»، بما هي تسميات تتآزر، بحسب كاتب «النص المترابط» و«من النص إلى النص المترابط»، لتوصيف عصر مختلف بطابعه الخاص، حتى وإن كان هناك تفاوت، بين الأمم والشعوب، في دخوله والإسهام في تحولاته الكبرى؛ كما تشترك في إيحائها إلى قواسم مشتركة، تجد مدلولها الحقيقي في كوننا ندخل حقبة حضارية جديدة من تاريخ البشرية، عنوانها المركزي هو الانتقال إلى المرحلة الرقمية، التي تهمين فيها الأجهزة الرقمية التي من خلالها يتم التواصل.
هي مرحلة تختلف، من دون شك، عن سابقاتها؛ إذ تحسب على «عصر يلهث فيه قادمه يكاد يلحق بسابقه، وتتهاوى فيه النظم والأفكار على مرأى من بدايتها، وتتقادم فيها الأشياء وهي في أوج جدتها»، على رأي نبيل علي، في مؤلف «الثقافة العربية وعصر المعلومات». لذلك؛ صار المرور من فعل الكتابة إلى ربط الكتابة نفسها بمعطى جعل المكتوب، قابلا للرؤية والقراءة على الشاشة ضمن هذا التحول المتسارع، يستدعي من القارئ عدم الاكتفاء بمعرفة القراءة، فقط، بعد أن صار مطالبا بالتفاعل مع النص رقميا. أي أننا لم نعد، هنا، أمام القارئ العادي، أو حتى القارئ المثالي، الذي كانت تـُنـَـظـّر له الكتابات، ما قبل الرقمية، بل أمام «قارئ رقمي»، صار مطلوبا منه التوفر على «أنماط إدراك» خاصة تجعله مختلفا عن القارئ الورقي، فيما المؤلف لم يعد هو المبدع والمنتج المتحكم في نسيج نصوصه الإبداعية، بعد أن فقد سلطته، على رأي المفكر المغربي عبد السلام بن عبد العالي، في مؤلفه «ضد الراهن».
هكذا، تتأكد قيمة الإنترنت، على مستوى التواصل والإبداع الأدبي والثقافي، مع بعض الفروقات فيما يخص درجات التأثر بهذا الوضع الجديد، حسب البلدان ودرجة انخراطها وأخذها بأسباب التكنولوجيات الحديثة، من جهة التوفر على متطلبات الارتباط بالواقع الجديد. وفي هذا السياق، ينطلق يحيى اليحياوي، الباحث المغربي المتخصص في علوم الاتصال، من الخصوصية المحلية، لينتقد بعض الأفكار الجاهزة حول الإنترنت في بلده، وفي كثير من بلدان العالم، فيقول إن «علاقتنا بالثقافة في المغرب علاقة شاذة في الظروف الطبيعية، فما بالك لو أضيفت لها المستجدات التكنولوجية؟!».
من جانبها، تنظر الناقدة والروائية المغربية زهور كرام للتحولات الحالية المتسارعة التي يعرفها العالم من وجهة نظر إيجابية، تتلخص في أن «انتقال الحضارات من مستوى تواصلي إلى آخر، أكثر استثمارا لتطور الفكر البشري، يولد أشكاله التعبيرية التي تعبر عن حالة الوعي بهذا الانتقال. ولهذا، يحق لأفراد كل مرحلة تاريخية التعبير بواسطة الإمكانات والأدوات المتاحة؛ لأن تلك الإمكانات ليست مجرد وسائط، وإنما تعبر عن شكل تفكير مرحلة».
وبالإيجابية نفسها، في النظر إلى هذه التحولات، لكن مع اشتراط قدرة الأفراد على التعامل مع متطلبات المرحلة، يرى الباحث والقاص والناقد السينمائي المغربي محمد اشويكة، أن الرهان على القارئ الإلكتروني رهان على قارئٍ نوعي؛ لأنه يستطيع تجاوز عائق القراءة الكلاسيكية التي تكتفي بالمادة التي تشملها تضاعيف الحامل الورقي، منبها إلى أن «القراءة الإلكترونية تنمي الكفاية التكنولوجية التي تكشف النص بصفته متاهة، إذا لم يحسن القارئ اكتشافها، من خلال مهاراته الانتقالية عبر روابط النص، تضيع أجزاء كثيرة منه، ولا تكتمل المتعة».
قارئ الشبكة العنكبوتية.. «حاطب ليل»
التكنولوجيا بدلاً من أن ترفع من معدل القراءة.. أسهمت في تسطيحها

محمد تنفو - رشيد منسوم

قارئ الشبكة العنكبوتية.. «حاطب ليل»

محمد تنفو - رشيد منسوم
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة