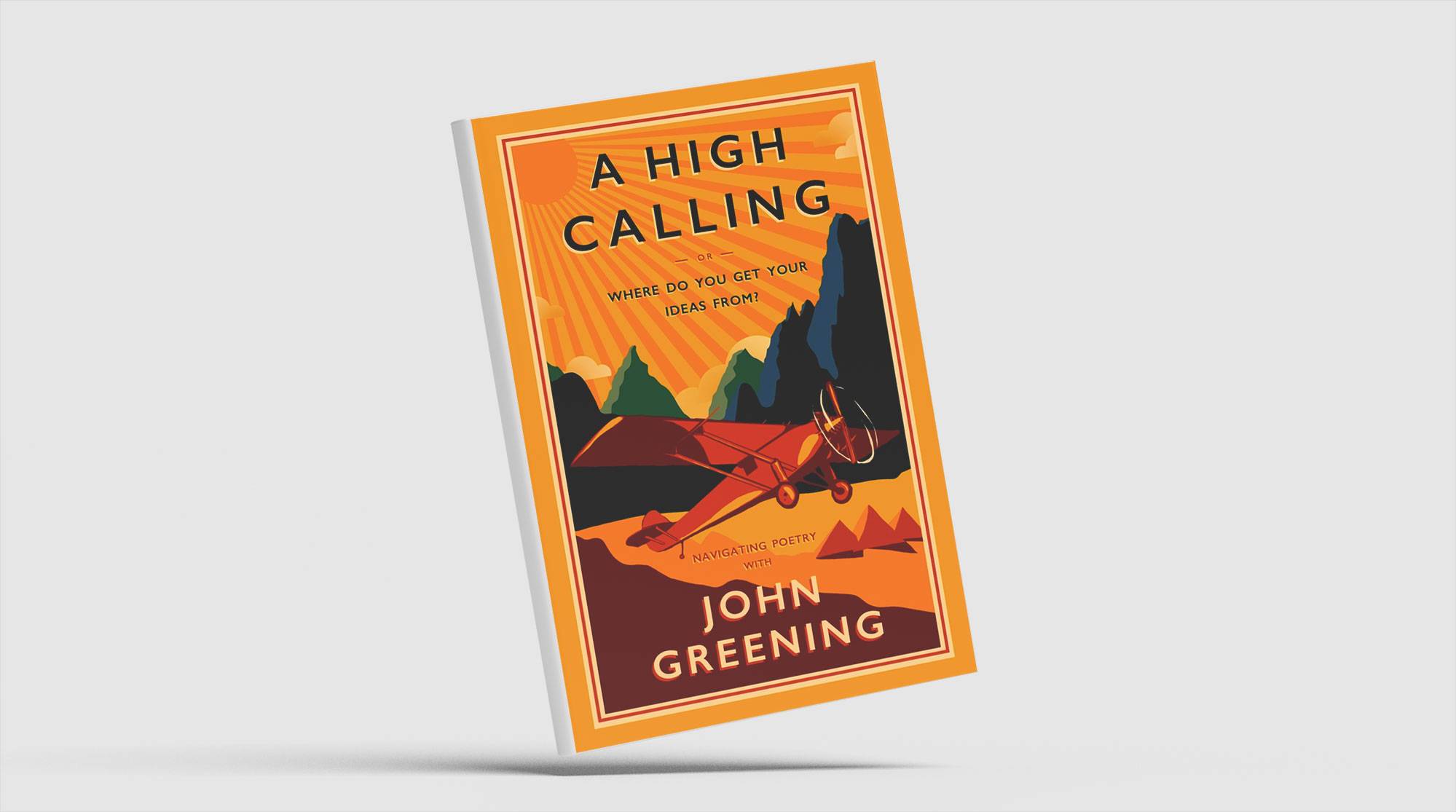«من بين احتمالات الموت المؤجل، إما قبول الصحراء، أو الخروج منها بحرًا.. ومن بين احتمالات الموت المؤكد، إما اختناقًا بكيس داعش أو إسرائيل أو أي قمع كان، أو الاختناق في أقبية الأنظمة من جهة أخرى.. من بين جميع الاحتمالات يبقى احتمال الحياة هو الأقل حظًا.. غابت جميع الوجوه التي أعرفها ورسمتها مرارًا تحت الأقنعة، أو تحت أكياس الخيش.. موت واحد بمساحة العالم.. قمع باق ويتمدد».. هذا ما وقع باسم الفنان أمجد غانم في مقدمة الكتب الخاص بمعرضه «راس وروس»، واحتضنه «جاليري1» في مدينة رام الله، مؤخرًا.
والمتجول في المعرض، ما بين لوحات «أرض السواد»، و«غارة»، و«وطن»، و«قيم»، و«نزوح»، و«درس»، و«أحمد عبد الكريم جواد»، و«أمام المجزرة»، و«حرية»، وغيرها، يلاحظ أن غنام يقاوم بلوحاته العنف المستشري في فلسطين والعالم، ويعمل على تعريته، في لوحات سوداوية لا تقل عن سواد العالم المعاش، وإن كان تحاكيه بشكل أو بآخر، عبر لوحات ارتبط بماسي الحروب لفنانين عالميين كبار، أو التهكم اللوني والتشكيلي الذي غلبت فيه الواقعية البعيدة عن «الكلاشيهات» على الأمل الذي حاول اللجوء إليه بلوني الزهر، والأزرق الفاقع.
ويقترح علينا أمجد غنام أعمالاً فنية ورسومات تنوء تحت وطأة الأسر والمنع والاحتجاز.. يأخذنا إلى حيث نعيش واقع وقسوة حياة مصادرة ومنهكة، ويحضر إلينا التجربة الإنسانية، وهو المسكون بهذه الفكرة، على قماش اللوحة بصيغ متعددة.. لوحات تطرح فكرة أزمة الإنسان داخل السجن أو السجن الذي في داخله، وكأنه لم يخرج تمامًا من تجربة الاعتقال التي عاشها في سجون الاحتلال، وهو المسكون بأقرانه من المعتقلين السياسيين، بآمالهم وأحلامهم المحبطة.
ويفرد غنام ألوانه الباهتة نسبيًا على مساحة اللوحة، وهو يجتهد في وضع تلك العلامات والخطوط والكتل، مستحضرًا بذلك الجسد الآدمي المنتهكة كينونته من قمة رأسه حتى أخمص قدميه، حيث تسجل لوحات «راس وروس» محنة المعتقل وموضوع الأسر والسجون المتلاصقة التي تتعاظم بدل أن تضمحل وتزول، وكأن اللوحات تدعونا ربما إلى أن نمد يدنا لنزيل غطاء الرأس عن الوجوه والعيون الممنوعة من البصر، أو لنتحسس ذلك الغطاء وتلك الغشاوة على وجوهنا.
ويلفت الفنان خالد حوراني إلى أن غنام «يأخذنا إلى درس راس وروس الشهير في كتب القراءة الأولى لخليل السكاكيني، ليضعه هنا في معادل بصري جديد، يبحث في المعنى الحقيقي للقراءة التي تقترحها الحياة الآن وهنا، ومن حضور الرأس لا بمعناه التوضيحي كما في الدرس، وإنما الرأس المغطى والمعصوب العينين، وكذلك عن حضور الجسد كموضوع للقمع والقهر.. رؤوس وقامات تحاول التمرد تارة، والسخرية من قيدها وهي تثور تارة أخرى، فيبدو أن الكيس والعتمة ليست عناصر مدخلة على الشخوص في اللوحة فقط، وإنما على اللوحة نفسها أيضًا، وهي من نفس خامتها في غالب الأمر.
إن ما يريده أمجد هو أن نتقرب من هذه التجربة الجسدية دون أن يورطنا في النواح والشكوى ودون رفع الشعارات، وهو بذلك يتركنا وحدنا في زمن تعصف به أزمات، وتضع كل حياة الإنسان، وليس حريته فقط، على كف عفريت، بل على أكف عفاريت الاحتلال والاستبداد والقمع، وكذلك الجهل والإرهاب، إلا أن هذه اللوحات تنم عن قدرة على الإنشاء والتخطيط والرسم والتلوين، ويصبغها الفنان بذكاء وهالة من السحر والغموض الآسر تجعلها أيضًا موضوعًا للحب والتعاطف الإنساني لا بتوقيت السجن، أي سجن، بل بتوقيت رام الله والقدس والملتبس».
يقول غنام في لقاء لنا معه: «راس وروس هو درس اللغة العربية الأول في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، وكتبه خليل السكاكيني ورسمت رسوماته الفنانة الفلسطينية الراحلة فاطمة المحب، والمعرض عبارة عن إعادة قراءة لذلك الدرس في ظل الظروف التي نعيشها ونعايشها اليوم، والتي يفرضها علينا الواقع السياسي في المنطقة العربية في السنوات الأخيرة. نقطة البداية كانت من محاولة محاكاة الأوضاع الحالية في سوريا، ونقاط الاشتباك والتشابه مع حدث معنا كفلسطينيين، من قتل واعتقال وتجويع وغيرها».
وهناك لوحات تروي حكايات معينة، أبرزها لوحة «أحمد عبد الكريم جواد»، وتروي بالرسم حكاية مواطن سوري عرض سيارته للبيع مقابل خمسة كيلوات من الأرز، وبعد أسبوع مات جوعًا، فرسم غنام صورته على طريقة الأيقونة المسيحية، مستبدلاً هالة القداسة بـ«كيس خيش» فارغ، هذا الكيس الحاضر في الكثير من لوحات المعرض، بما يحمله من رمزيات الاعتقال، والاختناق، والقمع، وهي الحالات التي باتت تكبل وتحاصر وتكاد تكون عناوين يومية في حيوات الفلسطينيين والعرب أيضًا هذه الأيام.
أما «الستارة الزرقاء»، فيحاكي فيها غنام لوحة «الغارنيكا» لبيكاسو، التي رسمها في عام 1937 حول الحرب الأهلية في إسبانيا. وحكاية رسمها تعود إلى المؤتمر الصحافي لوزير الخارجية الأميركي السابق كولن باول حول الغزو الأميركي للعراق في عام 2003، حيث تمت تغطية اللوحة حينها بستارة زرقاء، ولقي هذا التصرف انتقادًا كبيرًا من نقاد وفنانين وإعلاميين، وبررت الخارجية الأميركية هذا التصرف بأن الخطوط الحادة للوحة كانت ستؤثر على جودة تصوير المؤتمر الصحافي، في حين وجد غنام ما قاله قبله الكثير من الساسة وغيرهم، بأن وجود اللوحة التي تتحدث عن مآسي البشرية بسبب الحروب ستصعب من مهمة باول في إقناع الأميركيين والعالم بجدوى الغزو الأميركي على العراق، والحروب المتعددة لجيشها في العراق وأفغانستان وغيرها من الدول بدعوى «مكافحة الإرهاب»، فرسم «الغارنيكا» مغطاة بستارة زرقاء على صورة معتقل من معتقلي سجن أبو غريب، على الشاكلة التي خرجت فيها بعض الصور المسربة عن حادثة «أبو غريب» الشهيرة، والتي تمت فيها تعرية السجناء في ذلك السجن بالعراق، والتقاط صور «سيلفي» لمجندة ومجندين أميركيين مع العراة من المعتقلين العراقيين.
الفنان الفلسطيني أمجد غنام في «راس وروس»
أعمال معرضه في رام الله صرخات في وجه القمع

إحدى لوحات المعرض

الفنان الفلسطيني أمجد غنام في «راس وروس»

إحدى لوحات المعرض
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة