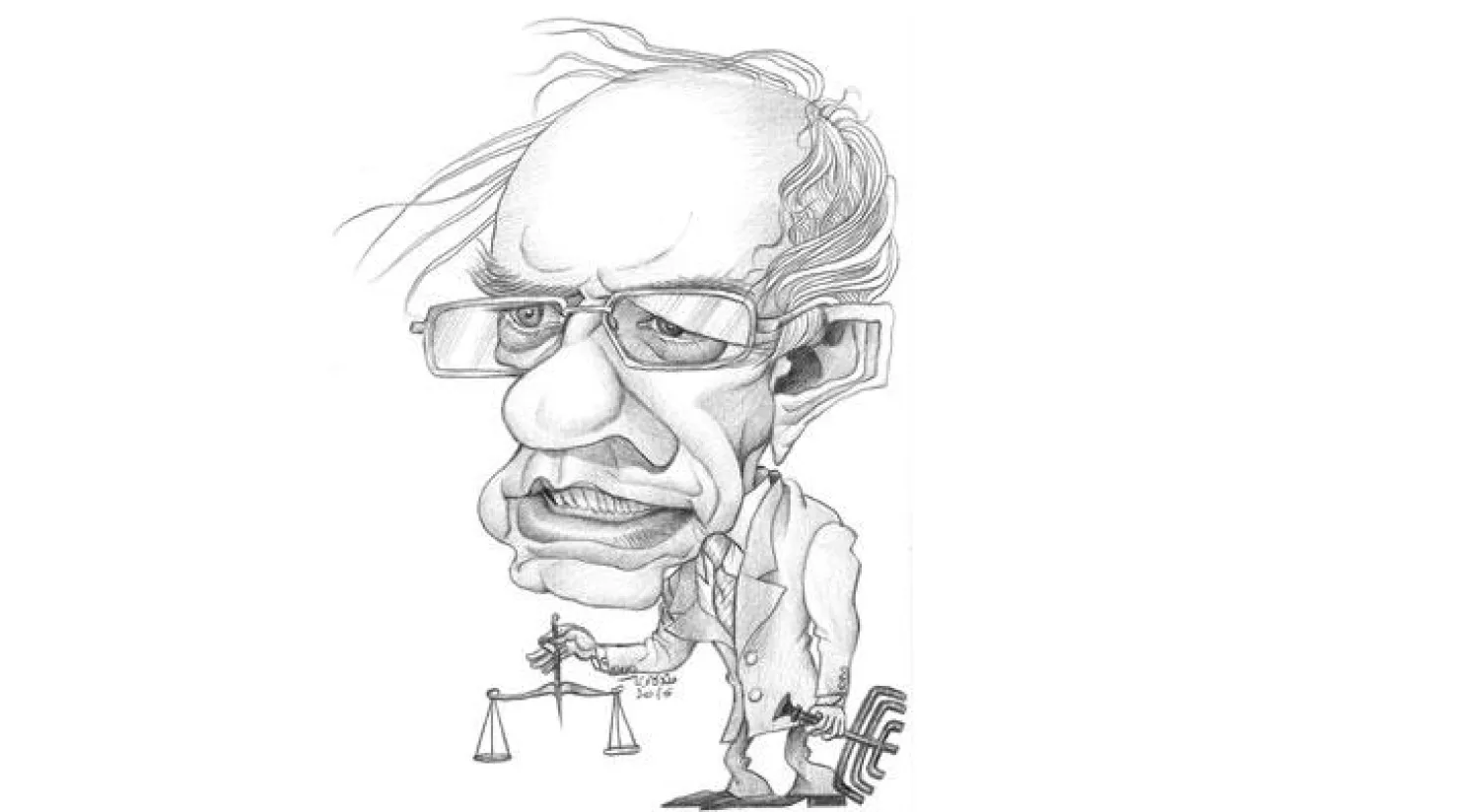يوم الثلاثاء قبل الماضي، في الانتخابات التمهيدية بولاية نيوهامبشير الأميركية، حقّق السناتور بيرني ساندرز فوزًا ساحقًا على وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون. وبدا أنه يهدد فرصتها للترشح باسم الحزب الديمقراطي لرئاسة الجمهورية في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ومن ثم أن تكون، إذا فازت، أول امرأة ترأس الولايات المتحدة. غير أن الوقت ما زال مبكرًا للحسم، فحتى الآن، شهدت ولايتان فقط هما آيوا ونيوهامبشير اختبارات تمهيدية. وتبقى ولايات كثيرة. ثم أنه ما زالت هناك فترة تقارب العشرة أشهر تفصلنا عن يوم الاقتراع الموعود. وحتمًا من الآن، وحتى ذلك الوقت، يمكن أن يحدث أي شيء بالنسبة لأي من المرشحين.
مع هذا، يمثل السناتور ساندرز ظاهرة جديدة في الانتخابات الرئاسية الأميركية، لجملة من الأسباب، أبرزها:
أولاً: أنه أكبر المرشحين - الديمقراطيين والجمهوريين - سنًا (75 سنة).
ثانيا: أنه وإن لم يكن أول سيناتور مستقل، لكنه أطولهم مدة في شغل المنصب (10 سنوات تقريبًا).
ثالثًا: أنه ليس شخصية وسيمة وأنيقة وذات جاذب تلفزيوني، والشيء نفسه ينطبق على زوجته.
رابعًا: أنه اشتراكي (العضو الوحيد في مجلسي الكونغرس الذي يعلن اشتراكيته صراحة).
خامسًا: أنه يهودي (المرشح الوحيد غير المسيحي بين جميع مرشحي الحزبين).
سادسًا: أنه من ولاية فيرمونت، ثاني أصغر الولايات الأميركية من حيث عدد السكان (بعد ولاية وايومينغ)، وبالتالي ثاني أقلها وزنًا في الانتخابات.
طبعًا، لا يثار كثيرًا في الحملة الانتخابية موضوع يهوديته. وحتمًا ما كان سيترشح للرئاسة كاشتراكي حتى في ولايته الليبرالية التقدمية. وللعلم، لا يوجد في الولايات المتحدة راهنًا حزب اشتراكي (بعدما حل الحزب نفسه عام 1972). ومع أنه يوجد حزب شيوعي صغير، يُقال إن نصف أعضائه عملاء سرّيون في مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي)، أو جواسيس من اليمين المتطرف.
ولد برنارد «بيرني» ساندرز في عائلة يهودية في مدينة نيويورك عام 1941. كان والداه يهوديين متدينين بولنديين، هاجرا من بولندا إلى أميركا مع بداية الحرب العالمية الثانية، قبل أن يحتل الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر بولندا، ويرسل يهودها إلى أفران الغاز. ووفق التقارير أرسل النازيون إلى أفران الغاز بعض أعمام ساندرز وعماته الذين رفضوا نصائح أخيهم بالهجرة مثله إلى أميركا.
عندما كان ساندرز صغيرًا أرسله والداه إلى مدرسة يهودية مسائية في نيويورك (بالإضافة إلى المدرسة الابتدائية الحكومية). وبعدما أكمل دراسته الثانوية في نيويورك، التحق بكلية بروكلن التابعة لجامعة مدينة نيويورك، ولكنه انتقل منها بعد سنة واحدة إلى جامعة شيكاغو المرموقة، حيث تخرج حاملاً درجة بكالوريوس في العلوم السياسية. وفيها التقى بزوجته الأولى ديبورا شيلينغ التي تزوجها عام 1964 وتطلقا عام 1966 ولم ينجب منها. لكنه أنجب ابنه الوحيد ليفي عام 1969 من صديقته سوزان كامبل موت. وفي عام 1988 تزوّج ثانية، من جين أومارا دريسكول، التي غدت لاحقًا رئيسة كلية بيرلينغتون.
جامعة شيكاغو، لم تعرّف ساندرز على زوجته الأولى فحسب، بل حدثت له هناك ثلاثة أشياء مهمة حددت مسار حياته: أولها، أنه صار زعيمًا طلابيًا إذ فاز برئاسة اتحاد الطلبة. وثانيها، أنه صار صهيونيًا، ومن ثم انتخب رئيسًا لاتحاد الطلبة الصهاينة في الجامعة، وأمضى سنة واحدة متطوعًا في مزرعة جماعية (كيبوتز) في إسرائيل. وثالثها، أنه اعتنق الفكر الاشتراكي. ثم اختير رئيسًا لاتحاد الطلبة الاشتراكيين في الجامعة. ولاحقًا، انضم إلى الحزب الاشتراكي الأميركي (قبل أن يحل نفسه عام 1972). وأيضًا، إبان فترة الجامعة، نشط في صفوف حركة الحقوق المدنية، وسافر إلى ولايات الجنوب للدفاع عن حقوق الزنوج، مع وفود طلابية (كانت غالبيتهم من اليهود).
وعام 1962، قاد ساندرز مظاهرة طالبت باستقالة جورج بيدل، رئيس جامعة شيكاغو، وذلك بسبب سياسة الجامعة العنصرية التي كانت تفصل داخلية الطلاب السود عن داخليات الطلاب البيض. ثم قاد ثلاثين طالبًا احتلوا مكتب مدير الجامعة.
وفي عام 1963، اعتقلته شرطة شيكاغو لقيادته مظاهرة ضد التفرقة العنصرية في مدارس المدينة. وأمضى في السجن يومًا واحدًا، لكن، بعد ذلك، صارت الشرطة تتجسس عليه، وتتابع نشاطاته.
واستمر ساندرز بنشاطاته في هذا الاتجاه، ففي عام 1964، قاد وفدًا طلابيًا من الجامعة توجه إلى العاصمة واشنطن، حيث شاركوا في مظاهرة الحقوق المدنية الشهيرة في واشنطن. وهي التظاهرة التي ألقى فيها مارتن لوثر كينغ، زعيم حركة الزنوج، خطبته المشهورة «لدي حلم».
بعد ذلك، عام 1968، قاد مظاهرة طلابية ضد التدخل العسكري الأميركي في فيتنام، وذلك أمام قاعة المؤتمر العام للحزب الديمقراطي (الذي رشّح السناتور جورج ماكغفرن لرئاسة الجمهورية ضد ريتشارد نيكسون) في شيكاغو.
* الناشط المزمن
بعد التخرّج في جامعة شيكاغو، عمل «بيرني» ساندرز في مهن كثيرة، بينها التعليم والنجارة. لكنه قرر عام 1968 مغادرة نيويورك والانتقال للعيش في ولاية فيرمونت الريفية الصغيرة لانجذابه (كما قال ذات يوم) لجمال الريف وسكينته. وبالفعل انتقل إلى مدينة بيرلينغتون الصغيرة التي تعد المدينة الوحيدة من حيث الحجم السكاني في ولاية فيرمونت. وهناك في فيرمونت، امتهن النجارة والكتابة وإنتاج الأفلام والمواد التعليمية وبيعها للمدارس. وواصل كذلك العمل السياسي، ولا سيما قيادة المظاهرات ضد التدخل العسكري الأميركي في فيتنام. وبعد حل الحزب الاشتراكي الأميركي نفسه (عام 1972)، أسّس ساندرز مع آخرين حزب «ليبرتي يونيون» (اتحاد الحرية). وتعاون مع حزب اشتراكي صغير آخر هو «بيبولز بارتي» (حزب الشعب).
وفي عام 1972، عندما كان عمره 31 سنة، ترشح ساندرز لمنصب حاكم فيرمونت، وكان أول مرشح اشتراكي لحكم ولاية في تاريخ الولايات المتحدة، لكنه خسر. ثم ترشح لشغل معقد فيرمونت الوحيد في مجلس النواب الأميركي، ومجددًا خسر. ثم ترشح لعضوية مجلس الشيوخ الأميركي، وخسر للمرة الثالثة.
وفي عام 1980، وبسبب هزائمه المتواصلة، ترك حزب «اتحاد الحرية»، وتخلّى عن الحديث الكثير عن «الاشتراكية الأميركية». ومن ثم، ترشح لمنصب عمدة مدينة بيرلينغتون، وهذه المرة فاز بالمنصب، ثم فاز بثلاث دورات متتالية.
طوال هذه الفترة لم يتخلّ ساندرز عن قناعاته الاشتراكية. ومع أنه كان يترشح ويفوز كمستقل كان يكرر أنه اشتراكي. بل إنه خلال تلك السنوات، أسهم في تأسيس تنظيمات اشتراكية صغيرة ظلت هامشية، منها «سيتيزن بارتي» (حزب المواطنين)، و«بروغريسيف كوأوليشن» (التحالف التقدمي).
كذلك، فإنه تحالف مع يساري يهودي آخر يعد من ألمع المثقفين الأميركيين التقدميين، وربما أهمهم في نقد السياسة الخارجية الأميركية هو ناعوم تشومسكي بروفسور الألسنية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (إم آي تي) وحتى اليوم. ومثلما انتقد الرجلان معًا بشدة التدخل العسكري الأميركي في فيتنام، يقودان حاليًا ما يعتبرانه التدخل العسكري الأميركي في الدول العربية والإسلامية.
بعد دخول ساندرز الكونغرس، نائبًا في مجلس النواب عام 1991، فإنه لم يتحدث داخل الكونغرس عن نفسه كاشتراكي، بل كمستقل. غير أنه مع ذلك أسس تحالف «النواب التقدميين» (حسب القاموس السياسي الأميركي، «التقدمي» يميل إلى اليسار أكثر من «الليبرالي»). وخلال ذلك العام عارض ساندرز مشروع قانون الكونغرس الذي منح الرئيس السابق جورج بوش الأب حق إعلان الحرب على العراق (حرب تحرير الكويت). وعام 2003، عارض مشروع قانون الكونغرس الذي منح ابنه الرئيس جورج بوش الابن حق غزو العراق، مع أنه كان قبل ذلك بسنتين، قد أيد بوش الابن في مسألة غزو أفغانستان، وبرّر موقفه بأنه يفعل ذلك للرد على هجمات 11 سبتمبر (أيلول) الإرهابية.
وبالإضافة إلى ما سبق، صوّت ساندرز في الكونغرس ضد قوانين أخرى، من بينها: قانون «باتريوت» الذي منح الرئيس الأميركي حق الحرب العالمية ضد الإرهاب، وقانون «حماية الولايات المتحدة من الإرهاب» الذي عرقل محاولات الرئيس باراك أوباما لإغلاق سجن غوانتانامو العسكري الأميركي في كوبا، وقانون «حماية النظام الاقتصادي الأميركي» الذي وضعه الكونغرس بعد الكارثة الاقتصادية عام 2008، واعتبر ساندرز أنه يحمي الشركات الرأسمالية.
* محاكمة بوش
في عام 2006، مع تورّط القوات الأميركية في العراق، بدأت حملة أميركية لمحاكمة الرئيس بوش الابن. وانطلقت الحملة من فيرمونت، ولاية ساندرز. ولقد تحالف عُمد ومشرّعون في مدن صغيرة وريفية هناك، ووقّعوا على عريضة تطلب من الكونغرس محاكمة بوش، وخططوا لـ«حملات ريفية» مماثلة في ولايات أخرى. وأيّد ساندرز محاكمة بوش، لكنه قال إنها «مستحيلة» بسبب سيطرة الحزب الجمهوري على مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس. ولم تقتصر معارضات ساندرز على المسائل السياسية، بل ركز أكثر على مواضيع اقتصادية. فحتى قبل الكارثة الاقتصادية عام 2008، قاد من داخل الكونغرس حملات متواصلة ضد سيطرة الشركات العملاقة على الاقتصاد الأميركي. ووقف ضد تبرّعات الشركات للمرشحين السياسيين. وضد نقل الشركات مصانعها ومقراتها الرئيسة إلى خارج الولايات المتحدة. وضد ما اعتبره «حرب» الغرفة التجارية الأميركية (من رئاستها في واشنطن) على نقابات العمال.
وعام 2007، قبل الكارثة الاقتصادية بسنة واحدة، تنبأ بأن «الرأسمالية القبيحة» ستقود الولايات المتحدة والعالم إلى «الخراب»، حسب كلامه. ثم عارض منح قروض حكومية (بلغ إجماليها قرابة مليار دولار) للبنوك الأميركية التي أفلست أو كادت تفلس. وتساءل: «لماذا ينقذ دافع الضرائب الأميركي المسكين هذه البنوك العملاقة التي لا تخاف الله؟». كذلك صوّت ساندرز ضد تجديد فترة الآن غرينسبان، رئيس البنك المركزي الأميركي (الاحتياطي الفيدرالي)، كما صوّت ضد تعيين تيموثي غايتنر وزيرًا للخزانة، بحجة أنهما على حد قوله يمثلان «الرأسمالية القبيحة». وهنا نشير إلى أنه خطب ذات مرة لثماني ساعات متواصلة في مجلس الشيوخ ضد «الرأسمالية القبيحة»، وظل يفرق بين «الرأسمالية الإنسانية» و«الرأسمالية القبيحة».
* ساندرز الاشتراكي
وفي العام الماضي، في خطاب أمام طلاب جامعة جورجتاون، في العاصمة واشنطن، وصف ساندرز نفسه بأنه «اشتراكي ديمقراطي»، وأشاد بالأنظمة الاشتراكية الديمقراطية في الدول الإسكندنافية كالسويد والنرويج والدنمارك. وعندما سأله طالب: «عرّف لنا اشتراكيتك»، أجاب: «لا أريد أن تسيطر الحكومة على كل متجر وشركة، بل أريد أن أنصف الطبقة الوسطى التي تخوض، كل يوم، العمل الجاد والشاق، الذي هو سبب تطورنا وتقدمنا. أنا لا أريد إعلان حرب على الشركات الأميركية المتعددة الجنسيات. لكنني أريد منها أن تنصف الأميركيين. إنها تواصل تصدير المصانع إلى خارج أميركا، وتواصل التهرب من دفع الضرائب المستحقة إلى الخزانة الأميركية». ومن هذه المنطلقات صوّت ضد اتفاقيات «نافتا» (التجارة الحرة مع دول أميركا اللاتينية) و«كافتا» (مع الصين)، و«بانتا» (مع دول حوض المحيط الهادي). وقال إن الكونغرس فعل ذلك بسبب «ضغوط ورشى» قدمتها هذه الشركات. وتابع أن هذه الشركات تريد «استغلال شعوب العالم الثالث» و«تحويل المواطن الأميركي إلى مستهلك، بدلاً من أن يكون منتجًا».
وخلال سنواته في مجلس الشيوخ، قاد سن قوانين ليبرالية، منها «أوباما كير» (التأمين الصحي الشامل) و«ستيودنتز كير» (تخفيض عبء المصاريف الجامعية) و«ماريدج ديفنس» (الدفاع عن الزواج)، وفي المقابل، دافع عن حقوق المثليين والمثليات. وفي العام الماضي، عندما أعلنت المحكمة العليا دستورية زواج المثليين والمثليات، أيدها.
* ... واليهودي
على صعيد آخر، كما يسعى ساندرز لإقناع أميركا بفضائل الاشتراكية من دون أن يقول إنه اشتراكي، فإنه يؤيد إسرائيل تأييدًا قويًا من دون أن يقول إنه صهيوني، أو يركز على يهوديته.
وخلال الشهر الماضي، كتبت صحيفة «واشنطن بوست» تقريرًا قالت فيه إن ساندرز «لا يؤمن بالمؤسسات الدينية»، ويقول إنه «يهودي علماني»، وإنه «يؤمن بالله، لكن من دون واجبات دينية». ولاحقًا، قال في مقابلة على تلفزيون «إن بي سي»، ردًا على سؤال طرح عليه بهذا الشأن: «أنا هو ما أنا. لست متدينًا لكنني روحاني. روحانيتي هي أننا كلنا روحانيون. لكن، لا يكفي هذا، يجب أن نكون، أيضًا، روحانيين إنسانيين». وفي العام الماضي، عندما زار البابا فرانسيس، رأس الكنيسة الكاثوليكية، الولايات المتحدة رحّب به ساندرز، وقابله واشترك في مناقشات دينية. ومما قاله: «مشكلة الأديان المؤسسة هي أنها تدعو من دون أن تفعل، ولهذا تحولت إلى الروحانية الإنسانية التي لا تدعو لكنها تفعل».
وهكذا، يظل الموضوع الديني يواجه ساندرز في هذه الحملة الانتخابية. ويتوقع أن يقلل التأييد له في ولايات الجنوب (الأكثر تدينًا من ولايته التي اكتسحها في الأسبوع الماضي).
حتى الآن، لم يُثر موضوع يهوديته، وأنه، إذا فاز، سيكون أول رئيس أميركي يهودي. لكن، لا بد أن يثار الموضوع.