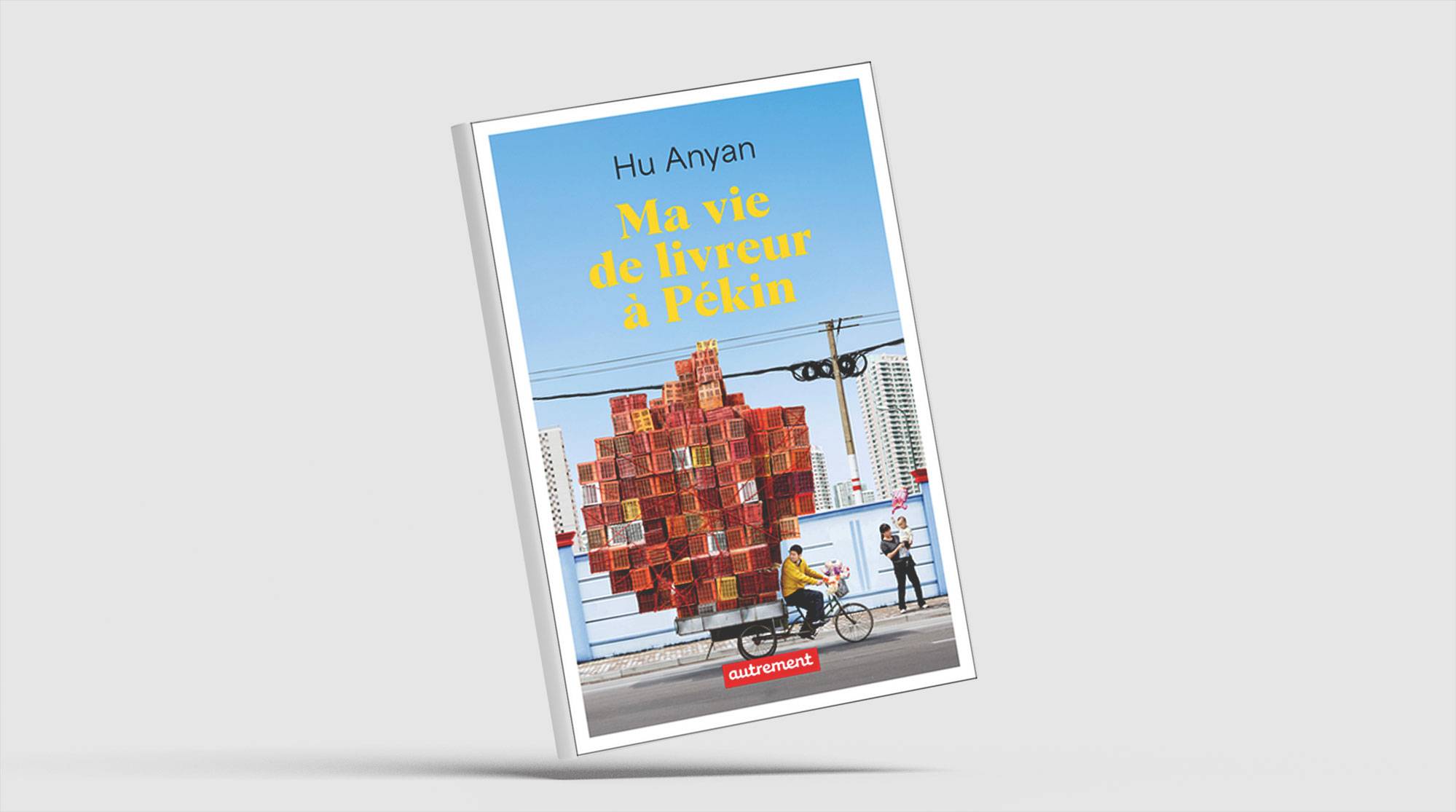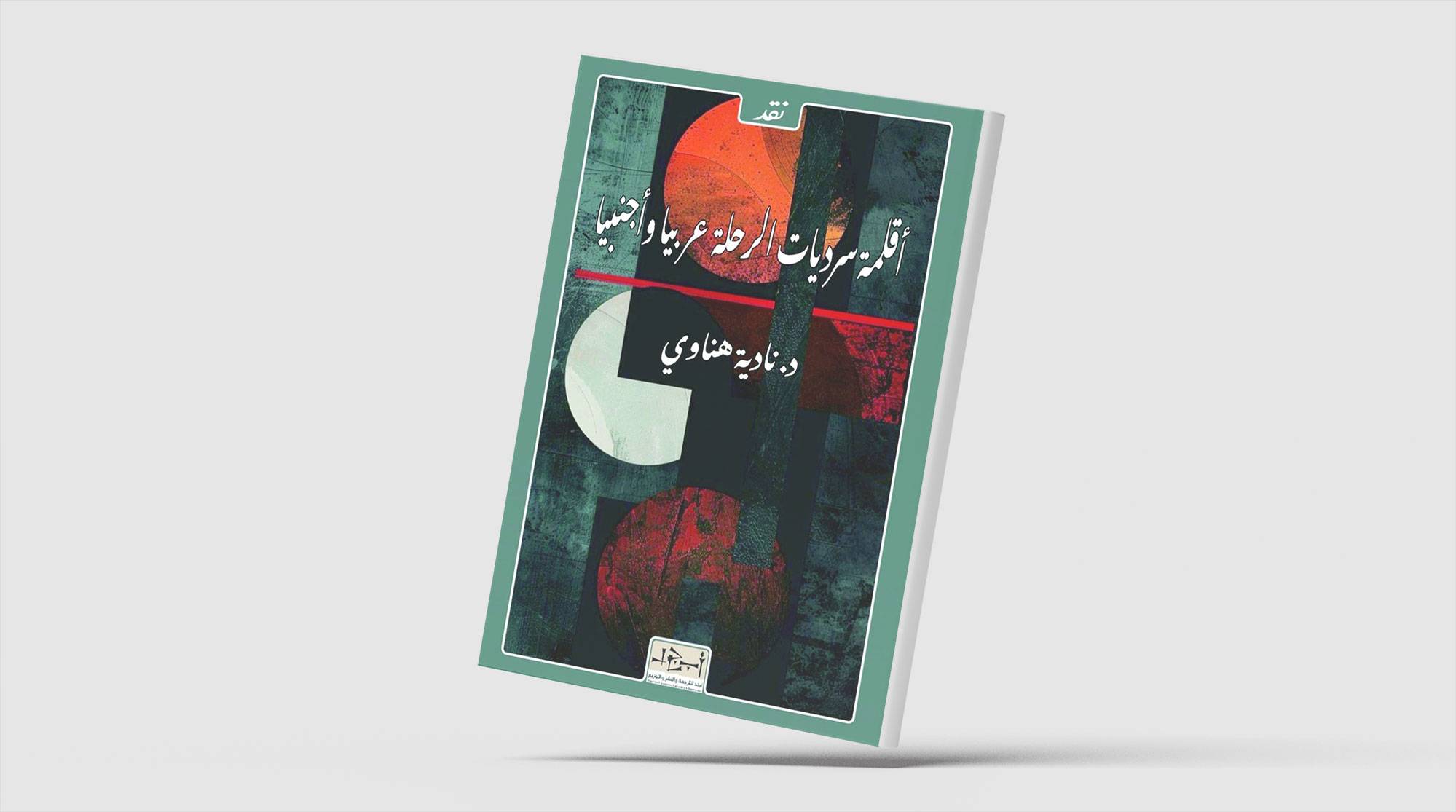تعرّف «الدولة» بكونها مجموع المؤسسات القانونية والإدارية والعسكرية التي يتم إنشاؤها، من لدن جماعة من الناس، بموجب عقد مشترك، لغرض تنظيم حياتهم في الميادين والمجالات كافة، كما تحيل إلى مجال ترابي محدد، وتمثل هذه المؤسسات جهازًا يشرف على المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية والعسكرية والاجتماعية. ومن ثم، فوجود الدولة رهين بتوفر مجموعة من الشروط الأساسية: الأرض، والسكان، والسلطة السياسية (القوانين، المؤسسات...)، وأن تعمل هذه الدولة على توفير وضمان الحقوق الأساسية لأفرادها (التعليم، الصحة، السكن والشغل...)، وحفظ الأمن والاستقرار. غير أن هذا الوجه الإيجابي للدولة قد لا يتجسد دائما على أرض الواقع، بل يمكن أن يصطدم فيه الأفراد بممارسات مخالفة لما هو مرجو من الدولة، فيكون الإنسان ضحية للعنف المنظم والظلم الاجتماعي والاقتصادي، والاستبداد الممارس من طرف الدولة نفسها. الأمر الذي يجعل مفهوم الدولة ينطوي على مفارقات فلسفية مهمة، إذ تتجاور فيه مفاهيم أخرى متقابلة وقيم متضادة (بين ادعائها لتحقيق الأمن وممارستها للعنف مثلا). من هنا، يمكن أن نطرح مجموعة من الإشكالات الفلسفية ونتساءل: ما الغاية من تأسيس الدولة؟ ومن أين تستمد مشروعيتها؟ وكيف جرى تبرير وجود الدولة من داخل تاريخ الفلسفة السياسية، الكلاسيكية والحديثة؟ وما الهدف من وجودها؟ هل هو تحقيق الأمن والاستقرار أم الهيمنة الطبقية واحتكار العنف؟
بالعودة إلى تاريخ الفلسفة اليونانية، نجد التفكير والاهتمام بالدولة حاضرًا لدى الفلاسفة اليونان. فقد حاول كل من أفلاطون وأرسطو التنظير لدولة مثالية قادرة على تجسيد الخير الأسمى. وفي هذا الصدد، نجد أفلاطون الذي دافع عن أن أساس الدولة الطبيعي يتجسد في وجود لا مساواة طبيعية بين الناس. فكما تنقسم النفس إلى ثلاث: نفس شهوانية، ونفس غضبية، ونفس عاقلة، ينقسم كذلك أفراد النوع الإنساني إلى فئات ثلاث: حرفيون وجنود وحكام. وما دامت وظيفة النفس العاقلة هي توجيه عمل النفس الشهوانية والنفس الغضبية بالشكل الذي يضمن الانسجام والتناغم في حياة الفرد، فإن وظيفة الحكام هي تدبير شؤون الحرفيين والجنود، وتوجيه عملهم نحو تحقيق الانسجام والتناغم في حياة الجماعة التي ينتمون إليها. فالعدالة كما يقول أفلاطون، في كتاب «الجمهورية»: «هي أن يؤدي كل فرد وظيفة واحدة هي تلك التي وهبته الطبيعة خير قدرة على أدائها». إن غاية الدولة عند أفلاطون هي تحقيق الانسجام والتناغم بين مكونات المجتمع. وهو تناغم لا يتحقق إلا بانصراف كل فئة إلى أداء المهمة التي هيأتها الطبيعة للقيام بها من دون التدخل في مهام الفئات الأخرى. فمن هيأته الطبيعة أن يكون حرفيًا، وزودته بما يلزم ذلك من مهارات وقدرات، فلا مفر له من أن يكون كذلك، وينجز ما يلزم من المهن والصنائع، ومن هيأته أن يكون محاربًا، فعليه أن يحمل السلاح ويقف بشجاعة ضد كل خطر يمكن أن يهدد المدينة/ الدولة Polis. ومن هيأته أن يكون حاكمًا، فعليه أن يتجه لتدبير شؤون الناس بفضيلة وحكمة وعدل. وهكذا نرى أن غاية الدولة ومشروعية وجودها تستمدها من الطبيعة البشرية، فهي من الأمور الطبيعية التي رافقت وجود البشرية التي تكون دائمًا في حاجة إلى من ينظمها.
في السياق نفسه، نجد الفيلسوف أرسطو، الذي ظل وفيًا لأفكار أفلاطون، على الرغم من بعض الانتقادات التي وجهها إلى فكره السياسي، فأرسطو أيضًا يؤكد على فكرة التراتبية واللامساواة الطبيعية بين الناس. بل يذهب أرسطو إلى أن هذا التراتب مقصود من طرف الطبيعة نفسها، التي «لا تفعل باطلا أبدًا». فكون الناس مختلفين ومتمايزين على مستوى المهارات والقدرات، يجعلهم في حاجة إلى بعضهم البعض، وبالضرورة ميالين إلى الألفة والاجتماع، لأن لا أحد منهم يستطيع أن يوفر بنفسه كل ما يحتاج إليه. لذلك كان الإنسان، حسب أرسطو، كائنًا مدنيًا بطبعه، أي كائنًا لا يستقيم وجوده إلا في مجتمع يتقاسم أفراده المهام والوظائف. وبهذا المعنى أيضًا، كانت الدولة من الأمور الطبيعية، أي من الأمور التي يقتضيها تحقيق الحاجات الطبيعية للإنسان، التي دونها لا يمكن أبدًا أن يتحقق. إن غاية الدولة عند أرسطو هي تحقيق الخير الأسمى، وهو سعادة الأفراد المكونين لها عبر تحقيق حاجاتهم الطبيعية من غذاء وسكن وأمن. بعد التحولات التي عرفتها أوروبا مع مطلع العصر الحديث، وبتأثير من الحركة الإنسية والتطورات الهائلة في مجال الفن والعلوم والعمارة، واكتشاف كروية الأرض، وعقم المنهج الأرسطي الذي قامت عليه المؤسسة الآمرة والحاكمة في أوروبا، وهي الكنيسة، سيستعيد التفكير في مفهوم الدولة أهميته، باعتباره موضوعا للتفكير الفلسفي والسياسي، حيث خاض رواد النهضة والتنوير، صراعا ضد النظرية الثيوقراطية، أو ما يسمى بنظرية الحق الإلهي، التي تفسر نشوء الدولة بفكرة دينية أو ما سمي بـ«حق الملوك المقدس». وتقوم هذه النظرية، على ضرورة تأليه الحاكم وعبادته وتقديسه، ولنا في مصر القديمة وروما مثال على ذلك. وستعرف هذه النظرية تطورًا على يد ملوك أوروبا في المرحلة الإقطاعية، إذ لم يعد ينظر للملك على أنه إله، بل إنه خليفة الله في الأرض. وهكذا رفض رواد النهضة الوصاية على الإنسان واعتباره قاصرًا يحتاج لمن يقوده ويملي عليه كيف يسلك ويتصرف. وفي هذا السياق، فكر أصحاب نظرية العقد الاجتماعي، أو المصنفين ضمنها، في مفهوم الدولة (هوبز/ لوك/ روسو)، حيث يرى أصحاب نظرية العقد الاجتماعي ويفترضون أن مشروعية الدولة وغايتها، تستمدهما من حالة الطبيعة التي كان الأفراد فيها يعيشون على الفطرة، أحرارا من دون أن يوجد ما يحد من حريتهم. لكن هذا النوع من الحرية أدى للفوضى والاضطراب. وهو ما جعلهم يفكرون في وسيلة للخروج من حياة الاضطراب والتطاحن، يعني أنهم فكروا في تأسيس حياة يسودها التنظيم والتوافق، فكانت الوسيلة هي العقد الاجتماعي كأساس للدولة التي يتنازلون لها عن جزء من حريتهم وحقوقهم. وعلى الرغم من أن رواد العقد الاجتماعي اتفقوا على تعريف العقد الاجتماعي وفرضية حالة الطبيعة، إلا أنهم يختلفون حول طبيعة العقد ومبرراته وغاية الدولة الناشئة، وكذلك حول تصورهم لحالة الطبيعة. فمثلا طوماس هوبز، يرى أن ظهور الدولة لم يكن طبيعيًا، بل هو «الثمرة الاصطناعية التي جاءت نتيجة ميثاق إرادي، ولحساب مصلحي»، لأن حالة الطبيعة هي حالة عنف وجور وتدمير وميل نحو الشر، الذي اعتبره هوبز، ميلاً طبيعيًا في الإنسان. فالإنسان لديه ميل طبيعي نحو العدوان والقوة. وهو ما يجعل الضعفاء ضحية لهذا المنطق. فحالة الطبيعة تطبعها الفوضى والعنف، «حرب الكل ضد الكل»، ما يحول دون قيام حياة اجتماعية آمنة ومستقرة. فيجد الإنسان نفسه أمام فقدان أهم ما لديه، وهو «البقاء على قيد الحياة». لذلك فكر الناس في بناء مجتمع سياسي يضع حدًا للحروب والعدوان والجور والظلم والتسلط، يستبدل بالعنف التكامل والتعاون. لذلك فكر المكونون للعقد بالتنازل عن كل سلطتهم وحقوقهم، لصالح رئيسهم/ راعيهم/ ملكهم، الذي سيتمتع بالسلطة المطلقة، لأنه لم يكن طرفًا في العقد وليس خاضعًا لأحد. وهكذا كانت الدولة هي التنظيم الجديد الذي قام من أجل ضمان أمنهم وتأمين سلامتهم. وفي هذا الصدد يقول هوبز، في كتابه «اللفيتان»، في النهاية، إن الدافع والهدف عند الذي يتخلى عن حقه أو يحوله، ليس إلا أمنه الشخصي في حياته وفي وسائل حفظ هذا الأمن».
إذا كانت غاية الدولة ومشروعيتها عند هوبز تستمدهما من ضمانها لأمن الناس وسلامتهم، نتيجة العقد الذي أقاموه وسلموا فيه كل حقوقهم لمن يجب طاعته والخضوع له، فإن جان جاك روسو، لم ير في الدولة أداة محافظة على أمن الناس وسلامتهم فقط، بل إن الدولة ليست غايتها الحفاظ على الأمن، بل غايتها بناء حياة اجتماعية، وتكوين مجتمع سياسي تقوم فيه الدولة بالمحافظة على حقوق الأفراد. فالدولة لا تقوم على احتكار الحاكم للسلط، بل على التعاون والتشارك والسيادة المطلقة للشعب عن طريق الإرادة العامة التي يعبر عنها في القوانين. وبالتالي تكون وظيفتها هي الحفاظ على حقوق المواطنين الذين لا يخضعون للحاكم داخل الدولة، بل يخضعون لسلطة القوانين التي ساهموا في وضعها. فالسيادة دائمة للشعب، وهذا ما يقصده روسو بقوله: «إن من يهب نفسه للجميع لا يهب نفسه لأحد»، فالدولة ليست كما تصور أصحاب النظرية الثيوقراطية أو هوبز متعالية على الإنسان بل هي وسيلة ضرورية لتحقيق أماني الإنسان ومطامحه، فهي توفر النظام والنفوذ الذي يحمي كل فرد من ظلم فرد آخر، إن مشروعية الدولة لا تستمدها عند روسو فقط من حالة الطبيعة، بل حالة الطبيعة حسب روسو هي حالة خيّرة، حالة سلم ووئام.
أما بالنسبة لاسبينوزا، فقد فكر في الدولة من منظور علماني مستفيدا من الصراع الديني الطاحن بين الكاثوليك والبروتستانت. فدافع عن دولة لا تنحصر وظيفتها في السيادة والتنظيم والتحكم، كما ذهب إلى ذلك هوبز. بل غاية الدولة عند اسبينوزا، تستمدها من قدرتها على تحرير الناس من الخوف، والعنف، والإرهاب الذي قد يمارسه المختلفون في التصورات والآراء والمعتقدات على بعضهم البعض بالقوة والعنف والإكراه. فالدولة حسب اسبينوزا، لا يجب أن تنحصر وظائفها في تطويع الناس والتحكم بهم، بل غايتها أسمى من ذلك، وهي تحرير أجسادهم وعقولهم لكي يفكروا بشكل حر في كل القضايا، استنادا إلى الحجج العقلانية وليس بالأسلحة والإرهاب والخوف. وفي هذا السياق يؤكد اسبينوزا، بعد أن حدد غاية الدولة، أن مشروعيتها يجب أن تنبع من مجموع الأفراد المكونين لها، الذين يكونون غير قادرين إن تركوا لذواتهم، على تدبير اختلافاتهم بالعقل والنقاش بعيدا عن الإكراه والقوة. لذلك، فإن قيام الدولة نابع من عدم قدرة المختلفين في الرأي والمعتقد، على تدبير اختلافاتهم، ودورها يتجسد في حماية الاختلاف والعمل على تكريسه. إن القيمة التاريخية لتصور اسبينوزا، تكمن في كونه غيّر من تصورنا للدولة، باعتبارها دولة سيادة وعنف مشروع إلى دولة راعية للاختلاف والحرية. وبالتالي، طالب اسبينوزا بضرورة فصل مجال الدولة على مجال الدين. فالدولة لا تدافع عن مذهب ديني ضد آخر. إنها تقف موقفا واحدا من جميع الأديان والمعتقدات، وتعمل على حماية الجميع، ورفض العنف. وفي هذا الصدد، يقول اسبينوزا: «إن الغاية من تأسيس الدولة ليس تحويل الموجودات العاقلة إلى حيوانات وآلات صماء، بل المقصود منها هو إتاحة الفرصة لأبدانهم وأذهانهم كي تقوم بوظائفها كاملة في أمان تام، بحيث يتسنى لهم أن يستخدموا عقولهم استخدامًا حرًا، من دون إشهار لأسلحة الحقد والغضب أو الخداع، وبحيث يتعاملون معًا دون ظلم أو إجحاف، فالحرية إذن هي الغاية الحقيقية من قيام الدولة».
مشروعية الدولة وغايتها بين الفكر السياسي.. الكلاسيكي والحداثي
ينطوي مفهومها على مفارقات فلسفية مهمة


مشروعية الدولة وغايتها بين الفكر السياسي.. الكلاسيكي والحداثي

لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة