منذ البداية يمكن القول إن النزعة الإنسانية هي تلك الفلسفة التي تضع الإنسان والقيم الإنسانية فوق كل شيء. إنها النزعة التي تثق بالإنسان وتتفاءل بإمكانياته وإنه قادر على صنع التقدم الحضاري. وقد نشأت هذه الحركة الثقافية في إيطاليا أولا في القرن الرابع عشر. ثم انتشرت من هناك إلى بقية أنحاء أوروبا وبلغت ذروتها في القرن السادس عشر: عصر النهضة بامتياز. وهي تعتبر الإنسان أجمل الكائنات وأفضلها وأرقاها وتثق به وبمستقبله كل الثقة. عندئذ عاد المفكرون الأوروبيون إلى النصوص اليونانية - الرومانية التي كانوا قد نسوها أو أهملوها طيلة العصور الوسطى المظلمة الكارهة للفلسفة والثقافة والمفعمة «بالجهل المقدس المسيحي». لقد عادوا فيما وراء المسيحية أو ما قبلها إلى اكتشاف نصوص أفلاطون وأرسطو وهوميروس وفيرجيل وشيشرون وسواهم كثيرون. ومن أهم المفكرين والشعراء النهضويين ذوي النزعة الإنسانية نذكر بتيرارك، وبيك الميراندولي الذي كان معجبا جدا بالعرب ويعتبرهم قدوة ومثالا، هذا بالإضافة إلى مارسيل فيشان، وإيراسموس الذي لقبوه بأمير عصر النهضة.
لقد ضاق كل هؤلاء ذرعا برجال الدين ومواعظهم وأفكارهم التقليدية المكرورة منذ مئات السنين. وشعروا بالاختناق في ذلك الجو المغلق للعصور الوسطى حيث لا توجد إلا اليقينيات القطعية والتعاليم اللاهوتية المفروضة عليك فرضا من فوق وعن طريق الإكراه والقسر. ولذلك راحوا يقفزون على كل العصور الوسطى التي تبلغ الألف سنة لكي يعودوا إلى أجواء اليونان والرومان حيث كانت الحرية متوافرة. وهكذا راحوا يترجمون كبار كتاب اليونان إلى اللغة اللاتينية أو اللغات القومية الأوروبية التي كانت في طور الانبثاق آنئذ: كالإيطالية، والفرنسية، والإنجليزية، والألمانية، إلخ.
ينبغي العلم أنهم أثناء العصور الوسطى كانوا يتحدثون عن الآداب الإنسانية- والآداب الإلهية. وكانوا يقصدون بالأولى مجمل المعارف الدنيوية التي يدرسونها للطلاب في كليات الفنون والبلاغة. وأما الثانية فكانوا يدرسونها في كليات اللاهوت المسيحي حيث يهتمون بالدين والإنجيل وشرحه والتعليق عليه. وكانت الدراسات اللاهوتية تهيمن على الدراسات الإنسانية بشكل واضح طيلة العصور الوسطى. وذلك لأن العلوم الإلهية أشرف من العلوم الإنسانية وأجل شأنا. وكانت الفلسفة تعتبر بمثابة خادمة طيعة لعلم اللاهوت المسيحي. وكان كلام رجال الدين شبه معصوم ولا يناقش وإنما يطاع فقط. ثم ابتدأت الأمور تتغير بدءا من القرن الرابع عشر حيث ظهر بتيرارك وتجرأ على إبداء إعجابه بالكُتاب «الوثنيين» السابقين على المسيحية. يا للفضيحة! ثم تلاه آخرون كثيرون ومشوا على نفس الخط. وبرر هؤلاء أخذهم عن فلاسفة اليونان والرومان بأن كتبهم تحتوي على الحكمة والعلم والعقلانية الصائبة على الرغم من وثنيتها. وبالتالي فيجوز الأخذ عنهم دون أن نتخلى عن الإيمان. وهذا هو موقف الفيلسوف العربي الأول الكندي الذي كان قبلهم بسبعة قرون تقريبا! ألم نقل لكم إن الأنوار العربية سبقت الأنوار الأوروبية وأثرت عليها؟
ولكن رجال الدين انزعجوا من هذا التصرف واعتبروه خروجا على المسيحية. وقالوا إن الحكمة لا توجد إلا في الكتب الدينية. وهكذا جرت معركة بين الطرفين استمرت عدة قرون حتى انتصار الحداثة.
لقد وضع هؤلاء الفلاسفة النهضويون والإنسانيون الإنسان في مركز كل اهتمام أو تساؤل. وقالوا إن كل معرفة لا تهدف إلى الرفع من شأن الإنسان لا جدوى منها ولا لزوم لها. وراحوا يحلمون ببناء مجتمع يختلف عن مجتمع القرون الوسطى المستكين لأقوال الكهنة والمستسلم للمقادير والظروف. راحوا يحلمون بتثقيف الإنسان وتهذيبه لكي يصبح عقلانيا ذكيا معتمدا على نفسه وإمكانياته لا متواكلا ولا كسولا. وقالوا إن التوصل إلى ذلك لا يمكن أن يتم من خلال الاعتماد على الكتب الصفراء لرجال الدين المسيحيين وإنما من خلال كتب كبار شعراء وفلاسفة اليونان والرومان.
على هذا النحو انطلقت الحركة الإنسانية قوية فاتحة. وكان من أهم ممثليها على مستوى أوروبا كلها: إيراسموس، خوان لويس فيفيس، غيوم بوديه، جاك لوفيفر ديتابل، لورنزو فالا، وآخرون كثيرون. وبفضل المطبعة الآلية التي ظهرت في ذلك الوقت راحت كتب هؤلاء المفكرين الإنسانيين تنتشر في كل الأوساط بسرعة البرق. ففي السابق كان نسخ الكتاب الواحد بخط اليد يستغرق أسابيع كثيرة أو حتى شهورا. وأما الآن فقد أصبحت طباعته وبمئات النسخ تتم بين عشية وضحاها... هنا نكتشف أهمية التكنولوجيا. فاختراع المطبعة آنذاك لا يقل خطورة وأهمية عن ظهور الإنترنت وثورة المعلوماتية حاليا.
وكل ذلك ساهم في انتشار الأفكار الجديدة لعصر النهضة والإصلاح الديني في آن معا. ولذلك قال أحدهم: لولا غوتنبرغ لما كان لوثر! المقصود لولا المطبعة لما نجح الإصلاح الديني. فهي التي أتاحت انتشار كتب لوثر البركانية الرائعة في كل أنحاء ألمانيا كانتشار النار في الهشيم. وهكذا فجر البابوية تفجيرا وأحدث زلزالا في القارة الأوروبية كلها.
ولحسن حظ هؤلاء الفلاسفة الجسورين فإن الأمراء الإيطاليين راحوا يدعمونهم معنويا ويغدقون عليهم ماديا. بل وحموهم من ضغط الكنيسة والعامة والمتعصبين دينيا. هذا ما فعله أمراء مدينة فلورنسا التي أنجبت أشهر الرسامين والفنانين والعلماء والفلاسفة.
فبفضل مساعدتهم راح المفكر مارسيل فيشان يترجم مؤلفات أفلاطون وتلامذته. وقد تشكلت أول أكاديمية علمية في مدينة فلورنسا. وكان من حسن حظها أن هاجر إليها كبار علماء بيزنطة بعد سقوط القسطنطينية على يد محمد الفاتح.
ولكن هذه الأكاديمية تعصبت لفكر أفلاطون إلى حد أنها منعت تدريس فكر أرسطو الذي دخل إلى إيطاليا عن طريق العرب: أي عن طريق فلسفة ابن سينا وابن رشد بشكل خاص.
ومعلوم أن فلسفة أفلاطون مثالية خيالية، في حين أن فلسفة تلميذه أرسطو واقعية مادية. ويمكن القول بأن كل تاريخ الفكر البشري منذ ذلك الوقت وحتى اليوم مقسوم إلى قسمين: قسم مثالي وقسم واقعي، قسم يتبع أفلاطون وقسم يتبع أرسطو. فبعض فلاسفة الإسلام مثلا يقعون في جهة أفلاطون، ولكن ابن رشد يقع في جهة أرسطو، وهلم جرا.
وبعدئذ انتشرت الفلسفة ذات النزعة الإنسانية في ألمانيا وهولندا قادمة من إيطاليا ثم دخلت إلى فرنسا. وعندما عارض رجال الدين دخول الفكر العربي الفلسفي بحجة أنه آت من جهة أعداء المسيحية و«الكفار» قال لهم فلاسفة النهضة: هذا الفكر يشكل جزءًا لا يتجزأ من ميراث البشرية والإنسانية. ونحن بحاجة إليه وسوف نأخذ به ونستفيد منه أيا تكن الجهة التي جاء منها.
ثم ظهر تيار جديد لدى العلماء من رجال الدين وهو ما يمكن أن ندعوه بالنزعة الإنسانية المتدينة: أي تلك التي توفق بين الكتابات المقدسة من جهة، وكتابات أدباء اليونان والرومان وفلاسفتهم من جهة أخرى. ويمكن اعتبار المفكر الهولندي إيراسموس أكبر مثال على هذا النوع. وكذلك المفكر الإنجليزي توماس مور. وبالتالي فالنزعة الإنسانية ليست كلها إلحادية. بل إن التيار المؤمن كان هو الغالب عليها في ذلك الزمان. الإلحاد لم ينتصر إلا لاحقا في القرنين التاسع عشر والعشرين.
ولكن حروب المذاهب داخل المسيحية بين الكاثوليكيين والبروتستانتيين وكل المجازر التي رافقتها وضعت حدا للنزعة الإنسانية المتفائلة جدا بنوايا الإنسان وإمكانياته. فقد كشف الإنسان عن وجهه القبيح أثناء تلك الحروب المذهبية المدمرة وبدا أنه قادر على ارتكاب أبشع الأعمال والمجازر. وهذه هي حالة العالم العربي اليوم. وبالتالي فما عاشوه هم سابقا نعيشه نحن حاليا. وهنا يكمن التفاوت التاريخي بين المجتمعات الأوروبية المستنيرة - والمجتمعات الإسلامية التي لم تستنر بعد إلا في شرائح ضيقة.
ثم طرأ تحول على مفهوم النزعة الإنسانية وأصبح أكثر واقعية إن لم يكن أكثر تشاؤما. وهذا ما يتجلى في كتابات الفيلسوف الفرنسي مونتيني (1533 - 1592) الذي صور الإنسان كما هو عليه لا كما نحلم أن يكون. فالإنسان المثالي الذي يترفع على الصغائر ولا يفعل إلا الخير لم يعد له وجود لديه. وإنما بدا الإنسان على حقيقته بخيره وشره، بعجره وبجره. فبقدر ما هو قادر على صنع المعجزات وتحقيق التقدم، بقدر ما هو قادر على ارتكاب أكبر المجازر والحماقات في حق أخيه الإنسان إذا ما اختلف عنه في العقيدة أو المذهب.
وعندئذ ابتدأت تظهر نزعة إنسانية معادية للدين كرد فعل على حروب المذاهب والطوائف المسيحية وما رافقها من فظائع ومجازر. وقال بعض المفكرين: إذا كان اللاهوت المسيحي يسمح بارتكاب كل هذه المجازر الدموية بين أبناء الدين الواحد فلا حاجة لنا به! ولكن البعض الآخر ركز فقط على مسؤولية رجال الدين المتعصبين وليس على الدين ذاته. وقالوا بأن الأصوليين التكفيريين فهموا الدين بشكل خطأ وحرفوه عن مساره الصحيح. ومعلوم أن الكاثوليكيين البابويين كانوا هم الأغلبية ولذا كانوا يكفرون البروتستانتيين وبقية المذاهب المسيحية ويستبيحون دماءهم تماما كما يفعل «داعش» الآن. ثم واصلت الحركة الفلسفية الإنسانية مسيرتها إلى الأمام في القرون التالية وولدت الفلسفة الكانطية في القرن الثامن عشر. وهي أكبر فلسفة نقدية تكشف عن إمكانيات العقل البشري ومحدوديته في آن معا. وقد أكدت الفلسفة الكانطية عندئذ على كونية الجنس البشري ووحدته وقالت بأن الإنسان قادر على صنع التقدم: أي الخروج من مرحلة الأصولية والتخلف إلى مرحلة الحضارة والاستنارة وتحسين الأوضاع المعيشية على هذه الأرض. ثم استمرت الحركة الإنسانية بعدئذ حتى ولدت الإعلان الشهير لحقوق الإنسان والمواطن بعد الثورة الفرنسية.
كيف نشأت النزعة الإنسانية في الفكر الأوروبي؟
العودة إلى التراث الأغريقي والروماني ساهمت في ذلك
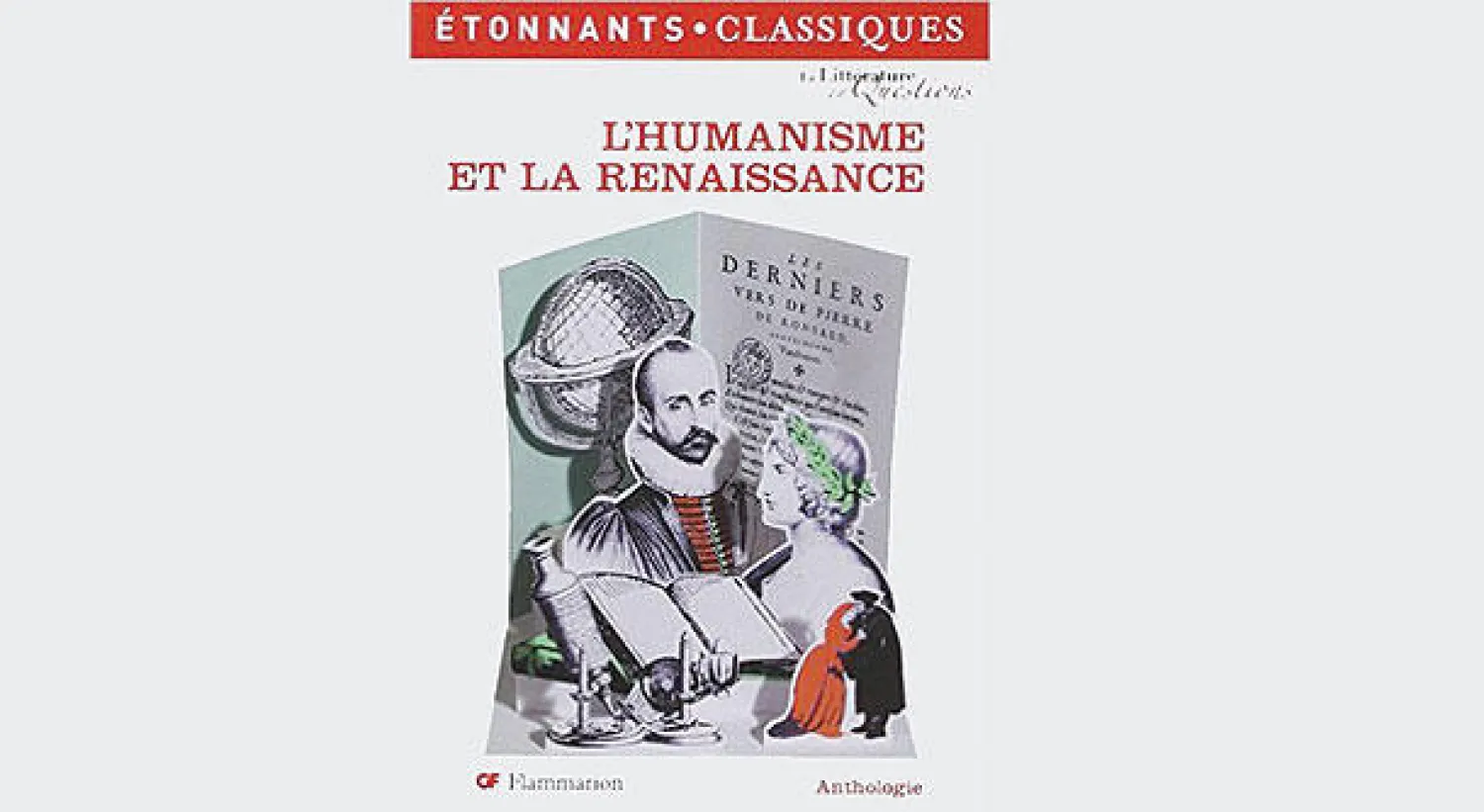
غلاف الكتاب

كيف نشأت النزعة الإنسانية في الفكر الأوروبي؟
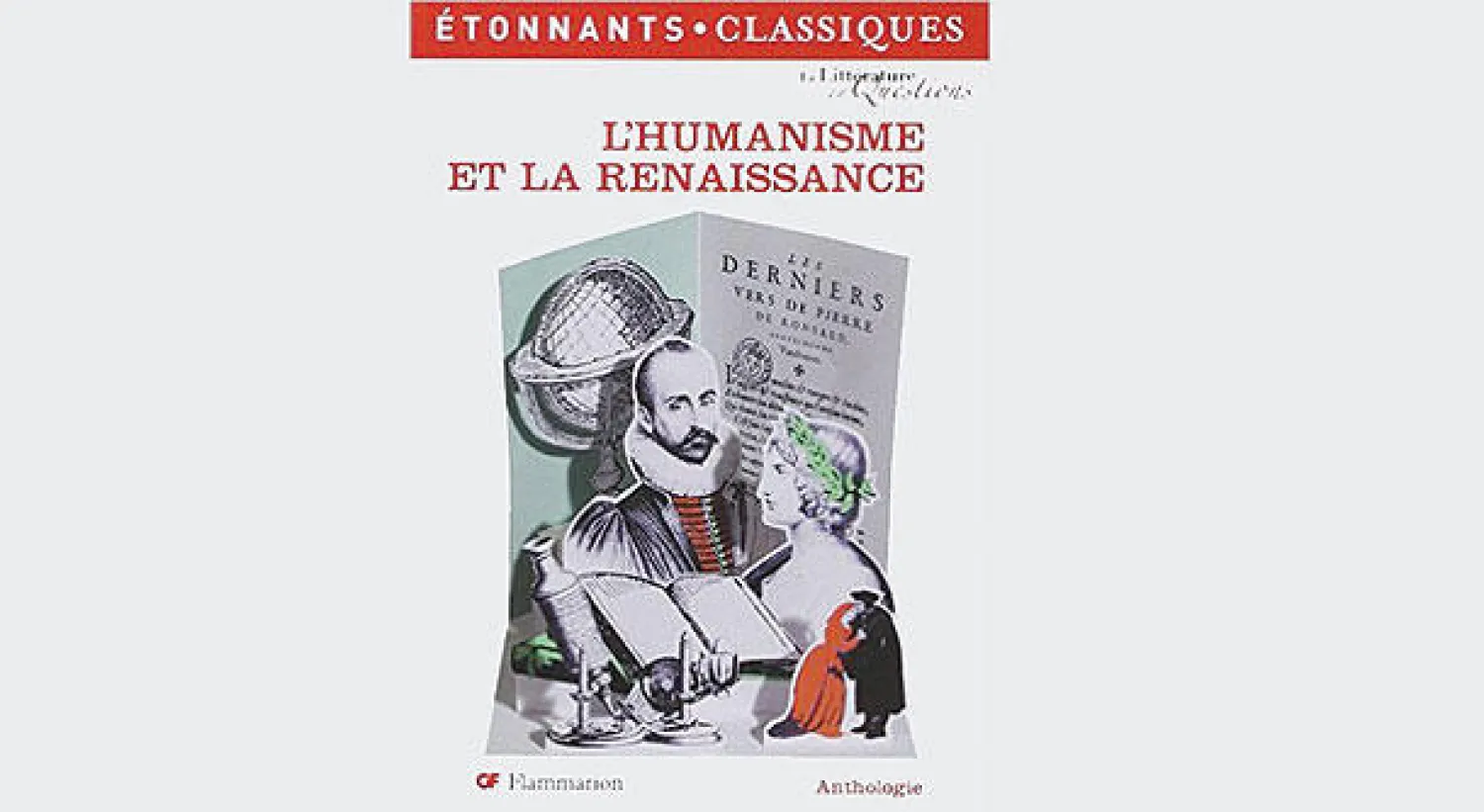
غلاف الكتاب
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة









