لا أظن أن الناقد الأدبي والمنظر الثقافي البريطاني تيري إيغلتون (Terry Eagleton) يمكن أن يهدأ يوماً أو يركن لراحة موهومة بالنسبة إلى المشتغل في حقل الدراسات الثقافية. لم تمر سنة خلال العقد الماضي وحتى يومنا هذا؛ إلا كان له فيها كتاب منشور في موضوعة ثقافية دسمة، ويبدو أن مشروعه المشترك مع جامعة ييل الأميركية المرموقة صار علامة مميزة في حقل الدراسات الثقافية الراهنة.
إيغلتون ماكينة عمل لا تهدأ، يقودها شغفٌ لا حدود لمدياته. أتخيل أحياناً أن إيغلتون يمكنُ أن يعبر شارعاً ويرى قطة على الرصيف، وحينها سيعمل عقله لحظياً على تحويل هذا المشهد الساكن الذي قد لا يثير شيئاً لدى آخرين إلى موضوعة ثقافية كاملة. دعونا نتأمل بعض عناوين كتب إيغلتون التي نشرها خلال السنوات العشر الماضية أو نحو ذلك، وسنرى المديات الشاسعة لمنطقة اشتغال إيغلتون في تضاريس الفكر الإنساني:
«الحدث الأدبي» 2012 (ترجم إلى العربية)، و«عَبْرَ البركة» 2013، و«كيف نقرأ الأدب» 2013 (ترجم إلى العربية)، و«أملٌ من غير تفاؤل» 2015، و«الثقافة» 2016، و«المادية» 2017 (ترجم إلى العربية)، و«تضحية راديكالية» 2018 (ترجم إلى العربية)، و«الفكاهة» 2019 (ترجم إلى العربية)، و«المأساة» 2020.
أحدث كتب إيغلتون في هذه السلسلة المبهرة من الكتب؛ التي تتجاوز الثيمات الأدبية إلى فلسفات الأفكار، هو كتابه الذي اختار عبارة «ثوريون نُقاد (Critical Revolutionaries)» لتكون عنواناً رئيسياً طافحاً بروح الثورة الفكرية التي تشتعل جذوتها في عقله ولم تهدأ منذ بواكيره الأولى، ثم جاء العنوان الثانوي «خمسة نقادٍ غيروا الطريقة التي نقرأ بها» ليكشف عن جوهر مسعى إيغلتون في هذا الكتاب. الكتاب منشور في شهر أبريل (نيسان) 2022 عن مطبعة جامعة ييل الأميركية.
اعتمد إيغلتون في هذا الكتاب مقاربة غاية في البساطة: مقدمة مع 5 فصول، كل فصل معنونٌ باسم الناقد مدار البحث. ربما تكون مقدمة إيغلتون التي امتدت على 8 صفحات هي العلامة الفارقة في هذا الكتاب عن سابقيه؛ فقد عُرِف عن إيغلتون مقدماتُهُ المقتضبة. النقاد الخمسة الذين تناولهم إيغلتون بدراسته (أو باستذكاره النوستالجي إذا شئنا الدقة) هم: تي إس إليوت، آي أي ريتشاردز، ويليام إمبسون، إف آر ليفز، رايموند ويليامز. اختتم إيغلتون كتابه بحشدٍ مكثف من الهوامش التوضيحية التي تلقي أضواء كاشفة على حيثيات مخصوصة.
وأنا أقرأ هذا الكتاب في نسخته الإنجليزية تحسستُ في غير موضع النبرة النوستالجية التي تعتمل في روح إيغلتون، بل وحتى - ربما - بعض الشعور بالذنب لما آل إليه وضع النقد الأدبي المعاصر، ونكادُ نلمحُ هذه الحقيقة من السطور الأولى للتقديم: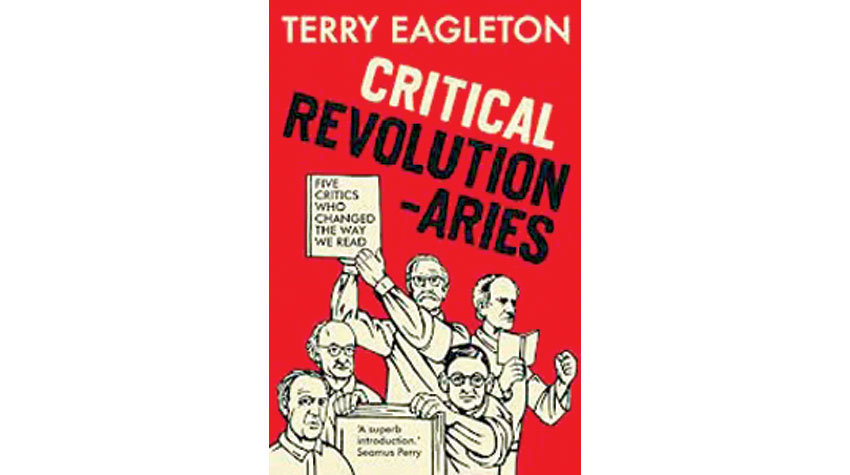
«القناعة التي ينطوي عليها هذا الكتابُ هي أن تقليداً حيوياً في النقد الأدبي بات يتهدده خطرُ الإهمال. يصح هذا الأمر - وإن كان إلى حدود معينة - في الحقل الأكاديمي مثلما يصح في نطاقات أوسع بكثير في العالم الأدبي. لستُ أرى سوى قليلين من طلبة الأدب اليوم يتوفرون على معرفة رصينة بعمل آي أي ريتشاردز على سبيل المثال، وربما يصح الأمر ذاته على أساتذتهم!!؛ لكن رغم ذلك؛ فإن النقاد الخمسة الذين أتناولهم بالدراسة في هذا الكتاب يُعدون بين النقاد الأدبيين الأكثر أصالة وتأثيراً في العصر الحديث، وهذا سبب أراه كافياً لكي يكونوا هم، وليس سواهم، بين خياراتي المفضلة للدراسة...».
يؤكد إيغلتون في موضع آخر من التقديم أن هؤلاء النقاد الخمسة يمثلون هيكلاً فكرياً ذا خصوصية مميزة تُعدّ أحد معالم القرن العشرين الأدبية المتفردة؛ فقد كانوا جميعاً - باستثناء إليوت - أساتذة في قلعة كامبردج الأدبية الراسخة، وكانوا جزءاً من ثورة نقدية نقلت الدراسة الأكاديمية للأدب إلى مستوى جديد غير مسبوق.
لستُ أعتزمُ هنا الحديث عن تفصيلات محددة في أطروحة إيغلتون في هذا الكتاب، بل إننا إذا استثنينا الأطروحة النوستالجية فلا جديد في هذا الكتاب؛ لكن ثمة دوماً نمطٌ من الانشداد الفكري لما يكتب إيغلتون حتى لو كان في موضوعات تبدو بديهية ومكرورة. يلمحُ القارئ في هذا الكتاب استكمالاً لرؤية إيغلتون في نقد أطروحات ما بعد الحداثة، وهو ما بدأه في كتابه «أوهام ما بعد الحداثة» واستكمله لاحقاً في كتاب «ما بعد النظرية»، والكتابان مترجمان إلى العربية.
أرى أن من الأسئلة الجوهرية التي يطرحها كتاب إيغلتون هو موضوعة الانعطافة الكبرى التي حصلت في خريطة النقد الأدبي المعاصر وتحوله من مبحث أدبي قائم بذاته إلى تيار في حقل ما تسمى «الدراسات الثقافية (Cultural Studies)». هل يمكن أن نرى في عصرنا هذا إليوت معاصراً؟ لا أظن ذلك؛ لأسباب كثيرة ثقافية وأكاديمية وحتى دينية!! لو أجرينا مسحاً سريعاً لخريطة النقد الأدبي العالمي لرأينا أنه بات مدفوعاً بعوامل «فكرية وبراغماتية» صارت تعمل على إعادة تشكيل خريطته الفكرية:
أولاً: تتمظهر العوامل الفكرية في تنامي مفهوم الدراسات النسقية العامة أو الشاملة (Generalized Systems Studies) في عموم المعرفة الإنسانية سواء أكانت علمية أم أدبية. هل نتخيلُ، على سبيل المثال، أن بمستطاع كائن مَنْ كان قبل عشر سنوات أن يصرح في حوارية منشورة له بأن «الأدب ينبغي أن يدرس مثل العلم، وأن الأدب آلة ترتقي بدينامية تطور الدماغ البشري»**؟ هل يمكن لأحد هؤلاء النقاد الخمسة أن يكتب شيئاً قريباً من هذا؟ لا يمكن مطلقاً؛ لأن الخريطة الفكرية الأدبية في النصف الأول من القرن العشرين لم تكن لتحتمل شيئاً مثل هذا العصف الذهني! عندما أكتبُ مثل هذا؛ فأنا أقرأ تضاريس الخريطة الأدبية، وتجتاحني جمرة من ذاكرة نوستالجية أتحسسُ فيها طعم اللذة الكبرى التي اجتنيتها من قراءة كلاسيكيات الأدب، ولستُ ممن يميلون كثيراً إلى تذويب الحدود بين العلم والأدب؛ لكن هذا هو واقع الحال السائدة في عالم اليوم.
ثانياً: أما العوامل البراغماتية فيمكن أن نشهدها في طبيعة الدراسة الأكاديمية للأدب. ليس سراً أن الدراسات الأكاديمية في الأدب باتت تشهدُ انحساراً عالمياً في مقابل صعود وتنامي الدراسات المسماة «STEM (وهي اختصار عالمي معتمد للعلم والتقنية والهندسة والرياضيات)»، وقد تسبب هذا الانزياح المتزايد نحو هذه الحقول في غلق كثير من الأقسام الأكاديمية الخاصة بالأدب والدراسات الأدبية. كانت إحدى الاستراتيجيات الالتفافية المعتمدة هي محاولة دمج كثير من الأقسام الخاصة بالإنسانيات في قسم واحد تحت لافتة «الدراسات الثقافية» ضغطاً للنفقات؛ إذ من المعروف أن المؤسسات الغربية - الأكاديمية وغير الأكاديمية - تعتمد معايير إجرائية تقوم على حساب العوائد؛ لذا فهي لن تتردد في تعديل برامجها تبعاً لمستجدات الواقع، ولن تركن أبداً إلى سياسات قديمة بدعوى الحفاظ على أنماط ثقافية محددة.
* * *
لا ضير في أن يبدي أحدنا نزوعاً نوستالجياً بين الفينة والأخرى؛ فليس في هذا عيب أو منقصة. ثم إن إيغلتون كاتب ذو أفق إنساني ممتد من غير تقييدات آيديولوجية أو سياسية، وهو قادر على إمتاعك حتى لو اختلفتَ معه؛ وهنا تصبح المعادلة واضحة: إذا أضفنا المتعة للشحنة النوستالجية التي يفجرها إيغلتون في عقولنا عندما يعيدنا إلى أيامٍ قرأنا فيها كتاب «فائدة الشعر وفائدة النقد» لإليوت، أو «سبعة أنماط من الغموض» لويليام إمبسون، أو «التقليد العظيم» لإف آر ليفز، أو «الأدب والمجتمع» لرايموند ويليامز، أو «مبادئ النقد الأدبي» لريتشاردز، فإن هذا سبب كاف يدفع بنا إلى قراءة إيغلتون بمزيد من الشغف والحماسة الفكرية.
* واضح أن عنوان المادة وظف عبارة «الغابة المقدسة (The Sacred Wood)» فيه... وهو عنوان مجموعة من مقالات في الشعر والنقد كتبها إليوت ونشرها عام 1920









