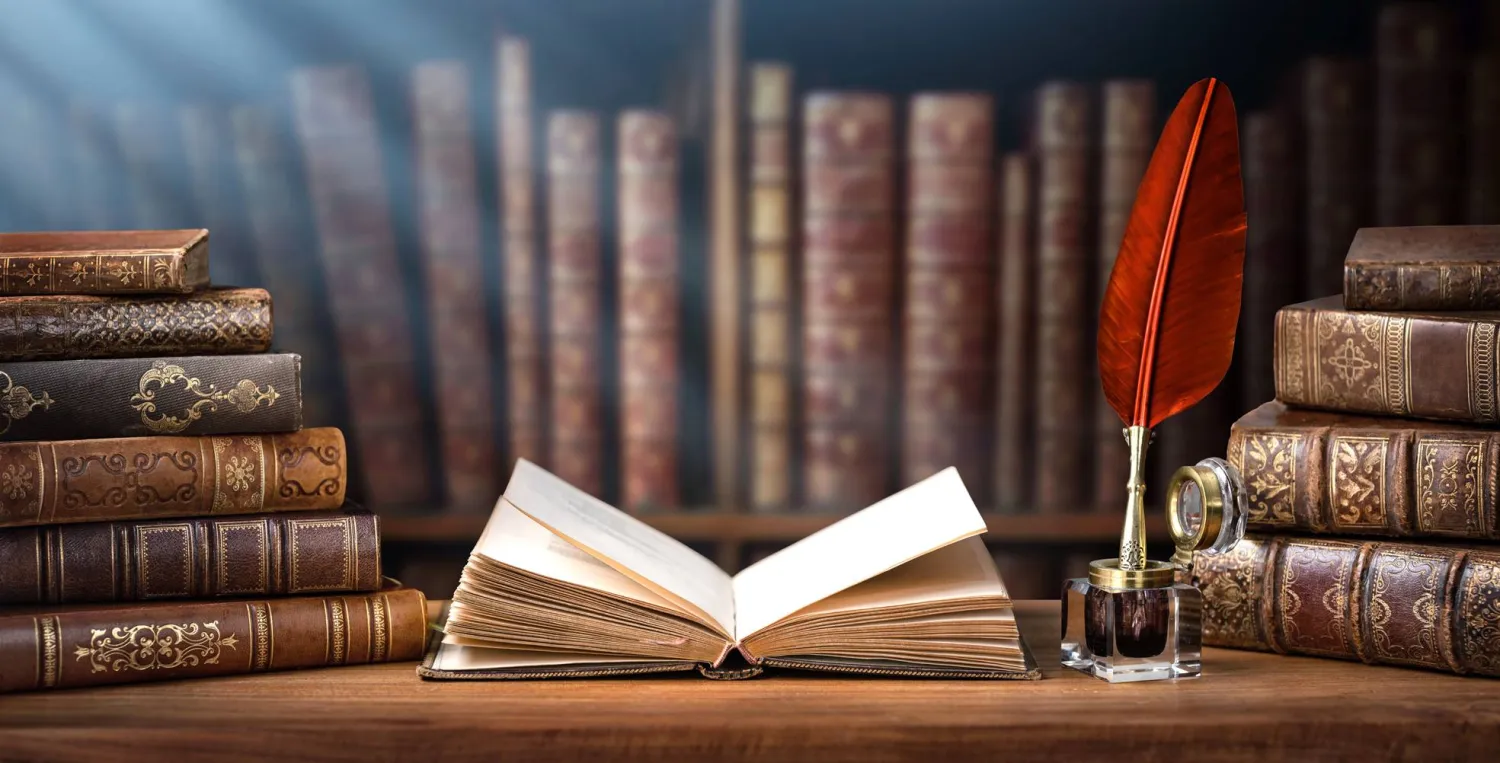كان ذلك قبل حوالي العشرين عاماً. كنت على موعد مع البروفسور ألفريد لويس دو بريمار، الأستاذ في جامعة إيكس آن بروفنس، قسم الدراسات العربية والإسلامية، وصاحب كتاب «تأسيس الإسلام بين الكتابة والتاريخ» الصادر بترجمته العربية عن دار الساقي عام 2009. كنت على موعد معه من أجل مناقشته حول هذا الكتاب وحول نظريته العامة عن التراث. بالمناسبة أنا مترجم هذا الكتاب المهم وليس الاسم المستعار الموضوع عليه: عيسى محاسبي. هذا سر أفشيه هنا للمرة الأولى. لقد تسرع الأستاذ جورج طرابيشي رحمه الله، ووضع هذا الاسم الوهمي عليه بعد أن وجدني متردداً أو متخوفاً قليلاً من التصريح باسمي الشخصي. كنا لا نزال آنذاك مرعوبين من الأصولية والأصوليين. ولماذا نكون مرعوبين والكتاب أكاديمي صرف من أعلى المستويات؟ والله مصيبة. أقسم بالله مصيبة. التراث المسيحي في الغرب يحظى بآلاف الدراسات النقدية التجديدية الحديثة ولا أحد يخاف عليه منها. بل إنه يزداد بعدها تألقاً وسطوعاً. أما نحن فممنوع منعاً باتاً أن تقول كلمة واحدة عن التراث، ما عدا تلك التي يقولها عنه التقليديون الذين أكل عليهم الدهر وشرب. كيف يمكن أن نتحلحل، أن نتقدم، في مثل هذا الجو؟ هل كتب علينا الجمود والخمود إلى أبد الدهر؟ هل كتب علينا التكرار والاجترار إلى ما لا نهاية؟ هنا يكمن الانسداد التاريخي الأعظم للعرب. لهذا السبب انخرطنا في دراسات تنويرية عن التراث، وعشنا لحظات غليان ثقافي حقيقي في بدايات هذا القرن. كان ذلك أيام «المؤسسة العربية للتحديث الفكري» التي أسسها محمد عبد المطلب الهوني وجورج طرابيشي ونصر حامد أبو زيد ومحمد أركون وبقية أقطاب التنوير العربي الإسلامي. ولا ننسى العفيف الأخضر الذي اعتنق فلسفة الأنوار، ولم ينبطح أمام موجة الإسلام السياسي أو المسيس حتى عندما كانت في أوج صعودها وجبروتها. وهي المؤسسة التي حاولت فك الانسداد التاريخي أو فتح ثغرة في جدار التاريخ المسدود. ولأجل ذلك فقد عقدت مؤتمراً ضخماً للمثقفين العرب في بيروت عام 2004، وحققت بعض الإنجازات التي لا يستهان بها ترجمة وكتابة بعد أن تحولت إلى ما يدعى بـ«رابطة العقلانيين العرب» على يد طرابيشي ورجاء بن سلامة والدكتور الهوني ذاته إلخ. كانت تلك لحظة إشراقية رائعة في بحر من الظلمات. وقد استغرقت مني ترجمة هذا الكتاب الأكاديمي مدة سنتين تقريباً. وكنت على تواصل مستمر مع البروفسور دو بريمار، حيث ساعدني بنصائحه وإرشاداته ووثائقه التراثية على إكمالها على أفضل وجه ممكن.
لكن بعد هذه الديباجة المستفيضة دعونا ندخل في صلب الموضوع. بعد أن استقبلني المستشرق الكبير في محطة آفينيون للقطارات، وهي محطة فاجأتني بحداثتها الصارخة أنا القادم من باريس ذهبنا للغداء في مطعم ضائع وسط الحقول... آه، ما أجمل أن تكون بعيداً عن باريس مديراً ظهرك لضجيج العواصم! كنا وحدنا في مطعم كبير يتسم بالعراقة الفرنسية ويتسع لمائة شخص على الأقل. كنا اثنين فقط وحولنا حشد من المضيفين والمضيفات الذين يهتمون بنا ويحرصون على راحتنا. كيف يمكن أن تجد مثل هذه التبجيل والتعظيم في باريس؟ مستحيل. بالكاد يخدمونك، أو يشعرون بوجودك. وحولك يخيم الهدوء المريح وظلال الأشجار العملاقة العتيقة وسكينة الريف الفرنسي. قلت للبروفسور دوبريمار: الناس لا يعيشون في باريس، الناس ينهبون الحياة نهباً، أو قل إن الحياة تنهبهم وتستهلكهم وتستنفدهم. الناس يتسابقون تحت الأرض وفوق الأرض كالنمل. هل هذه حياة؟
بترارك
في نهاية الوجبة خطرت على بالي فكرة. كنت أعرف أن بيت الشاعر الكبير رينيه شار موجود في المنطقة، ولكن كنت أخشى أن يكون بعيداً جداً، وأن أكلف مضيفي ما لا طاقة له به. ومع ذلك فقد تجرأت وسألته: أين توجد مدينة ليل سور لاسورغ يا ترى؟ وحكيت له القصة قائلاً بأني كنت أحلم بزيارتها منذ زمن طويل لكي أرى المكان الذي عاش فيه هذا الشاعر الذي هجر باريس كلها من أجله. وكنت بشكل خاص أريد أن أرى نهر السورغ الذي يخترق المدينة، والذي خلده الشاعر الكبير بقصيدة عصماء. وفوجئت بالسيد دوبريمار ينهض فوراً ويقول لي: تعال معي، إنها على مبعدة عشر دقائق فقط بالسيارة. وكانت المفاجأة كبيرة... وهكذا شاهدت المدينة والنهر الجميل الذي يخلع عليها سحرها الفتان. لن أترجم هنا حرفاً واحداً من تلك القصيدة الشهيرة لأنها عمودية مقفاة، وبالتالي فأخشى أن أقتلها إذا ما ترجمتها. لو كانت قصيدة نثر لفعلت ذلك، ولكن المغامرة هنا غير مضمونة العواقب. وربما أثارت الضحك والسخرية. من يستطيع أن يترجم الشعر؟ كان جان بول سارتر يقول: الشعر لا يترجم. انتهى الموضوع.
في طريق العودة إلى البيت، أشار البروفسور دو بريمار بيده من نافذة السيارة إلى إحدى المناطق البعيدة قائلاً لي: هناك يوجد المنتجع الذي كان يختلي فيه شاعر النهضة الإيطالية بيترارك. قلت له: أرجوك، توقف! هل يمكننا أن نزوره؟ ضحك وقال: نعم يمكننا، ثم أردف قائلاً: ما كنت أعرف أنك تحب الطبيعة إلى مثل هذا الحد.
وهكذا عرجنا على تلك المنطقة الفاتنة التي كان يقصدها بيترارك، وكانت أجمل من مدينة رينيه شار. كان جمالها من النوع الذي يخطف الأبصار. وتمنيت لو بقيت هناك دهراً. نهر غزير يرحب بك ويسيل تحت قدميك في منطقة أشجار وغابات وجبال وشلالات. إنه عرس الطبيعة... لا تكاد ترى السماء فوقك. ولكن هناك صخرة معلقة كالقرص المدور في أعلى الجبل أقلقتني. قلت له: ألن تسقط على رأسنا يا ترى إذا ما تابعنا السير في الوادي حتى نصبح تحتها بالضبط؟ فأجاب: على حد علمي فإنها موجودة هنا منذ عشرات القرون ولم تسقط على رأس أحد حتى الآن... ثم أضاف: عندما كانت تصيب بيترارك نوائب الدهر كان يلجأ إلى هنا لكي يتسلى، لكي ينسى، لكي يتعزى:
يغتلي فيهم ارتيابي حتى
تتقراهم يداي بلمس
هنا كان يتذكر «لورا» تلك المرأة الإشعاعية التي لمح وجهها يوماً ما وهي خارجة من الكنيسة في مدينة آفينيون فخر على وجهه صاعقاً مصعوقاً. مبالغات وتهويلات؟ بالكاد. من يعرف متى تسقط عليه صاعقة الحب؟ من يعرف متى يصيبه الحب بالضربة القاضية؟ وهو شيء لا يحصل إلا مرة واحدة في العمر هذا إذا ما حصل. لا تطمعوا بأكثر من ذلك. هيهات! وعندما يحصل تشعر وكأن أبواب الجنة قد فتحت أمامك على مصراعيها... لقد كان حب بيترارك للورا عذرياً خالصاً مثل حب مجنون ليلى أو جميل بثينة أو ذو الرمة ومي، إلخ. وذلك لأنها كانت متزوجة وهو لم يكن يريد منها شيئاً. كان يريد فقط أن يلمحها من وقت لآخر.
رينيه شار
ثم ماتت لورا وهي في عز الشباب وتحولت إلى أسطورة ملائكية. وظل يناجيها ويكتب لها الأشعار حتى آخر لحظة في حياته. وكان واثقاً أنه سيلقاها في العالم الآخر، حيث لا منغصات ولا تعقيدات، حيث الأبدية والخلود:
إن كان قد عز في الدنيا اللقاء بكم
في موقف الحشر نلقاكم وتلقونا
صاحبكم المسكين التعيس ابن زيدون ما غيره! هو الآخر أيضاً كان مفجوعاً ويحلم برؤية ولادة يوم القيامة بعد أن كانت قد لوعته ومسحت به الأرض مسحاً... ولكن يقال بأنها غيرت موقفها وندمت على ما فات بدليل قولها هذين البيتين:
أغار عليك من نفسي ومني
ومنك ومن زمانك والمكان
ولو أني وضعتك في جفوني
إلى يوم القيامة ما كفاني
في الواقع أن بيترارك كان شخصية خصبة تعج بالمتناقضات. فهو قد ولد عام 1304 ومات عام 1379: أي في فترة متذبذبة لم تكن فيها العصور الوسطى قد ماتت بعد، ولا العصور الحديثة قد ولدت بعد. وهي فترات تنجب عادة شخصيات متمزقة ومنقسمة على نفسها تماماً كالعصر العربي الإسلامي الذي نعيشه نحن اليوم. إنه عصر انتقال وقطيعة ونزيف داخلي حاد. لقد كان بيترارك متمزقاً بين الماضي والحاضر، بين المسيحية والوثنية، بين المتع الحسية والزهد الناسك، بين الشعر والنثر... كان شرهاً منخرطاً في شهوات هذا العالم إلى أقصى الحدود في بدايات شبابه الأول، وذلك قبل أن تصيبه الأزمة النفسية التي حولته فيما بعد إلى زاهد، ناسك، متوحد. وكان ناشطاً سياسياً لا يتردد في لعب الأدوار الخطرة وأداء المهمات السرية التي توكل إليه من قبل الأمراء والبابوات والملوك. كان محاطاً بالأصدقاء والمعجبين، وكان بيته دائماً مليئاً يعج بالبشر. ومع ذلك فكان يشعر بالوحدة أو الوحشة التي تكتسحه من الداخل اكتساحاً. كان يقول هذه العبارة الرائعة التي شفتني وعالجتني: أشعر دائماً بعطش في قلبي! ما كان يستطيع التوفيق بسهولة بين إيمانه الديني العميق من جهة، وبين شغفه بالحضارة اليونانية - الرومانية الوثنية السابقة على المسيحية من جهة أخرى. باختصار شديد: كان قلبه في جهة، وعقله في جهة أخرى. رفقاً بالأرواح الحائرة، بالأجنحة المتكسرة!
ذكريات : قصة لقائي بالبروفسور ألفريد لويس دو بريمار

ألفريد لويس دو بريمار

ذكريات : قصة لقائي بالبروفسور ألفريد لويس دو بريمار

ألفريد لويس دو بريمار
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة