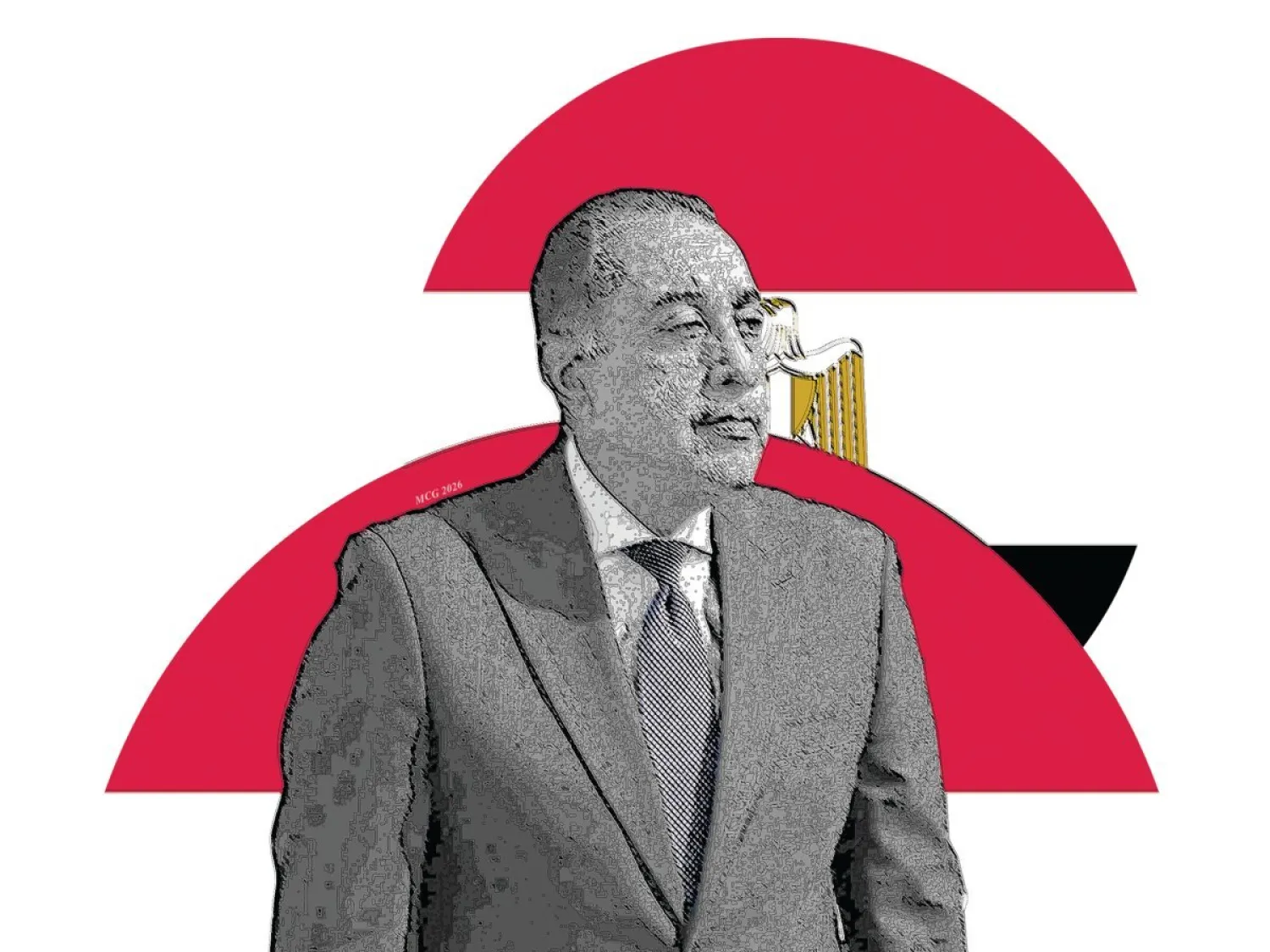تحوّلت محطة القطارات الرئيسية في العاصمة الألمانية برلين خلال الأيام الماضية إلى أشبه بخلية من النحل. إنها صورة تناقض نفسها قبل أسبوعين فقط، عندما كان المكان لا يزال هادئاً؛ إذ إنه لم يكن قد استعاد بعد كامل نشاطه المعتاد بسبب جائحة «كوفيد - 19» التي أجبرت سكان العاصمة على تقليص سفرهم إلى الحد الأدنى.
اليوم، يبدو هذا المكان صاخباً... يعجّ بالمسافرين الذين يتدفقون يومياً إلى مدينة برلين بالآلاف، معظمهم قادمون على متن قطارات بدأت رحلتها في مدن أوكرانيا... مروراً ببولندا.
إنهم يصلون حاملين حقائب سفر صغيرة توحي بأنهم سياح جاءوا لتمضية بضعة أيام. بيد أنهم ليسوا سياحاً، بل هم لاجئون فارّون من جحيم الحرب المستعرة في أوكرانيا.
صعوبة الرحلة وطولها دفعا بهؤلاء إلى الاكتفاء بحمل أقل ما يمكنهم حمله من ممتلكاتهم، وترك الكثير خلفهم.
أعداد كبيرة من الواصلين هم من النساء والأطفال، أما الرجال منهم فهم بمعظمهم من غير الأوكرانيين. ولكن في برلين، يستقبلهم المتطوّعون الذين ينتظرون في محطة القطارات الرئيسة مرتدين سترات صفراء، بالشكل نفسه. ويقتادونهم إلى مكان داخل المحطة يؤمّن لهم فيه الأكل والشراب وأخذ المتوافر من المساعدات من ملابس وأساسيات يومية. ومن ثم يساعدونهم في ملء الأوراق الثبوتية اللازمة لتقديم طلبات اللجوء.
وخارج المحطة، تنتصب خيمة بيضاء رفع عليها علم أوكرانيا، في داخلها متطوعون آخرون يساعدون اللاجئين بتقديم توجيهات حول الطريق الأفضل للوصول إلى الوجهة المقصودة، أو ينقل منهم مَن يريد إلى مراكز لجوء وإيواء مؤقتة.
الكثير تغير في ألمانيا منذ أسبوعين. فالعاصمة برلين تستقبل يومياً قرابة الـ10 آلاف لاجئ آتٍ من أوكرانيا. وعلى الرغم من تخصيص حكومة الولاية (برلين، بالمناسبة مدينة – ولاية) موارد كثيرة لتأمين حاجات اللاجئين الجدد، فإن أعداد الواصلين فاقت التوقعات، لا سيما أن معظم اللاجئين الوافدين من الأراضي الأوكرانية يصلون أولاً إلى برلين بحكم قربها النسبي من الحدود مع بولندا، لكنهم يتوزّعون منها لاحقاً على ولايات ألمانية أخرى.
كاتيا كيبينغ، وزيرة الشؤون الاجتماعية في ولاية برلين، تتحدث عن وصول محطة القطارات الرئيسة في برلين إلى طاقتها الاستيعابية القصوى. وتحذّر من أن «التحدي» سيصبح أكثر صعوبة يوماً بعد يوم. ومن جهة ثانية، عمدة المدينة إلى إعادة فتح المطارات القديمة في المدينة لاستقبال اللاجئين فيها، وتحويل مرافقها إلى مراكز مؤقتة يمكن للاجئين المبيت فيها، ريثما يصار إلى توزيعهم على مراكز ومساكن أخرى.
من هذه المطارات مطار تيغيل الذي كان لغاية العام الماضي واحداً من مطار دوليين أساسيين في محيط العاصمة، إلا أنه توقف عن العمل بعد فتح المطار الجديد. وكان مطار تيغيل نفسه قد استخدم أزمة جائحة «كوفيد - 19» مركزاً للتلقيح ضد فيروس الجائحة. وها هو اليوم يُغيّر دوره مرة جديدة ليصبح مركزاً مؤقتاً للجوء. وهنا نشير إلى أن مطاراً دولياً سابقاً آخر استخدم عام 2015 لاستقبال اللاجئين السوريين، هو مطار تمبلهوف الذي توقّف عن العمل 2008، وهو الذي كان قد تحوّل إلى رمز للعاصمة الألمانية لاستخدامه من قبل الحلفاء عام 1948 مركزاً لعمليات إسقاط المساعدات للسكان أيام حصار برلين من قِبل السوفيات.
مشاكل إيواء وتعليم
حالياً، رغم استعدادات سلطات برلين لاستقبال أعداد كبيرة من اللاجئين مع بداية الحرب في أوكرانيا، فهي لم تتوقع أن ترتفع أعداد الواصلين بهذه السرعة، ولا تبدو مرافق المدينة – على كثرتها – مهيأة للتعامل مع سيل يضم الآلاف من اللاجئين يومياً. ذلك أن العديد من المؤسسات التابعة للولاية وللحكومة الفيدرالية الألمانية كانت ما زالت تعمل بالحد الأدنى بسبب «كوفيد - 19»، لكنها تجد نفسها الآن مجبرة على الانتقال إلى طاقتها القصوى خلال أيام قليلة.
وفي هذا السياق، نذكر أنه لا يسجل كل اللاجئين الواصلين إلى ألمانيا أنفسهم مع الحكومة من أجل الحصول على سكن؛ إذ تصل أعداد غير قليلة منهم للسكن مع عائلاتهم الموجودة أصلاً في ألمانيا. بيد أن هذا الأمر خلق مشكلة إضافية تتمثل بالعثور على مساكن مساحتها أوسع لاحتواء العائلات الجديدة. وفي مدينة تعاني أصلاً من مشكلة في السكن، فإن هذه الأزمة آخذة في التفاقم.
ولم تخلق أزمة اللاجئين مشاكل في السكن فقط، بل أيضاً في المدارس. وحتى الآن لا تُجبر الحكومة الألمانية اللاجئين على تسجيل أولادهم في المدارس، ولكنها قد تدخل قريباً قوانين تفرض عليهم ذلك. وهذا الأمر قد يفاقم مشاكل قطاع المدارس، خاصة في برلين التي تعاني نقصاً كبيراً في عدد المدرّسين وانعدام القدرة على استيعاب مزيد من الطلبة في صفوف تستقبل أكثر من طاقتها منذ سنوات. ورغم أن المدارس الألمانية واجهت تحدياً مشابهاً لما تعانيه اليوم، في العام 2015، عندما تعين عليها استقبال آلاف الطلاب الجدد الآتين من سوريا من دون أي إلمام باللغة الألمانية، فهي لا يبدو أنها خططت منذ تلك التجربة لحالات مستقبلية شبيهة. وحقاً، تتحدث وزارة التعليم في برلين اليوم عن خلق 50 صفاً (أو فصلاً دراسياً) جديداً تعد «صفوف استقبال» يتأمن عبرها إدخال الأطفال الأوكرانيين إليها لتعليمهم اللغة قبل إدماجهم في الصفوف. لكن هذا الرقم صغير جداً، ولن يكون قادراً على استيعاب إلا جزء صغير من الطلاب الجدد، وفق صحيفة «بيرلينر تزايتونغ».
وتقول الصحيفة بأنه قياساً لأعداد الواصلين يومياً، وإلى أن عدداً كبيراً منهم من الأطفال، فإن ثمة حاجة إلى استحداث أكثر من 500 صف شبيه وليس 50 صفاً فقط.
كذلك، تشير الصحيفة إلى كتاب نشرته صحافية متخصصة في التعليم، بعد أزمة اللاجئين عام 2015، حول الدروس المُستفادة من تلك الأزمة في ضوء الضغوط التي سببتها على قطاع التعليم. واستنتجت مؤلفة الكتاب أن الحكومة «لم تدرس نتائج الأزمة داخل الصفوف ولا طريقة معالجتها. وليس لديها، بالتالي، اليوم وسيلة تطبقها على اللاجئين الجدد الوافدين من أوكرانيا».
أزمة ارتفاع الأسعار
ولكن ليس هذا فقط ما تغير في ألمانيا خلال الأسبوعين الماضيين. فأسعار الوقود والديزل وفواتير الكهرباء والتدفئة ترتفع بشكل جنوني منذ أيام حتى باتت تؤرق المستهلكين والحكومة على حد سواء. وبينما تبحث الحكومة الفيدرالية الألمانية عن حلول وبدائل سريعة لتخفيف الحمل الثقيل المتزايد على كاهل سكانها، تزداد النصائح المقدمة لاستخدام وسائل نقل بديلة عن السيارات وتشغيل التدفئة لساعات أقل، مع أن فصل الشتاء لم ينته... والطقس البارد لم يدفأ بعد.
والواقع، أن ألمانيا ربما تكون، إلى جانب النمسا، من أكثر الدول الأوروبية تأثراً سلبياً من الناحية الاقتصادية بالحرب في أوكرانيا. فألمانيا تستورد من روسيا أكثر من 55 في المائة من غازها، و52 في المائة من فحمها و34 في المائة من نفطها، في حين تستورد النمسا 80 في المائة من غازها من روسيا. وخلال السنوات القليلة الماضية، منذ قرار السلطات الألمانية وقف المعامل الألمانية للطاقة النووية إثر حادث فوكوشيما عام 2011 في اليابان، ازداد اعتماد ألمانيا على الغاز الروسي بشكل كبير.
بدائل «نورد ستريم 2»
وهكذا، وافقت برلين على بناء مشروع «نورد ستريم2» لزيادة كمية الغاز الروسي الذي يصل مباشرة إلى الأراضي الألمانية، رغم أن مشروعاً شبيهاً موضوع في الخدمة منذ أكثر من 10 سنوات. فإن الحرب في أوكرانيا غيرت هذه المعادلة. وبعد مقاومة برلين إبان حكم أنجيلا ميركل وقف مشروع «نورد ستريم2» لسنوات، وتمسّك الحكومات السابقة بالمشروع رغم العقوبات الأميركية عليه، أعلنت حكومة أولاف شولتز الجديدة وقف العمل به، وإعادة «تقييم المخاطر الأمنية» التي يتسبب بها. وكان هذا، تحديداً، انتقاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب لتبني ألمانيا المشروع. وكان ترمب، في الواقع، هو الذي فرض العقوبات عليه محذّراً من أن ازدياد اعتماد ألمانيا على الطاقة الروسية سيجعلها أسيرة لسياسات الكرملين.
يومذاك، لم تقتنع برلين بوجهة النظر الأميركية تلك إلى أن وقعت الحرب في أوكرانيا... وبدأت روسيا عملياتها العسكرية على أبواب دول حلف شمال الأطلسي (ناتو).
أكثر من هذا، لم تكتفِ ألمانيا بوقف المشروع، بل باشرت التسريع بمشاريع غاز ونفط بديلة بهدف تقليص الاعتماد على الطاقة الروسية. وساعد في ذلك أن حزب «الخضر» البيئي، الشريك البارز في الحكومة الألمانية الجديدة، كان خطّ في اتفاقية الائتلاف الحكومي زيادة الإنفاق على مشاريع الطاقة الخضراء. ويُعرف عن حزب «الخضر» أنه من أكثر الأحزاب الألمانية اندفاعاً إلى تبني سياسة أكثر استقلالية عن روسيا، وهو كان الحزب الوحيد الذي انتقد تقارب الحكومات الألمانية المتعاقبة مع موسكو، واتخذ مواقف منتقدة من السلطات الروسية، خاصة، لجهة تاريخها مع حقوق الإنسان.
وتأمل الآن ألمانيا بأن توقف اعتمادها على النفط الروسي بحلول نهاية العام الحالي، وعلى الفحم في حلول الصيف المقبل، كما قال وزير الاقتصاد روبرت هابيك المنتمي لحزب «الخضر». ولكن وقف اعتمادها على الغاز الروسي سيكون مهمة أصعب بكثير.
العلاقات مع روسيا
هابيك أقر بأن فرض حظر كامل على الغاز والنفط الروسي في الوقت الراهن سيؤدي إلى كارثة اقتصادية على ألمانيا. وأضاف في تصريحات للقناة الألمانية الأولى، إن وقفها تلك الصادرات «سيؤدي إلى نقص في الإمداد وحتى وقف كامل للإمدادات في ألمانيا». وأردف أن ما سيترتب على ذلك سيكون «بطالة جماعية وفقر وأشخاص عاجزون عن تدفئة منازلهم، وآخرون لن يعود لديهم وقود لملء سياراتهم». وأكد، أن البطالة الجماعية تعني وقف العمل بالكثير من المصانع التي لن تظل قادرة على تشغيل آلاتها بسبب عجزها عن دفع فواتير الطاقة المشغلة.
ومن ثم، بين خطط الحكومة الفيدرالية لتخفيف الاعتماد على الغاز الروسي، بناء معملين للغاز المُسال ما سيمكّن ألمانيا من استقدام غاز من دول أخرى مثل الولايات المتحدة وأستراليا وقطر. ولكن بناء المعملين سيستغرق قرابة السنتين، بجانب أن استيراد الغاز المُسال سيكون أكثر تكلفة لألمانيا.
مع هذا، هناك مَن يروّج لوقف استيراد الغاز الروسي على الفور. من هؤلاء، النائب نوربرت روتغن، المنتمي إلى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الذي كانت ترأسه المستشارة السابقة أنجيلا ميركل. ورغم أن روتغن ينتمي إلى حزب كان مسؤولاً عن سياسة الطاقة في البلاد والاعتماد المتزايد على روسيا في هذا المجال، فهو يكرّر انتقاداته للحكومة الحالية «لتلكؤها في اتخاذ قرار بوقف واردات الطاقة الروسية». ويعتبر هذا السياسي المحافظ أن أموال ألمانيا تموّل الحرب على أوكرانيا؛ إذ كتب مقالاً في صحيفة ألمانية قبل أيام قال فيه «أكثر من مليار يورو تصب في صندوق (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين الحربي يومياً، وتحبط العقوبات المفروضة على البنك المركزي الروسي».
بل، عزّزت توصية الأكاديمية الليوبولدينية الوطنية للعلوم من الجدل القائم؛ إذ استنتجت في ورقة أعدتها أنه في حال قطع الغاز والنفط الروسي فوراً «سيظل ممكنا إدارة الوضع في ألمانيا». واقترحت هذه الأكاديمية - المعهد التي من مهامها تقديم دراسات علمية لقضايا أساسية لديها تأثير على المجتمع الألماني، إجراءات عدة لمساعدة البلاد على التخلص من الاعتماد على الطاقة الروسية. إلا أن الحكومة الألمانية رفضت التوصية على الفور وبقيت مصرّة على أنه لا يمكن وقف استيراد الغاز الروسي فوراً.
ولقد أثار هذا الموقف انتقادات لاذعة لألمانيا وجّهها لها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عندما خاطب البرلمان الألماني الفيدرالي (البوندستاغ) يوم الخميس الماضي، واتهم أوروبا ببناء جدار بينها وبين أوكرانيا، في إيحاءات تاريخية تتعلق بـ«جدار برلين». ومما قاله زيلينسكي، أن ألمانيا تحاول أن تحمي اقتصادها، وهذا يمنعها من اتخاذ قرارات بفرض عقوبات على روسيا قادرة على وقف الحرب.
حرب أوكرانيا أعادت فتح ملف السياسة الدفاعية
> يوافق المراقبون المتابعون على أن المخاوف الاقتصادية هي التي تحرك ألمانيا الآن. والمخاوف تلك تتعدى الغاز والنفط، لتصل إلى القمح وبذور الزيوت التي تستوردها ألمانيا من أوكرانيا. وكانت هذه المخاوف قد بدأت تظهر على رفوف المتاجر الفارغة من الزيوت النباتية والطحين؛ ما أجبر المتاجر على إعادة فرض حد للكميات التي يمكن للفرد شراؤها من تلك المنتجات. ويذكر ذلك بأيام «كوفيد -19» الأولى حين أخذت المتاجر تفرغ من بعض الأساسيات التي تدافع السكان على تخزينها.
إلا أن التغييرات الأعمق التي طالت ألمانيا بفعل الحرب الدائرة في أوكرانيا، لا تتوقف فقط على سياسة الطاقة، وإن كانت تلك بعيدة أو متوسطة المدى. فالتغيير الأكبر والأبرز يتعلق بسياسة الدفاع الألمانية. وخلال أيام قليلة منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أعلن المستشار أولاف شولتز قرارات وصفت بـ«التاريخية»؛ لأنها تلغي عقوداً من سياسات بقيت ألمانيا متمسكة بها لأسباب تاريخية. ومعلوم أن حكومات «ما بعد الحرب العالمية الثانية» حرصت على خفض الإنفاق العسكري وتقليص قوة الجيش الألماني، وظلت دائماً رافضة للتدخل في الخارج إلا في عمليات ضمن إطار دولي وفقط في دور غير قتالي. ولكن شولتز ثار على كل تلك المخاوف، وأعلن أخيرا أن ألمانيا ستبدأ بإرسال أسلحة قتالية لأوكرانيا، عاكساً قرارات سابقة تمنع تصدير السلاح إلى أماكن نزاع. وأعلن أيضاً تخصيص صندوق فوري بقيمة ضخمة تصل إلى 100 مليار يورو، لتحديث الجيش الألماني ومعداته.
كذلك، أعلن شولتز أن ألمانيا سترفع الإنفاق الدفاعي على الفور ليصل إلى 2 في المائة من ناتجها الإجمالي، في زيادة بأكثر من نصف نقطة مئوية، لتصل إلى النسبة التي يوصي بها «ناتو» لأعضائه. وزيادة الإنفاق هذا سيجعل ألمانيا الدول الأوروبية الأكثر إنفاقاً على دفاعها كونها صاحبة أقوى اقتصاد في القارة.
ومن جهة ثانية، سيعمل شولتز على إدخال هذه النسبة في الدستور الألماني خوفاً من أن تراجع أي حكومة قادمة عن ذلك. وفي إطار تحديثها لمعدات الجيش، قررت ألمانيا أيضاً الاستعاضة عن المقاتلات القاذفة القديمة من نوع «تورنادو»، التي تعود إلى الثمانينات، بمقاتلات قاذفة أميركية من نوع «إف - 35». وهذه الطائرات الحديثة قادرة على حمل صواريخ نووية. وهي جزء من اتفاق أميركي - ألماني بأن تؤمّن برلين طائرات تستطيع المشاركة في أي حرب نووية محتملة مقابل تأمين واشنطن الصواريخ النووية. وللعلم، هذه الصواريخ موجودة أصلاً في ألمانيا في مخابئ سرية، ولكن وجودها كان محل جدل طويل في ألمانيا. ولقد شهد «البوندستاغ» جلسات كثيرة لمناقشة وجود الصواريخ على الأراضي الألمانية والاستماع إلى حزب تلو الآخر يطالب بإزالتها. ولكن قرار الاستعاضة عن الـ«تورنادو» بالـ«إف - 35» - وهي الأغلى والأحدث من نوعها - ينهي فعلياً هذا الجدل، ويؤكد أن ألمانيا تستثمر في إبقاء تلك الصواريخ النووية الأميركية مخبأة وجاهزة لديها.
واللافت هنا، أن معظم الأحزاب، باستثناء حزبي اليمين واليسار المتطرفين، اللذين لا يتمتعان بتأثير يذكر لتواضع حجم تمثيلهما في «البوندستاغ»، تؤيد كل هذه التحديثات في السياسة الدفاع للبلاد. ثم إن بات حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي - الذي رسم سياسة البلاد طيلة السنوات الـ15 الماضية، يتحدث اليوم عن «أخطاء كبيرة» ارتكبت بإبقاء الجيش الألماني ضعيفاً. بل، بات هذا الحزب المحافظ اليميني هو مَن يطالب بوقف فوري لاستيراد الغاز الروسي، مع أن المستشارة السابقة ميركل - التي ترأسته لعقدين من الزمن - هي التي سنّت تلك السياسات المقربة من روسيا.
أكثر من هذا، يتكلّم الديمقراطيون المسيحيون اليوم، من مقاعد المعارضة، إلى ضرورة الانتقال إلى «وضع الدفاع» بحسب النائب هنينغ أوته، نائب رئيس لجنة الدفاع في «البوندستاغ». ولقد علق أوته على قرار شراء طائرات الـ«إف - 35» بالقول «إن الجيش ككل في حاجة إلى تعزيز نفسه، وهو في حاجة ماسة إلى الانتقال من وضع السلام إلى وضع الدفاع».
تحديات جديدة في ألمانيا بسبب الحرب الأوكرانية
اهتمام كبير بمعالجة مشكلة اللجوء... الآتية بعد تداعيات «كوفيد ـ 19»


تحديات جديدة في ألمانيا بسبب الحرب الأوكرانية

لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة