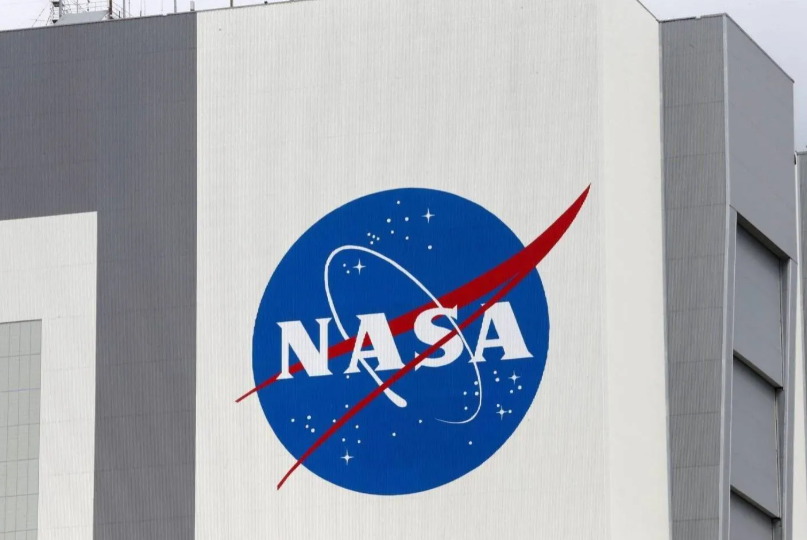مذ ألمت بنا الجائحة الكونية الأخيرة، تضاعف إحساس أغلب سكان المناطق الحضرية بالتغيير الذي يصيب عالمهم حتى شاع الحديث المتفلسف حول «التغير في طبيعة التغيير ذاته». وللحقيقة، فإن تسارعه - بصورته الاجتماعية الشاملة - مسألة مستجدة في التاريخ البشري جعلها زيغمونت باومان في كتابه «الحداثة السائلة» علامة عصر الحداثة وسمته الجامعة، حيث «تتفاوت أنظمة العيش الحديث في عدة جوانب، لكن ما يجمع بينها هو تحديداً كونها هشة ومؤقتة وسريعة التأثر بالتحولات وخضوعها الدائم للتغيير». لكن التقاط باومان وغيره من الفلاسفة لحضور التغيير المتزايد في حياة البشر لم توازه الفلسفة ببحث جدي في ماهية عملية التغيير ذاتها، في وقت كانت العلوم الطبيعية والاجتماعية تقدم توصيفات دقيقة عن كيفية حدوثه وأسبابه في مجالاتها المحددة: من البيولوجيا والكيمياء إلى الفيزياء والجيولوجيا، ومن علم الاجتماع والأنثروبولوجيا إلى التاريخ والسياسة. هذا رغم أن مهمة الفلاسفة - على ما يقوله كارل ماركس على الأقل - يجب «ألا تقتصر على تفسير العالم، بل أساساً تغييره».
وقد تكشف تقصير الفلسفة بشكل مسُتغرب في لحظة «كوفيد 19». وجاءت تعليقات الفلاسفة المرتجلة بشأنها أقرب لتصريحات علاقات عامة منها نتاج تأمل متمكن، وتركوا مواقع التأثير والتوجيه الفكري للعلماء والأطباء والسياسيين، بل وبدت نفسها أكثر الصناعات الفكرية تخلفاً عن العصر، لا تمتلك شيئاً جديداً تقوله للناس، مكتفية بصراعات داخل أبراجها الأكاديمية العاجية، إما حول نظريات موروثة من تاريخها، أو المعاني الكبرى المستعصية بحكم منطقها عن الحسم من فئة ما العدالة؟ وما الحرية؟
ويبدو أن بعض المشتغلين بالتفلسف قد لمسوا قطيعتهم عن مجتمعاتهم بفضل الجائحة نفسها، وشرعوا لذلك بالتساؤل عن كيفية إنقاذ مهنة «محبة الحكمة» من ذاتها ومواضع «التقصير» فيها. فاعتبر بعضهم - مثل الفيلسوف الفوضوي جون زيرزان - أن خضوع الفلسفة كممارسة للسلطة أخرجها عملياً من ساحة السياسة التي طالما كانت مختبر الأفكار ومعرضها، وحصرتها في قاعات أقسام أكاديمية مستقلة لا يجمعها مع الأقسام العلمية الأخرى سوى أوهى العلاقات، ففقدت راهنتيها وصلتها بالحياة، وانتقلت إلى مقاعد المشاهدين. وكتب أحدهم، البروفسور غراهام هارمن، في مجلة «الفيلسوف» البريطانية مقراً بالتقصير: «فلنكن صرحاء: لقد فعلت الفلسفة أقل القليل لاستكشاف التفاوت بين التغيير الكمي والتغيير النوعي»، داعياً إلى تفكيك الصيغة التي يتم بها حالياً تقسيم فروع الفلسفة والتعلم من الجيولوجيا مثلاً التي وكأنها تُقدم اليوم للبشر علامات ترقيم تمكنهم من قراءة تقلبات الأزمنة والتأمل في ماهيات التغييرات الكبرى بغض النظر عن أي مفاهيم أو فلسفات مثالية. لكن هذه الصحوة ما زالت استثناء، والعزم على التغيير ما زال كأنه حبيس المنزل: تحديث المناهج الدراسية الفلسفية للسماح بقراءات خارج الأعمال الكلاسيكية ومن علوم مختلفة، وفرض كوتات تمثيل للنساء والأقليات والأجانب في هيئات التدريس والطلاب المقبولين، وإمكان التجسير الشكلي مع علوم أخرى في الحصول على المؤهلات، وتبني حلول تقنية متقدمة لتمكين التدريس والبحث بالاستفادة من معطيات التكنولوجيا الحديثة، وهذه جميعها إجراءات محمودة ومطلوبة حتماً، لكنها لن تكسر الهوة بين الفلسفة والواقع السائل، الهش، الخاضع أبداً للتغيير.
تاريخياً، اتخذت الفلسفة موقفين متناقضين من التغيير كظاهرة كلية منذ نعومة أظفارها. فهناك الإغريقي بارمينديس (ولد حوالي 515 قبل الميلاد) الذي أنكر كل تغيير معتبراً «أن ثمة قصة واحدة وطريقاً واحداً فحسب. وأن كل إشارة على طريق الحياة البشرية تصرخ هذا الوجود مكتمل بذاته وفريد وثابت ومتجه إلى فناء أكيد» مقابل مواطنه هيراقليطس (ولد 540 قبل الميلاد) الذي أصر على أن كل شيء على الإطلاق موضوع تغيير، و«لا شيء ثابت سوى التغيير». وبين هذين الموقفين لم يقدم لنا الفلاسفة طيلة عقود ما يعين على فهم عملية التغيير ذاتها، أو هم حاولوا جرنا - لا سيما بعد فشل التجارب الكبرى لتغيير العالم في القرن العشرين - إلى نقاش جدلي محض مداه أن تغيير مفهومنا لـ«الحقيقة» هو طريقنا الوحيد لتغيير العالم، فيما وظفت النخب الحاكمة مفهوم التغيير حصراً فيما يكرس هيمنتها ويعظم امتيازاتها.
لكن إذا كان للفلسفة يوماً أن تكون طرفاً فاعلاً في التعامل مع التغيير وصنعه، فلا بد لها أن تخرج من وهم القبض على «الحقيقة»، والانتقال - كما دعا نيتشه في «ما بعد الخير والشر» - إلى مساحة التساؤل الاستنكاري عن حاجتنا لـ«الحقيقة» وقيمتها لمواجهة القدر، في الوقت الذي يمكن لـ«لا حقيقة» أن تؤدي دوراً أفضل أحياناً.
ما كشفت عنه الجائحة وما نحتاجه من الفلاسفة اليوم هو أن يَدَعونا من المفاهيم المجردة والفذلكات اللفظية والقيود المسبقة والمبادئ الثابتة والأنظمة المغلقة والحلول النهائية، ويمنحونا أدوات تفكير تمكننا - كأفراد من الأكثرية غير الملمة بكواليس الصنعة الفلسفية - من تقييم موقفنا في ظل الواقع خلال لحظة ما، واتخاذ توجهات على أساس ذلك التقييم بهدف التعامل مع التغيير، والوصول إلى نوع من السيطرة على الواقع مع امتلاك المرونة لاستبدال التوجهات عند تبدل المعطيات من حولنا.
وبالطبع فإن التوجهات التي يتخذها الأفراد لا تأتي بالضرورة عفو الخاطر، إذ أن لها مرجعيات في معتقداتهم وثقافتهم وهوياتهم - على تعدد مستوياتها -، وسيكون ضرورياً على الفلسفة أن تقدم لنا فهماً محدداً للكيفية التي تتفاعل بها تلك المرجعيات مع المستجدات عند صياغة توجهاتهم.
ولا يعني ذلك استبعاد الفلسفة من الشأن العام لمصلحة خدمة الأفراد - بذاتهم - على تدبر أمورهم مع التغيير، ذلك أن بناء تصورات محددة للكيفية التي تتعدل فيها توجهاتهم - وبالتبعية سلوكياتهم - بناء لتفاعل مرجعياتهم مع مستجدات واقعهم قد يسمح لنا كمجتمعات عصرية بفهم الطرائق التي يمكن بها البحث عن توجهات مشتركة بين أكبر عدد ممكن من الأفراد، والبناء عليها في تصميم استجابتنا الجمعية تجاه مُستجدات عالمنا. ولذا فإن مهمة الفيلسوف تتضمن كذلك - كما تقول الأستاذة تشيارا ريسريادوني في مقالها «الفلسفة السائلة» - أن يمنح الأفراد القدرة على رؤية حلم مشترك عن المستقبل وكأنه أكثر واقعية من كابوسنا الحالي. وذلك يعني أساساً امتلاك الجرأة المقتدرة على فك الارتباط مع الزمني اللحظي عند قراءة التغيير وتشكيله، والفصل بين العناصر (المتغيرة) في التغيير عن العناصر (غير المتغيرة).
جرأة فلسفية مثل هذي تمنح صاحبها الرؤية للتعامل مع المستقبل كواقع والانطلاق منه للنظر في حاضرنا كماضٍ له، ومن ثم عزل العناصر الراهنة التي ينبغي الحفاظ عليها لأهميتها في القادم من الأيام. ويتضمن ذلك نوعاً من سياسات محافظية مختارة، وتثبيت واع لأجزاء من نسيج واقعنا الحالي وضمان استدامتها سعياً للتأثير على نوعية التغيير وصولاً إلى المستقبل - الحلم، وإلا فالسقوط في الكابوس.
وهذا كله ليس ترفاً يمكن للفلاسفة تركه والانشغال عنه بقضايا أخرى، بل هو في جوانب كثيرة من حياتنا المعاصرة مسألة حياة أو موت، ليس بسبب الجائحة الحالية ومترتباتها فحسب، وإنما أيضاً بسبب قضايا عابرة للحدود تمس الوجود الآمن للبشرية تالياً، كالأسلحة النووية، وتهديدات الدمار الشامل، وأزمات المناخ والبيئة، وقضايا الطاقة الأحفورية، والأوبئة، وكثير غير ذلك.
تفضلوا أيها الفلاسفة: مهماتكم ثقيلة وكثيرة، ونحن بحاجة لكم، أكثر من أي وقت مضى.
«كوفيد ـ 19» يتحدى الفلاسفة
مُطالبون بالتخلص من المفاهيم المجردة والمبادئ الثابتة ومنحنا أدوات للتفكير

غراهام هارمن - جون زيرزان - زيغمونت باومان

«كوفيد ـ 19» يتحدى الفلاسفة

غراهام هارمن - جون زيرزان - زيغمونت باومان
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة