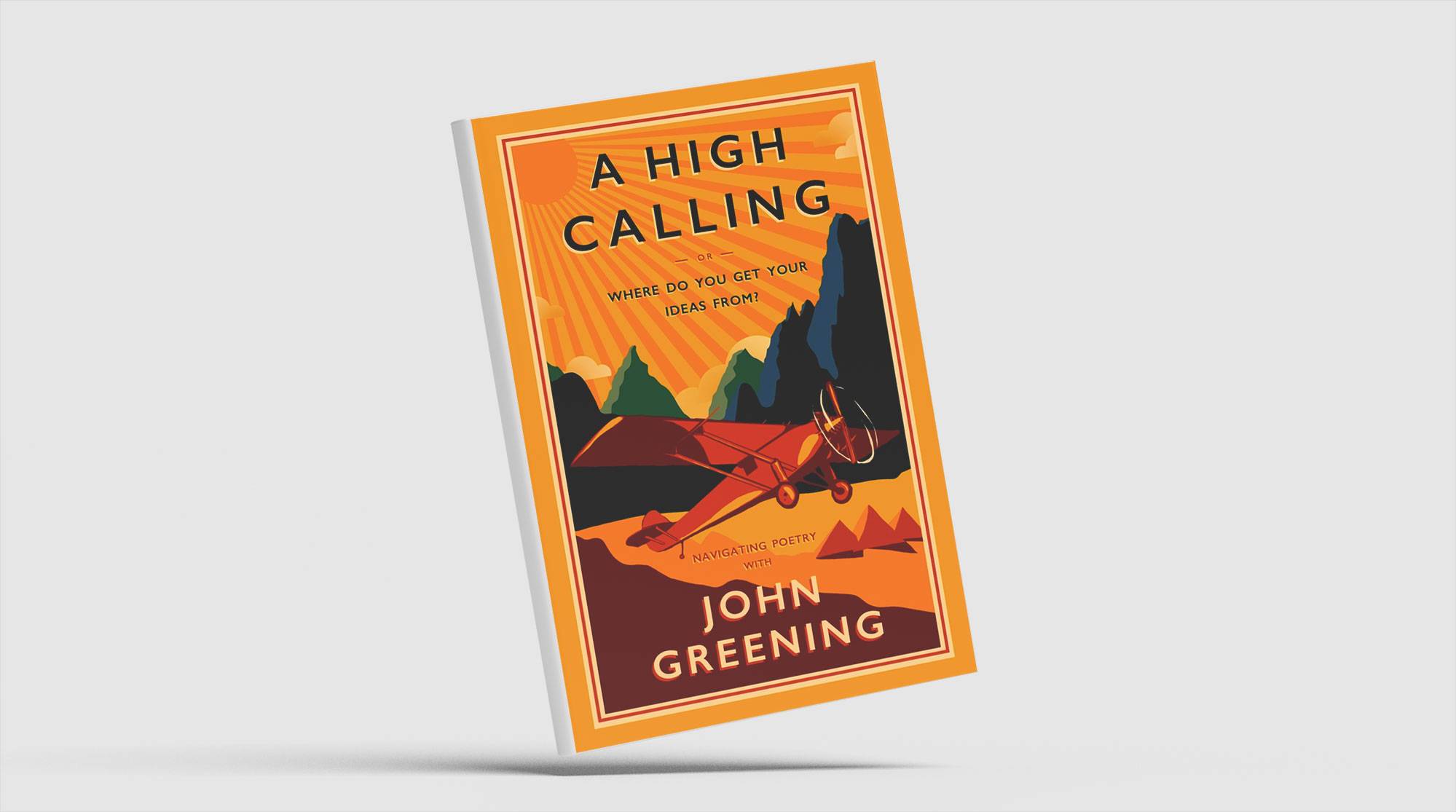من المؤسف أن الرواية اليوم لم تعد تُعنى بالشكل بقدر عنايتها بالمضمون الذي صارت تهتم به اهتماماً جعلها تتفنن في توظيفه؛ بدءاً من ولعها بالسياسة والفلسفة والصحافة، وانتهاء بالتداخل مع المعارف والثقافات، بشكل بيّن وبصور متغايرة. ووراء شح الفن ونضوب التجريب في الكتابة الروائية، العجلة في استثمار المقدرة، والافتقار إلى أصالة الوعي بأهمية الإخلاص للفن والتعبير به.
وما كان لروايات عربية مثل «ثرثرة فوق النيل» أو «اللص والكلاب» أو «موسم الهجرة إلى الشمال» أو «النخلة والجيران» أن تكون أمثولات سردية لولا عناية كتّابها بالأشكال التي بها عرضوا مضامينهم المميزة المنتقدة والمحرضة والمثورة والمصورة للواقع ومتغيراته. وهكذا لاقت كتاباتهم صدىً نقدياً وجماهيرياً أخذته وما زالت تأخذه على الصعيدين الفني والحياتي.
بيد أن جل الإنتاج الروائي اليوم هو كمي يُعنى بالثيمة الموضوعية ويفتقر إلى التجريب النوعي في شكل مشاريع سردية يراهن على نجاحها. وقد يقال إن تسارع الواقع وجسامة منغصاته وبشاعة تداعياته على اختلاف صورها وأبعادها هو ما يستدعي من الروائي العربي الاهتمام بالمضامين، أما المواكبة السردية لما هو تجريبي وجديد؛ فهذا ما يندر حصوله، بل إن الروائي العربي نفسه على عجلة من أمره، وهو محتدم الحال أيضاً كاحتدام واقعه.
وجزء من هذا الاحتدام عائد إلى الهوس بكتابة رواية مفصلَّة على وفق مقاسات تحددها دواعٍ خارجية، كالتعجل للحاق بفرصة نشر ما، أو الاشتراك في مسابقة ما، خصوصاً أن هناك جوائز من الدسامة بما يسيل لها اللعاب، وقد يسعى الروائي بكل ما أوتي من سرعة إلى الإيفاء بمتطلبات الترشح لها، ملبياً مستلزماتها؛ الأمر الذي يزيد من حدة الضغط والاحتدام ليكون هذا الروائي في وضع لا يحسد عليه وهو يبحث عن قالب تقليدي يضخ فيه منظوره الواقعي فوتوغرافياً أو مونودرامياً، ولا شأن له بأي تجريب غير محسوب النتائج، كما أنه لا سعي لديه للظفر بأي فرص تسنح له بالتأني والتأمل الفنيين.
وبهذا ترسم الرواية صورة تقليدية للواقع في احتدامه ومعتادية قواعده وأبنيته، فلا هي تبحث عما هو مدفون تحت هذا المعتاد من مخبوءات؛ ولا هي تخلخل الثوابت وتضعضع الأساسات.
ومع التسارع في الإنتاج الكمي للمضامين يكون المتحصل النوعي ضعيفاً، ليكون مآل الرواية العربية مستقبلاً مآلاً مأزوماً بالإشباع الموضوعاتي حد التخمة والإغراق. ومن تداعيات هذا الإغراق أن غدت الحكاية هي القالب المعتاد الأكثر استعمالاً في الكتابة السردية اليوم. وقد عدَّها جيرار جينيت ترسيمة أساسية في بناء الرواية، مميزاً الحكاية عن القصة والسرد؛ إذ إن الفعل السردي فيها عادة ما يكون حدثاً قولياً ضمن خطاطة اتصالية ذات طرفين: الأول بطل هو حكاء، والثاني مستمع متلق هو نديم. ومنطق الأفعال هو الذي يجعل الحدث مروياً كما هو شفهياً أو مكتوباً على نحو تكون فيه الشخصيات إما «مبئرة» وإما «مبأرة»، ويكون مجرى الأحداث منتظماً زمنياً كسلسلة تتعلق بأشياء ذات حياة أو بأفكار تبين على السطح (عودة إلى خطاب الحكاية، ص133).
ولا يضمن توظيف الحكاية إنتاج سرد متماسك إلا بوجود منظور تطوري وإدراكي يعزز التقاليد الشفوية والكتابية للحكاية. ولا فرق في ذلك إن كان السرد طبيعياً أم كان غير طبيعي. ومثَّل جينيت على هذا الأخير ــ وإن لم يسمه بهذا الاسم ــ ببقاء الأفراد أحياء بعد أن يكون الذئب قد التهمهم، أو بقاء يونس في بطن الحوت ثلاثة أيام وخروجه بعد ذلك سالماً (عودة إلى خطاب الحكاية، ص173)، وهو ما تناوله بشكل واف براين ريتشاردسون في مقالته «نظرية السرد المضادة واللاطبيعية... وما بعد الحداثة» وتحدث عن بعض جوانبه ديفيد هيرمان في مقالته «علم السرد علماً إدراكياً (Narratology as a cognitive science)».
وإذا كان السرد الطبيعي يقوم على فرضية مطابقة ما هو حقيقي ضمن سياق اتصالي يماثل أوضاع الواقع الحياتية، فإن فرضية السرد غير الطبيعي تقوم على أساس عدم استنساخ العالم بشكله المباشر، وإنما التعبير عنه على نحو وهمي تحكمه مبادئ لا علاقة لها بالعالم الحقيقي من حولنا، لكن بالفهم الإدراكي تتعزز الصلة التوليفية بين السرد والعقل، فيكون في إعادة بناء الفهم العقلي شكل من أشكال التواصل مع هذا السرد. وهذا ما يجعل السرد غير الطبيعي أكثر تحدياً في توظيف الحكاية، لأن التواصل السردي يظل مرتهناً بالفهم الإدراكي لما هو غير معقول واقعياً.
ومن الروايات التي وقعت في مطب الفهم الإدراكي في توظيف الحكاية بطريقة السرد غير الطبيعي لما هو جسدي، رواية «عن لا شيء يحكي» لطه حامد الشبيب (منشورات اتحاد الأدباء والكتاب في العراق 2020)، ومرد الإخفاق في التوظيف يعود إلى:
أولاً: أن الروائي جعل بطله الأعمى (حمادي) حكاءً بضمير الأنا، ممارساً أفعالاً غير منطقية لا تتناسب مع حالته ضريراً، مردداً باستمرار: «أنا حمادي الأعمى»، وموظفاً حاسة البصر باستعمال الفعل «أرى»: «مخيلتي ترى لي - أراهم يندفعون - أرى الزرقة - أستطيع أن أراها لا تبتسم - هكذا أراها بين الأشكال المرسومة - فإذا بي أراه مع المجموعة - أرى حمزة في أكثر من مظاهرة... إلخ)، غير مهتم بتوظيف الحواس الأخرى.
ولو كان السارد موضوعياً لتمكن من تبرير أفعال البطل غير المعقولة تبريراً عقلياً يتيح للقارئ فهمها وإدراكها. وهو ما نجح في توظيفه إبراهيم أصلان في روايته «مالك الحزين» التي فيها توفر الفهم الإدراكي للسرد غير الطبيعي بوجود سارد موضوعي بضمير الغائب وبطل أعمى هو «الشيخ حسني» الصائد للعميان مثله، والذي كان ينجح في إيهامهم أنه مرشد لهم وأنه ليس أعمى، معتمداً على حاستي السمع واللمس.
ثانياً: أن الروائي جعل الحكاء مستمعاً نديماً، هو ليس مساعداً يحقق للحكاية كفاية نحوية؛ بل معيقاً يقطع الحكي ويوقف تدفقه من خلال تكرار ظهور هذا النديم مقاطعاً الحكاء. ولو كان السرد طبيعياً لأفادت الإعاقة البطل ولدفعت بحكايته إلى الأمام. ولهذا استثنى إمبرتوايكو المعوقين كالعميان والمجانين من السرد لعدم قدرتهم على الحكي لمستمع هو غير معاق. (ينظر: القارئ في الحكاية، ص61).
ثالثاً: أن لغة الحكاء الشفاهية بدت مصطنعة وغير قادرة على إيهام المستمعين بمنطقية التخريف عن أمر هو اللاشيء... (سأحكي لكم حكاية طويلة عن لا شيء وجوده مؤكد في نظر أعمى) ص11.
رابعاً: أن معتادية الموضوع الروائي المتمثل في التلون الآيديولوجي وعدم المبدئية في تبني المواقف الفكرية ممثلاً في شخصيتي «حمزة» و«حمدية»، تضادت مع الحكاء «حمادي» وهو يحاول أن يصعِّد وتيرة الحبك غير الطبيعي بأفعال غير منطقية، فتارة يحدد الألوان ويصف الوجوه، وتارة أخرى يرسم انطباعات، من قبيل قوله: «قلبي يدق ويدق، وأرتجف، وأشعر أن وجهي يصير أصغر - هل كان الناس يرون دموعاً تنزل على خدي - وجهاً بني اللون، ليس أسمر، لا بني اللون... قريباً من لون الصدأ... وجه مجدور كله صفحة وعقد ولحية منثورة نثراً»، وبهذا انتفى التعاضد النصي ولم يعد التواصل اللفظي يسند بعضه بعضاً.
خامساً: الكسل السردي الذي يجعل الروائي يرصف الأحداث رصفاً بلا استراتيجية تنفذ إلى تراكيب الحكاية (أريد أن أحكي لكم حكاية ما أدري شنو، حكاية عن لا شيء، الأعمى خير من يحكي عن لا شيء... شنو تحكي عن لا شيء؟ شنو سكرت، فتبسم، إن كنت لا ترى لا شيء وتحكي عنه؛ فأنت بذلك تتحدث وتحكي عن لا شيء) ص9 ـ 10.
سادساً: هذا الرصف يهدر متعة القراءة ويمنع القارئ النموذجي من الاستجابة الجمالية للنص؛ إذ لا قرائن نحوية تركيبية دلالية تداولية تتوفر فيه، من قبيل قول الحكاء: «أتكئ الآن بظهري على جذع شجرة السدر الحنفية الخارجة من الحائط مفتوحة. الماء يتدفق ولا أحد يحبسه». ص99. ولكن كيف رأى الأعمى هذا المشهد لو لم يكن قد سمع صوت الماء؟ وكيف يكون أعمى وهو يرى «الأشكال المرسومة أمامي على الأرض تتراكب ويتعقد تشابكها... لا يوجد منفذ خلالها. أرفع عيني عن نهاية عصاي. عيناي الآن لا تنظران إلى جزء من أجزاء العصا. إنهما تنظران إلى نقطة ما في عمق شارعنا الضيق الصغير. منذ شهور وسنين لم أنظر إلى تلك النقطة أو سواها في عمق شارعنا»؟ ص91.
وهناك أمران يدللان على أن الروائي كان مدركاً المطب الذي وقع فيه حكّاؤه؛ الأول: محاولته التذكير بين الفينة والأخرى وبشكل متواتر بأن ما يراه الحكاء مسند إلى المخيلة؛ فهي التي توحي له بما يراه بعينيه... «فجأة تُنبهني مخيلتي إلى أني تركت ورائي باب البيت مفتوحاً على مصراعيه» ص107. والأمر الثاني توكيده أن ما يراه الحكاء هو عبارة عن لا شيء... «إنك لا تستطيع أن تقول عن الشيء هذا هو الشيء الفلاني إلا إذا حددت صفاته بالضبط... لأني لا أراه؛ فهذا يعني أني أتحدث عن شيء وجوده غير مؤكد بالكامل) ص 10.
وقد حاول الكاتب في آخر سطر من الرواية تبرير منطقية حكايته عن الأعمى «حمادي» بالقول: «حمادي لا يرى؛ إنما قلبه الذي كان يرى في تلك اللحظات» ص317. ولكن كيف يبررها وما زال السرد فيها غير طبيعي وبلا فهم إدراكي معقول؟!
وعدم توفر القرائن هو ما يجعل كثيراً من الروائيين يعافون توظيف الحكاية بطريقة السرد غير الطبيعي، محاذرين الوقوع في مطب الفهم الإدراكي الذي أخفقت رواية «عن لا شيء يحكي» في تحقيقه؛ لتكون رواية غير متماسكة والسبب عدم معقولية قالبها الحكائي.
الحكي بطريقة السرد غير الطبيعي
من الظواهر السلبية في الرواية العربية


الحكي بطريقة السرد غير الطبيعي

لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة