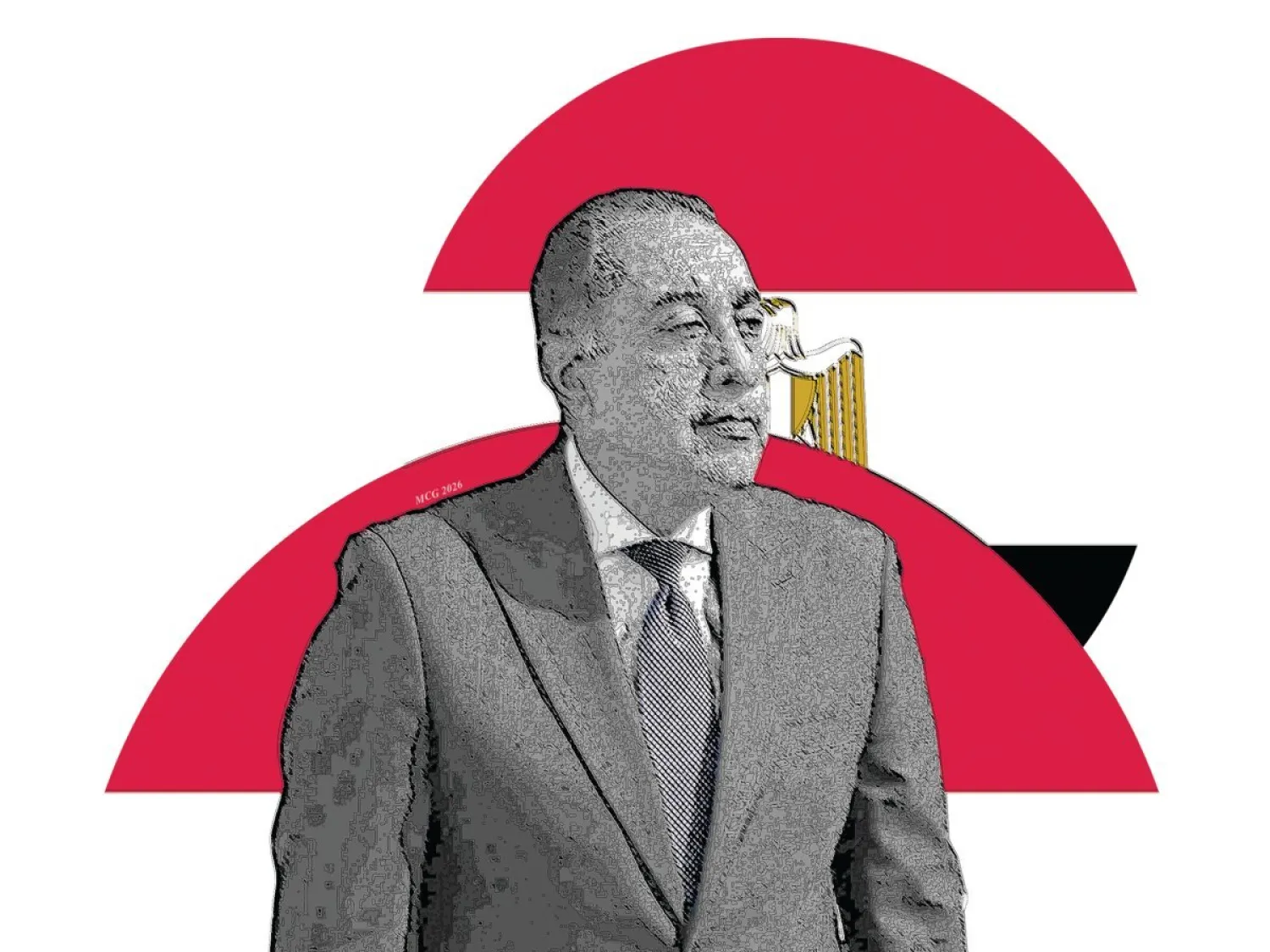بصرف النظر إن كانت الرسالة التي يقال إن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وجهها إلى إيران بشأن موقف متشدد قرر اتخاذه حيال الفصائل المسلحة الموالية لها صحيحة أم لا، فإنها تعطي مؤشراً بأن خطى الكاظمي وحكومته بدأت تسير بخطى أكثر ثقة من ذي قبل. فالرسالة التي أشارت لها وكالة « أسوشييتد برس» لم يصدر نفي عنها من أي طرف من الأطراف، لا إيران ولا العراق. لكن بصرف النظر عنها، فإن التوجه السياسي للعراق بدأ يتجه الآن نحو مسار جديد في علاقاته الإقليمية والدولية، بمن في ذلك إيران والولايات المتحدة الأميركية أو العلاقات العربية. ففي حين بات يحكم العلاقة العراقية - الأميركية هو الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن الذي جرى أخيراً، فإن العلاقة مع إيران دخلت مرحلة تفاهم جديدة بدا فيها ضبط إيقاع الفصائل المسلحة أهم ملامحها. فإيران دخلت الآن مرحلة جديدة مختلفة تماماً عما كانت عليه الأمور على عهد مرحلة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب؛ وذلك بدخولها مرحلة المفاوضات الحرجة مع القوى الغربية والولايات المتحدة الأميركية.
خلال الشهر الماضي، طبقاً للطريقة التي دار فيها بها الحوار الاستراتيجي مع واشنطن، أو الزيارات التي قام بها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن القمة التي تأجلت مرتين لأسباب بدت موضوعية بين كل من العراق ومصر والأردن، يتضح أن بغداد بدأت تفكر خارج الصندوق، وتتحدث عن علاقات واتفاقات في الهواء الطلق. والأهم من ذلك كله، أن حجم الدعم لمثل هذه الخطوات والتحركات أكبر بكثير من الرفض أو الاعتراض من قبل هذا الطرف أو ذاك.
الحوار المتكافئ
الحوار الذي انطلق في السابع من أبريل (نيسان) الحالي في جولته الثالثة بين بغداد وواشنطن يعدّ ولأول مرة أول حواراً متكافئاً بين الطرفين. صحيح أن الحوار يستند في جانب منه إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي وقّعت بين بغداد وواشنطن عام 2009 خلال الفترة الأولى من عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، لكن نقطة قوة بغداد الآن في عهد رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، أنه ليس جزءاً من الإشكالات التي حصلت خلال السنوات العشر الماضية. فطبقاً لاتفاقية عام 2009، فإنه يتعين على الأميركيين الانسحاب من العراق في أواخر عام 2011. وبالفعل انسحب الأميركيون من العراق؛ الأمر الذي ترك فراغاً واضحاً شغله الإرهاب شيئاً فشيئاً بسبب عجز الحكومات التي قامت بعملية الانسحاب عن ملء الفراغ الأمني في المناطق الغربية من البلاد. ذلك أنه بعد نحو ثلاث سنوات اجتاح مسلحو تنظيم «داعش» معظم المحافظات الغربية خلال شهر يونيو (حزيران) عام 2014، بدءاً من محافظتي نينوى وصلاح الدين وأجزاء من محافظتي كركوك وديالى، بينما تمكن التنظيم الإرهابي من احتلال محافظة الأنبار عام 2015.
في هذه الأثناء، كانت السلطات العراقية خلال المرحلة الانتقالية بين حكومتي نوري المالكي وحيدر العبادي عام 2014 قد قدمت طلباً للولايات المتحدة الأميركية بإرسال قواتها من جديد إلى العراق لمحاربة «داعش». وبعد تردد وافق الرئيس (يومذاك) باراك أوباما على استخدام القوة الجوية لضرب مواقع التنظيم، وفي وقت لاحق أرسل قوة عسكرية إلى العراق. ولكن بعد نحو ثلاث سنوات في أعقاب الانتهاء من عمليات التحرير تغير نمط العلاقة بين العراق والولايات المتحدة. ففي حين تريد حكومة بغداد رسم مسار واقعي مع واشنطن في إطار التحالف الدولي، فإن القوى التي تنامت قوتها بعد إعلان تأسيس «هيئة الحشد الشعبي» ودخول العديد من الفصائل المسلحة ضمن تشكيلاتها جعل مهمة بغداد أكثر تعقيداً في التعامل مع هذا الملف.
التركة أم الوديعة
على وقع هذه الإشكاليات تسلم مصطفى الكاظمي، مدير جهاز المخابرات العراقي، منصب رئاسة الوزراء، وكان مجيئه آخر الخيارات الصعبة التي اضطرت بعض القوى السياسية إلى الموافقة عليها.
أبرز ميزات الكاظمي، أنه لم يكن طامحاً لشغل المنصب مع أنه يعرف أن من وافق عليه لن يكون في صفه مهما كان أداؤه. وحقاً، حين تولى منصبه كان عليه مواجهة تركة صعبة جداً زادتها صعوبة جائحة «كوفيد - 19» التي أخذت تتفاقم في العراق خلال الفترة التي تولى فيها الكاظمي منصبه (مايو/أيار عام 2020). وفي جانب آخر، كان عليه الإيفاء بالتزاماته حيال المظاهرات التي اندلعت خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019، وكان الكاظمي أحد الشخصيات التي بدا للجميع أنها مقبولة من قبل أطراف كثيرة في جسم المظاهرات.
وهكذا، مع الحجم الهائل من التحديات والاستهدافات، بما في ذلك استهدافه شخصياً من قبل العديد من العناصر التي كانت تدوس على صوره في الشارع وهي ترتدي الزي العسكري، تعامل رئيس الوزراء بحكمة بالغة، إلى أن تمكن بهدوء يحسب له من امتصاص كل الصدمات التي كان يصعب على مسؤول آخر مواجهتها. وبعد أقل من سنة، اشتد ساعده وبدأ يتحرك بخطى واثقة على صُعد مختلفة، في المقدمة منها العلاقات الخارجية بعدما كان أوفى بوعده على صعيد حسم موعد الانتخابات المبكرة وتحديد آلياتها. وبين التركة الثقيلة من الحكومات السابقة والوديعة التي يتعين عليه التعامل معها، والمتمثلة بالمظاهرات، استطاع مصطفى الكاظمي مد جسور الثقة في الداخل العراقي؛ الأمر الذي جعله يتعامل مع الخارج بإيقاع مختلف.
علاقات ندية لا تبعية
لعل أهم ما تميزت به الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن عاملا الوضوح والصراحة؛ وذلك تمهيداً لتأسيس علاقات متكافئة بين طرفين سياديين لا علاقات تبعية من طرف واحد. وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في تدوينة له على موقع «تويتر»، شارحاً «استطعنا خلال الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأميركية أن نُكرّسَ لمسار جديد يعكس استجابة المفاوض العراقي للمصالح الوطنية في إطار السيادة الكاملة، ليأخذ العراق حضوره المتوازن في شراكة ممتدة ومتعددة المجالات». وأضاف الوزير العراقي «شكراً لمعالي الوزير أنتوني بلينكن (وزير الخارجية الأميركي) لإدارته الوفد المفاوض عن الجانب الأميركي بما يعزّز العلاقات بين بلدينا».
أيضاً، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بدا هو الآخر متفائلاً بشأن إمكانية بناء علاقات متوازنة مع الجانب الأميركي. وفي تغريدة له على «تويتر» قال الكاظمي، إن «نتائج الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بوابة لاستعادة الوضع الطبيعي في العراق، وبما يستحق العراق، وهو إنجاز جدير أن نهنئ به شعبنا المحب للسلام». وأردف، أن «الحوار هو الطريق السليمة لحل الأزمات. شعبنا يستحق أن يعيش السلم والأمن والازدهار، لا الصراعات والحروب والسلاح المنفلت والمغامرات».
وحول هذا الأمر، يقول أستاذ العلوم السياسية في كلية النهرين الدكتور ياسين البكري، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحوار الاستراتيجي نقطة مهمة لتحديد مهام القوات الأميركية الموجودة بطلب من الحكومة العراقية بعد تداعيات دخول (داعش) للعراق عام 2014، ودعم القوات العراقية ومكافحة الإرهاب». وتابع «هذا الحوار يُعدّ بمثابة تأسيس لعلاقات أكثر طبيعية، وفي مجالات تتجاوز الملف الأمني باتجاه تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق وأميركا، التي بقيت من دون متابعة من الجانب العراقي».
كذلك، أوضح البكري، عن أن «تفعيل ملفات الدعم الأميركي وتحديدها خطوة مهمة بالنسبة للعراق الذي يواجه تحديات تبدأ مع الأمن ولا تنتهي به... وهو ما يؤسس لشراكات يحتاج إليها العراق مع قوة عظمى مثل الولايات المتحدة الأميركية»، موضحاً أن «هذا المسار يبقى معترضاً عليه من قبل الجماعات المسلحة لأهداف جُلّها متعلق بالصراع الأميركي ـ الإيراني، ومن هنا، نجد التصريحات أقرب إلى أدوات ضغط متعلقة بالتمهيد لمفاوضات إيرانية - أميركية منها إلى تصريحات تتعلق بالسيادة العراقية». وأكد البكري من ثم «... ومن هنا نجد أن مستقبل التصريحات والسلوكيات، تصعيداً لمستوى راديكالي أو تخفيضاً، مرتبط بمستقبل الحوار الأميركي - الإيراني ومقدمات بنائه معلومة».
هذا، وفي سياق ردود الفعل، فقد رحّبت قوى سياسية عراقية عديدة بنتائج الجولة الثالثة من هذا الحوار. ففي بيانات صدرت عنها، أعلنت قيادات بينها كل من مسرور بارزاني رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان - العراق، ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي رئيس ائتلاف «النصر»، وعمّار الحكيم رئيس تحالف «عراقيون»، وهادي العامري زعيم تحالف «الفتح»... ترحيبهم بنتائج الحوار.
«زمن عراقي» جديد
يضاف إلى كل ما سبق، أن الجانب الإيراني لم يبدُ هذه المرة في وارد فرض الشروط على العراق على صعيد كيفية إدارة الحوار مع واشنطن. إذ إنه في عام 2015 حين جرى التوقيع على الاتفاق النووي بين إيران والمجموعة الغربية (5 زائد 1) كان الزمن مختلفاً. وصحيح أن الرئيس الحالي جو بايدن كان نائباً للرئيس، لكن الرئيس (يومذاك) باراك أوباما كان متحمساً للتوصل إلى اتفاق يوقف برنامج إيران النووي لمدة عشر سنوات... وغير معني عملياً بوقف تمددها في المنطقة. ولكن بعد مجيء دونالد ترمب إلى السلطة في واشنطن تغيّر الوضع، وأخذت الأوضاع تأخذ مساراً آخر. هذا المسار الآخر الذي تمثل بتولي بايدن الرئاسة هذه المرة لم تأخذه إيران كثيراً بنظر الاعتبار. فالقيادة الإيرانية، لا تزال تنظر إلى بايدن القديم، وبالتالي، بنت تصوراتها على صعيد المفاوضات معه بدءاً من حيث توقف الزمن عام 2016، بينما يرى مراقبون أن بايدن النائب غير بايدن الرئيس.
أيضاً، بين الزمنين الإيراني والأميركي هناك «زمن عراقي» تمثل بسقوط حكومة عادل عبد المهدي، القريبة من طهران، وتولّي حكومة جديدة هي حكومة مصطفى الكاظمي لا تبدو على المسافة نفسها من القيادة الإيرانية، على الأقل من وجهة نظر الفصائل المسلحة التي ناصبت الكاظمي العداء بينما تبدو علاقة رئيس الوزراء الحالي مع إيران الرسمية على الأقل طبيعية.
في سياق هذا «الزمن» الجديد الذي بدأ يتبلور بدءاً من سلسلة إجراءات اتخذتها حكومة الكاظمي، وصولاً إلى الحوار الاستراتيجي، يقول مستشار رئيس الوزراء العراقي الدكتور حسين علاوي في حديث لـ«الشرق الأوسط» عن هذا الحوار «إن انطلاق المرحلة الثالثة من الحوار الاستراتيجي العراقي - الأميركي نجاحٌ يحسب للحكومة العراقية وحكومة الرئيس بايدن». ويستطرد موضحاً، إن «الإصرار من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على نقل العلاقات نحو أفق أوسع من الجانب الأحادي إلى الجوانب المتعددة سيكون كفيلاً بدعم التجربة الديمقراطية ومكافحة الإرهاب».
ويضيف علاوي، أن «انعقاد هذا الحوار يأتي في ضوء اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين». وبشأن طبيعة القضايا التي ستتناولها هذه الجولة من الحوار، يفيد بأن «هذه الجولة ستتناول قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب، والاقتصاد والطاقة، والمسائل السياسية والتعاون في مجال التعليم والثقافة».
وبشأن الوجود الأميركي في العراق وما يمثله من خلافات، يرى علاوي أن «هذه القضية واحدة من القضايا الأساسية التي يتناولها هذا الحوار، ذلك أن الوجود الأميركي، وكما يعرف الجميع، هو وجود استشاري... إذ سبق سحب أعداد كبيرة من المستشارين الأميركيين ولم يتبق منهم اليوم سوى 2500 مستشار». وهنا يؤكد حسين علاوي، أن «الحكومة العراقية تعمل على تخفيض عدد المستشارين من خلال وضع جدول زمني مشترك على مدى ثلاث سنوات، مع تحديد المهمة الأساسية لعمل البعثة الاستشارية الأميركية هي لمحاربة فلول التنظيم الإرهابي (داعش) وتدريب القوات العراقية المشتركة». ويختتم بالقول، إن «من بين البنود التي يتضمنها هذا الحوار وضع خطة لتدريب القوات العراقية، وتقديم الاستشارة للقوات العراقية المشتركة ضد فلول (داعش)».