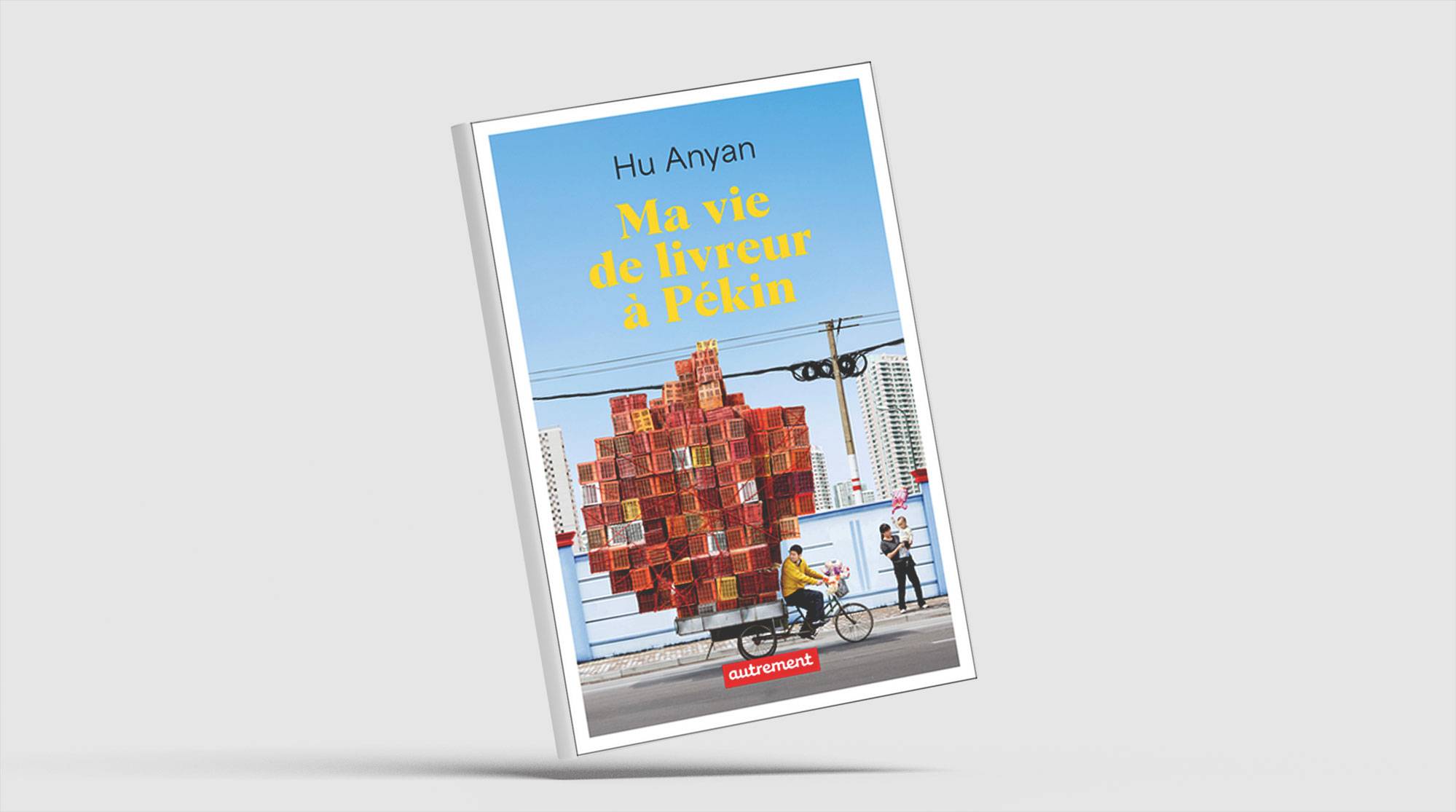ما الذي يمتاز به صوت محمد عبد المطلب من خصائص فنية تجعل أغانيه لا تزال حاضرة بيننا بعد مرور فترة طويلة على رحيله، يطرب لها ويرددها المثقفون والناس الشعبيون في مجالسهم الخاصة على حد سواء.
هذا ما يكشف عنه كتاب «محمد عبد المطلب - سلطان الغناء». الكتاب صدر أخيراً للكاتب المصري محب جميل عن دار «آفاق» للنشر والتوزيع بالقاهرة، ويقع في 198 صفحة، وكتب مقدمته المؤرخ الموسيقي اللبناني الدكتور فكتور سحاب الذي يقول: «لم نسمع في الكون، صوتاً أجش وأبح، ومع ذلك يطربك طرباً جارفاً يبلغ بالمستمع العربي أقصى درجات المتعة».
يقتفي الكتاب رحلة محمد عبد المطلب الطفل الخامس بين إخوته الذي ولد عام 1910. الذي كان يقضي وقته بين حقول القطن والقمح، يحفظ القرآن الكريم ومبادئ القراءة والكتابة. يقول المؤلف عن ذلك: «اعتاد أن يغني لرفاقه بين الحقول ما حفظه من طقاطيق المطرب عبد اللطيف البنا، فيشب على محبة كتب (الطقاطيق) التي يبتاعها من مصروفه الزهيد، وفي مفارقة أولى يجد الطفل نفسه في مواجهة مطربه المفضل آنذاك عبد اللطيف البنا في أحد الأفراح، وعندها تبدأ أولى محطاته بعد أن يضمه البنا لفرقته الصغيرة التي تجوب أفراح القرى آنذاك، وصولاً لمحطة تعلمه الموسيقى والغناء على يد الملحن الراحل داود حسني، أحد ألمع العاملين في المسرح الغنائي في ذلك الوقت، وظلت نصيحته الأغلى التي ظل عبد المطلب يتذكرها حتى أيامه الأخيرة كانت اقتراح حسني عليه أن يصعد مئذنة أحد مساجد حي المغربلين وسط القاهرة ليؤذن الفجر حتى تستقيم أحباله الصوتية».
خلف عبد الوهاب
يمر الكتاب على مشاهد تنقل الشاب محمد عبد المطلب ساعياً وراء حلمه وزاده إيمانه بقدراته الصوتية وحبه للغناء إلى أن وضع اسمه بين نجوم الصف الأول في الأغنية العربية في القرن العشرين. وينقل لنا بداياته الفنية ولحظة اعتلائه المسرح ليتحشرج صوته أمام الجمهور في لحظة إحباط وتعثر لم ينسها طوال حياته، كما لم ينس أولى حفلاته عام 1926 على مسرح الأزبكية بمرافقة تخت موسيقي، التي لم تكلل بالنجاح المنشود، حتى كانت المحطة التي غيرت من شكل حياته آنذاك، وهي زيارته لبيت الموسيقار محمد عبد الوهاب.
ينقل الكتاب على لسان عبد المطلب في أحد أحاديثه: «ذهبت إلى المطرب محمد عبد الوهاب، وكان يومها مطرباً مشهوراً ومعروفاً في الحفلات العامة والأفراح الكبرى، وطلبت منه أن يلحقني بفرقته لكي أعمل ضمن الكورس الذين كانوا يُسمون في تلك الأيام المذهبجية». تلك الزيارة لم تمنح فقط عبد المطلب عملاً في وقت ضاق فيه العيش، ولكنها أيضاً كانت فرصة لتجديد ثقته في نفسه: «قلت في نفسي: لو لم أكن أملك صوتاً جيداً، لما قبلني مطرب كبير مثل عبد الوهاب ضمن أفراد فرقته حتى لو ولو كان عملي فيها لا يزيد عن مذهبجي يغني وراءه، فهو بالتأكيد يكره أن يسمع صوت نشاز بين أفراد فرقته».
قضي عبد المطلب سبع سنوات من عمره وراء عبد الوهاب، يقف خلفه في الأفراح والحفلات، يردد مع المذهبجية مقاطع من أغنياته، ثم تتغير الأقدار ليقرر مغادرة فرقة موسيقار الأجيال ويبدأ بداية غنائية جديدة.
مفارقات البدايات
تتقاطع سيرة عبد المطلب (1910 - 1980) مع حالة الصخب الفني في ثلاثينيات القرن الماضي التي تجلت في صالات شارع عماد الدين الشهير، الذي يقول عنه المؤلف: «كان شارع عماد الدين في وسط القاهرة تلك الأيام أشبه بشارع برودواي الآن في نيويورك، حيث صخب الفرق الاستعراضية والمسارح الغنائية، هنا يتعرف عبد المطلب على الموسيقار فريد الأطرش، وبديعة مصابني، وتشاهده أسمهان في إحدى وصلاته وتمدحه، ويظهر اسمه للمرة الأولى في موسم عام 1934 ضمن استعراض (شهيرات النساء)، وفي إحدى الليالي من تجليه في الطرب أمطره الجمهور بريالات من الفضة والجنيهات الذهبية، ومن هنا توالت ليالي الصخب ليعلو صوت عبد المطلب مُتذوقاً طعم النجاح، ومنه إلى مسارح الإسكندرية». ولكنه لم يجد هناك الإعجاب والتقدير ذاته لصوته، فلم يستقبله الجمهور بتلك المدينة الساحلية بترحيب، حتى أنه في إحدى حفلاته بها رماه الجمهور بالبيض والطماطم. ولعل هذه كانت، كما يضيف مؤلف السيرة، واحدة من المرات التي لم ينسها عبد المطلب، فقد خرج إلى الشارع يبكي من شدة تأثره. وهكذا تأخذ الدنيا عبد المطلب من القمة للقاع، لكنه انتشله من هذا الهبوط لقاؤه بالكاتب المسرحي بديع خيري ونجيب الريحاني لتبدأ رحلة ليست باليسيرة حتى يتربع على عرش الأغنية الشعبية المصرية.
ومن أبرز أغنيات عبد المطلب في تلك الفترة «ساكن في حي السيدة»، و«رمضان جانا» و«ودع هواك»، وتعد من أبرز الأغنيات التي استقرت في الوجدان الشعبي، لتُقيم في الذاكرة إلى اليوم بكلماتها المشهدية والبصمة الذاتية الشجية لصوت وأداء محمد عبد المطلب.
وأدرج الكتاب ملحقاً كاملاً عن السيرة التي رواها عبد المطلب عن نفسه مقتبسة من نصوص حوارات صحافية معه، من بينها سؤال وُجه له في حوار عام 1967 عما يُميز شخصيته الفنية فقال: «إن لي شخصيتي الخاصة في الغناء، وفي هذه الشخصية الشعبية تكمن أصالتي، وقد أثبت الزمن أنني كنت على صواب عندما أبيت التغيير، فجمهوري يزداد كل سنة عن ذي قبل. يسمعني الشباب المودرن والرجل الذي في عمري»، بالإضافة لملاحق عن أشهر أغنيات عبد المطلب، ومجموعة نادرة من الصور على مدى مراحل حياته المختلفة، ومراجعة للأسطوانات النادرة التي سجلها في بدايات العشرينيات وحتى منتصف الثلاثينيات، ولقطات طريفة وردت في أحاديثه الصحافية كوصفه لطربوشه الذي كان يعتمره عادة، ويقول عنه: «طربوشي هو سر نجاحي فيما أعتقد. فقد أصبح بمرور الأيام جزءاً من شخصيتي، وجمهوري يحب طربوشي كما يحبني، لو تخليت عن طربوشي في أي حفلة غنائية، لضيعت نصف تصفيق الجمهور على الأقل».