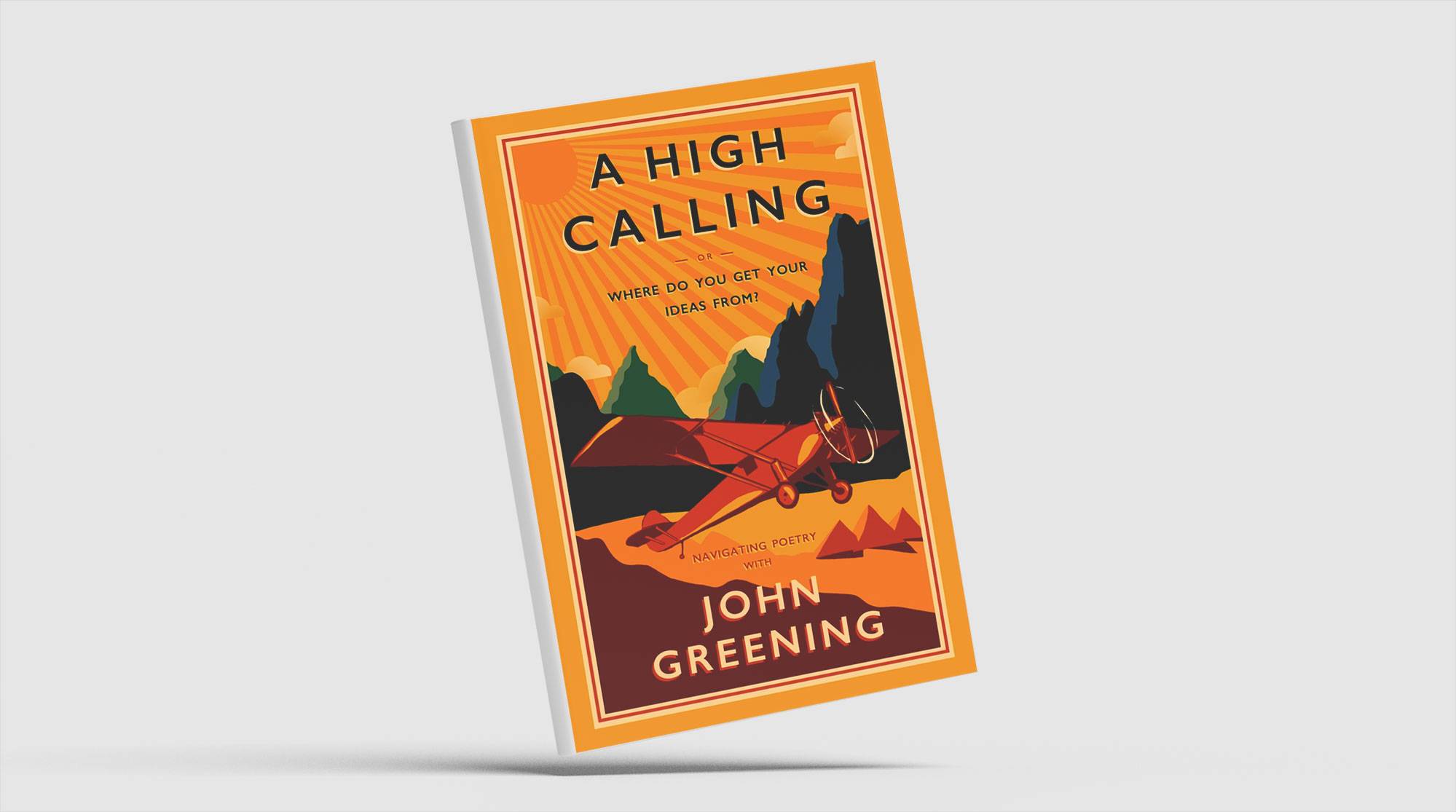بكلمة اعتذارية للقارئ، يدشن الشاعر أسامة مهران ديوانه الأول «حد أدنى» الذي تأخر صدوره طيلة 40 عاماً، محاولاً استعادة مناخ شعراء جيل السبعينات في مصر الذي ينتمي إليه. ويبرر ذلك بالمراجعة والفرز والتمهل والخوف من الفشل، وسط ظروف ومناكفات متشددة في قضايا الفن والواقع، لم يعد فيها «الحسن العربي» خالصاً لنفسه وزمنه وفطرته. لذلك أراد أن يتقدم إليه بأوراق اعتماد «ليست مصابة بجروح، أو معيبة بطموح، أو معنية فقط بتاريخ. كان لزاماً عليّ أن أفرز كل ما يخرج ليعيش». وبتواضع جم، يطلب من القارئ العفو عن التقصير في حقه على مدار كل هذه السنين، ويهيئه لمصالحة يرى أنها «ضرورية بين كل ما كتبت، وكل ما قررت أن أقدمه إلى المتلقي».
نعم، اعتذر الشاعر للقارئ، ولم يعتذر للشعر، قارئه الأول الاستثنائي، الشعر ابن الحياة والجمال، ينتفض الزمن ويلهو فيه كطفل، ويتسابقان على من يلمس الحقيقة أولاً. ثم ماذا لو لم يوجد القارئ، هل يكف الشاعر عن كتابة الشعر، تماماً مثل الفنان لو لم يوجد المشاهد للوحته، وماذا أيضاً لو اعتذر الشاعر للشجرة أو البحر أو الصمت، بصفتها قراءه، وكراسه المفتوح على براح الطبيعة والجمال، يخط فيه ويمحو ما يشاء من دلالات ورموز، ومعاني وأفكار؛ هل نحسبه مختلاً أو مجنوناً. الشعر لا ينتظر أحداً، لا يحمل حقائب أو جوازات سفر إلى أمكنة محددة، الشعر ينتظر نفسه دائماً.
ورغم ذلك، يبدو هذا الاعتذار وعياً هارباً من الشاعر على مدار كل تلك السنوات، مشكلاً ما يشبه المرثية الخاصة، ليس فقط باعتبار ما كان، وإنما باعتبار ما سيكون، هذه المنطقة المراوغة في حفرة الزمن التي تناور وتلعب فوق سطحها الذات الشاعرة، كأنها تريد أن تستعيد بئرها الأولى، بعد ما لحق بها من عطش وجفاف.
الديوان صدر منذ بضعة أشهر عند دار «الأدهم» للتوزيع والنشر بالقاهرة، ويشكل عنوانه «حد أدنى» عتبة أساسية للوقوف على عالمه الفني... نعم، ثمة حد أدني لكل شيء، بل للوجود نفسه، هناك سقف يجب المحافظة عليه حتى لا نعرى، ونصبح نهباً للفراغ. لكن، ما أقسي الحد الأدنى في الشعر، ابن المغامرة والتجريب المفتوح على كل شيء، بلا فواصل وعقد زمنية سميكة في العناصر والأشياء، هناك قواعد وقوانين وركائز لا حد أدني لها، فجدلها صيرورة دائماً بين الحركة والثبات، بين الوجود في هشاشته وضعفه الإنساني وقوته التي تنهض من بين ركام هذا الضعف، وتحيله إلى نقطة مضيئة كاشفة في مثلث الذاكرة والحلم والواقع، ناهيك من أن معيار الحد الأدنى يشي بأن ماهية الأشياء فيما ينتسب إليها، وليس في كيفية العلاقة بينها وبين هذا الانتساب.
ربما لذلك، يحرص الشاعر دائماً على أن يوفر حداً أدنى من الوضوح لقصيدته ذات البنية التفعيلية الراسخة، فهي مسكونة دائماً بالهم العام، بدلالته السياسية والاجتماعية والتاريخية؛ يحكم هذه الهم مدار القصيدة، ويشكل فاعليتها حتى في علاقة الذات العاطفية بالمرأة والحب والحياة. يلوح هذه الهم في الديوان، ويراوح بين الوضوح، ابن المباشرة الممسوسة بما يمكن تسميته «واقعية اللحظة»، وبينه حين يتخفى في غلالة الرمز والدلالة. يطالعنا ذلك في قصيدة «مشربية من زمن المعز» التي يستهل بها الديوان، ويقول فيها:
«منذ سلامة مقصدنا
دمدمتُ
هل ما يفعله نخيلُ الرغبة
في أنفسنا يشفع للمتشفَّي
فينا أن يرتاحْ
أن يصفح عنَّا
أو يمنحنا سر المفتاحْ؟
هل ما ترقبه أيدينا
أو ما تنثره سوءاتُ مشاربنا
أو ما ينقصنا في حَلق معانينا
يسمح ببكاء آخر
أو فَرحْ؟
قد تنغمس اللذة في الأوجاع
وفي الجرح.
قد يندمل الإسهابُ
وقد يكتمل الشرح».
يتوجه الخطاب بشكل ضمني إلى المعز لدين الله الفاطمي، مؤسس مدينة القاهرة، في شكل رسالة مسكونة بالسؤال والحنين إلى لحظة غابرة لا تزال روائحها تفوح في غبار التاريخ والأيام. وبنظرة انتقائية، تتخذ القصيدة من رمزية «المشربية - الشرفة» دلالة على ذلك الزمن، لكن البون يتسع فنياً بين الرمز والدلالة، بين المشربية بنسقها «الأرابيسك» الفني المعشق، وجماليات تكرار العناصر والوحدات ودقة وبراعة التكوين، وبين القصيدة التي اعتورها أحياناً تعسف القافية ولي عنق اللغة من أجل الوصول إليها. وفي مقابل زمن المشربية بصفتها مرثية شعرية، يتراءى الحاضر المسفوك بالدم والذبح الذي لا يعرف كيف يرثي نفسه في «فوضي الأشياء الصغيرة» وفي «رمية قرص».
وتتكشف مأساوية الحاضر في قصيدة أخرى أكثر تماسكاً وانسجاماً، على مستويي الرؤية والتشكيل، بعنوان «أجراس معلقة على مآذن المعز»، حيث تبدو القاهرة صوتاً آخر، ومدينة أخرى، ابنة لحظتها الخاصة، ويتماهى سؤال الذات بالبحث عن الأنثى الخلاص، المستحيلة، وسط مشاهد من أجواء ثورة 25 يناير (كانون الثاني) تطل كوميض خافت، بزخمها في الشوارع والحناجر والميادين، بينما تتحول مآذن المعز وأجراسها وسط الغبار إلى رمز لصلاة منسية محرمة مجروحة على أرواح ضحايا وشهداء اغتالتهم يد الغدر والخيانة:
«لا أعرف من أين أتيتِ؟
وإلى أين ذهبت؟
ولماذا تنتصرين الآن على نفسكِ؟
هل كانت كل مقاومتكِ إفكاً
يتحكم في مشروع حياتي؟
هل أنفض عن جسدي
حِملَ كراماتك
وأطارد روحاً شريرة بفتات الصدقات؟
لا ينفع أن أتسامح أو أتصافحَ
في عز الثورات
فجميع القتلة مشغولون بوأد الفتنة
واستقبال العام القادم
كُفِّي عن غضبك سيدتي
وكفاكِ ظهوراً في المرآة».
يحتشد الديوان برموز الفيضان والنهر والخصب والرذاذ، والمطر والميدان، كما تتناثر بقع من الحزن والبكاء والفقد والرحيل والهديل، وأحياناً يضع نفسه في المفارقات الثنائية المتعارضة، محاولاً كسر المسافة وتضييق الفجوة بينها، والبحث عن مشترك إنساني يلم شتاتها، ولو في شكل بوح خاطف ومناجاة شجية لا تجد سوى حرقة المقارنة سبيلاً للوصول إلى الوطن، أو الأنثى، أو الحرية، أو إلى اللاشيء، فليس ثمة ما يوحد بين «أنتِ وأنا» سوي حرف «الواو» المضطرب الملول الذي يقبع مجرد أداة وعلامة عابرة للعطف والشفقة بين كيانين يفتشان عن ظل آخر يوحد بينهما في متاهة الحياة.
ربما لذلك، دائماً يطل الحاضر بدواله ورموزه في الديوان مشوباً بالخوف والقلق والتوتر، كما أنه لا يطل على ذاته من نافذة تخصه، إنما من نافذة بلاغة تقليدية وماض لا يعرف كيف يفارقه، ليلتصق به بإرادة حرة وعين أكثر اتساعاً وحيوية على المستقبل والوجود:
«كان الماضي الأجمل
يتوارى في الأذهان
يطل علينا من وادٍ
ينتحل النسيان
وعيونُ الصُّبح المرهقة الرؤيا
تتجلى في نظرة عشقٍ
في لفتة فنانْ
لبلادٍ جاءتْ
وبلاد رحلت
من دون مكان».
ويتناثر جدل الصدى والصوت، الصورة والأصل، في كثير من قصائد الديوان، في محاولة لإبراز حسية الصوت واللغة، وكسر أحادية المشهد واللقطة والرؤية، بحثاً عن مرثية خاصة للذات، والحلم والوطن والأشياء، مرثية تشبه النغم والأغنية، والمغفرة أحياناً. هنا، يرتفع إيقاع الغنائية في الديوان، وتصبح المرثية بمثابة صدى للحن قديم يتسلق أسوار الذاكرة والحلم، ويكمل دورته حضوراً وغياباً في ظلالهما... هكذا، يبدو المعنى في قصيدة بعنوان «وطني وصباي وأحلامي» تتناص مع أغنية عاطفية شهيرة بالاسم نفسه، توحد بين معنى الوطن والأنثى:
«أسميتكِ
تاريخ ميلادي
وحصوة ملحٍ
من طينة أجدادي
لن أسألكِ
عن لون طباعك
عن قفاز ذراعك
عن شكلكِ حين تلمين
الضوءَ الخافت
من جوف الأبعاد
لا أغزو صفحتك الرسمية
كي أعرف عنك
ما لا أعرفه بحرية
لم أفرض نفسي
أو أرمي حملي الأثقل
في حيرة عينيك
أو رعشة كفيك».
وبعد... لم يستطع أسامة مهران أن ينتظر وصول قطار السبعينات الشعري في موعده، فحمل حقيبة شعره الغض ورحل عن البلاد، وها هو يعود بعد كل هذه السنوات، بعدما وصل القطار وغادر المحطة إلى محطات كثيرة، لكن لا بأس من أن يفرغ حقيبته، ويتأمل في هذا الديوان وأعمال أخرى لاحقة، صورة أخرى لقطار آخر أرجو أن يصل إليه بحب وشعر.
أسامة مهران يستعيد شعرية السبعينات في مصر
بعد أربعين عاماً يصدر ديوانه الأول «حد أدنى»


أسامة مهران يستعيد شعرية السبعينات في مصر

لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة