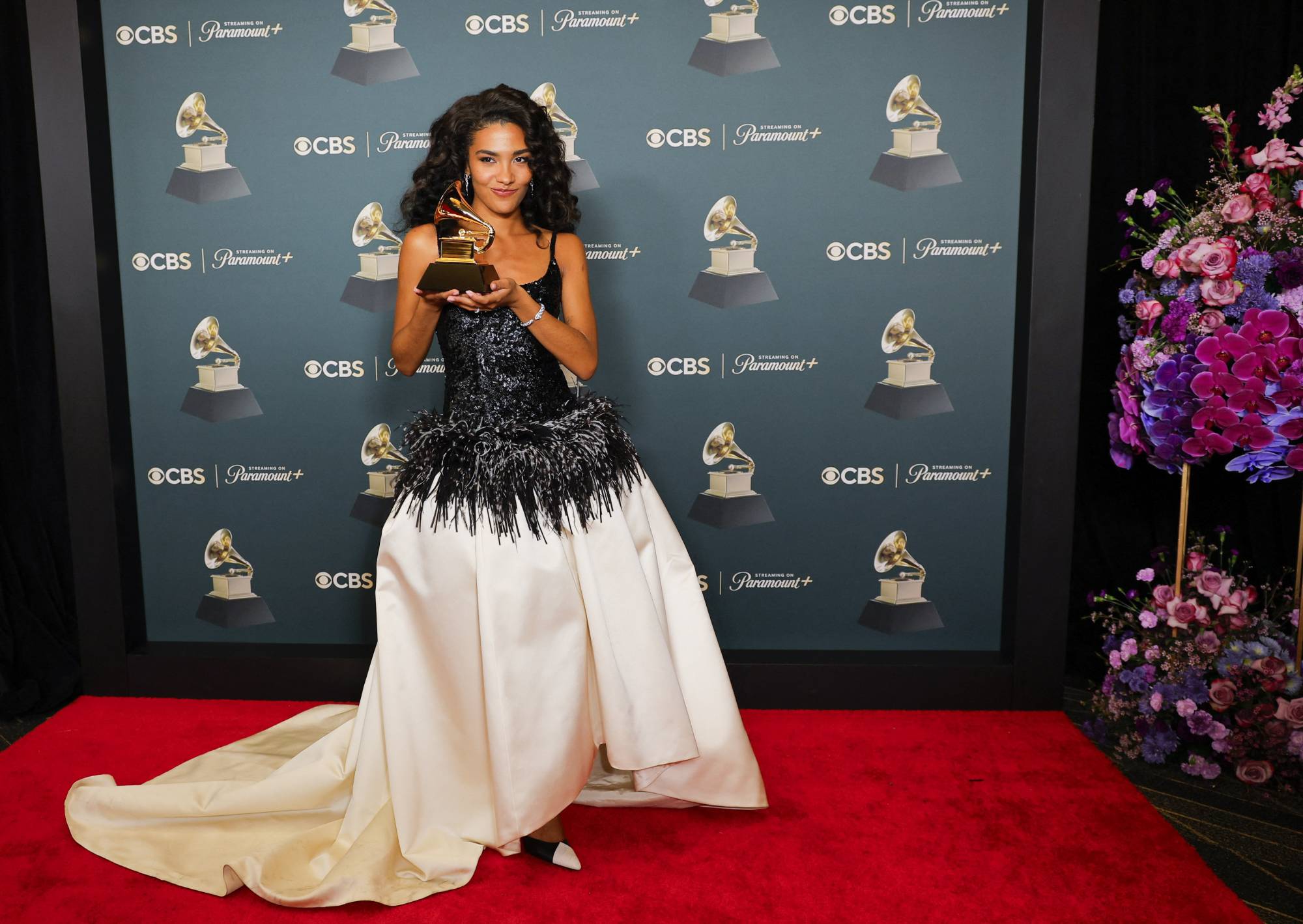في مخبأه السري يشرع الرئيس بكتابة سيرته؛ ليُجيب عن سؤال يُفترض أن الأبناء سيسألونه وهم في لجة الفوضى العارمة: ماذا حدث؟، لكن الرئيس الذي يفكر بالكتابة حلاً لمشكلته المستعصية في مواجهة موته المحتم وذاته التي لا يجدها فيما يكتب، يحار بجملته الأولى، هل تتعلَّق بنشأته الأولى، بداية مشواره طفلاً فقيراً يسير متوارياً خلف عباءة أمه السوداء في أزقة المدينة طمعاً في ما سيجيد به من تقرأ له الأم طالعه، أم تختص بخاتمته رئيساً يهرب من قصره متخفياً بعد أن سقط حكمه واحتُلت بلاده؟ وفي الحالتين لا كتابة، فلا يكتب الرئيس سوى ثلاث جمل تتعلق جملتان منها بطفولة بائسة، في حين تتحدث الثالثة عن معنى أن تعيش في حضانة رجل قاسٍ يجبرك على أن تسبح بالنهر في الشتاء القارص، ويجري شطب الجمل الباقية، فلا يصلنا منها سوى توتر الرئيس واضطرابه. في الجملة الأولى، وهي أقرب إلى صورة يستعيدها الرئيس عن طفل يسير خلف أمه، يصطدم الرئيس بوضعه القلق والمربك، بين كونه راوياً يحاول أن يسرد لنا قصته، وبين فهم المتلقين لما سيكتب؛ فالكتابة عن طفل فقير مغرية وتمدُّ الراوي بتفاصيل كثيرة مشوقة، لكنها تدمر صورة الرئيس في عيون شعبه، إنها تحطيم لـ«أيقونة» الزعيم الذي اخترع شعباً يخافه حد العبادة. في حين تظهر خاتمته بداية مغرية لسرد القصة؛ فلا إثارة يحققها مشهد طفل فقير يعيش في قرية منسية على دجلة، إنما الخاتمة بعودة الرئيس المخلوع إلى قريته تلهم الذاكرة وتحفزها على استعادة ما حصل، وتقدم جواباً عن سؤال الأبناء القادمين: ماذا حدث؟
ولا كتابة، ولا سيرة يتركها لنا الرئيس، ذلك أن الكتابة تتعلَّق بالتفاصيل التي لا تستعيدها الذاكرة. ثمة عجز يتواصل وتتضح تفاصيله عن كتابة السيرة، وهو العجز ذاته عن التذكر. وفي هذا العجز تكمن مشكلة رواية وراء الرئيس الهارب «دار الكا، بغداد، 2019». ولا بأس؛ فلكلِّ رواية مشكلة تحاول حلَّها، فالرئيس يعجز عن كتابة سيرته؛ لأنه لا يستطيع استبدال الكتابة بالسلطة المفقودة؛ هو الراوي الوحيد، كلي المعرفة والوجود، للقصة الوحيدة المتاحة للجميع والمفروضة عليهم فرداً فرداً، وقد عاشها وكتبها حدثاً فحدثاً، فصلاً ففصلاً، طيلة خمسة وثلاثين عاماً؛ فكيف للكلمات أن تعادل السلطة بقصتها المتكاملة؟ إن الاستسلام للكتابة يعزز فقدان القدرة على استعادة القصة الوحيدة التي أجاد الرئيس كتابتها، وهي تمثيل السلطة بامتلاكها، ويُفيد كذلك أن الموت صار الحكاية الوحيدة المعبرة عنها بقول الرئيس لنفسه «سأموت». فإذا كانت فكرة كتابة المذاكرات، أو السيرة الذاتية للرئيس، قد حضرت في ذهن ووجدان الرئيس تحت ضغط وإلحاح الموت، وإن عليه أن يحسم الجدل القادم، لا محالة، بين الأبناء المختلفين بصدد الإجابة عن السؤال المفترض «ماذا حدث؟»، فإن الرئيس نفسه غير معني بهذا الجدل، هو رافض للاستسلام له؛ فهو قد عرف أنه لا يجد ذاته فيما يكتب ويتذكر؛ هذه الذات المضيّعة كان الرئيس قد وجدها وتمسّك بها وهو يكتب قصته – سيرته المحببة بدماء وحياة أبناء شعبه كونه الحاكم الأوحد للبلاد، فأما ما بعد فقدان السلطة فلا قصة، لا سيرة. هذه الحقيقة فعلت فعلها في نوفيلّا الجزائري، فكانت نتاجاً لها على كل الصعد، بدءاً من العنوان إلى الاقتصاد في التفاصيل، وليس ختاماً بعدد صفحات النوفيلّا.
يختصر عنوان النوفيلّا، وراء الرئيس الهارب، كلَّ شيء في هذه الرواية؛ فهو ترجمان للنص. نحن هنا إزاء تعقُّب وتتبع لمسار الرئيس الهارب. والتتبع هو إحدى الدلالات العميقة للقص. لكن هذا التتبع يُحايث ما حدث حقاً وحقيقة على أرض الواقع؛ فالرواية تقص أثر الرئيس، تتبع خطواته خطوة فخطوة. تبدأ النوفيلّا من لحظة السقوط المريعة، بعد انفجار ثانٍ مخنوق يقرر الرئيس الرحيل، إلى أين؟ لا يعرف! ثم تبدأ رحلة الهرب. نتتبع خطوات الرئيس المختبئ في جوف شاحنة بين دواليب الملابس وأثاث بيت يهرب أصحابه من الموت في الشوارع بعد احتلال البلاد. يتخذ الرئيس وضع الوقوف، وينظر إلى عاصمة بلاده المحتلة، بل إلى شعبه الجائع الذي خرج من البيوت القديمة، الآيلة للسقوط، إن لم تسقط وقتها حقاً، ليمارس شهوة الانتقام من سلطة الرئيس الهارب. من فتحة بين الدواليب ينظر ويرى كيف يسحل الجياع المنتقمون رؤوس تماثيله، ويسأل نفسه من أين جاء هؤلاء؟ والجواب حاضر دائماً: إنهم لم يخبروا الرئيس. مساعدوه وكبار ضباطه أخفوا عنه حقيقة الأمر، حقيقة البلاد. هو نفسه يختصر، كما عنوان هذه النوفيلّا، سيرته بالمباغتة التي تصنع الخوف ويتحول، بالتراكم، إلى حب وحاجة؛ فلا قيمة لسؤاله، إنما هو العتبة الأولى الممهِّدة لتمثيل فعل الندم، ندم الرئيس على ما فعله بنفسه وبلاده.
يفرض العنوان كل هذا؛ فنحن نتعقَّب مسار الهرب بالتوازي مع ما حدث في الواقع، كما لو أننا أمام فيلم يعرض قصة هرب الرئيس من قصره. ومما يفرضه هذا الأمر، ويمهِّد له هو الاقتصاد في التفاصيل. وهذه مفارقة تستحق المناقشة، فلا سيرة من دون تفاصيل، وقد نقول إن السير إنما تنمو وتتعمَّق بوفرة التفاصيل. فهل كانت النوفيلّا مهتمَّة بتفاصيل فعل الهرب، أم كانت مختصة بكتابة سيرة موجزة للرئيس الهارب؟. لقد جعل الاقتصاد بالتفاصيل الرواية سيرة مختصرة تختص بفعل الهرب نفسه، ويندرج في هذه السيرة رغبة الرئيس ذاتها بكتابة سيرته، هي بعض مما فرضه العنوان، مثلما فرض كذلك الاقتصاد في عدد صفحات هذه النوفيلا؛ إذ لا يزيد عدد صفحاتها على خمسٍ وسبعين صفحة.
ولكن، لماذا كل هذا الاقتصاد في التفاصيل، ومن ثمّ في عدد الصفحات؟ لماذا كان على مؤلف كتاب الطاغية المستبد، ذي التفاصيل المتسعة والمتداخلة، أن يقصر روايته على فعل الهرب وما يتصل به من تتبع وتقصّ، لا عن لحظة السيرة؟ في رواية سابقة لزهير الجزائري، عن موضوع وعالم مجاور، يختص بالخائف والمخيف، كنا إزاء وفرة وتوسُّع في التفاصيل؛ فعالم الخائف هو ذاته عالم المخيف؛ فلولا الخوف ما كان هناك خائف ولا كان هناك مخيف، وكلاهما اسم فاعل في النهاية، غير أن قصة الرئيس مختلفة كلياً عن قصة الخائف والمخيف.
وراء الرئيس الهارب تشح التفاصيل، وتغدو الرواية تمثيلاً سردياً لمنطق الهرب والندم على ضياع السلطة. ثمة توازن بين عجز الرئيس عن الكتابة والاقتصاد في السرد والتقصي، وبين العجز عن كتابة سيرة الديكتاتور لدى الكتَّاب العراقيين، وممثلهم هنا كاتب الرواية. ولا أظن أن هذا الأمر يقع على عاتق الكاتب وروايته، أو يشكِّل مثلبة عليه وعلى روايته؛ ذلك أن رواية الديكتاتور، كما تقدِّمها روايات أميركا اللاتينية، تبني عوالمها السردية على أساس من وجود التفاصيل المبذولة في الملفات الخاصة عن حياة الديكتاتور؛ فهي قصته وسيرته الشخصية المستمدة من الملفات المعاد تخيَّلها في روايات كتاب أميركا اللاتينية، وهو ما فعله، بالضبط، صاحب رواية عالم صدام حسين الذي لا نعرف حقيقة جنسيته، لكن روايته تقول لنا إن مؤلفها قد قرأ الملف الشخصي لصدام حسين وما يتَّصل به من ملفات ساندة. وهذا أمر غير متوافر في الحالة العراقية، فأين هي ملفات صدام الذي تذكره نوفيلّا الجزائري باسمه الشخصي المعروف، كما تنص على غيره من الأسماء العراقية الحقيقية المرتبطة به؛ هل يملك العراق ملفاً شخصياً حقيقياً عن حياة صدام؟ بيقين أقول، كلا، وألف كلا؛ فكلُّ شيء جرى تدميره أو سرقته أو حرقه وإتلافه، وكأنهم لا يريدون للعراق أن يكتب روايته الخاصة عن الديكتاتور العراقي السابق .
إن عجز الرئيس في نوفيلّا وراء الرئيس الهارب يترجم لنا عجزاً مماثلاً على صعيد الرواية العراقية عن كتابة رواية ديكتاتور ينفرد بها العراق وحده دون سائر البلاد العربية. لماذا هذا التخصيص؟ لأنه لا ديكتاتور في العالم العربي غير الديكتاتور العراقي، وهذا حكم الثقافة والتاريخ والجغرافيا والمعرفة أيضاً، مثلما إن لا منفى، عربياً، غير ما أنتجه الشتات الفلسطيني والمنفى العراقي المتواصل بعنادٍ ووقاحة لا غفران لها.
زهير الجزائري يكتب «نوفيلّا» أخيرة عن سيرة {الرئيس الهارب}


زهير الجزائري يكتب «نوفيلّا» أخيرة عن سيرة {الرئيس الهارب}

لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة