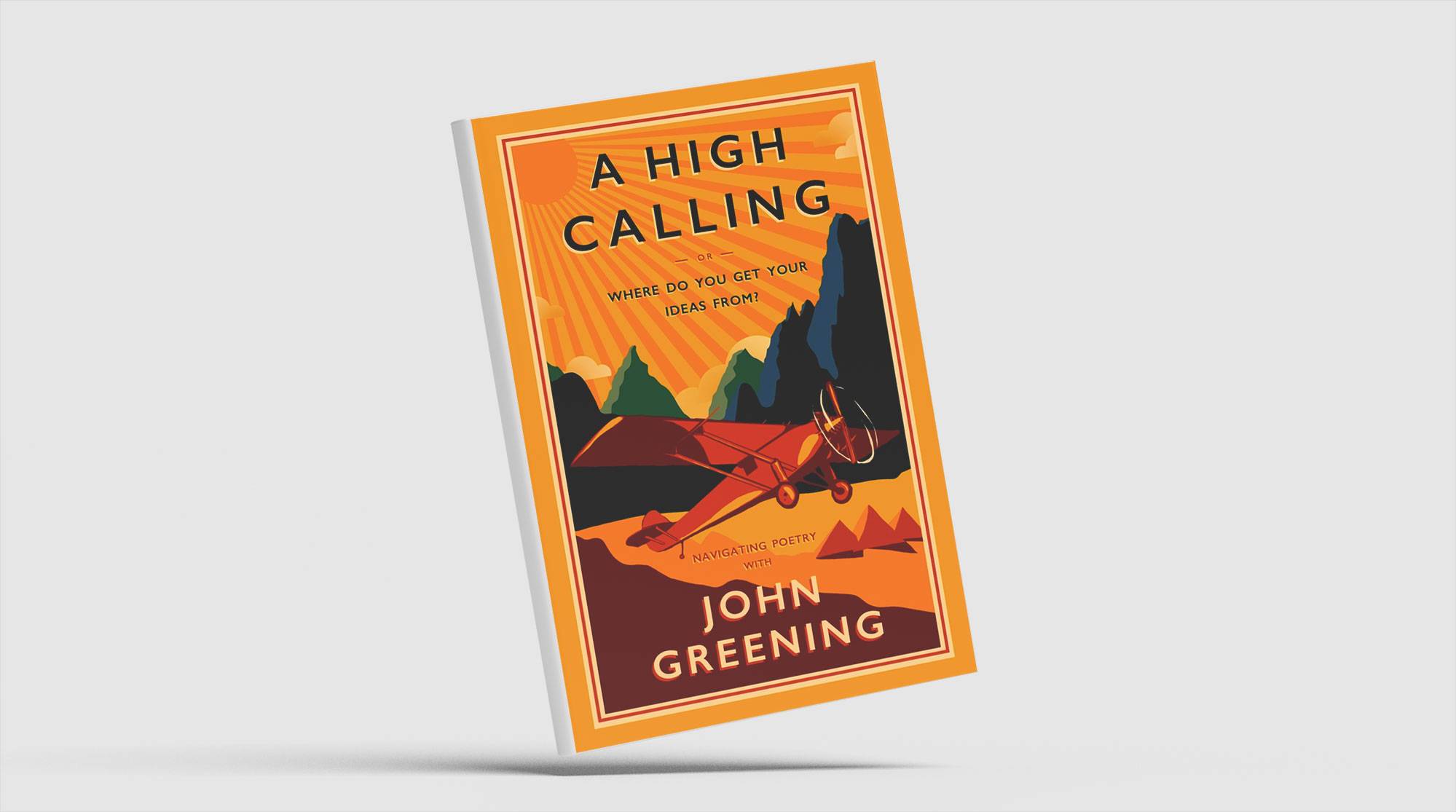يتبادل السهو والطمأنينة الأدوار والأقنعة في ديوان «كن شجاعاً هذه المرة»، للشاعر إبراهيم داود، الصادر حديثاً عن دار «ميريت» بالقاهرة، ويشكلان مدارات الفعل الشعري، فيبدو مشدوداً دائماً إلى حافة لحظة حميمة وحرجة في الوقت نفسه، مسكوناً بإيقاع حياة أصبحت ثقيلة رتيبة، وإحساس ممض بالخوف والوحشة والفقد.
ويضمر العنوان بدلالته التحريضية، ومن خلال فعل الأمر «كن»، معنى مجازياً وزمنياً في الوقت نفسه، بينما يبقى الضمير الموجه إليه الخطاب متأرجحاً بين الآخر المخاطب المستتر، والذات الشاعرة نفسها، وكأنها توجه الخطاب إليه عبر وسيط يمكن أن يشكل هماً مشتركاً بينهما، على مستوى الشعر والحياة معاً، وعلى مستوى الماضي والحاضر أيضاً. كما تكشف «هذه المرة»، بدلالتها الزمنية الخاطفة، عن فحوى هذه اللحظة الحرجة الفارقة عما عداها من لحظات.
فهل الشعر إذن لحظة حرجة في إناء الوجود؟ نعم، هو كذلك لأنه ابن زمنه الخاص، بل إن نشوته الجمالية كثيراً ما تكمن في مقدرته على السهو، حيث الرغبة في الإزاحة والتخطي، تخطي الأشياء، وعدم الطمأنينة لظلالها ويقينها المراوغ، ربما لذلك تبدو حكمة الذات الشاعرة هنا وكأنها صرخة احتجاج خافتة في الداخل «اطمئن لتسهو، واسهُ لتطمئن».
تسكن هذه الحكمة لا وعي الذات الشاعرة، وتلعب دوراً محفزاً على تبادل الأدوار والأقنعة في الديوان بين السهو والطمأنينة، فالسهو ليس محض غريزة شعورية عمياء، إنما معطى جمالي مفتوح على شتي الاحتمالات، يبحث عن لحظة حرجة استثنائية ليحقق من خلالها وجوده في النص، لكن الذات الشاعرة في مراوحتها بين الوعي واللاوعي لا تطمئن كثيراً لهذا الوجود، فتتعامل معه كظل لطمأنينة عابرة، ومحطة سرعان ما تغادرها إلى محطات ومرافئ أخرى مغايرة... يطالعنا هذا الهم على نحو لافت في نص يتركه الشاعر من دون عنوان، مستهلاً به الديوان، يقول:
«اللغة متفق عليها
والعاشق الذي ضاق من الثرثرة
عن العشق...
يبحث عن طرق قصيرة
تفضي إلى البحر الكبير
طرقٌ ضيقة
تسكن إلى جانبيها الحياة
يمشي فيها آمناً
يصطاد ألحاناً غامضة
تعينه على الشتاء
وتستوعب إحساسه القديم بالفقد».
لا تغيب مفارقة السهو والطمأنينة عن جو هذا النص، فهي تستبطنه، وتشكل دلالاته ورموزه، عبر مطلق اللغة العام المتفق عليه، الذي يمثل موازاة رمزية لطمأنينة مؤقتة، تسعى الذات لاجتراحه، وتحويله بالترك والسهو إلى مطلق خاص، عبر «طرق قصيرة، طرق ضيقة»، من أجل لحظة حرجة مثمرة يمكن أن تستوعب فيها إحساساً قديماً بالفقد، وتحس بالأمان.
في ظل هذه المفارقة، تتسع حقول الدوال والرمز في نصوص الديوان المنداحة عبر 63 صفحة، يتراوح بعضها بين الومضة الخاطفة في عدة أسطر والنص الطويل نسبياً، يعززها الشاعر بعناوين أغلبها بصيغة النكرة المفردة، ومنها (طيبة، ومصابيح، وعودة، وقسوة، وشجاعة، وإجهاد، ويناير، وثرثرة، وحنين)، كما يأتي بعضها في صيغة النكرة المركبة، سواء بصيغة الجمع على سبيل الصفة أو الإضافة (أصغر سناً، ونوم متقطع، وقبل قليل، وإيقاع غريب، ومعرفة قديمة، وغرفة عارية، وأنا وأنتِ)، بينما تأتي بقية العناوين بصيغة التعريف (الباقون، والوحيد، والعاصمة، والخدمة، والجنون).
لكن هذا التقسيم لا يتم بشكل عشوائي، وليس وليد مصادفة ما، بل هو تجسيد طبيعي لشعرية البساطة والفضاء المختزل، حيث العالم يصبح أكثر حميمية وقرباً في صيغة المفرد، كما تصبح حركة الذات أكثر انسيابية وهي تصوب سهامها صوب الأشياء في هشاشتها وألفتها، لتلتقط اللحظات الإنسانية الحرجة الهاربة من جسد الزمن وعباءة الوجود... الأشياء التي تمشي في الأعماق بعيداً عن ركام القشرة والعادة، مخلفة في دفقها ما يشبه الحكمة أو الخلاصة لمشاعر وأفعال وأحاسيس وأحلام وذكريات تتناثر في فضاء النصوص، وتتكثف في لطشة الختام، كطرقة ناقوس تذكر بأن ثمة أثراً شاهداً على حياة كانت هنا، لا تزال روائحها عالقة في غبار الذاكرة والروح والجسد... يتجسد كل هذا على نحو لافت أيضاً في نص «شجاعة» الذي وسم عنوان الديوان:
«توجد حواجز بداخلك
وبنادق مصوّبة من مكان ما
ولا يوجد زيت في البيت
الكواكب القريبة اقتربت من البيت
واحتشدت الأمراض على أول الشارع
أنت في غرفتك
تشتاق إلى بلادك في النهار
وتدعو لها بالليل
ولا تصنع شيئاً آخر
أخرج
تكلم مع المحيطات عن الطيور
عن الأحزان التي تتدفق تحت البيوت
عن الربيع
عن إحساسك القديم بالفقد
عن الرقص
عن الحب الذي جاء بعد هذا العمر
عن العمر».
يشد النص بنزوعه التحريضي فضاء المشهد، ويكسبه مسحة خاصة، تتقاطع فيها شظايا الداخل والخارج، كما يعلو سقف الدلالة بتنويع دوال الخطاب بين المخاطب الصريح الذي يعكس حركة الأشياء كما هي في الواقع، وضمير الأنا المستتر الذي يشير إلى الداخل، ويعكس حركة الذات غير المطمئنة، ويدفعها إلى القفز فوق حواجز الخوف والتردد، حيث لا مفر من أن تكون تجسيداً حقيقياً شجاعاً لاقتحام هذه اللحظة الحرجة، والارتطام بكينونتها فوق صخرة الحلم. وكأن النص رقصة استثنائية من أجل كسر الصمت، صمت الحياة واللغة والمشهد، متابعاً قوة الدفع عبر شفرة فعل الأمر والنفي الحادة:
«اترك خيالك للرياح
وطمئن الغرقى على الحياة
الكواكب القريبة اقتربت
وأنت تتوارى خلف النشيج
لن تنفعك النيازك
لن يقف الماضي إلى جوارِك
- كن شجاعاً هذه المرّة».
يعتمد الديوان على بنية لغوية بسيطة، ورؤية تراهن على يقظة الذاكرة، لذلك يبدو كثير من النصوص وكأنه نقرات حانية فوق جدار الزمن، حتى لا يجرف في خطاه الغليظة طفولة الروح والأحلام والذكريات، ويبدو رهان الشعر في كونه نقطة التوازن التي تحفظ لهذه النقرات رنينها ليتسع ويتواصل... بينما يقترن الفقد بإحساس له طعم المرثية، يضاعف افتقاد الموسيقى والطرب من نبرة الإحساس به، كأن هذه النقرات بمثابة اللحن المفقود، وهو ما يطالعنا في ومضات خاطفة، مثل: «جهل»، و«ضجيج»، و«الصمت»، وغيرها، التي تبدو كصدي لذلك اللحن:
«لا يخافون التاريخ.
التاريخ الذي يسطره الحزنُ الآن
في مكان ما
***
جهلهم بالموسيقى
ضيعنا».
***
«التجاعيد التي ظهرت
تبدو حديثة العهد بالزمن
تبدو طريّة
وتستعد للركض
صرنا فرادى وسط هذا الزحام
أشواقنا تتعثر عن مدخل البيت
وأوراقنا تتطاير».
***
«لا يوجد شيء مؤكد
يوجد كلام
وبالطبع أمل
يعتقد العابر أنه اقترب
والعاشق أنه وصل
ولا توجد رائحة للطعام».
في هذه النقرات المباغتة، يعلو رنين المخاوف والوساوس والهواجس، وينسحب التلاعب بالذاكرة والخيال إلى تجسيد النوازع والأفكار السلبية الباعثة على الحزن والخوف والندم والأسى، كدلالة على افتقاد الإنسان أمنه الروحي والجسدي، وعدم القدرة على احتمال زوايا أخرى للحكاية، لا تحفظ له حتى الحد الأدنى من هذا الأمن، أو تذكره برائحته كعلامة وصوت... وهو ما يطالعنا في نص «رائحة جديدة»:
«استيقظ الناس ذات صباح على رائحة جديدة
قيل لهم المدينة أصبحت قديمة
وإن الطلاء الجديد ضروري
... لأننا في انتظار زائرين.
مياسر الناس خرجوا إلى المدن الجديدة
وأخذوا معهم الماء والشجر
وتركوا الآخرين يقاومون الرائحة
ذهبوا إلى النهر
فلم يجدوا نهراً
الرائحة جلست ولم يأتِ أحد
بعد سنوات...
صار للرائحة صوت
ولم يعد هناك من يصغي لأحد».
فهكذا، تعكس نصوص الديوان ببساطتها المغوية مهمة تبدو خاصة بالشعر، تتجسد فيما يمكن تسميته إزكاء روح التشبث بإرادة الحياة، والمقدرة على تحسين قدرة العيش وسط اضطرابها ومخاوفها، فما يجلبه السهو والطمأنينة زائل، وما يُبقي كينونة الشاعر مشتعلة هو الرغبة الجارفة في هذا التشبث الذي يجعل من الشعر ليس فقط صانعاً للجمال، وإنما للأمل أيضاً... هذا ما يحض عليه هذا الديوان اللافت المتميز.
شعرية البساطة واللحظات الحرجة
إبراهيم داود في ديوانه «كن شجاعاً هذه المرة»


شعرية البساطة واللحظات الحرجة

لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة