إذا كان من جماليات الرواية التصاقها بالواقع التصاقاً تخييلياً يقربها من التاريخ، فكيف يكون الحال حين تكون سيرة ذاتية، فيها يتركز السرد على شخصية واحدة ؟!
لا شك أن السيرة الذاتية نوع من أنواع الرواية، وهي تتميز بوجود (منطقة تسبيب) كما يسميها والاس مارتن، فيها يوصل بين طرفين الأول هو المؤرخ وما يستنتجه والآخر الروائي وما يتخيله. وبوجود هذه المنطقة تفترق كتابة السيرة عن كتابة التقارير وتوثيق الذكريات وتسجيل الاعترافات.
أما لماذا يختار الكاتب من أنواع الرواية السيرة الذاتية، فلسببين الأول أنّه بالسيرة الذاتية يستطيع أنْ يراجع ماضيه وما مرَّ به من تجارب نافعة أو وخيمة وما اتخذه من مواقف إيجابية رشيدة أو ما ارتكبه من ممارسات سلبية مرذولة، مركزاً أيضاً على وقفات حياتية بعينها خاضها فخرج بحكمة ما، أو صدمته فأتاحت له التأمل في قدره ومحاسبة حيثياته، متفكراً في ذاته ومصيره، محاولاً إيجاد معنى لحياته. وكل ذلك من خلال فعل الكتابة.
والسبب الثاني أنّ التعامل مع الزمان لن يكون استباقياً بالمرة كما لن يكون مزجياً؛ بل هو مخصوص في ثلاث فعاليات تراهن على الزمان الماضي فلا تتعداه، وهي: زمان التصور المسبق وزمان الفعل أو التصوير وزمان إعادة التصوير بالاسترجاع. (نظريات السرد الحديثة، والاس مارتن، ص97ـ98)
وبسبب هذه الخصوصية في التعامل مع الزمان تفترق كتابة السيرة الذاتية عن كتابة التاريخ، فالأولى ذات صلة بالتفسير السيكولوجي وتفريغ الطاقة النفسية المضادة، فتتبرأ الأنا من تحولاتها وتعرف ماهيتها، بينما الكتابة التاريخية آيديولوجية لأنها موجهة للآخر. وفي كلا الحالين تظل الرواية جنساً أوسع من أن يكون نوعاً أو شكلاً، جامعاً في داخله السيكولوجيا والسيرة والتاريخ.
وبسبب التفريغ السيكولوجي عن طريق ميكانيزمية الكف والقلق تغدو السيرة الذاتية فاعلة، وبما يمنح الشخصية قدرة على التبرم من نفسها أو لومها على سلبيتها أو مكاشفتها بجوانب إيجابية هي غافلة عنها أو مكبوتة في لا وعيها.
وبهذا تستعيد الذات وجودها، متخذة لهذه الاستعادة صوراً مختلفة بعضها فيزيقي، وبعضها أو أكثرها ميتافيزيقي يتمثل العدمية مستحضراً أسئلة الوجود التي بها تكتب الذات سيرتها جاعلة من نفسها تاريخاً مفرداً أو فردياً، به تعيد بناء ماضيها.
ومن شروط استعادة الذات لنفسها أن تعيش داخلياً في التاريخ كلحظة مشروطة يدعمها مجرى حدثي معين، فالذات خارج تاريخها منسحقة ومتلاشية لكنها داخل تاريخها تعيش فيما بعد هذا التاريخ، لتصبح العدمية فلسفة مصير بها ثناء أو تقريظ للذات الإشكالية التي هي نفسها التاريخ. بمعنى أنّ في العدمية استلاب الوجود لصالح الذات وهو ما سماه أدورنو (الديالكتيك السلبي) الذي فيه يتلاشى الوجود وتصبح سيرورة العالم خرافة وغلواء وسقوطاً واستلاباً وقمعاً.
وبالتمثيل الميتافيزيقي للعدمية والإحساس السيكولوجي بالكف والقلق تتحرر الذات من كبتها وأزماتها وتنطلق ساردة تاريخ حياتها ثائرة على الزمان محاولة استعادة ضياعها في صورة يوتوبيا، تجد فيها ماهية نفسها حائلة دون محوها، متفائلة بالقادم إذ ليس (من الضروري دائماً أن يتجسد الحق. يكفي أن يحوم حولنا كروح تدعو إلى التناغم كما إنشاد الأجراس يمتد تموجها عبر الأثير) (المقولة لغوته نقلها عنه هيدجر في كتابه أصل العمل الفني)
وهو ما نجده متجسداً في رواية (صيادو الريح) للروائية العراقية لمياء الآلوسي والرواية صادرة عن الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، وهي سيرة ذاتية تسرد قلق الذات وعدمية وجودها بإرادة طوباوية تدمر النفس بالقوة المتنافذة وغير المتوازنة ما بين الذات والزمان التي بسببها يدمر المرء حياته بالخوف هلعاً وذعراً، وقد تناهبته الهواجس وانتابته الظنون، وهدده الموت بالفناء.
والمرء لا يكون مدمِراً لنفسه إلا حين يغدو كائناً متوحشاً لا يتصرف بما تملي عليه طبيعته على حد تعبير برتران تروادك الذي رأى أن بدون الوعي يصير وحده يقدر على جعل القرود متحضرة.
وفي هذه الرواية نجد الفطرة التي يمثلها مشهد الصبية صيادي الأسماك تقابل القبح الذي يمثله مشهد الملثمين الداعشيين الآتين من قرون الوحشية والهمجية مستلبين المدينة وأهلها، ترميزاً إلى أن الفعل الطبيعي للغريزة البشرية ليس وحشياً؛ بل هو إنساني، به يتصرف الإنسان على سجيته بوازع الطيب مندفعاً نحو الخير وإن عاش بعيداً عن التحضر وسكن الكهوف أو أقام وسط البراري والأحراش، بينما الفعل اللاطبيعي ليس من الغريزة في شيء؛ لأنه بوهيمي وشرير يحول الإنسان إلى وحش ذي سلوك عدواني يخالف الطبع الآدمي وسجاياه الفطرية حتى وإن سكن القصور وعاش في لب المدنية والتحضر.
ويتهدد هذا السلوك البوهيمي الحيوات الآمنة ويجعلها نهباً لمشاعر سيكولوجية سلبية، فتغدو مكفوفة عن تاريخها وقلقة على حاضرها ومستقبلها، متقلبة من القلق إلى الارتعاش ومن التداعي خيبة وحذراً إلى الكف سقوطاً وموتاً. ويغدو كل شيء مستباحاً تحت مطرقة إرادة القوة التي بها يصير المكان معادلاً موضوعياً للذات التي انتهكتها المشاعر السلبية.
وما هيمنة المونولوجات الداخلية سوى تدليل على هذا الانتهاك» هل فكرت فيه في تلك اللحظة بالذات أم فكرت به كجزء من هذه المدينة حيث تزدحم أمامي كل الأسماء في لحظة تداعيها» (الرواية، ص9)
ومن نتائج هذا البعد السيكولوجي أن يتحول سرد الذات لسيرتها من الاحتدام الفيزيقي إلى الأوار الميتافيزيقي حتى يصل بها حد التفلسف، تنبؤاً بيوتوبيا مستقبلية، فيها تجد تاريخها جديداً فستعيد وجودها، وتتجاوز عدميتها منتصرة على مشاعرها السلبية. وواحدة من صور هذه اليوتوبيا الانفلات من دوامة الضياع.
وحين يجتاح المدينة التعصب والعنف والنبذ لا تتهدد حياة الأفراد، لا تجد الذات الواعية في نفسها قدرة على المواجهة سوى أن تكتب تاريخها بطريقة ملحمية.
وتتأتى الملحمية من كون الذات خارجياً تريد الجمع بين المتضادات والتوفيق بين المتنافرات وداخلياً تعاني الضياع وتكابد العزلة بلا جدوى، وهو ما يؤدي إلى التبلد والاستسلام وعدم القدرة على فعل شيء مع مزيد من مشاعر الرعب والأنين فتشعر الساردة «بفقدان الرغبة في الحياة واستعداد فطري مريض للموت أو ربما هو نوع من توخي الحذر من هذه الساعة السوداء القادمة لا محالة وكأن وريث الأرض يريد مغادرتها على وجه السرعة» (الرواية، ص15)
وتشيخ هذه الذات قبل الأوان وتنهزم بالاستسلام مكتفية بدور الشاهدة التي ليس لها إلا أن تراقب ما يجري أمامها من حفلات الدم ومشاهد الانتحار «عندما تقوست على مقعدي كبحار عجوز جعدت قامته أملاح البحر وهزائمه المتلاحقة وغربته الدائمة، شعرت بالقرف من كل شيء أريد أن أشعر بالألم لكني أصبحت متبلدة جداً كنت كصيادي الريح لا شيء سوى الخواء فالمدينة كانت ورائي وبيتي وأشيائي وربما لن أعود إليها مجدداً»(الرواية، ص67) والمقصود بالمدينة تكريت التي اجتاحها «داعش» وهي مسقط رأس الكاتبة ومحل سكناها قبل الاحتلال وأثنائه وبعده.
ومن الوقائع الدموية التي عاشتها الساردة كشاهدة عيانية ونقلتها إلينا مشاهد فجائعية منحت الحبكة تماسكاً وأضفت على الثيمة دراماتيكية مأساوية، مشهد الجسد المسجى المحشور بين جثتين ومشهد الجنود بملابسهم الرثة والملثمون يحيطون بهم بالسياط والسيوف والبنادق في قاعدة سبايكر ومشهد الكابوس الذي فيه الساردة شاهدة على موتها، مرة وهي ترى نفسها جثة ممزقة تسقط على قاعدة الحديد فيتناثر لحمها، ومرة أخرى وهي داخل القبر.
وافتقاد الشاهدة للشجاعة ورغبتها في الانعزال محواً وإلغاء هو الذي يصيبها بالعطب فلا تقدر إلا أن تشاهد المواقف تمر من أمامها أو تسمع بها. وليس أمامها سوى تسجيلها وانتظار ما سيحدث بعدها، ولهذا تحاسب نفسها داخلياً كنوع من جلد الأنا على تخاذلها وجبنها وصمتها، فتتخلخل الثوابت لديها «بعد عام من الغربة لم يعد للوطن تعريف محدد، لم أعد أعرفه حقاً، كم أحتاج إلى أن أضع قدمي على الأرض من جديد كي أتمكن من اكتساب القناعة التامة أو المنقوصة في استعادة الحياة كي أجد عنواناً جديداً لوطن يمنحني يقيناً جديداً» (الرواية، ص314)
وتنجح المؤلفة لمياء الآلوسي في منح السيرة الذاتية سيرورة انفتاحية من خلال تركها النهاية مستمرة بطريقة مخيبة للآمال، فبعد أن تراكمت في الذاكرة صور التهجير والنزوح لم يعد المكان والمكين كما كانا، فلقد تغيرا كلياً.
ورغم انتهاء الاحتلال، فإن الذات الساردة ما زالت تتلبسها المشاعر السلبية وتحاصرها العدمية، فترى نفسها شيئاً جامداً بلا حياة، مرة كاستمارة تستنسخ باليوم الواحد آلاف المرات، ومرة ككائن وضيع بلا قيمة.
وهذه الذات وإن رجعت إلى بيتها بشجرته ومرآبه وحديقته لكن الأسئلة تغالبها، وتجعلها تعيد النظر في وجودها، لا سيما بعد أن علمت أن رأس آدمي دفن في المرآب وجثة تحوم الكلاب حولها في الحديقة، كإشارة اليغورية إلى أن المكين بالمكان وليس من سبيل لاستعادة المكان من دون ترميم شروخ المكين أولاً كي يستعيد وجوده آخراً.
وتثير صورة قنينة المطهر التي طلبها الجندي من الساردة في آخر سطر من الرواية سؤالاً ملحاً مفاده هل أن وسائل التوطين وطرائق الاستعادة وإعادة التعمير بعد مخاضات النزوح والتهجير ستنفع في تطهير دواخل المكين من أدرانه وسلبياته أو أنها لن تنفع سوى في تطهير المكان من بعض مظاهر الدمامة والقبح ليس إلا، ليكون الإنسان مجرد صيد ريح.
سيرة لعدمية الضياع الملحمي
رواية «صيادو الريح» للعراقية لمياء الآلوسي
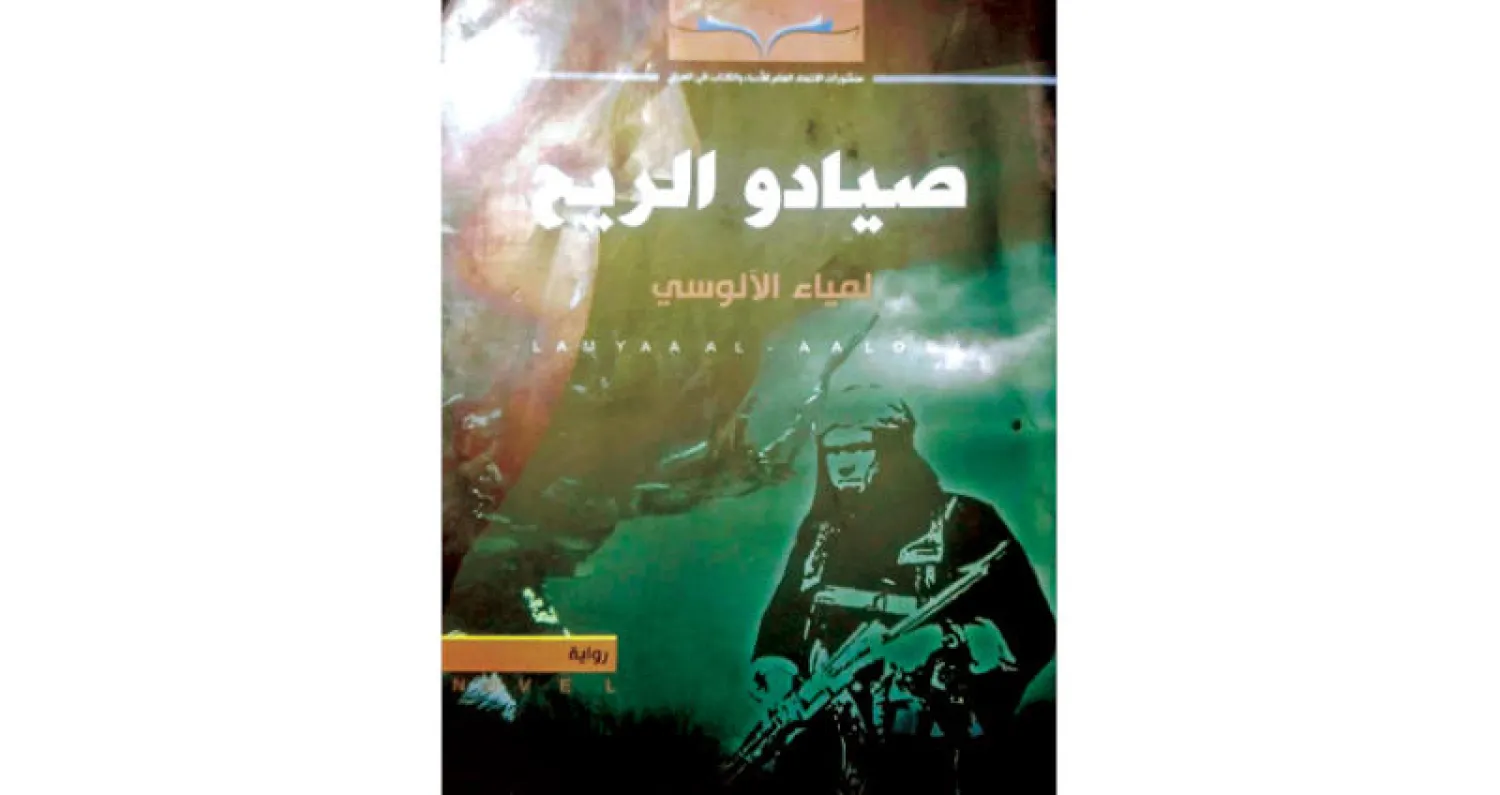

سيرة لعدمية الضياع الملحمي
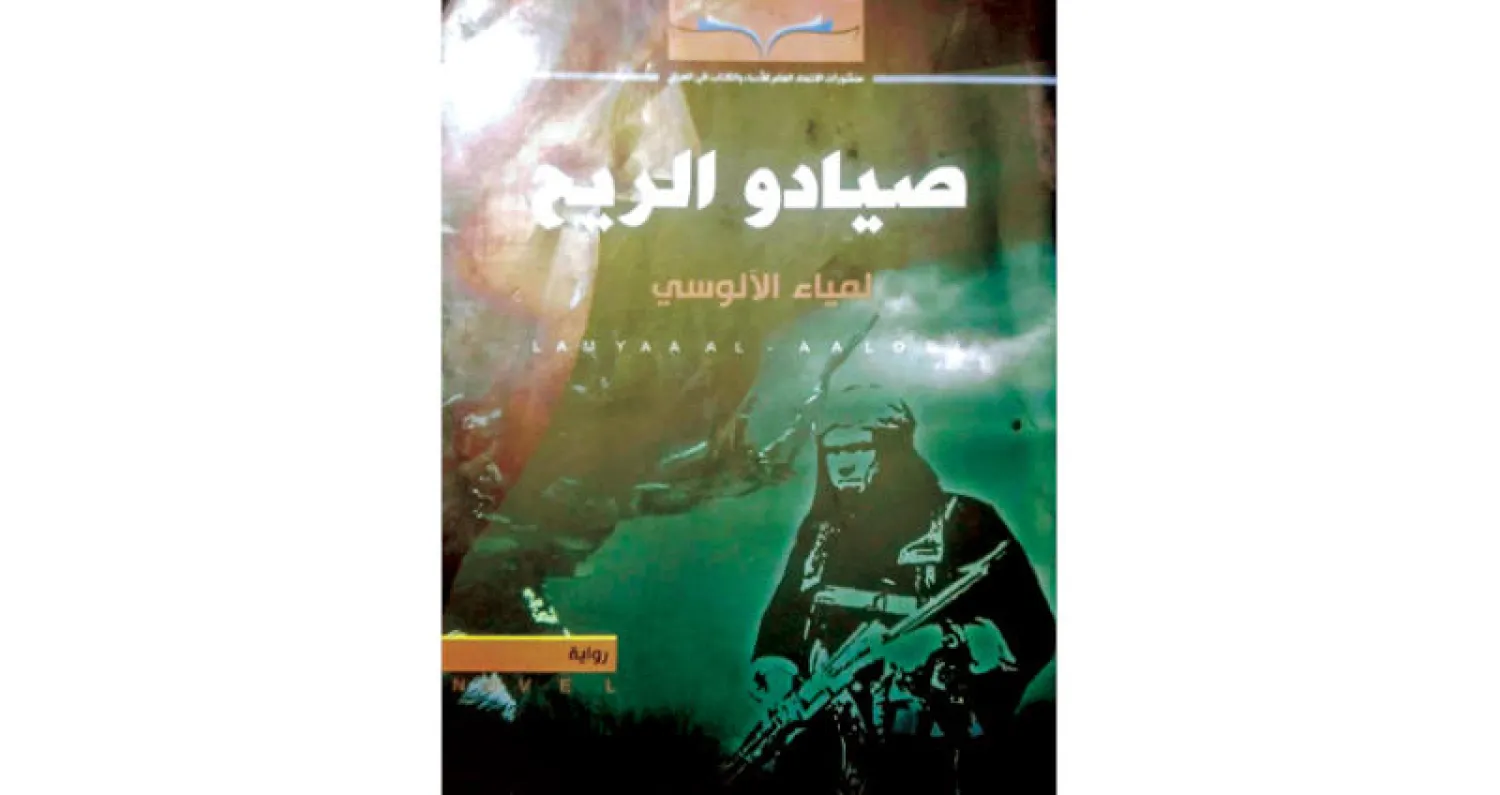
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة










