يحيي الغرب هذه الأيام الذكرى المئوية الأولى لنشوب الحرب العظمى (1914 - 1918). وفي هذه المناسبة صدر هذا العام عن دار نشر تسمى «ذيل الثعبان» بلندن مجلد في أكثر من 500 صفحة عنوانه: «الأرض الحرام: كتابات من عالم الحرب» (No Man’s Land: Writings from a World at War) حرره بيت آيرتون (Pete Ayrton) يقدم نماذج مما كتبه 47 كاتبا عن هذه الخبرة التي شكلت جزءا مهما من تاريخ القرن الـ20.
حرص الكتاب على أن يقدم أعمالا تمثل كل المشاركين في الحرب ما بين بريطانيين وفرنسيين وألمان وهنود وإيطاليين وروس وأميركيين ونمساويين وأستراليين ونيوزيلنديين وكنديين ويونانيين وتشيك وكروات ومجريين وأرمن وكتالونيين وأتراك وبولنديين. تنوع كبير يشير من ناحية إلى الأبعاد الكونية لهذه الحرب غير المسبوقة. ويتيح لنا من ناحية أخرى، أن نرى الصراع من عدة زوايا. فهنا نرى الحليف والعدو، الرجل والمرأة، الحدث والناضج، وقد التحموا جميعا في عناق مهلك، وتعمدوا بالدم والنار.
يقدم الكتاب مقتطفات من أعمال غدت الآن من الكلاسيكيات ودخلت التراث الأدبي الحديث: مثل رواية «القنغر» للروائي الإنجليزي د.. لورانس، و«رحلة إلى نهاية الليل» للروائي الفرنسي لوي فردينان سيلين، و«كل شيء هادئ في الميدان الغربي» للروائي الألماني إريك ماريا ريمارك. ويقدم أيضا أعمالا لا يعرفها إلا قلائل مثل كتابات عمر سيف الدين (من تركيا) وجوزيف بلا القطالوني الإسباني. وفيما بين هؤلاء وأولئك نلتقي بأسماء لا يمكن إغفالها في مثل هذا السياق، بل في أي سياق: مثل ويليام فولكنر وويلا كاثر من أميركا، وهنري باربوس وجول رومان وجان جيونو من فرنسا، وجون غولز ورذي وريتشارد أولدنجتون من بريطانيا، وإرنست يونجر من ألمانيا، وياروسلاف هاشيك من تشيكوسلوفاكيا وإسحاق بابل من روسيا.
مسرح هذه الكتابات هو الميدان الغربي، والبلقان، والجبهة الإيطالية، وغماليبولي في تركيا، والمعارك البحرية. إنه يسجل ذكريات رجال شاركوا في القتال، ورجال ونساء بقوا وراء الخطوط يشاركون بطرق أخرى في المجهود الحربي، وجنود عادوا إلى الوطن بعد انتهاء الحرب، ولكنهم لم يتمكنوا قط من أن ينسوا ما مروا به من تجارب.
ما الدوافع التي كانت تحرك هؤلاء جميعا؟ الفرنسيين والبريطانيين والألمان، فقد كانت دوافعهم واضحة وبسيطة، فهم يدينون بالولاء لأوطانهم، ويحاربون من أجلها. وأما المحاربون من سائر البلدان فكانت دوافعهم أقل وضوحا، على الأقل لأنهم من بلاد حديثة العهد بالقومية أو بتكوين إمبراطورية خارج الحدود. إن إيطاليا مثلا لم تغد أمة موحدة إلا في 1861، ولم يكن الشعور بالقومية الإيطالية قد تبلور بعد، وكان بعض المحاربين الإيطاليين من أنصار النظام الملكي، بينما البعض الآخر من أنصار النظام الجمهوري. وكثير من الأفارقة والهنود الذين جندوا في القتال لم يكونوا يشعرون بأي التزام وطني نحو الجيوش البريطانية أو الفرنسية التي تستخدمهم، فلا هذه الحرب حربهم، ولا هؤلاء الأوروبيون قومهم. وكان البعض مرتزقة يتطلع إلى الراتب الذي ستعود عليه به الحرب (وهو ما نجده مثلا في رواية الأديب الهندي مولك راج آنند «عبر المياه السوداء»)، وهناك من يطمحون أن تحفظ أوروبا لهم الجميل فتمنح بلادهم الاستقلال بعد نهاية الحرب.
ويوضح الكتاب أن صدمة الحرب جعلت البعض غير قادر على التكيف مع الحياة المدنية عند عودته. في رواية الكاتبة الويلزية هيلين زينا سميث «ليس بهذا الهدوء: ربيبات الحرب» (1930) تقول البطلة التي كانت سائقة عربة إسعاف أثناء الحرب:
«البيت، البيت.. لست آبه.
لست آبه. إني راكدة. عجوز. إني في الواحدة والعشرين، ولكني قديمة قدم التلال. جف مني الوجدان. لقد جففت الحرب كل مشاعري. ضاع مني شيء لن يعود قط. لست أريد أن أعود إلى البيت».
وهناك من رأوا في الحرب دليلا على أن النظام الاجتماعي بحاجة إلى تغيير، وأنه لا بد أن ينشأ نظام دولي جديد تنتفي معه الفوارق بين الأمم والطبقات. وقد كانت فترة ما بعد الحرب، فعلا، فترة حماسة ثورية في بعض البلدان، وإصلاحات ديمقراطية في بلدان أخرى.
يبدأ كتاب آخر بوصف كيف تلقى الناس إعلان الحرب. في رواية هنري باربوس «تحت النار» (1916) نقرأ:
«إنها الثورة الفرنسية وقد قامت من جديد».
ويتمتم آخر: «حذارِ أيتها الرؤوس المتوجة!».
ويضيف ثالث: «ربما كانت هذه هي الحرب التي ستنهي كل الحروب».
وقفة هنا. ويهتز جبين البعض، وما زالوا شاحبين من المأساة الكئيبة لليلة من الأرق الذي يرفض عرقا».
«نهاية للحروب! أيمكن أن يكون هذا؟ إن محنة العالم لا شفاء منها».
وينتهي الكتاب – من وجهة النظر الألمانية – براوي إريك ماريا ريمارك في «كل شيء هادئ في الميدان الغربي» (1929)، وهو يقول، على نحو لا يخلو من بارقة أمل في تجاوز المحنة:
«غير أنه ربما كانت أفكاري هذه كلها مجرد كآبة وارتباك، سيتطايران كالتراب عندما أقف تحت شجر الحور مرة أخرى، وأستمع إلى خشخشة أوراقه. لا يمكن أن تكون قد اختفت كلية: تلك الرقة التي تقلق دمنا، اللايقين، الهم، كل الأشياء القادمة، أوجه المستقبل الألف، موسيقى الأحلام والكتب، الخشخشة والتفكير في النساء. لا يمكن لهذا كله أن يكون قد تساقط في غمرة القصف، والقنوط، ومواخير الجيش. إن الأشجار هنا تتوهج ساطعة ذهبا، وثمار الدردار الجبلي حمراء إزاء الأوراق، ودروب الريف البيضاء تجري نحو الأفق. وفي مقصف الجنود طنين كخلايا النحل عن إشاعات السلام».
ومن مزايا الكتاب أنه يقدم الحرب من منظور المرأة، إلى جانب منظور الرجل. هناك مثلا ماري بوردن، وهي روائية أميركية المولد كتبت مجموعتها القصصية «المنطقة المحرمة» (1929) من واقع عملها ممرضة في أحد المستشفيات الميدانية في إنجلترا. وهناك أيرين راثبون، وهي كاتبة إنجليزية عملت ممرضة في إنجلترا وفرنسا، وكتبت رواية أوتوبيوغرافية عنوانها «نحن الذين كنا شبابا» (1930) صورت فيها كيف أن الحرب كانت زمن مأساة، ولكنها كانت أيضا – وهنا المفارقة – زمن تغير منعش:
«تمتمت مولي: لا بد أنك كنت تلعنين الحرب.
أجل. أجل. ولكني حين أنظر إلى الوراء الآن أظن أننا كنا نحبها أيضا. أواه. كم أن هذا يصعب شرحه. لقد كانت حربنا، كما ترين. ورغم أنها كانت حدثا يوميا وقتها، وكانت نفوسنا تغثى منها، فإنها تبدو الآن ذات سحر أخاذ مروع».
وهناك كاتبة بريطانية أخرى هي فيرا بريتن صاحبة المذكرات التي تسمى «عهد الشباب» (1933) تصور - من منظور المرأة التي بقيت وراء خطوط القتال – مشاعر القنوط التي ولدتها الحرب في نفوس كثير من النساء، حتى إن إحداهن نشرت إعلانا في إحدى الصحف في باب «القلوب المعذبة» نصه:
«سيدة قتل خطيبها (في الحرب) على استعداد أن تقترن – عن طيب خاطر – بضابط فقد البصر تماما، أو مقعد من جراء الحرب بأي صورة». وتتأمل فيرا بريتن قائلة: «للوهلة الأولى يبدو هذا باعثا على الدهشة. ولكن بعد حين تحس بالمأساة المتضمنة هنا: إن السيدة (الغالب أنها قد تقدمت بها السن، وإلا لكانت أشارت إلى نفسها بكلمة «شابة») لا تتمتع بملكات أو مؤهلات كما هو واضح. إنها لا تريد أن تواجه وحشة مستقبل بلا شاغل ولا روابط. لكن الرجل الوحيد الذي أحبته قد مات. وكل الرجال الآن سواء في نظرها، ولم يعد يهم من الذي ستتزوجه، ومن ثم فهي تعتقد أنها ستتزوج رجلا يحتاج إليها حقا. إن رجلا فقد بصره أو شوه بدنه – باقي حياته – ليس أمامه كبير فرصة لأن يقع في حب أحد. وحتى لو أحب فلن يجرؤ على البوح بذلك. لكنه سيكون بحاجة إلى ممرضة دائمة. وإذا هي اقترنت به فستؤدي له أكثر مما تؤديه الممرضة، وربما وجدت عزاء عن حزنها في تكريس حياتها لأحد. ومن هنا كان الإعلان. أتراه سيتلقى ردا؟ إنه ترتيب عملي صرف، ولكنه يتضمن عنصرا من التضحية بالذات يستحق الاحترام.
تكشف هذه الكتابات عن الوحشية التي يمكن أن ينحدر إليها الإنسان. كما تكشف – على نحو مدهش – عن قدرته على التضامن والتعاطف في قلب ظروف بالغة القسوة. وهي تلقي الضوء على حقبة تغيرات مهمة في الأبنية الاجتماعية والسياسية والفنية. لقد عاصر هؤلاء الكتاب فنانين من طراز سترافنسكي وفبرن في الموسيقى، وبول كلي وليجيه في فن التصوير، وفرانك لويد رايت في العمارة – ولكن هذه قصة أخرى.
كتابات تعمدت بالدم والنار
روايات وقصص عن الحرب العالمية الأولى لـ47 كاتبا من جنسيات مختلفة
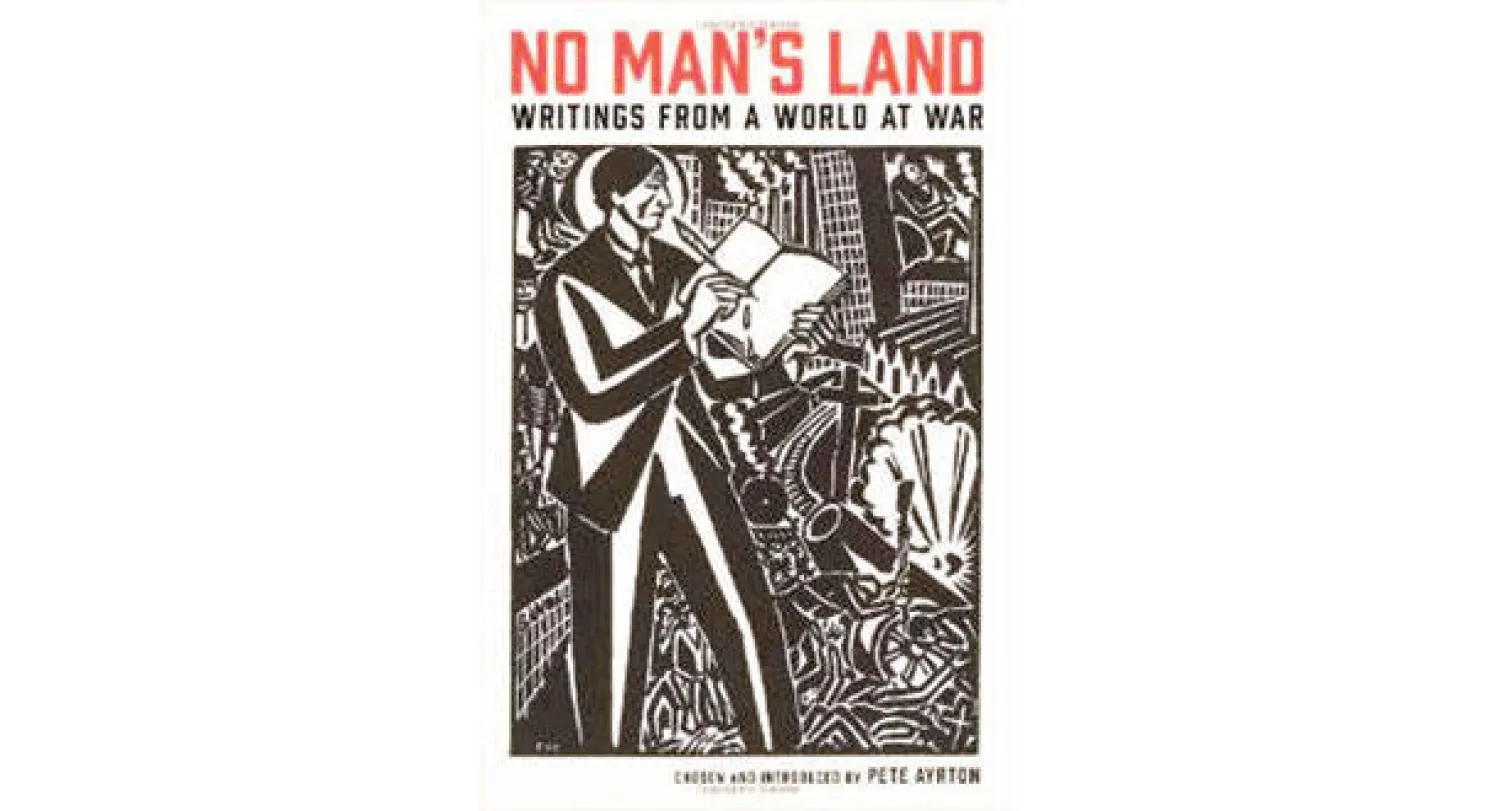
غلاف الكتاب

كتابات تعمدت بالدم والنار
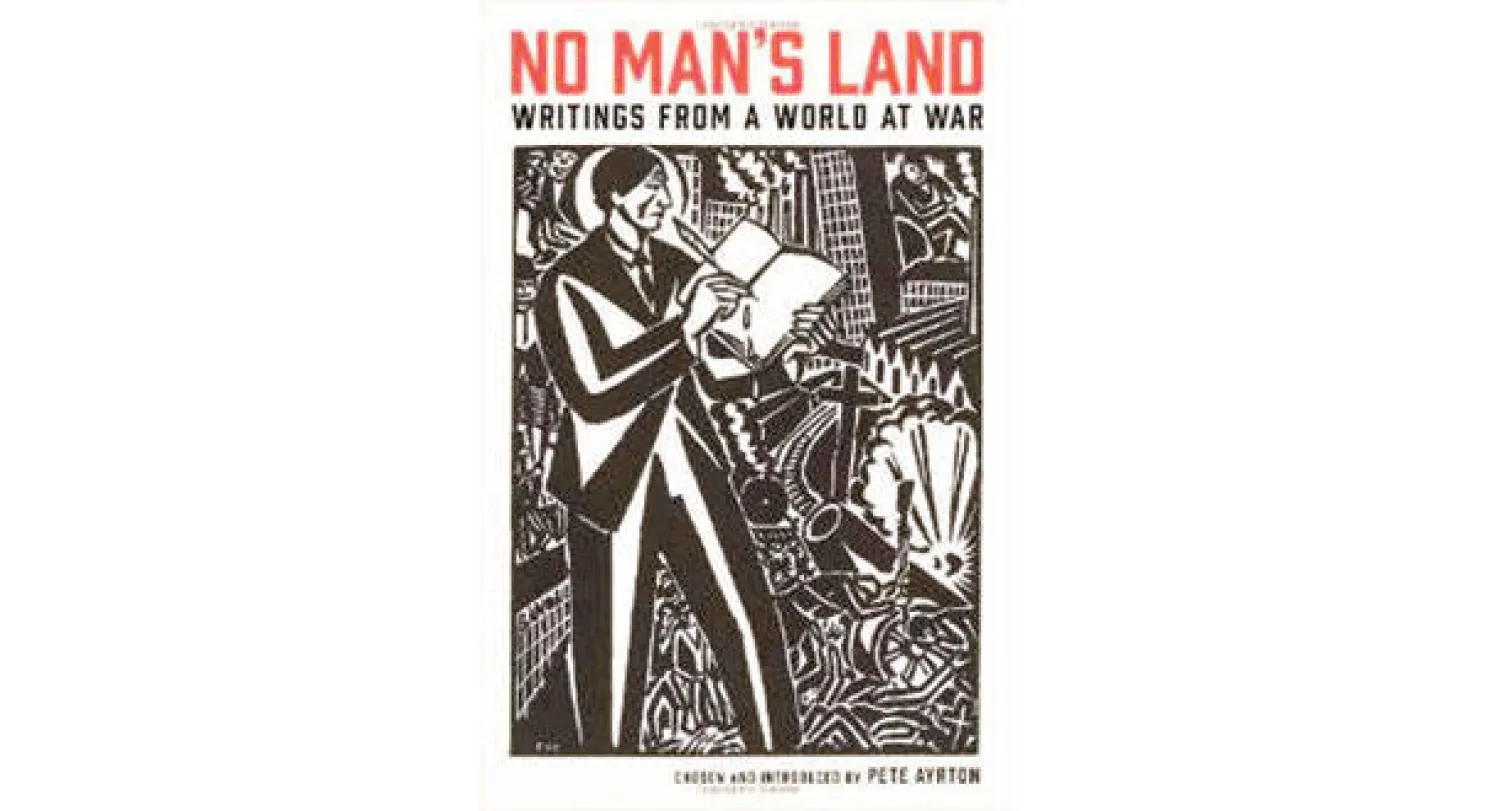
غلاف الكتاب
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة










