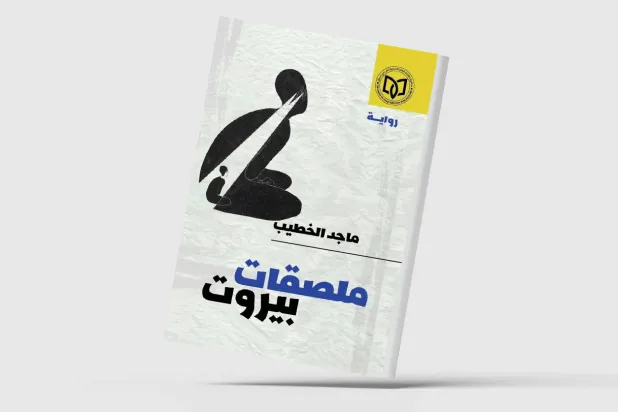تنتمي رواية «الوصايا»، الصادرة عن «الكتب خان»، للكاتب المصري عادل عصمت، إلى «رواية الأجيال»، أو «الرواية النهرية» بتعبير الكاتب الروائي الفرنسي رومان رولان. وثمة أمثلة كثيرة على الرواية النهرية في الأدب العربي، مثل: ثلاثية نجيب محفوظ، ورباعية شمران الياسري، وخماسية عبد الرحمن منيف. وهذه الرواية هي أشبه بالنهر الكبير الذي تصبُّ فيه فروع وجداول كثيرة تجعله يتدفّق بقوّة من المنبع إلى المصبّ. ورغم أنّ «الوصايا» رواية واحدة، وليست سلسلة من الروايات، كما هو الحال في «البحث عن الزمن الضائع» لمارسيل بروست، أو «الكوميديا الإنسانية» لبلزاك، فإنها رواية أجيال متعددة، وشخصيات وأحداث متنوعة، تمتدّ من عشرينات القرن الماضي حتى الوقت الحاضر، ولعل شخصيتي الجد والحفيد تستشرفان المستقبل، وتقدّمان تعريفاً منطقياً للحياة، من خلال بحثهما المتواصل عن الحقيقة، أو سعيهما للخلاص عن طريق تحمّل المشقّة، ومحاربة المتع الجسدية الزائلة، والتخلي باعتباره أعظم الفضائل.
وتكتظ الرواية بالأحداث والشخصيات الرئيسة، مثل الجد عبد الرحمن سليم، وحفيده الذي لا نعرف اسمه على مدار الرواية، لكنّ المدقق في قراءة النص سيكتشف أنّ هذا الحفيد هو ابن عبد الله الذي ارتأى والده الشيخ عبد الرحمن أن يعمل في «الغيط»، بعد أن انقطع ولداه صالح ونعيم إلى الدراسة وتحصيل العلم. لم يشأ عادل عصمت أن يخوض في السياسة أو يتورط فيها لأنها تشدّه إلى الواقع كثيراً، وتحرمه من ملَكَة الخيال. وبما أنّ الروائي خرّيج قسم الفلسفة، وهو مُدرك لكثير من معطياتها، فقد ارتأى أن يرصّع نصّه السردي بشذرات فلسفية، بعضها صعب عويص، وبعضها الآخر سهل يسير الفهم يرسم صورة منطقية يستوعبها القارئ العادي.
ويحتاج النص السردي الناجح إلى شكل متفرد، يوفر للقراء عنصر الإقناع الفني، فالمسافة التي تفصل بين بوح الجد لحفيده وموته هي يوم واحد فقط. ففي يوم الأربعاء المصادف 20 ديسمبر (كانون الأول) 1978، استدعى الشيخ عبد الرحمن سليم حفيده، وأخبره بأنه سوف يموت يوم الجمعة الموافق 22 من الشهر ذاته، وليس أمام الجد سوى يوم واحد يتيح له أن يكشف كل الأسرار التي خبأها عن الجميع على مدى سبعة عقود تقريباً. وبما أنّ هذه المهمة مستحيلة، فقد لجأ الكاتب إلى حيلة فنية، تتمثل بنقل خلاصة تجاربه الحياتية الواسعة على شكل وصايا عشر، تبدأ بالخلاص في المشقة، وتنتهي بالتخلي، وما بينهما هناك وصايا أخرى تتعلق بالفرح، والحزن، والمحبة، والمُتع العابرة، وتحمل الألم، وما إلى ذلك.
وتشكِّل الوصايا العشر الهيكل المعماري للرواية، لكنها لا تشترط زمناً خطياً، ولا تفترض أحداثاً تتابعية، لأن الكاتب أراد أن يلم بكثير من الأحداث التي تأخذ أشكالاً دائرية، مثل البذرة التي تموت لتصبح نبتة وغصناً وورقة وزهرة، ثم تتحول إلى ثمرة تحتوي بداخلها على بذرة جديدة؛ وهي أقرب إلى دورة الإنسان الذي يولد طفلاً، ثم يشبّ وينجب، قبل أن يهرم ويموت، لكنه يستمر من خلال ذريته وإنجازاته التي يخلفها وراءه قبل أن يمضي إلى المجهول.
ويمكن اعتبار «الوصايا» رواية ريفية بامتياز، رغم أن بعض الوقائع تحدث في مدن وبلدات متعددة، وقد ترك هذا التنوع المناطقي أثره على لغة الرواية التي استعانت بكثير من المفردات الريفية التي وجدت طريقها إلى النص السردي، من دون أن تُخل باشتراطات اللغة الفصحى.
الشيخ عبد الرحمن سليم وشقيقه نعيم يمثلان الجيل الأول، وقد تزوج عبد الرحمن من خديجة التي أنجبت له ستة أولاد، مات اثنان منهم وبقي أربعة على قيد الحياة، وهم: عبد الله وصالح ونعيم وفاطمة. وإلى جانب زوجته، كان الشيخ عبد الرحمن يحب السيدة كوثر، زوجة صديقه نور الدين، لكنه لم يقترف إثماً، لأنه أيقن ببصيرته الثاقبة أن المتعة عابرة مهما طال أمدها، لكنها ظلت مثل الواحة في حياته العاطفية الجدباء، ولولا وجودها الفيزيقي لارتبكت حياته تماماً.
ويحاول هذا الشيخ أن يُخضع الأسرة برمتها لمشيئته، ويروضها على قبول أفكاره التي تنتمي لزمان غير زمانهم، لكنهم يتمردون عليه، وينفضون عنه تباعاً. يتزوج عبد الله من صفية، ويقترن صالح بفادية، ويرتبط نعيم بسعاد البندرية التي تنقل بذرة الاحتجاج والتمرّد من المدينة إلى القرية. وبموازاة الأولاد، هناك علي سليم، ابن شقيقه نعيم، الذي يلعب دوراً مهماً في تصاعد الأحداث. يتزوج علي سليم في بداية الأربعينات من نبيّة التي تُرزق بثلاثة أولاد، وهم: فادية وجمال ويوسف، ثم يموت متأثراً بمرض عضال. ولم يلتجئ عادل عصمت إلى المعطيات السياسية، وإنما لاذَ بمنظومة العقائد والتصورات الخرافية التي تنتعش في المجتمع المصري، خصوصاً في الطبقات الاجتماعية التي لم تنل حظاً وافراً من التعليم، فقدّم لنا شخصية الأم، السيدة خديجة التي تعتقد أنّ دارهم مسكونة، وأنها تخوض نزاعاً مع «مَنْ لا اسم لهم»، لأنهم يريدون أن يطردونهم من الدار، ويقيمون فيها.
وينغمس عبد الله بالعمل في «الغيط»، إلى جانب علي سليم، بينما يذهب صالح إلى «الكُتَّاب»، ومنه إلى كلية علوم الدين، ويتزوج على وفق مشيئة أبيه من فادية علي سليم، قبل أن يصبح إماماً ويُبعث إلى نيجيريا، في أول تصدع تشهده العائلة. أما نعيم، فقد أصبح مُعلِّماً، لكنّ الحكومة ساقته للجبهة، وأصيب بطلقة في كتفه، ثم تزوّج من سعاد، مدّرسة العلوم التي تسكن في الشقة المجاورة لهم في طنطا، والتي تجد صعوبة في الاندماج بحياة القرية.
أما الحفيد، أو «الولد الساقط» كما يناديه جده، لأنه سقط في امتحانات كلية الزراعة، فسوف يصبح مدرساً في مدرسة طنطا الزراعية، ثم يحصل على الدكتوراه في علم أمراض النبات.وتتظلّم نبيّة لأن الشيخ عبد الرحمن أخذ منها الحسابات، وأسندها إلى ابنه نعيم، وترك لعبد الله تصريف شؤون الأرض، أما هو فقد انصرف للتأمل والعبادة، وتدبير شؤون الناس الاجتماعية والقانونية.
ويموت صالح ويُدفن في القاهرة، لكن شقيقته فاطمة تقرر دفن جلبابه في مقبرة العائلة التي مات فيها الجد، ثم أعقبته السيدة خديجة. الخطأ الكبير الذي ارتكبه الجد كان عندما هدم البيت القديم، وبنى إلى جواره منزلاً جديداً. أما الأرض التي ضاعت في الثلاثينات، فقد أعادها الشيخ عبد الرحمن بعد مشقة متواصلة، لكنه قرر توزيعها وهو حي يرزق، مؤكداً وصيته الأخيرة التي تقول إن «التخلي هو أعظم الفضائل».
وهكذا، فقد تخلى عن البيت، والأرض الزراعية، والمتع العابرة في الحياة، لكنه ظل يقاوم شهواته حتى الرمق الأخير، لأنه حين أمسك يد كوثر أول مرة، وكاد أن يرتكب المعصية «انطلق صراخ وصفير، فأدرك أنها علامة» هزّته من الأعماق، فعاد إلى رشده من جديد. وتوحي هذه الرواية بأن شخصياتها ليست ورقية، وإنما هي من لحم ودم، ومشاعر وأحاسيس دفّاقة، وتتوفر على الصدق الفني الذي يُعدّ من أهم اشتراطات العمل الأدبي الناجح.
«الوصايا»... رواية أجيال وأحداث تمتد من عشرينات القرن الماضي
من روايات «القائمة القصيرة» لجائزة «بوكر» العربية


«الوصايا»... رواية أجيال وأحداث تمتد من عشرينات القرن الماضي

لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة