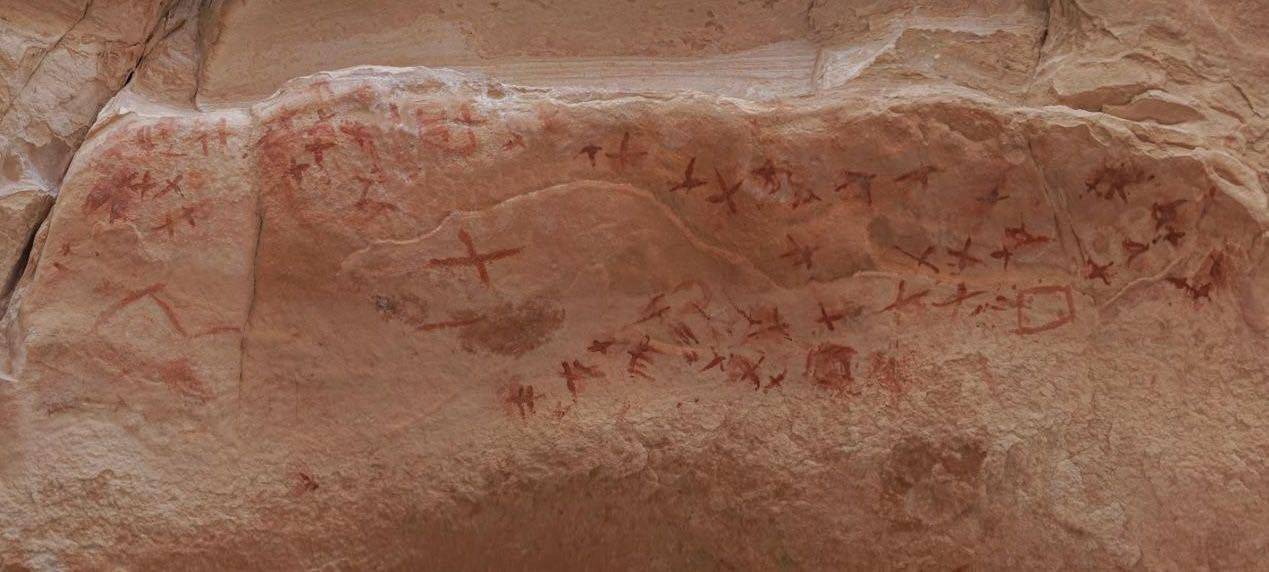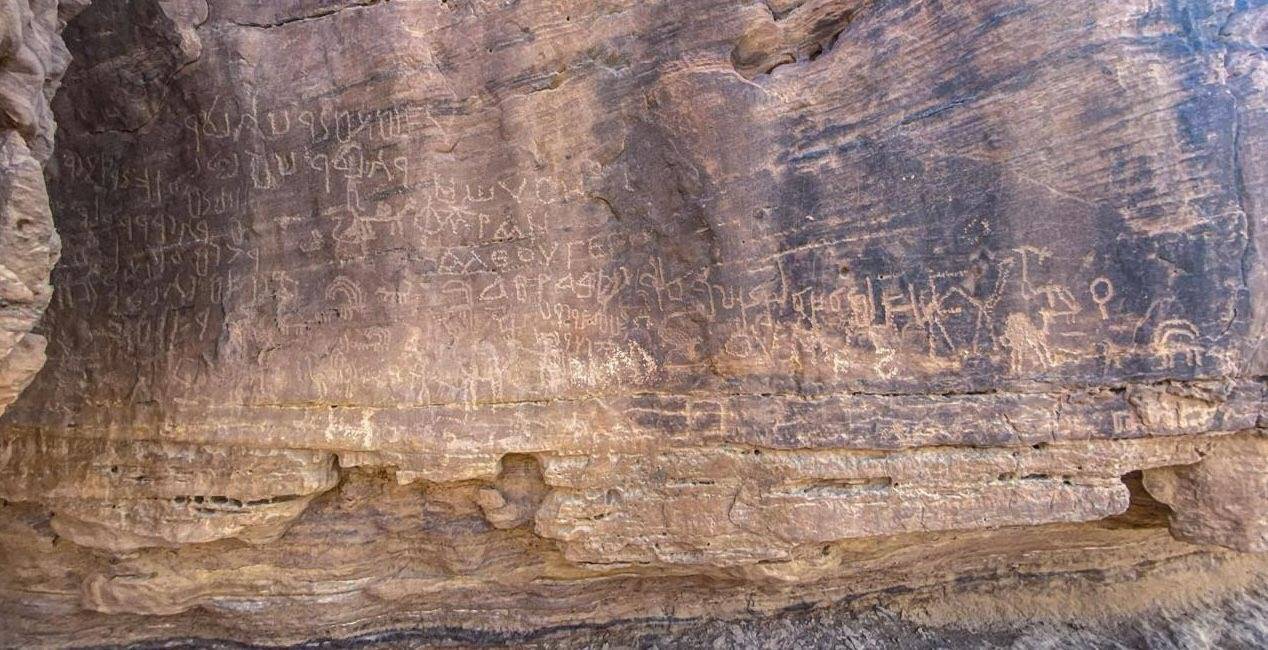توصلت دراسة جديدة من المقرر طرحها السبت المقبل خلال اجتماع مشترك للجمعية الدولية لعلوم الغدد الصماء وجمعية أمراض الغدد الصماء في شيكاغو، إلى أن العلاج بفيتامين "دي" يؤدي بالمخ إلى تحسين الوزن والسيطرة على مستويات السكر في الدم لدى الفئران المصابة بالسمنة.
وقالت ستيفاني سيسلي الاستاذ المساعد بكلية "بايلور" للطب في هيوستون والباحثة الرئيسة في الدراسة "نقص فيتامين دي يحدث في الغالب في الأشخاص المصابين بالسمنة وفي مرضى السكر من النوع الثاني، وإن كان لا أحد يدري علميا ما إذا كان يساهم في الإصابة بهذين المرضين. وتشير نتائج دراستنا إلى أن فيتامين دي قد يلعب دورا في الإصابة بالسمنة ومرض السكر من النوع الثاني عن طريق مفعوله في المخ".
وأوضحت سيسلي أن "المخ هو المنظم الرئيس للوزن"، حيث توجد منطقة في المخ تسمى "الهيبوثالاموس" أو تحت المهاد تتحكم في الوزن ومستوى السكر في الدم ويوجد فيها مستقبلات فيتامين دي.
من جهة أخرى، ذكر موقع "ساينس ديلي" المعني بشؤون العلم، أنه جرى حرمان الفئران من الطعام لمدة أربع ساعات حتى يمكن قياس مستوى السكر في الدم أثناء الصوم. بعد ذلك جرى إعطاء 12 فأرا جرعة من فيتامين دي مذابة في محلول يعمل كمركبة لتوصيل الدواء، ولم يتم إعطاء 14 فأرا آخر، تماثل في وزنها وزن المجموعة الأولى، سوى المحلول بدون فيتامين دي.
وبعد مرور ساعة تم قياس مستوى السكر لدى المجموعتين، حيث تبين أن الفئران التي جرى إعطاؤها فيتامين دي تحسن مستوى السكر لديها.
وخلصت سيسلي إلى أن "فيتامين دي لا يمثل مطلقا وسيلة فورية لانقاص الوزن، لكنه قد ينجح مع وسائل نعرف أنها ناجحة مثل الحمية الغذائية وممارسة الرياضة". وقالت إنه يلزم مزيد من البحث لتحديد ما إذا كانت السمنة تمنع نقل فيتامين دي إلى المخ أو مفعوله فيه.
دراسة: فيتامين «دي» الحل لتخفيف الوزن
https://aawsat.com/home/article/124211



دراسة: فيتامين «دي» الحل لتخفيف الوزن
يساعد على التحكم بدرجات السكر في الجسم


دراسة: فيتامين «دي» الحل لتخفيف الوزن

لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة