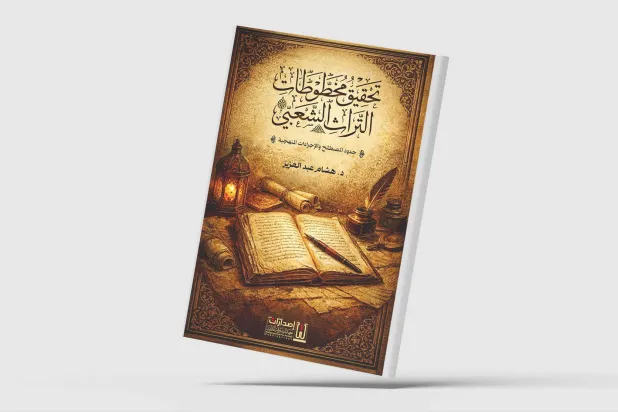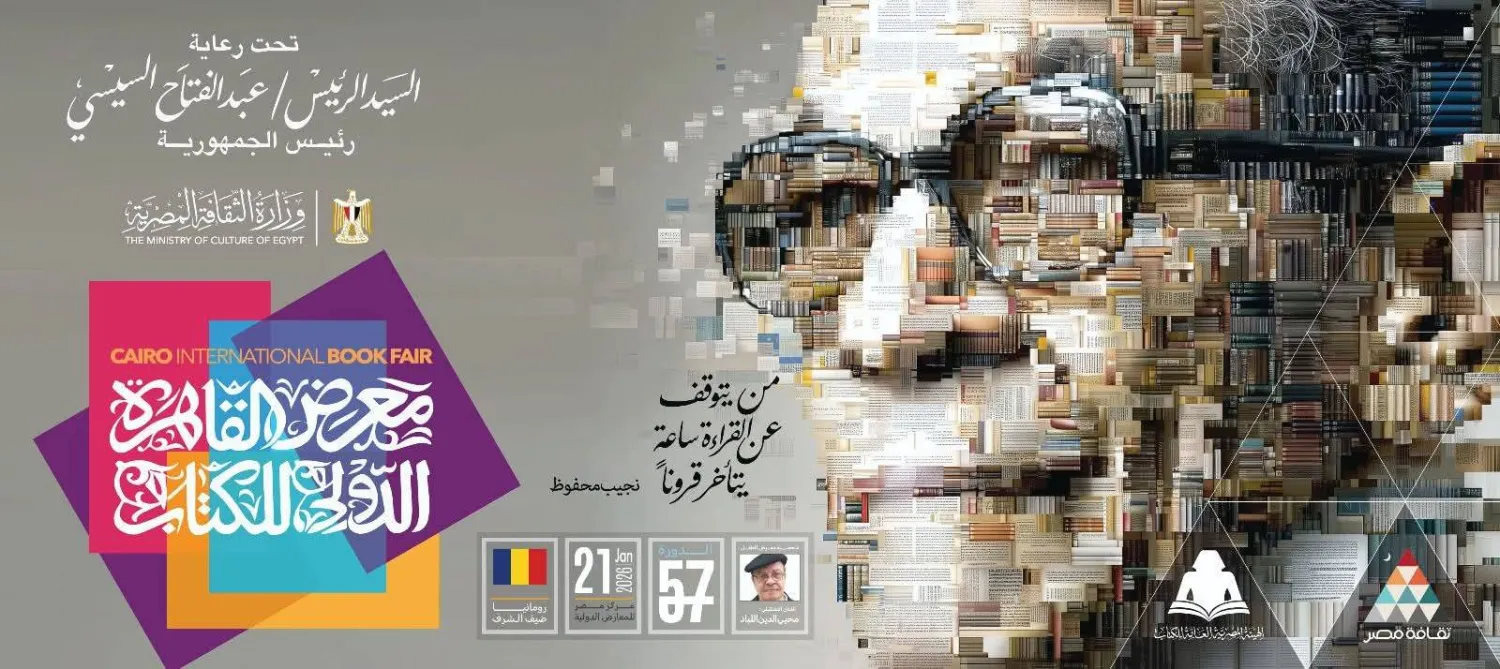«الحمد لله أنني أكرّم في وطني وأنني استطعت أن أعطي أبناء بلدي هذه الكتابة النابعة من جذورهم وأفعالهم. فخورة ببلدي؛ لهذا لم أحاول تركه حتى في أصعب الأوقات وأشكركم على تقديركم». بهذه الكلمات القليلة المؤثرة والمبللة بالدموع شكرت الأديبة إملي نصر الله رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، وهي تحادثه هاتفياً أثناء تسلمها وسام الأرز الوطني من رتبة «كوموندور» يوم الثلاثاء الماضي، في منزلها بعد أن أقعدها المرض عن الذهاب إلى القصر الجمهوري مع عائلتها، كما يفعل المكرمون عادة لتسلم أوسمتهم.
بدت إملي نصر الله وهي في السابعة والثمانين، بنفس إشراقة وجهها المعتادة وسماحتها، وتواضعها الجمّ وهي تقول: «أرجو أن أكون مستحقة هذه الحياة التي سعيت بكل جهد لأجعلها مثمرة، من خلال الكلمة والأدب اللبناني، ومن خلال خروجي من الفلاحة إلى الكتابة».
إملي نصر الله أديبة أنصفها القراء وغبنها المثقفون. أُنصفت لأنها كانت من أكثر الكتاب اللبنانيين، بين أبناء جيلها إغراء لأساتذة المدارس باعتماد كتبهم أو التوصية بقراءتها، أو الاقتباس منها؛ لهذا ربما ليس من لبناني لم يقرأ لها ولو نصاً صغيراً أو كتاباً، مهما كانت علاقته بالقراءة واهية. لكنها في الوقت نفسه، غبنت من قبل المثقفين؛ لأنها كتبت في زمن فارت فيه نظريات الحداثة في الشعر والرواية وبرزت روائيات متحديات متحررات، توسلن الأدب للتعبير عن احتجاجاتهن ورغبتهن الجامحة في الانعتاق من التقاليد والعادات الآسرة. فهي نموذج يكاد يكون على النقيض من تمرد ليلى بعلبكي العالي الصوت أو عبثية حنان الشيخ وسوريالية غادة السمان. لهذا بدت دائماً بالنسبة للكتّاب الآخرين، وكأنها تعيش حياة شديدة التقليدية، لا جنوح فيها ولا جموح، وتكتب أدباً هادئاً لا يبغي صخباً ولا يطلب ضجيجاً يحيط به، على عكس ما كان يتطلبه ذلك الزمان.
لكن صاحبة «الرهينة» و«الإقلاع عكس الزمن» و«الجمر الغافي» كانت تعتبر أنها تخوض معاركها التحررية على طريقتها الخاصة، وأنها حققت إنجازات كبيرة لمجرد أنها تابعت دراستها رغم أنها نشأت في قرية الكفير التي لا مدرسة فيها تتجاوز الصف الثالث الابتدائي، وأصبحت كاتبة وهي ابنة لوالد أمي، وأم خرجت من المرحلة الابتدائية. كانت تشعر بالتحدي وبأنها تنتصر خطوة بعد أخرى حين وجدت أنها وصلت إلى «الجامعة الأميركية» في بيروت مع أنها لم تكن تملك ما يؤمن دراستها. موّلت نفسها من العمل الصحافي الذي ابتدأته بفضل سيدتين دعمتاها، هما وداد قرطاس التي قبلتها معلمةً في المدرسة الأهلية التي كانت مديرتها، والكاتبة ادفيك جريديني شيبوب التي كانت رئيسة تحرير «صوت المرأة» التي شرعت أمامها أبواب الصحافة، وبقيت تعمل فيها حتى عام 1970 حيث قضت في مجلة «الصياد» 15 عاماً، لتترك بعدها إلى مجال آخر. ومن التحقيقات التي أجرتها والكتابات الصحافية التي مارستها، نهلت كثيراً واكتشفت عوالم جديدة، وكتبت عن أناس لم تكن لتلتقيهم لولا هذه التجربة. لكنها مع ثقل المسؤولية العائلية ورغبتها في أن تقول هي ما تريد عكفت على كتاباتها الخاصة، تاركة أي التزام وظيفي آخر، بعد أن تزوجت من رفيق عمرها فيليب نصر الله.
ومع أن الظروف في قرية ولادتها كوكبا، كما في الكفير التي انتقلت إليها صغيرة، لم تكن مواتية والتمييز ضد المرأة والعادات المحافظة لم تكن في خدمة تطلعاتها، إلا أن هذه المرأة المثابرة التي تزحف إلى هدفها كسلحفاة عنيدة، وجدت حولها خالين ساهما بشكل رئيسي في دعمها، الأول كاتب وعاشق للقلم هو أيوب أبو نصر، وكان أثناء تواجده في المهجر، وقبل عودته إلى لبنان، في «الرابطة القلمية» في نيويورك مع جبران خليل جبران، والخال الثاني مهاجر ميسور الحال هو توفيق أبو نصر، حرم من التعليم وقرر أن يعوض ما فاته من خلال مساعدة إملي وشقيقها مالياً. ويبدو أن الجدة كانت حكواتية متمرسة وعلى يديها تعلمت القص في السنين الغضة.
منذ شرعت في كتابة روايتها الأولى اختارت إملي أن تكتب عما تعرف وتعيش وتتنفس. وكان إخوتها قد هاجروا باكراً إلى كندا مما ترك أثراً كبيراً في نفسها فكتبت «طيور أيلول» عن الاغتراب وهذا البعاد الاختياري القاسي عن الوطن، فنالت بصدورها عام 1962 ثلاث جوائز، وبقيت الرواية تطبع وتنفد من حينها كما ترجمت إلى عدة لغات، كما هي حال غالبية كتبها. وبقيت نصر الله تكتب عن الاغتراب الذي عانت منه عائلتها جيلاً بعد آخر، في «الجمر الغافي» و«الإقلاع عكس الريح» وغيرها. فالهجرة من الموضوعات الأثيرة لديها مثل الحرب التي عايشتها كما كل اللبنانيين وكتبت عنها في «يوميات هرّ» و«خبزنا اليومي». وفي خضم رواياتها تبقى المرأة التي أذاها أن تراها مظلومة ومسلوبة الحقوق حاضرة، حتى أن روايتها «شجرة الدفلي» منعت في بعض الدول العربية. وكتبت ما يشبه موسوعة من ست مجلدات تحت عنوان «نساء رائدات من الشرق ومن الغرب» تعيد فيها كتابة حياة نساء من حضارات وأزمنة مختلفة «بقصد تسليط الضوء على ما مرت به المرأة، عبر العصور، من صراع مع نفسها، ومع محيطها، في سبيل إنماء طاقاتها، وتحقيق طموحها وأحلامها، وبالتالي، بلوغ الرتبة الرفيعة التي استحقتها». متوخية بذلك أن تكون كل واحدة من رائدات الأمس، مشعل هداية وإلهاماً لرائدات الغد.
بهذه الروح كتبت إملي نصر الله دائماً، لها هدف تنويري تربوي. فلم تنس مرة أنها امرأة ولها دور ترسمه كما تراه لا كما تفرضه عليها بيئتها المحافظة الأولى التي سرعان ما تحررت منها، أو بيئتها البيروتية اللاحقة التي كانت تغلي عشقاً لصرعات الحداثة. ولم يغب عنها أنها أم يوم تفرغت لعائلتها، أو أنها جدة حين صارت تكتب وتعتني بأحفادها في غياب أولادها. ظنت دائماً أن هذه التجارب اليومية العائلية والعاطفية هي نبع تغرف منه لتجعل أدبها أقرب إلى الحياة. لذلك؛ بقيت كتاباتها مليئة بالحب والعطف، تنضح إنسانية، وتعابيرها لا فذلكة فيها، وجملها لا تتصنع الصور أو تلعب على أوتار المشاعر. ظلت أمينة للقرية وشجرها وزهرها وتربتها وناسها، ولم تنس لحظة أنها عاشت فلاحة ذات يوم، رغم أن ذلك يعود إلى طفولتها الأولى. لعلها رغم حكمتها الشديدة، بقيت طفلة في مكان ما، واحتفظت ببراءة في الأسلوب ليس لغيرها، ومهارة في القص للأطفال لم يعط لكثيرين. فكم قلة هم الكتاب العرب الذين أغووا الطفولة بنصوصهم؟ فمن قرأ «أندا الخوتا» من الأولاد لا بد عشق النص وعاد ليقرأه تكراراً ثم كان حريصاً على أن يكمل حكاية هذه المرأة البائسة حين استكملتها بكتاب آخر هو «أين تذهب أندا؟» وعلى «الينبوع» و«بساط الثلج» التي استوحتها من إحدى سفراتها و«شادي الصغير» الذي يعيش في مزرعة قرب نهر ويحلم بالسفر كما تسافر السمكات السابحة أمامه في الماء» كان لأطفال لبنان الحظ أن يكبروا، وكان لإملي نصر الله ما يكفي من الصدق والصفاء والتوازن، لتكون بصبرها وبساطتها واحدة من الكتاب العرب المحظوظين الذين نجحوا في مخاطبة ضمائر الكبار كما الصغار، دون تكلف أو صنعة. ويأتي التكريم الرئاسي بمثابة اعتراف بقيمة الأدب الواقعي الخارج من صلب المجتمع.
8:47 دقيقه
الكاتبة اللبنانية إملي نصر الله... أنصفها القراء وظلمها المثقفون
https://aawsat.com/home/article/1167746/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%85%D9%84%D9%8A-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A3%D9%86%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%B8%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%88%D9%86



الكاتبة اللبنانية إملي نصر الله... أنصفها القراء وظلمها المثقفون
مكرمة من رئاسة الجمهورية بوسام الأرز الوطني من رتبة «كوموندور»

الوزير سليم جريصاتي يقلّد الأديبة إملي نصر الله الوسام الرئاسي
- بيروت: سوسن الأبطح
- بيروت: سوسن الأبطح

الكاتبة اللبنانية إملي نصر الله... أنصفها القراء وظلمها المثقفون

الوزير سليم جريصاتي يقلّد الأديبة إملي نصر الله الوسام الرئاسي
مواضيع
مقالات ذات صلة
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة