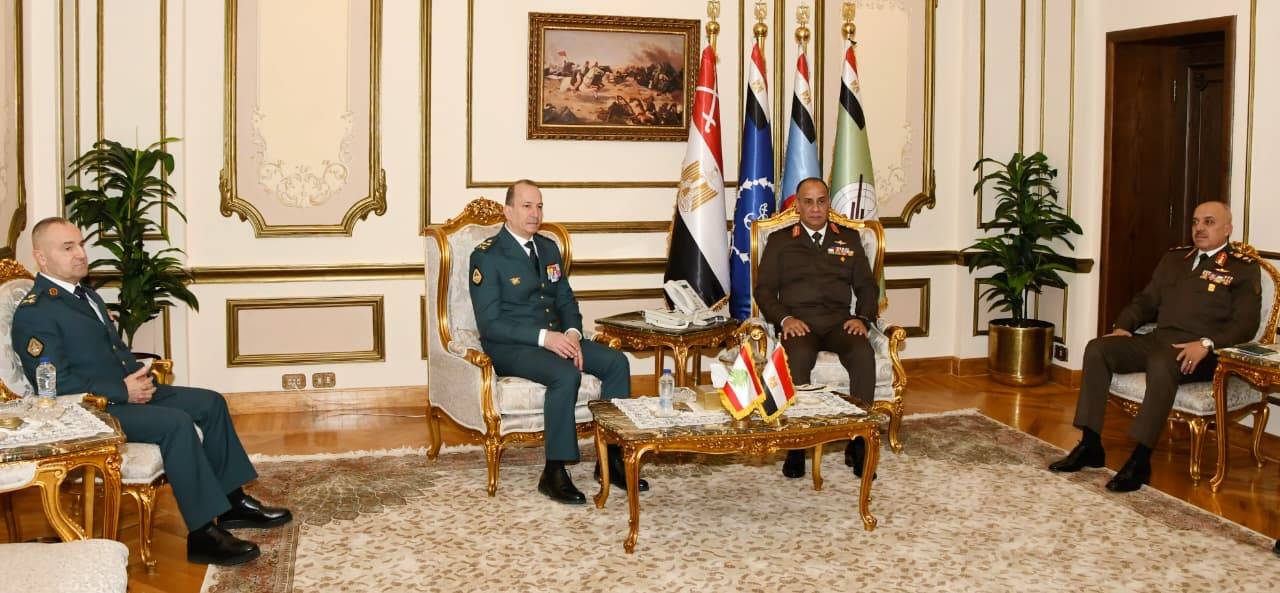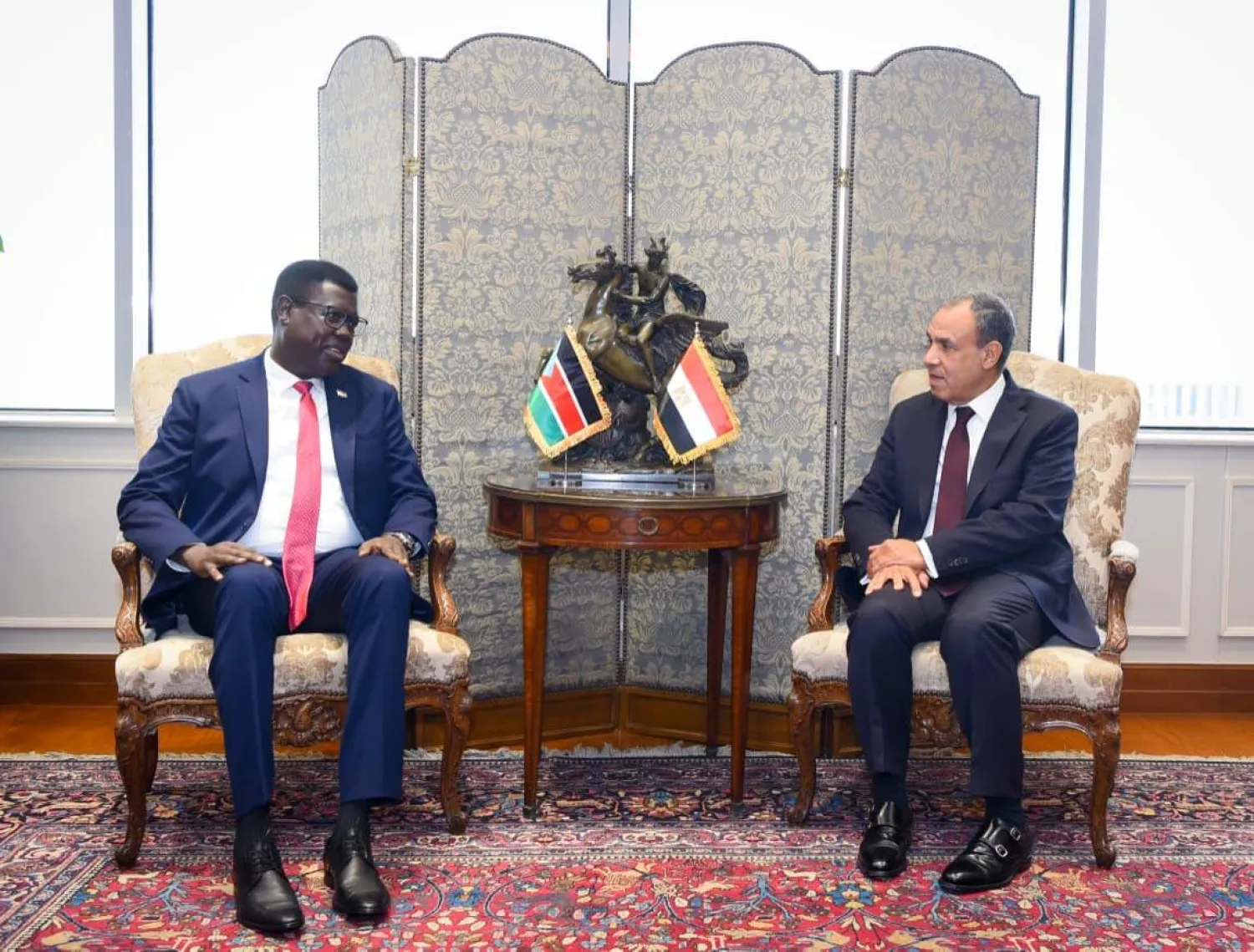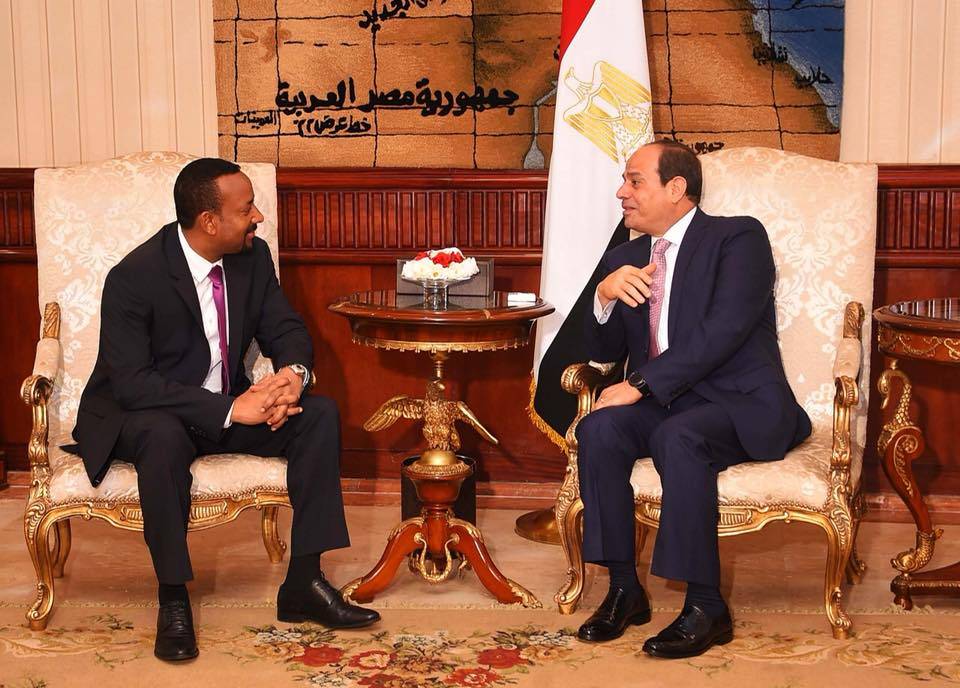بداية عام 2017، بدا أن إيران وروسيا وتركيا في طريقهم نحو فترة من العداء على خلفية التوجسات التاريخية العميقة والمتبادلة فيما بينهم. وكانت لا تزال حمى تبادل الاتهامات والإهانات مشتعلة بين روسيا وتركيا منذ حادثة إسقاط طائرة روسية مقاتلة داخل الأجواء السورية. أما إيران وتركيا فوقفتا على طرفي نقيض من الأزمة السورية، واختلفتا فيما بينهما حول مصير بشار الأسد الذي يفتقر إلى أي وجود حقيقي على أرض الواقع. أيضاً، ساورت إيران بعض الريبة حيال روسيا مع إرجاء الأخيرة تسليم منظومات أسلحة اشترتها طهران وسددت ثمنها، إلى جانب فرضها قيوداً على المحاولات الإيرانية للترويج للآيديولوجية الخمينية داخل حدود الاتحاد الروسي.
مع هذا، قرب نهاية العام، ظهرت صورة جديدة لإيران وروسيا وتركيا باعتبارهم أعضاء في تحالف ثلاثي يرمي لرسم ملامح مستقبل الشرق الأوسط في أعقاب عقدين من الفوضى والإرهاب والحرب. وللمرة الأولى، عقدت الدول الثلاث اجتماع قمة في منتجع سوتشي، وصفته وسائل الإعلام الإيرانية، التي تميل دوماً إلى المبالغة، باعتباره «يالطا الجديدة»، في إشارة إلى المؤتمر الذي عقدته الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا في أعقاب الحرب العالمية الثانية وقرروا خلاله «مستقبل العالم» في حقبة ما بعد الحرب. الأهم أن اجتماع القمة جمع بين كبار القيادات العسكرية في الدول الثلاث للمرة الأولى والتي عكفت على صياغة استراتيجية مشتركة.
وتمثلت النقطة الأهم التي تمخضت عنها القمة في اتفاق إيران وروسيا وتركيا على ما يبدو، على تقسيم سوريا فعلياً إلى خمس مناطق لخفض التصعيد، مع سيطرة كل منها على واحدة من هذه المناطق وترك الاثنتين المتبقيتين للولايات المتحدة وحلفائها الأكراد والدول العربية ممثلة في الأردن.
كما خرجت القمة باتفاق ضمني حول إبقاء الأسد في دمشق لـ18 شهراً أخرى يجري خلالها تنفيذ الخطة الروسية وتعزيزها. الواضح أنه ستكون هناك حاجة إلى الأسد كي يوقّع على تشريعات ويمررها البرلمان الشكلي الذي يعمل تحت قيادته، من أجل إضفاء غطاء شرعي على الخطة الروسية. وقد عبّر عن ذلك بوضوح قائد «الحرس الثوري» الجنرال محمد علي جعفري عندما قال: «ننتظر من الرئيس الأسد إضفاء طابع قانوني على القوات الشعبية»، في إشارة إلى «زينبيون» و«فاطميون» و«حزب الله» والميليشيات الأخرى التي شكّلتها إيران.
من جهتها، تحتاج موسكو هي الأخرى إلى الأسد لدفع الاتفاق الخاص باستئجارها أجزاء على السواحل السورية المطلة على البحر المتوسط قدماً. وهي تحتاج إلى هذه المناطق من أجل بناء أو توسيع قواعدها الجوية - البحرية. أما أنقرة، فتنتظر من الأسد إقرار قانون يسمح لها بالإبقاء على قوات على الأراضي السورية لعزل المناطق التي تقطنها أغلبية كردية، وكذلك اتخاذ إجراءات عسكرية ضد الجماعات الكردية المعادية لتركيا.
وتدرك أنقرة وموسكو وطهران جيداً أنه لن يكون بمقدور أي حكومة سوريا مستقبلية الإقرار بمثل هذا النمط من الوجود الذي تسعى خلفه روسيا وإيران وتركيا داخل الأراضي السورية. بيد أنه بمجرد إنجاز الأسد الخدمات الأخيرة المطلوبة منه، سيتخلى عنه من يحمونه غير مأسوف عليه.
إضافة إلى ذلك، ثمة أسباب أخرى تدفع أنقرة وموسكو وطهران للسعي وراء وضع نهاية للورطة السورية بسرعة، منها أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يواجه انتخابات رئاسية صعبة العام المقبل في ظل دستور جديد تخلى عن النظام البرلماني، وأقر محله آخر رئاسياً يركز معظم السلطات بيد من يجلس على مقعد الرئاسة. ويبدو إردوغان على ثقة شبه كاملة في الفوز، لكن يبقى التساؤل: بأي نسبة؟ الواقع أنه حال عزوف الناخبين عن التصويت وفوز إردوغان بأغلبية ضئيلة، فإنه سيفتقر حينئذ للسلطة الأخلاقية والسياسية التي تمكنه من الانطلاق في تنفيذ «الخطة الكبرى» التي سنتعرض لها لاحقاً. والواضح أن إردوغان في حاجة إلى الفوز بنتيجة كبيرة، وتكمن فرصته الوحيدة لتحقيق ذلك في الوقت الراهن في اقتناص قضمة كبيرة من التفاحة السورية.
وبالمثل، يواجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انتخابات رئاسية، ربما تكون الأخيرة بالنسبة له، العام المقبل. ويكاد يكون على ثقة هو الآخر من فوزه، لكنه يشعر بالقلق حيال شكل فوزه الانتخابي وحجمه. الواضح أن بوتين لا يرغب في إنهاء مسيرته السياسية بأدنى مستوى تأييد انتخابي. وفي ظل الاضطراب الذي يعانيه الاقتصاد الروسي وعدم استعداد قوى غربية لمنح روسيا مكانة متكافئة كقوة عظمى، يحتاج بوتين إلى نصر ضخم يتعذر تحقيقه اليوم سوى عبر إقرار تسوية ذكية في سوريا، مع المبالغة في الحديث عن «دحر الإرهاب» داخل ميدان القتال. أيضاً، يشعر بوتين بالقلق من مشاعر التذمر بين المسلمين الروس الذين تشير أغلب التقديرات إلى أنهم يشكلون نحو 27 في المائة من السكان. كانت صور الطائرات الروسية وهي تقصف مدناً يقطنها «إخوة مسلمون» قد أثارت بعض التوتر وعدم الارتياح في مختلف جنبات المجتمعات المسلمة داخل الاتحاد الروسي. ومن خلال ادعائه بوجود دولتين مسلمتين كبريين إلى جانبه، تركيا السُنية وإيران الشيعية، بإمكان بوتين طمأنة المسلمين الروس الذين كثيراً ما صوتوا لصالحه بأعداد ضخمة.
من ناحية أخرى، لدى إيران أسباب خاصة بها تدعوها للرغبة في التوصل لترتيبات تسوية في سوريا. على سبيل المثال، تكشف الموازنة الجديدة التي قدمها الرئيس حسن روحاني في 10 ديسمبر (كانون الأول) أن الاقتصاد الإيراني يواجه على الأقل عاماً آخر من النمو البطيء بجانب عجز قياسي، وتضخم يتجاوز 10 في المائة.
والواضح أن الأيام كشفت عن أن سوريا أشبه بـ«زواج متعة» تتجاوز تكاليف الاحتفاظ به إلى الأبد قدرة إيران، خصوصاً في ظل زيجات أخرى مشابهة لها مع ميليشيات في لبنان وفلسطين واليمن والعراق وغيرها. ففي وقت تعجز إيران عن سداد رواتب موظفيها بانتظام، يواجه إنفاق أموال ضخمة من أجل «تصدير الثورة» انتقادات حتى داخل «المجلس الإسلامي» الذي يتسم عادة بالوداعة السياسية. وتعني زيادة الميزانية العسكرية بنسبة 12 في المائة تضييق الخناق على مجالات أخرى، مع مخاطرة إثارة حالة من السخط الشعبي.
وعليه، نجد أن القيادة الإيرانية تتحدث هي الأخرى عن «نصر كامل داخل سوريا» على أمل تخفيف وجودها وأعبائها المالية هناك. أيضاً تحتاج طهران إلى أنقرة، ليس فقط لإحداث انقسام في صفوف المعسكر المناوئ للأسد، وإنما كذلك لإلحاق الضعف بحلف «الناتو» في جناحه الشرقي، مع السماح لإيران بتعزيز مكاسبها داخل العراق.
على المستوى التكتيكي، يبدو «التحالف الثلاثي» منطقياً، ذلك أن كل من روسيا وتركيا وإيران تواجه ضغوطاً من قوى غربية لأسباب مختلفة، وتتطلع نحو سبل للخروج من حالة العزلة التي فرضتها هذه الدول على نفسها عبر تحركاتها العدائية في القرم وأوكرانيا في حالة روسيا، والقلأقل التي تثيرها إيران داخل دول عربية عدة، ناهيك عن الخطاب التركي المناهض للغرب الآخذ في التصعيد.
إلا أنه على الصعيد الاستراتيجي، يبدو «التحالف الثلاثي» أكثر تعقيداً. تاريخياً، ساد العداء والتنافس العلاقات بين إيران وروسيا وتركيا. وبين القرنين الثامن عشر والعشرين، تورطت روسيا وإيران فيما لا يقل عن ست حروب كبرى. كما غزت قوات روسية إيران واحتلت أجزاء منها خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية. وفي أواخر أربعينات القرن الماضي، حاولت روسيا استقطاع أقاليم كبرى من إيران وتحويلها إلى جمهوريات صغيرة تدور في فلك نفوذها.
وبالمثل، خاضت روسيا وتركيا ثماني حروب كبرى بين القرنين الثامن عشر والعشرين، وكانا في معسكرين متقابلين خلال الحرب العالمية الأولى. وعلى امتداد عقود الإمبراطورية القيصرية، ضمت روسيا مساحات كبيرة من الأراضي الإيرانية والتركية إليها، منها القرم التي انتزعتها من يد الإمبراطورية العثمانية، وجنوب القوقاز التي انتزعتها من فارس القاجارية.
مع هذا، لا يعتبر التاريخ وحده العامل الذي يقوض إمكانات «التحالف الثلاثي»، وإنما تفصل بين القوى الثلاث كذلك رؤى مختلفة بخصوص المستقبل. من جهته، بنى بوتين رؤيته على فكرة يصفها البعض بـ«وهم يورآسيا» الجغرافي، الذي تبعاً له تقع روسيا في قلب قارة مميزة عن أوروبا وعن آسيا، لكنها تمثل أفضل ما في القارتين؛ الأمر الذي يؤهلها لأن تضطلع بدور القائد. ورغم أنه لا يوجد تعريف محدد لـ«يورآسيا»، فإنه من المفترض أنها تشكل مساحات واسعة من وسط أوروبا وشرقها، وصولاً إلى جبال الأورال، بجانب مناطق آسيا الوسطى وسيبريا المجاورة مباشرة للمحيط الهادي. وتتضمن الأجزاء الجنوبية من «يورآسيا»، جنوب القوقاز وإيران وصولاً إلى المحيط الهندي، بجانب بلاد الشام.
ويتناغم «مخطط يورآسيا الكبير» مع أسطورة روسيا القديمة و«روما الثالثة». وتروق هذه الفكرة لأصحاب النزعات السلافية الذين يحلمون بمساحة عالمية سلافية تقودها روسيا.
وإذا كانت رؤية بوتين جرى التعبير عنها على نحو جغرافي خرافي، تأتي رؤية إردوغان في صيغة شبه تاريخية تدور حول «العثمانية الجديدة»، وتقوم على فكرة أن المناطق التي كان يحكمها العثمانيون من قبل يمكن أن تعاد السيطرة عليها في إطار جديد من «التعاون الحر»؛ وذلك لحماية السلام وتمهيد الطريق أمام الرخاء. وتتضمن هذه المناطق شمال أفريقيا والمشرق العربي والبلقان، والكثير من أرجاء القوقاز والمناطق المحيطة ببحر قزوين والدول الألطية في آسيا الوسطى. وفي معظم هذه المناطق، ربما تجد تركيا في روسيا منافساً لها، إن لم تكن عدواً بصورة مباشرة. وبينما ستخوض تركيا هذه المواجهة بناءً على ادعائها بأنها تحمي الإسلام أو الثقافة التركمانية، ستدخلها روسيا بناءً على ادعاء بأنها حامية الثقافة السلافية داخل المناطق التي يشكل السلاف غالبية سكانها في القوقاز وآسيا الوسطى.
وداخل المناطق ذاتها تقريباً، ستدخل تركيا التي تزعم لنفسها زعامة المسلمين السنة، في تنافس مباشر مع إيران التي تزعم في ظل نظامها الخميني الحالي اكتشاف الصورة الحقيقية الوحيدة للإسلام. وفي هذه الحالة، ربما تواجه تركيا مشكلات مع الأقلية الشيعية لديها. كما أن اللعب بالبطاقة الدينية ربما يكون أكثر صعوبة مع الطوائف المتعددة التي تمثل المزيج القائم في المشرق العربي، ناهيك عن المسيحيين في البلقان وأجزاء من القوقاز.
وفي وقت اعتمدت روسيا على فكرة جغرافية واختارت تركيا فكرة تاريخية، تميل إيران في ظل نظامها الحالي إلى أسطورة شبه دينية جرى الترويج لها تحت مسمى «الإسلام النقي» القائم على مبدأ «ولاية الفقيه». ويكشف التاريخ عن أنه بينما يمكن للأفكار الدينية أن تجمع الناس، فإن هذه الوحدة دائماً ما تكون قصيرة الأجل. في المقابل، فإن المشروعات السياسية بمقدورها خلق كيانات أكثر استمرارية مثل إمبراطورية أو دولة قومية. بمعنى آخر، فإن الدين الذي لا يمكنه الإقرار بالاختلاف، دائماً ما ينتهي به الحال إلى تفريق شمل الناس، بينما تملك السياسة القدرة على توحيد صفوفهم، على الأقل لأنها تتيح لهم مساحة للوصول إلى حلول وسطى.
على مدار أربعة عقود سيطر خلالها الملالي على الحكم في إيران، ليس ثمة دليل يشير إلى أن النمط الذي يروجون له من الإسلام يجتذب تابعين جدداً في المنطقة التي يرغبون في الهيمنة عليها.
بيد أن المشكلة الرئيسية في الرؤى الثلاث - الروسية والتركية والإيرانية - أن أياً منها لا تتمتع بجاذبية ثقافية أو موارد اقتصادية؛ ما يجعلها تبدو أشبه بمجرد أوهام خطيرة.
وتقوم الرؤى الثلاث على فرضية مفادها أن الشعوب التي تعيش في المناطق المستهدفة تتطلع نحو قوى خارجية كقائد لها، وأن الولايات المتحدة مع تخليها عن دورها القيادي العالمي والاتحاد الأوروبي مع غرقه في مشكلاته، يفسحان المجال أمام قوى متوسطة الحجم، مثل روسيا وتركيا وإيران للتقدم نحو الأمام والاضطلاع بدور قيادي.
إلا أن هذا الرأي يفترض أن الشعوب المستهدفة، مثل العرب أو شعوب آسيا الوسطى، ستظل دوماً ضعيفة ومنقسمة على نفسها وعاجزة عن صياغة رؤية خاصة بها. وتقلل مثل هذه الحسابات من قيمة الموارد والعزيمة التي تملكها ولو أصغر الدول حجماً للمضي قدماً في الطريق الذي تختاره بمحض إرادتها.
ومع اقتراب عام 2017 من نهايته، يبدو التحالف الثلاثي متماسكاً، لكن هذا لا يمنع احتمالية انهياره قريباً، خصوصاً أن القوى الثلاث تركز أنظارها على المناطق ذاتها وتسعى لتولي زمام القيادة. كما أن الدول الثلاث لا تجمع بينها ثقافة مشتركة أو تاريخ من التعاون أو التحالف. الأسوأ أنها تستخدم أساليب تنتمي إلى القرن التاسع عشر في التعامل مع مخاطر القرن الحادي والعشرين وفرصه.
«تحالف سوتشي»... ثلاثي الأوهام المتعارضة


«تحالف سوتشي»... ثلاثي الأوهام المتعارضة

لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة