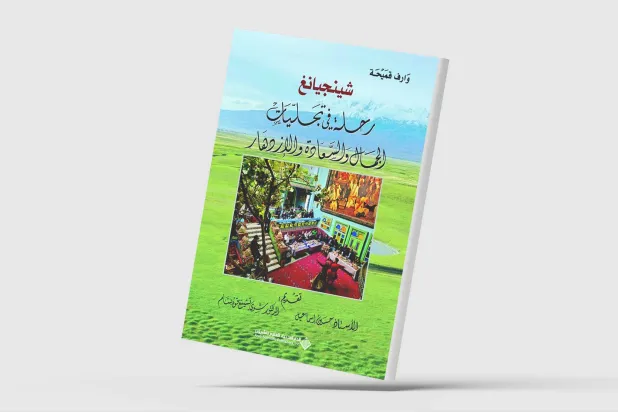عندما يكتب ثلاثون باحثاً/ ة عربياً عن «الزمن»، في مؤلف واحد، مع كل ما يشوب هذا الموضوع تحديداً من مشكلات وارتباكات، فإنه لأمر يستحق الاهتمام والتمعن. إذ ليس أكبر من أزمة تعاطي العربي مع «زمنه» القديم منه والحديث، بل ثمة إحساس دائم، بأن كل ما يلحق بنا هو سوء تفاهم مزمن مع «الزمن»، ومحاولة للحاق به دون جدوى.
الميزة هذه المرة، وفي هذا الكتاب بالذات، الذي يصدره بشكل دوري، «تجمع الباحثات اللبنانيات»، إنه مهجوس بالفعل بسؤال الإخفاق والنجاح، بإعادة فهم علاقتنا بالأحداث، بالأمكنة، بالعمارة، الألم، الشعر، الخبر، المسرح، المهنة، الرغبة، المحرمات، السلطة، الأنوثة، القانون، وحتى الاقتصاد والإنتاج من خلال ماهية علاقتنا بالزمن. غالبية الدراسات تقول في النهاية، مهما اختلفت الأسئلة والمعالجات «فإن كيفية تعاملك مع الزمن، هو الذي يحدد مسارك ومن ثم مآلك».
طبعاً السؤال الذي سيتبادر إلى الأذهان للتو، هو كيف؟
«الثقافة العربية في علاقتها مع الزمن تصادمية، عدائية، لأنها ترى فيه مصدر كل شر، والفراق والمرض والشيخوخة، الفناء، المستقبل مخيف (والله يستر من الجاية). الماضي مصدر حنين وبكاء على الإطلال (رزق الله على أيام زمان)» وكأنما الماضي هو الشيء الوحيد الجميل لكنه انتهى. والحاضر يجب ألا يستغرق فيه الإنسان كي لا ينسى الآخرة». بينما في ثقافة العولمة التي نريد أن نلحق بقطارها فإن «الزمن هو الوقت، هو إدارة الوقت والتخطيط واستشراف المستقبل» تقول فاديا حطيط في معرض دراستها لديوان الشاعر حسن عبد الله المعنون باسم «فرح» الموجه للأطفال. إذ حتى في الكتابة للطفولة ترى الباحثة أن ثمة فرقاً في التعاطي مع الزمن عند حسن عبد الله كشاعر عربي وما نراه في الثقافة الغربية. فهو يكتب للطفولة بمعناها التقليدي ببعدها الرومانسي، كرمز للبراءة والسعادة بحيث «يصبح التفاؤل أمراً جوهرياً» بينما النظرة الغربية تضع صعوبات الطفولة نصب عينيها، وتنشغل بوضع حلول لمعضلات الصغار من أجل مستقبل أفضل.
ليس جديداً أن العربي انشغل طويلاً بالماضي ولا يزال، ولافت المحور المخصص للشهادات الشخصية التي كتبتها كل من إيفلين حمدان، ونازك سابا يارد، وحسام عيتاني، وخاتون سلمى، وكذلك مي جبران، حيث جاءت في غالبيتها متوغلة في العودة إلى ذاكرة عتيقة بحثاً عن الذات. لعل ذاكرتنا كعرب تنحو دائماً باتجاه الأكثر قدماً ولا تجازف في التعاطي مع ما هو أقرب وقد يكون أقل وضوحاً. لسبب ما تذكر ظاهرة حب العودة إلى الماضي البعيد في هذه الشهادات الذاتية، بإصابات ألزهايمر، التي تجعل الإنسان أشد صلة بطفولته وشبابه الأول منه بما هو لصيق به.
فهل نحن أمة مصابة بألزهايمر لشدة ما نحب الماضي ومع ذلك تبقى علاقتنا معه مضطربة. يبدو أننا في المسرح أيضاً كثيرو العودة إلى استرجاع الأحداث حيث تعتمد وطفاء حمادة في دراستها على ثلاثة نصوص وعرضين اثنين، بحيث أن هذه النصوص جميعها «زمنها استرجاعي» وإن كنا بعد اكتمال العرض نرى أزمنة أخرى تدخل على الخط مثل التعاقبي والتكراري والمستقبلي، نتيجة العمل الإخراجي على النص.
حتى في المحور الشيق المخصص لدراسات حول «تسارع الزمن» نجد الباحث محمد الحداد يقول وهو يتحدث عن الانتفاضات العربية في وجه السلطة إن «المسار الثوري سار في اتجاه تسريع التاريخ في تونس ثم مصر فليبيا واليمن، وتوقف بغتة في سوريا، وارتد هذا التراجع وأصبح مساراً عكسياً، إذ أثر سلباً في اليمن، ثم في ليبيا، فمصر، وتونس. كأن الزمن رجع بنا القهقرى». لا بل أخطر من ذلك، يرى الحداد أنه لا يبدو ممكناً تسريع حركة التاريخ من دون عنف. وكما في غالبية دراسات الكتاب، ونظراً للمعارك الكثيرة - وفي كل اتجاه - التي نعيشها، تبقى الأسئلة كثيرة والإجابات مفتوحة، والمستقبل ضبابي. بعد قراءة ممتازة لأحداث «ثورة الياسمين» وامتداداتها العربية، يسأل الحداد: «هل الثورات العربية فاتحة ما بعد الحداثة أم هي استمرار لمعارك داحس والغبراء وصفين والجمل والفتنة الكبرى» مع استحالة الوصول إلى جواب موضوعي بالنسبة له. كذلك يسأل: «هل كان الحراك العربي تسريعاً للزمن أو شللاً مؤقتاً عمّق أزمات المجتمعات العربية ودفعها إلى حركة تدمير ذاتي؟» ويكمل بالقول: «قناعتي الوحيدة هي أن المستقبل مفتوح على أكثر من احتمال، بل على احتمالات قد تكون عسيرة التصور في الوقت الحاضر».
هكذا نفهم أننا حين نخرج من مأزق «الإقامة في الماضي» الذي أدمناه، ونحاول أن نسرع الزمن ونلحق بالقطار فإن الدراسات تتحدث عن اضطراب وقلق وربما عنف كما شهدنا سابقاً. فالدراسات التي حاولت رصد الإعلام مثلاً تأخذنا إلى إجابات متناقضة تعكس صعوبات في التعامل مع الوقت وارتباكاً في السلوك اليومي. ففي الأجوبة على استبيان لدراسة أجرتها نهوند القادري على 55 طالبا وطالبة، في كلية الإعلام، ماستر بحثي، يقول الطلاب في إجابة على طريقة استخدامهم لوسائل التواصل إن 27 في المائة يستخدمونها للمعلومات و23 في المائة للأخبار، و15 في المائة للعمل، و19 في المائة للتسلية و15 في المائة للتواصل. أي عملياً 65 في المائة من الاستخدام يصب في خانة العمل. ومع ذلك فإن أكثر من نصف هؤلاء يفكرون دائماً أو أحياناً في التوقف عن استخدام الإنترنت. وحين يسألون عن السبب فإن نصف الذين أجابوا على الأسئلة قالوا لتجنب هدر الوقت. والمثير أيضاً أنهم حين يسألون هل يجدون في استخدامهم للإنترنت انعكاساً إيجابياً على أدائهم الأكاديمي فإن 30 في المائة فقط تجيب إلى حد كبير، و49 في المائة إلى حد ما، و31 في المائة لا يرون انعكاساً. حين يتعلق الأمر بطلاب كلية الإعلام الذين يبنى عملهم في الأساس على الخبر، تواتر الأحداث، والراهنية بعد أن أصبحت المواقع الصحافية موضة تفوق الصحف وتنافسها، فإن التفكير في الاستغناء عن الإنترنت بنسبة نصف الطلاب المستبينين وعدم إيجاد جدوى بنسبة الثلث في بقاء الاتصال مع العالم، يدل على خلل ما إما في التعاطي مع شبكة الإنترنت أو إدارة الوقت، أو في فهم المهنة التي يفترض أنهم يستعدون لمباشرتها. والمعضلات الثلاث معاً يعتبر عبد الله الزين الحيدري في دراسته «الزمن الاجتماعي والزمن الميدياتيكي» أنها تتسبب في أزمة. ويقول إن مبحث الزمن في الإعلام لم يدرس بالقدر الكافي كما هو الحال في الدراسات العربية النقدية والأدبية والفلسفية. فهل الزمن الإعلامي، الذي نعتمده لنفهم ما يدور حولنا مضطرباً أيضاً، هذا أمر في غاية الخطورة. للاستزادة من هذا الموضوع نجد عند لمى كحال في دراستها «الإنسان المعاصر بين الزمن الاتصالي والزمن الواقعي، أزمنة متداخلة ومتقاطعة» بعض الإيضاحات. فمن خلال دراسة ما يزيد على عشرين حالة، تخلص إلى أننا «نعيش هنا وهناك، في كل مكان في آن معاً، نعيش الآن والأمس، والغد في اللحظة نفسها، وبالتالي نستخلص أن العالم الافتراضي يحتوي بداخله على الأزمنة كلها، وإن كان هناك تحليل مناقض يقول إننا نعيش في اللامكان ونعيش سطوة اللحظة». خلاصتان رئيسيتان مفيدتان عند لمى كحال: أن الوسائل الحديثة أقحمت الواقعي بالافتراضي ووضعت الفرد أمام سيل من اللحظات الحاضرة المتدفقة التي تسير جميعها بموازاة بعضها البعض من دون أن توقف إحداها الأخرى. والخلاصة الثانية هي على عكس ما يقول البعض فإن وسائل التواصل ردمت الهوة بين الأجيال في العالم الافتراضي، بينما لا تزال المسافة كبيرة بين الجيلين في العالم الواقعي. وهو ما يخلق نوعاً من الخلل بين العالمين.
النتائج تبدو موضع إثارة أيضاً في دراسة محمد علي شكر عن تسارع الزمن وتأثر السلطة إذ يجد أن دور وسائل الاتصال في بلادنا من الناحية الإعلامية، لعبت دوراً أسرع بكثير من الذي رأيناه في الدول التي اخترعتها، بسبب ما أحدثته من انتفاضات وتغيرات على مستوى السلطة الحاكمة، وبسبب الاهتمام الشديد من الجيل الشاب بالتقنيات الحديثة، التي أعتقته من «عبودية الإعلام التقليدي الذي فشل في ترويضه». إذا كان من استنتاجات عامة لهذه الدراسات فهي أنها تفسر لماذا يبدو الزمن الماضي أكثر دفئاً وجمالاً وأقرب إلى الهدوء والدعة، فيما خوض غمار حياة تكنولوجية شديدة الحداثة، تبدو فيها الأزمنة مركبة، متداخلة، متصارعة، هو نوع من الجنون.
بيسان طي تقرأ كتاب هارموت روزا «التسارع نقد اجتماعي للوقت» لنكتشف معها ليس فقط أهمية السيطرة على الوقت من أجل عيش أكثر هناءة، وإنما أيضاً أن العالم مشغول بـ«اقتصاد الوقت». الوقت هو المال، هو المحرك وأن «ثقافة الحداثة عنيدة في معارضتها لأساليب تضييع الوقت». ومع روزا وبيسان طي، نلحظ أننا نعاني في العالم العربي من أعراض ضغط الحياة، وشح الوقت وتسارع الإيقاع اليومي، دون أن نلمس عملياً آثاراً إنتاجية فعلية. وهو ما كتبت عنه رفيف صيداوي أيضاً في «الزمن وتقاطعاته من خلال عالم العمل»، وعن أن المهن «تفقد ديمومتها واستقرارها، بخلاف فترة الحداثة، حيث كانت لا تزال المهن تنتقل من الآباء إلى الأبناء. صارت بنى العمل داخل المؤسسة وفي فترة قياسية تشهد تحولات وبإيقاع سريع، بل التغير يطاول شكل العمل نفسه، ونوع المهن، وماهيتها. تأخذنا الدراسات في الكتاب، إلى محاولات فلسفية وسيكولوجية واجتماعية لفهم الزمن، ويغيب في أحيان كثيرة، الزمن بمعناه اليومي الأولي وما يعانيه من فوضى. فأسوأ ما نعاني منه ربما، هو اختلال خط التاريخ، معرفتنا لتتابع الأحداث. إدراكنا لمعنى التعاقب الصحيح للأحداث، ما الذي جرى قبل، وما الذي حدث بعد، وفي أي سياق، وما هي الملابسات. تكفي إعادة توثيق المعلومات حول أي حدث، وقراءته من جديد لتتغير نظرتنا إليه. فغالبية الطلاب الجامعيين العرب لم يكونوا قبل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، يعرفون «نكبة» ولا «نكسة»، ولا يعرفون شيئاً عن اتفاقيات السلام. مع أنه لا هوية لإنسان لا يعرف خط زمنه الشخصي والجماعي. كثيرون كي لا نقول غالبيتنا لا نمتلك رؤية واضحة وحقيقية لخط الزمن الجماعي، لذلك نبقى في الأفكار الهلامية والاختلاقات السياسية، والافتراءات الإعلامية. الزمن أولوية وخط الزمن الذي يوازي الهوية هو جوهر المعرفة.
«الباحثات اللبنانيات» مشغولات بلعبة «تسريع الزمن»
كتاب التجمع السنوي صدر بمشاركة ثلاثين باحثاً

عزة سليمان من {تجمع باحثات} - نهوند القادري من محررات الكتاب

«الباحثات اللبنانيات» مشغولات بلعبة «تسريع الزمن»

عزة سليمان من {تجمع باحثات} - نهوند القادري من محررات الكتاب
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة