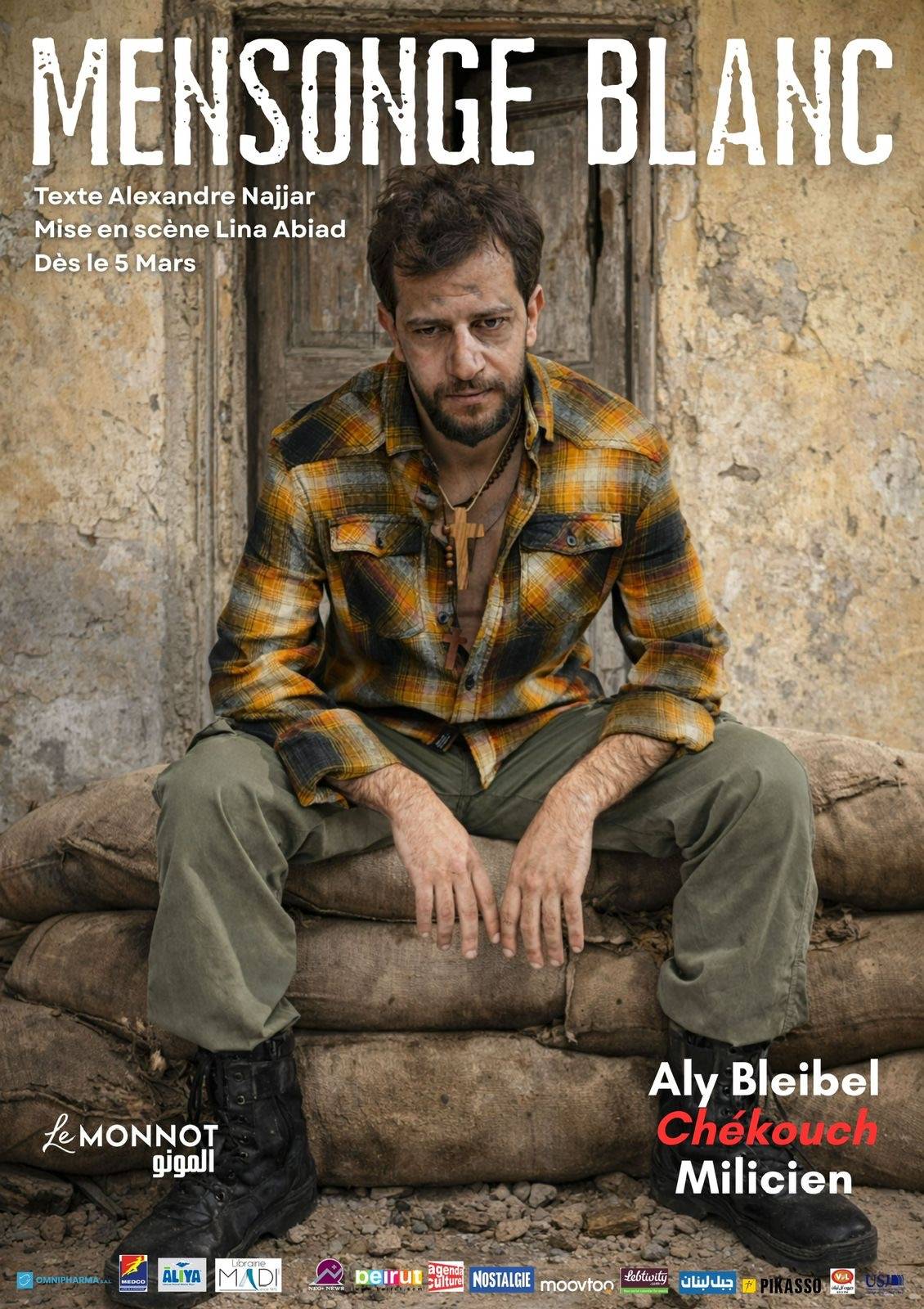ثلة ذكية من الشواعر المغربيات يتدافعن في الباحة المفتوحة على الألم، لينثرن ضفائرهن الخضراء تحت شمس أفريقيا الكثيرة من المتوسط حتى الأطلسي.
سنية الفرجاني في مجموعتها الشعرية الجديدة، «امرأة بني باندو»، منشورات «برسيكتف»، 2017، واحدة من تلك الثلة الذكية، وهي تفكك نصها وتركبه على وفق تدبير لغوي حساس لتصنع بصمتها التعبيرية الخاصة، إذ تحاول أن تقول لقارئها: إن الباحة تحتشد بالكثير، غيرنا، نحن بنات الثلة الذكية، حيث التشابه والقص واللصق، إذ علينا أن نلفت الانتباه عبر البوح لا الضجيج.
ليس سهلاً أن يعثر الشاعر (ة) على كرسيه البسيط لكن في الركن الواضح من تلك الباحة، إذ عليه أن يمر بلحظات مزمنة من المكابرة والمكابدة، التي هي سلَّمه غير المأمون لبلوغ أفضل حالاته: قصيدته التي لا تشبه قصيدة غيره وإن تأثر بجميع شعراء العالم.
قصيدة الفرجاني تلويحة مقتضبة للعالم من خلف ستارة مواربة مفتوحة على طقس خائف «كوطن عربي يرتجف» كما تقول. «صرتُ أثقل من حديقة / وكأس فوق طاولة الليل / امتلأت، فجأةً… ارتجفتُ كوطنٍ عربي / أمسكتُ قدمي وسرتُ بهما نحو الباب / كان الباب مصاباً بضوءٍ ما».
ثمة اختراقات «لا منطقية»، كما تبدو لقارئ متدرب، غير مدرَّب، للجملة العربية المألوفة، حيث، هنا، واحدة من العلامات الكثيرة في القصيدة الجميلة، لبلوغ الدهشة غير المرئية فيها، دهشة توخزُ قارئها من حيث لا يتوقع.
لتأتي الصورة اللافتة مثل: «كان الباب مصاباً بضوء ما»، علامة أخرى من تلك العلامات الكثيرة. تكتب الفرجاني قصيدتها تحت وطأة شعور حاد بالوحشة، لكن هذه الوحشة ليست شعوراً أنانياً، كالشعور بالألم الذي لا يؤلم غير صاحب الألم، وحده، بل لأنها شاعرة يتضاعف في قلبها رنين السلاسل، كامرأة أيضاً، وهي ترمق العالم من خلف تلك الستارة المواربة: القصيدة. هي شاعرة يملي عليها ألمها الشخصي أن تتلمس آلام العالم من حولها، وهي «تجمع زجاج الناس المهشمين»:
«أعدكِ يا حياتي / أن أستيقظ باكراً كديك / كي أبدأ الضوء من أوله / وأجمع من طريقي / زجاج الناس المهشمين».
قصيدة الفرجاني كتابة ضد الوقت. اقتباس الحادثة وتفنيدها والذهاب إلى غرفة النوم بأرق متوقع، وانعطافة لاإرادية نحو الشارع العام صباحاً بعينين لم تغمضا باسترخاء لأن العالم متوتر «كن سخيا أيّها الليل / فالنهار جبار / كنمر سريع ومفترس وقاتل أحلام / كن سِمْسِماً أيها الظلامْ / فليس في خاطري أن أنامْ».
ثمة «سريلة» - من سوريالي - تلمع هنا وهناك في قصيدة الفرجاني، وفي أغلبها لا تخرج عن طريقتها في اعتماد ذلك «اللامنطق» الذي أشرت إليه قبل سطور، عندما يصبح الحب سؤالاً غريباً عن الغربة والغرباء وإن كنّا مقيمين في قلب غابة رحيمة: «لماذا حين نحب / نصير غير ملائمين للطقسْ / وتجتمع الحروب فوق أجسادنا / نشعر بالحجارة تسقط فينا / ونسمع وقع الغيابْ / ونمشي خطى لا تؤدي لأي وطنْ». و«السريلة» تتبدى في انكسار الجملة / الصورة عندما لا يتطابق العالم مع اللغة، ولا مع الأحلام إلا بمعناها كتابة تلقائية لا تخضع إلى عرف النمط اللغوي وصورة الحياة في هشاشتها.
طبعاً، أن يلتقط قارئ مثلي، لفتته قصائد هذه الشاعرة، ما يمس حواسه وحساسيته، على ضوء ذائقته النقدية، وطريقة استقباله لنصها الشعري، فإن الأمر لا يخلو من التباس بشأن المكتوب والمقروء، لأن هذا القارئ له مواصفات ومواضعات وتلمسات تخصه وحده، أي تختلف عن تلك التي تستعمر قراء آخرين قرأوا هذا النص. فثمة، إذن، فجوة، أو فجوات، بين النص وقرّائه المتعددين، وما هي إلا طبيعة الكتابة والقراءة، حيث النقصان اللابد منه، فليس من نص مكتمل، ولا قراءة بلا فجوات، وهذا، أيضاً، من سنن القراءة والكتابة.
وإذا كتبت الفرجاني عن مدينتها، أو قريتها أو محلتها (بني ماندو) فهي ترصد جغرافيا كبرى للاتفاهم مع الواقع ولا تجد سوى وسيلة وحيدة للتفاهم غير أن تجعل من بني ماندو عاصمة للوحشة، منذ انطفاء آخر شمعة في آخرة الليل حتى ذاك الصباح الذي استيقظت من أجله، مثل ديك، كي تدرك أول انبثاقه.
قصيدة النثر العربية، الشائعة، التي يكتبها الشبان العرب، من الجنسين صارت تمثل إحراجاً نقدياً للمشتغلين في نقد الشعر، لأنها نص هلامي يستظهر الغموض ويستبطن السهولة، نص يغري بالمعنى المشكوك فيه واللامعنى المؤكد في قصائد هذي الأيام، لكن تجربة هذه الشاعرة تشي بوعود واقتراحات وفرص استقبال جمالية عدة.
شاعرة تجمع زجاج الناس المهشمين
https://aawsat.com/home/article/1034786/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B4%D9%85%D9%8A%D9%86



شاعرة تجمع زجاج الناس المهشمين
«امرأة بني باندو» للتونسية سنية الفرجاني

- لندن: عواد ناصر
- لندن: عواد ناصر

شاعرة تجمع زجاج الناس المهشمين

مواضيع
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة