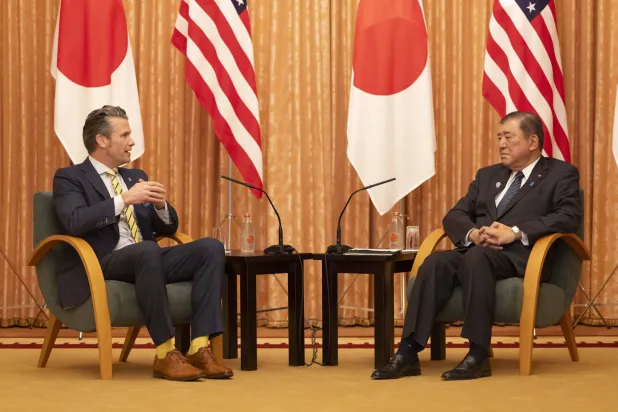بعد مرور شهرين على انطلاق الولاية الثانية لدونالد ترمب، ما زال ملف العلاقات بين واشنطن وجوارها الأميركي اللاتيني موضع تساؤلات وتخمينات حول موقعه في تراتبية أولويات الإدارة الأميركية الجديدة. إنه ما زال كذلك رغم المؤشرات الكثيرة التي وردت في خطاب القَسَم الرئاسي أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، وما تلاها من خطوات بشأن ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وإعلان الحرب على التنظيمات الإجرامية الناشطة في تجارة المخدرات، وفرض حزمة من الرسوم الجمركية الإضافية على البضائع والسلع الواردة من المكسيك، أحد الشركاء التجاريين الأساسيين للولايات المتحدة، ناهيك من التوعد باسترجاع السيطرة على قناة بنما، وإطلاق التهديدات باتجاه كولومبيا وكوبا وفنزويلا.
على الرغم من اختيار الرئيس الأميركي دونالد ترمب السيناتور ماركو روبيو، أبرز «صقور» الدياسبورا الأميركية اللاتينية في واشنطن، لمنصب وزير الخارجية، فإن الرئيس العائد لم يكشف حتى الآن عن نياته الحقيقية، ولا عن تفاصيل برنامجه بشأن ما تُوصف تقليدياً بـ«الحديقة الخلفية» لواشنطن ودائرة نفوذها العميق منذ عقود طويلة.
السبب في ذلك هو أن جلّ اهتمام ترمب حتى الساعة يبدو منصبّاً على تحقيق وعده الأكبر في السياسة الخارجية بإنهاء الحرب في أوكرانيا، والتفرغ لاحقاً للملفات الرئيسة الأخرى، التي ما زال التركيز عليها دون ما هو على الحرب الأوكرانية.
فقط المكسيك وبنما
في الخطاب الذي افتتح به ترمب ولايته الرئاسية الثانية لم يشر إلى أي منطقة أو دولة في العالم سوى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة وبنما. إلا أنه إبان ولايته الأولى، كان ترمب أول رئيس أميركي منذ 7 عقود لا يزور أي دولة في أميركا اللاتينية، باستثناء مشاركته لساعات معدودة في «قمة مجموعة العشرين» التي استضافتها الأرجنتين عام 2018. وفي حملته الانتخابية الأخيرة، كما في حملة عام 2016، لم يذكر أميركا اللاتينية إلا من باب كونها المصدر الرئيس للهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة، وبؤرة للمنظمات الإجرامية التي تغرق السوق الأميركية بالمخدرات والعنف، متوعداً بتضييق الحصار على كوبا، وإسقاط نظام مادورو في فنزويلا.
يعود ترمب إلى البيت الأبيض وفي جعبته إحباط لما تعذّر عليه تحقيقه خلال الولاية الأولى من وعود بشأن أميركا اللاتينية، ويبدي مزيجاً من الغضب وعدم الاكتراث بهذه المنطقة التي، رغم أهميتها الاستراتيجية التاريخية بالنسبة للولايات المتحدة ، ينحو إلى التعامل معها بأسلوب الوصاية والتبعية والقدرة الواثقة من فرض الشروط عليها، لا من باب المصالح المشتركة والحرص على استقرارها السياسي والاجتماعي.
وليس أدلّ على نظرته الفوقية إلى هذه المنطقة، وعلى المخاوف التي تساور «الدائرة الضيقة» النافذة التي دعمت وصوله إلى البيت الأبيض، من القرار التنفيذي الذي أصدره بعد أيام من جلوسه في المكتب البيضاوي بإعلان «الإنجليزية» اللغة الرسمية الوحيدة في الولايات المتحدة. وبذا تجاهل أن الإسبانية هي اللغة الأم لما يزيد على 45 مليوناً من سكانها، وأنها منتشرة على نطاق واسع ليس فحسب في المدن الكبرى مثل لوس أنجليس وميامي ونيويورك، بل أيضاً في العمق الأميركي والمناطق الزراعية الشاسعة.
للتذكير، في عام 1823 أطلق الرئيس الأميركي (يومذاك) جيمس مونرو في خطاب أمام الكونغرس شعاره الشهير «أميركا للأميركيين». ولقد بنيت على هذا الشعار إحدى أقدم السياسات الخارجية الأميركية التي صارت تُعرف بـ«شرعة مونرو»، التي كانت عملياً تحذيراً موجهاً إلى الدول الأوروبية الكبرى (يومذاك) بألا تتدخل في شؤون القارة الأميركية، بعدما «كرّت سبحة» استقلال البلدان الأميركية اللاتينية عن الأنظمة الملكية في إسبانيا وفرنسا والبرتغال.
بيد أن هذه العقيدة، التي بدت في ظاهرها «وقفة تضامنية» مع بلدان المنطقة الظافرة باستقلالها بعد حروب طويلة ومدمِّرة مع القوى الاستعمارية، تحوَّلت سريعاً إلى سياسة توسُّعية لحماية مصالح واشنطن الاقتصادية، وأداة للتدخل السياسي والعسكري والاقتصادي في شؤون دول الجوار.
وبالفعل، لم تتردد واشنطن يومها في اعتبار أي محاولة أوروبية للتدخل في شؤون بلدان المنطقة اعتداءً على المصالح الأميركية، والتأكيد على أن واشنطن ستتولى الدفاع عن «سيادة القارة» الأميركية.
بين الأمس واليوم
لم يكن تنفيذ تلك السياسة سهلاً في تلك الفترة؛ لأن الولايات المتحدة يومذاك ما كانت القوة العظمى التي نعرفها اليوم، بل كانت دولةً ضعيفةً مقصورةً على ساحلها الشرقي بعد أقل من 50 سنة على استقلالها. لكن تلك «الشرعة» بقيت راسخة بوصفها واحداً من الأسس التي قامت عليها السياسة الخارجية الأميركية، وبدأت تظهر تجليّاتها العملية أواخر القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين. واستمرَّت بعد ذلك إلى أن كان أخطر فصولها «أزمة الصواريخ الروسية في كوبا» التي وضعت العالم على شفا مواجهة نووية.
مع أن «شرعة مونرو» لم تعد قابلة للتطبيق اليوم كما في الماضي، فإنها ترسَّخت على مرّ العقود في الذهنية السياسية الأميركية تجاه البلدان المجاورة، وتحوَّلت إلى الهاجس الرئيس لهذه البلدان في علاقاتها مع واشنطن التي لا تزال تلعب دوراً فاعلاً جداً في سياسات هذه البلدان.
من جهة ثانية، بعدما كانت تلك «الشرعة» أساساً لسياسة واشنطن وجهوزيتها لاستخدام القوة العسكرية من أجل منع تمدّد نفوذ الدول الأوروبية إلى مستعمراتها السابقة، تجد الولايات المتحدة نفسها اليوم في مواجهة تحدٍّ مختلف يهدد مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية في المنطقة.
إنه تحدّي التغلغل الصيني في حديقتها الخلفية، الذي بات يهدد هيمنتها الاقتصادية التاريخية على جوارها الإقليمي. وما يزيد من خطورة هذا التحدي أنه يتزامن مع بداية انحسار الهيمنة الأميركية، وتراجع النفوذ الأوروبي، وازدياد الثقة الذاتية لدى القوى الاقتصادية الناشئة.
العملاق الصيني
لسنوات عديدة لم يكترث الأميركيون كثيراً لخطورة التغلغل الصيني البطيء - والبعيد غالباً عن الأضواء - في أميركا اللاتينية، وتحوُّل بكين شريكاً تجارياً واستثمارياً في المرافق الحيوية.
ولكن خلال السنوات الخمس الأخيرة، وحدها، وقَّعت الصين اتفاقات واسعة للشراكة الاستراتيجية مع كل من الأرجنتين والبرازيل وتشيلي والإكوادور والمكسيك وبيرو وفنزويلا. وغدت منذ عام 2017 الشريك التجاري الأول لبلدان المنطقة على صعيد الصادرات، بعدما سجَّلت المبادلات التجارية بين الطرفين نمواً بنسبة 30 في المائة ذلك العام.
في موازاة ذلك، بلغ مجموع الاستثمارات الصينية في أميركا اللاتينية نهاية العام الماضي 241 مليار دولار. وأعلن الرئيس الصيني تشي جينبينغ أخيراً أن استثمارات بلاده في المنطقة ستتضاعف في السنوات الخمس المقبلة، إذ ستتجاوز نسبة نمو الاستثمارات الصينية المباشرة في أميركا اللاتينية بكثير نسبة نمو الاستثمارات الأميركية والأوروبية.
هذا، ومنذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض، كرّر المسؤولون الصينيون في مناسبات عدة أن لأميركا اللاتينية أهميةً استراتيجيةً بالنسبة لنمو الاقتصاد الصيني، وأن التزامات الحكومة الصينية تجاه بلدان المنطقة التزامات طويلة الأمد. وتَبدَّى هذا الأمر غير مرة في المنتدى الذي يجمع الصين وبلدان أميركا اللاتينية وحوض الكاريبي، الذي كان من قرارات دورته الأخيرة التي انعقدت في تشيلي، وضع خطة عمل تمتد لخمس سنوات، وإنشاء خط للنقل البحري امتداداً إقليمياً لمشروع «طريق الحرير».
وبعدما كانت الاستثمارات الصينية جميعها في السابق تركّز على البُنى التحتية واستخراج المعادن في أميركا اللاتينية، انتقل التركيز الآن إلى القطاعات التصنيعية. وما يزيد من مخاوف واشنطن الاستراتيجية الآن، أن رغبة الصين في إرساء دورها قوةً بديلةً في النظام العالمي لم تواجه أصواتاً معترضةً في أميركا اللاتينية.
يعود ترمب وفي جعبته إحباط لما تعذّر عليه تحقيقه خلال الولاية الأولى من وعود بشأن أميركا اللاتينية
لا تصدير للنموذجين السياسي والاقتصادي
ثمة مسألة أساسية أخرى تجعل بلدان أميركا اللاتينية أكثر انفتاحاً على التعاون مع الصين في علاقاتها الثنائية والمتعددة الأطراف، هي أن بكين لا تبدي أي اهتمام لتصدير نموذجها السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي إلى هذه البلدان، كما يحصل مع الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.
والحقيقة أن هذه البلدان ترفض، بطرق مختلفة، الانتقادات الغربية لنموذجيها الاقتصادي والاجتماعي، وتعدها انتهاكاً لسيادتها. ولقد تسبب ذلك غير مرة في اتجاه دول أميركية لاتينية حليفة تقليدياً للولايات المتحدة إلى تفضيل التعاون مع الصين على حساب علاقاتها مع واشنطن.
لا شك في أن هذا الواقع دفع بالإدارة الأميركية الجديدة إلى تغيير جذري في أسلوبها للتعامل مع دول الجوار الأميركي اللاتيني، كالتهديد باستعادة السيطرة على قناة بنما، واستخدام القوة العسكرية إذا استدعى الأمر، أو الترحيل القسري للمهاجرين غير الشرعيين إلى كولومبيا وفنزويلا، أو إبعاد آخرين إلى الإكوادور والسلفادور، وتجاوز الأحكام القضائية التي منعت ذلك، أو دفع المكسيك - تحت وطأة التهديد بفرض زيادة كبيرة على الرسوم الجمركية - إلى نشر قواتها المسلحة على امتداد الحدود المشتركة لمنع تسلل عصابات الاتجار بالمخدرات إلى الولايات المتحدة... بل والتلميح إلى إرسال قوات أميركية خاصة لملاحقة هذه العصابات في حال امتنعت حكومة المكسيك عن التجاوب.