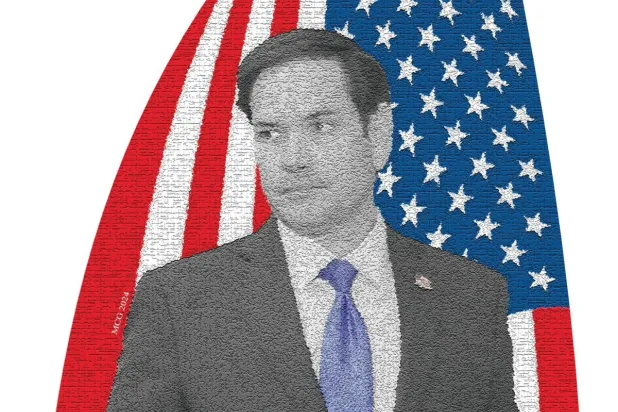في حين حسم ثنائي «حزب الله» و«حركة أمل» في لبنان خياراته تجاه دعم ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية لمنصب رئاسة الجمهورية، لا تزال خيارات قوى المعارضة أوسع، رغم تحقيق «بداية تقدم» في المفاوضات الجارية.
هذه المفاوضات الجارية تتركز بين القوى المسيحية بشكل خاص، بينما لم تحسم «كتلة الاعتدال الوطني» (جلّ أعضائها من النواب السنّة المستقلين) مرشحها بعد، بانتظار الترشيحات، وتنقسم كتلة «التغييريين» المؤلفة من 13 نائباً إلى اتجاهين، أحدهما يرفض تسمية أحد من الشخصيات المتداولة، والثاني يؤيد بعض الأسماء التي تقترحها المعارضة. وفيما يلي بعض الأسماء المقترحة:
* رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية
> يعد الوزيرال سابق سليمان فرنجية من أحد أبرز المرشحين والمرشح شبه الدائم للرئاسة. دخل البرلمان اللبناني عام 1991، وكان حينها أصغر نائب بالبرلمان، وشارك في الحكومات مرات عدة عبر توليه أكثر من وزارة، منها وزارة الداخلية.
يعرف فرنجية، الذي أورث مقعده النيابي لابنه طوني، بعلاقته الوطيدة مع النظام السوري ورئيسه بشار الأسد الذي يتحدّث عن علاقة صداقة عائلية بينهما. ورداً على معارضي وصوله إلى الرئاسة بسبب علاقته بسوريا و«حزب الله»، قال في تصريح له أواخر الشهر الماضي: «أنا لست مستعداً للتآمر على لبنان من أجل سوريا بل سأتآمر على سوريا من أجل لبنان، ولا يمكن أن أقبل ببقاء النازحين إذا لم يوافق الرئيس الأسد على عودتهم، رغم أنه يقبل بذلك».

* العماد جوزيف عون
> يبرز اسم قائد الجيش في كثير من الأحيان كمرشح وسطي، ويُدرَج في خانة المقرّبين من الولايات المتحدة. وهو يعتبر، مثل سائر قادة الجيش، مرشحاً طبيعياً لرئاسة الجمهورية، كونه المسيحي الماروني الذي يتولّى رئاسة المؤسسة العسكرية التي سبق أن أوصلت عدداً من الرؤساء إلى هذا الموقع، وآخرهم في الحقبة الحديثة، إميل لحود (1998 - 2007)، وميشال سليمان (2008 - 2014)، وميشال عون.
طُرِح اسم العماد جوزيف عون كأحد أبرز المرشحين، خصوصاً التوافقيين، رغم تأكيد المقرّبين منه أنه لم يطرح نفسه لهذا الموقع. وهنا ينبغي الإشارة إلى أن انتخاب عون يحتاج إلى تعديل دستوري، كون قائد الجيش من موظفي الفئة الأولى الذين لا يمكن انتخابهم إلا بعد سنتين من استقالتهم أو تقاعدهم، ويُعد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل من أبرز المعارضين لدعم ترشيحه.
يُعرف عون بعلاقاته الواسعة والجيدة مع مختلف الأفرقاء داخل لبنان وخارجه. وسجّل خلال مسيرته في المؤسسة العسكرية منذ عام 2017 زيارات خارجية مهمة له، حيث عقد لقاءات خلالها مع مسؤولين في بلدان عدة، أبرزها فرنسا والولايات المتحدة. وفي الداخل يكاد يجمع الأفرقاء اللبنانيون على نجاحه على رأس المؤسسة العسكرية.
* الوزير الأسبق زياد بارود
> الوزير الأسبق زياد بارود، سياسي وحقوقي لبناني وناشط في المجتمع المدني، ويُعد من المقربين من بكركي (أي البطريركية المارونية). شغل منصب وزير الداخلية والبلديات من عام 2008 إلى عام 2011 لفترتين متتاليتين في حكومتي فؤاد السنيورة وسعد الحريري. وهو يعمل الآن محامياً في الاستئناف ومقرراً للجنة التشريعية لنقابة المحامين في بيروت، كما أنه يحاضر في القانون في جامعة القديس يوسف (اليسوعية)، كما حاضر في المعهد العالي وفي جامعة الروح القدس وفي الجامعة الأنطونية.
كان باسيل طرح اسمه للرئاسة في الخريف الماضي كأحد الخيارات، لكنه اصطدم برفض بعض قوى المعارضة. وللعلم، سبق لبارود أن خاض انتخابات البرلمان على لائحة العونيين قبل بضع سنوات.

* النائب السابق صلاح حنين
> في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلن النّائب السّابق صلاح حنين، ترشّحه رسمياً إلى انتخابات رئاسة الجمهورية بعدما تداول نواب وقوى سياسية باسمه كمرشح وسطيّ، وأبرزهم نواب من «كتلة التغيير» ونواب معارضون أدرجوا اسمه ضمن قائمة البحث التي تناقش فيها المعارضة.
حنين محام وخبير قانوني حاصل على دكتوراه في القانون الدولي من جامعة ساوثامبتون Southampton البريطانية عام 1991. ولقد انتُخب نائباً عن محافظة جبل لبنان دائرة بعبدا – عاليه عام 2000، كما انتخب عضواً في اللجان النيابية بين عامي 2000 و2005 في لجان المال والموازنة، والاقتصاد الوطني، والمرأة والطفل، وهو عضو أيضاً في لجنة الفرنكوفونية.
يتحدّر حنين من أسرة سياسية، فوالده النائب والوزير السابق إدوار حنين، كان أمين عام «الجبهة اللبنانية» إبّان الحرب اللبنانية، وهو ما قرّبه من «لقاء قرنة شهوان» حين كان عضواً في اللقاء المعارض للوجود السوري في لبنان.