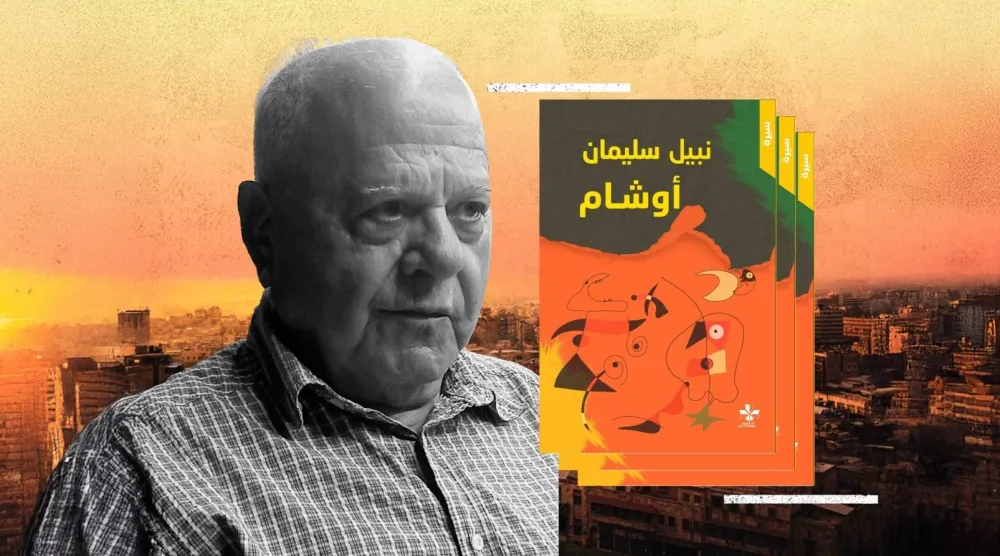عندما اختارت الطبيبة الفلسطينية حليمة عايد ترابين (1894-2014) أحد أحفادها لتطلق عليه اسم «متحف» كانت تمضي في تحقيق أحلامها بإعادة افتتاح متحف «تراث من عبق التراب» الذي أسسته جدتها حاكمة العايد ترابين (1775-1885) في قرية غزالة شمال بئر سبع، عام 1790. وتعرض للتخريب، ونهب الكثير من مقتنياته عام 1948، وفق ما يرويه الباحث الأكاديمي الفلسطيني متحف عايد ترابين بقوله إن جدته حليمة أخذته من كنف العائلة بعمر مبكر، وأرسلته إلى روسيا لدراسة علم المتاحف، والتعمق فيه، ليكون أحد «حراس التراث والثقافة الفلسطينية»، وأن حليمة، التي ورثت مهنة الطب العربي والبدوي عن جداتها، كرست شبابها لدراسته، ونالت درجة الدكتوراه بالجراحة من القسطنطينية عام 1916، وسافرت خلال حياتها إلى دمشق، وعدة مدن مصرية، وصنعاء في اليمن، ومكة، وسيناء، والنقب. وخلال وجودها في القسطنطينية كانت تلتقي ابن عمها الطبيب الشهير في دمشق أحمد منيف عثمان محمد عايد ترابين (1886-1962) مؤسس معهد الطب والكلية العلمية بدمشق، وهو من الفرع الفلسطيني المصري عائلة «أباظة العايد» التي استقرت في سوريا عام 1831، وعرفت في سوريا باسم العائدي، وعرفت في مدينة يافا بـ«عائلة هيكل».

خلال اللقاءات كانا يناقشان الأفكار، ويتبادلان الخبرات، واتفقا على ضرورة تعريف الأوروبيين بالثقافة الفلسطينية والعربية. ومثّل ذلك دافعاً لإرسال حليمة حفيدها (متحف) إلى روسيا لتهيئته من قبل معارفها من المختصين لدراسة فن إدارة الدبلوماسية الثقافية الدولية من خلال علم المتاحف والتربية المتحفية. وبدوره اعتنى منيف العائدي بإرسال أبنائه وإيفاد طلابه للدراسة في أوروبا، ومنهم الراحل الدكتور عثمان العائدي الذي له مساهمات مهمة على مدار أكثر من خمسين سنة في تطوير قطاع السياحة والثقافة والاقتصاد في سوريا.
والباحث الأكاديمي متحف عايد ترابين هو اليوم الممثل الأوروبي للاتحاد العام للمؤرخين الآثاريين في فلسطين، والمنسق الدولي في المجلس الدولي للمتاحف التابع لمنظمة «اليونيسكو» الدولية نيابة عن «إيكوم فلسطين». وقد تمكن من تحقيق حلم جدته بعد وفاتها بستة أعوام وأسس «أكاديمية علم المتاحف الفلسطيني والعربي» في العاصمة الفرنسية باريس عام 2022، والتي ضمت «متحف تراث من عبق التراب» الذي جمع ما تبقى من مقتنيات المتحف التي تبعثرت نتيجة الأحداث التي شهدتها فلسطين عام النكبة 1948، إلى جانب وثائق وموجودات تحمل قيمة تاريخية معرفية وتراثية منها نحو 250 ثوباً فلسطينياً من كافة المناطق، وحلي، وأدوات طب شعبي، وطوابع، ونقود، وأوراق مالية، وغيرها، بالإضافة إلى مكتبة تحوي أكثر من 1000 كتاب، وأرشيفات من القرن السابع عشر إلى القرن الحادي والعشرين، وإلى جانبها دار نشر تعنى بنشر الدراسات والأبحاث المتعلقة بالتراث والثقافة الفلسطينية، بهدف تطوير ومأسسة علم المتاحف الفلسطيني والعربي، ونيل الاعتراف الدولي بهذا العلم بوصف أنه مفهوم أكاديمي، وقد نجح في ذلك، ونال اعتراف العديد من الدول الأوروبية في المفهوم الأكاديمي.

ويعبر متحف عايد ترابين عن اعتزازه بعائلته التي لم تكن «مجتمعاً مغلقاً؛ فلأكثر من ألف عام، استكشف الرجال والنساء الثقافة والطب والقانون وطرق التجارة، وحماية الضعفاء»، كما يفخر بجداته، لا سيما جدته حليمة التي ربتّه قائلاً: «تخيل امرأة شابة من الشرق، تبلغ من العمر سبعة عشر أو ثمانية عشر عاماً، تذهب إلى تركيا في بداية الحرب العالمية الأولى لتتعلم، وتطلع على ثقافات مختلفة، بعقل منفتح».
ويحضّر الباحث الأكاديمي متحف عايد ترابين لإصدار دراسة أخذت من عمره خمسة عشر عاماً من البحث والتدقيق والجمع، بمشاركة من الفرنسية الباحثة كلمنتينا بولي، حول تاريخ عائلته المتحدرة من قبيلة العايد ترابين، والأدوار الريادية التي لعبتها في مناطق وجودها عبر التاريخ بين مصر وبلاد الشام على مدى مائتي وثلاثين عاماً. ليكون بحثه «وثيقة» تركز بشكل رئيس على الروابط بين المساهمات الثقافية والتاريخية للقبائل العربية التي تنقلت عبر الجغرافيا الممتدة من اليمن والحجاز ومصر، وحتى بلاد الشام.
وتتناول الدراسة تجربة الطبيبة حاكمة التي تعلمت الطب في الإسكندرية، وتخصصت بطب العيون، وكانت «صاحبة أفكار ثورية في زمانها، فقد تمكنت من إقناع البدو في محيطها بالاحتفاظ بمقتنيات المتوفين بدل دفنها معهم كما جرت العادة». ثم أسست «متحف تراث من عطر الأرض» ليكون وسيلة «لـتعزيز المعرفة، وشفاء الذاكرة»، انطلاقاً من مبدأ «العقل السليم في الجسم السليم»، ومفهوم «الحكيم والفهيم» في ربط بين صحة الجسد وسلامة الذاكرة باعتبارها هوية حية تتنقل عبر الأجيال، بما يعكس السياق الفريد لفلسطين باعتبار أنه جزء لا يتجزأ من التراث الإنساني.