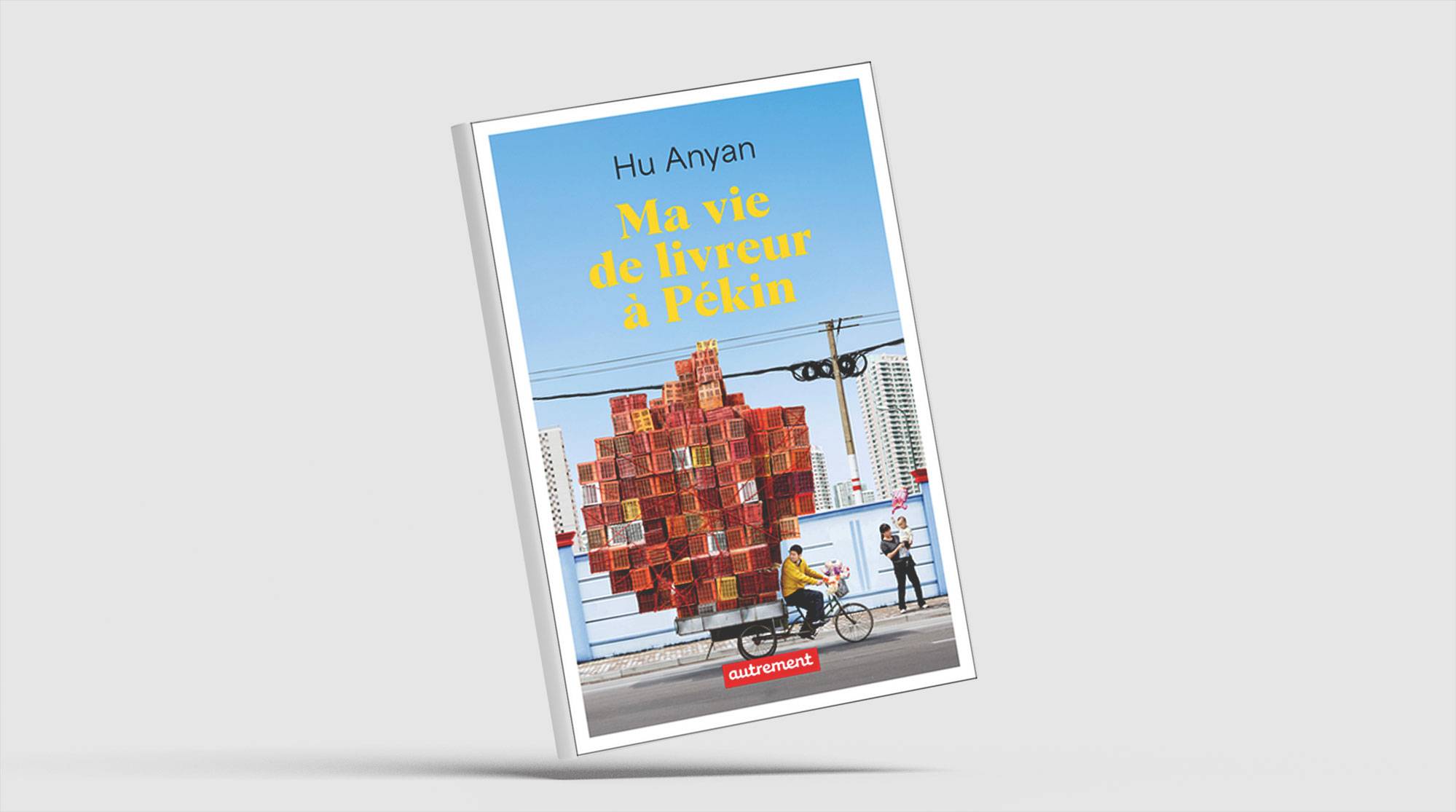استطاع الشاعر البحريني مهدي سلمان أن يترك بصمة بارزة على خريطة الشعر في بلاده عبر عدد من دواوينه الشعرية التي تتميز بتراكيب بصرية جريئة ولغة مشحونة برؤى جديدة. صدر ديوانه الأول «ها هنا جمرة وطن، أرخبيل»، 2007، لتتوالى بعده أعماله التي لفتت الأنظار لموهبته الكبيرة؛ مثل «السماء تنظف منديلها البرتقالي»، و«لن أقول شيئاً هذه المرة»، و«لا شيء يحدث ولا حتى القصيدة».
ومن الشعر تمتد تجربته الإبداعية إلى المسرح بقوة، حيث شارك ممثلاً في نحو 20 مسرحية؛ منها «اللعبة»، و«المستنقع»، و«الوهم»، كما أخرج مسرحيتي «مكان ما»، و«التركة»، وحصد جوائز مرموقة في المهرجانات الفنية المتخصصة... هنا حوار معه حول تجربته وهمومه الأدبية:
* لنبدأ بثنائية الشعر والمسرح في تجربتك، فالقصيدة، على الأقل في تصور العامة، فن ذهني ساكن، في حين أن المسرحية فن بصري حركي... هل ثمة تناقض بين النوعين؟
-هنالك بالتأكيد اختلافات بين كتابة القصيدة وكتابة المسرحية، لكن هذا الاختلاف لا يرقى ليكون تناقضاً، إن الأجناس الأدبية اليوم تستقي من بعضها، وتتجاور بكل هدوء، فيأخذ الشعر الحالة الدرامية من المسرح، ويأخذ المسرح الحالة التأملية الرائية من الشعر، وتنهل الرواية والقصة من مظاهر هذا وذاك. وعموماً لم يكن الشعر يوماً فناً ساكناً، على الرغم من كونه ذهنياً، فلطالما احتوى الشعر على صراع عنيف بين الأفكار والمشاعر، وهذا الصراع أهم سمات المسرحية. وكذلك لم تكن المسرحية دائماً فناً حركياً، فلقد استخدم كتّاب المسرح في كثير من تجاربهم طرق وأساليب التأمل الشعري لإنتاج الحدث. فعل ذلك كتّاب مسرح العبث؛ مثل يونسكو، وبيكيت، وكذلك تجارب توفيق الحكيم المسرحية الذهنية، وقبلهم استغل كتاب المسرح الكلاسيكي الحوار الداخلي والمناجاة من أجل الاقتراب من روح الشعر في المسرح.

* أيهما أسبق في إثارة ولعك ووجدانك، القصيدة أم المسرحية، وكيف أثرت إحداهما على الأخرى من واقع تجربتك؟
- لا أتذكر بالتحديد أسبقية شكل على آخر، لقد كان الشكلان ينموان معاً في تجربتي، ويتبادلان الأهمية والتأثير، وكذلك يتساقيان الفهم من التجارب المختلفة. ولطالما كان الشعر قريباً من المسرح والمسرح قريباً من الشعر، منذ سوفوكليس حتى شكسبير. ولطالما كانت الكتابة لأحدهما تغترف من تقنيات الشكل الآخر، ومن أدواته وإمكاناته، ليس على مستوى الممارسة في الكتابة فقط، إنما كذلك في آلية تحليل وتفسير وتقليب الأفكار والعواطف والقضايا، لا يمكن للكاتب أن يقول أين يكمن هذا التأثير، وكيف، لكنني أومن أنه موجود في الكتابة للشكلين، وفي التمثيل والإلقاء على السواء.
* لنتحدث قليلاً عن فكرة «الجمهور» فهي حاضرة بقوة أمامك بصفتك ممثلاً يصعد إلى خشبة المسرح، لكن كيف تتمثلها بصفتك شاعراً؟
* لو سألتِ أي ممثل على المسرح كيف ترى الجمهور، لقال لك إنه لا يراه، حضور الجمهور في المسرح هو حضور فكرة، فحين تظلم القاعة، ويصعد الممثل على الخشبة لا يرى أمامه إلا الظلمة التي فيها ومن خلالها يدخل ويخرج من وإلى الشخصية، أظن فكرة الجمهور في الكتابة تشبه هذا، ظلمة لا تتبينها، لكنها أمامك، تدخل نحوها شخصاً، وما إن تخطو فيها حتى تصير شخصاً آخر.
* ماذا عن موضوع «التطهر» بوصفه وظيفة قديمة في التراجيديا الإغريقية... هل يمكن أن تصنع قصيدة النثر حالياً حالة شبيهة وتخرج الانفعالات المكبوتة داخل القارئ، لا سيما الخوف والشفقة؟
- بقدر الخلاف على معنى محدد لمفهوم مصطلح التطهر أو التنفيس، لا يمكن القطع بإمكانية شكل ما شعري أو سواه في حيازة نتاج هذا المفهوم، فهو موجود في جميع الأشكال - الشعرية وغيرها - كما في المسرح، بنسب مختلفة. إنه جزء من صنع الفن، طالما أن الفن جزء منه يخاطب العقل والقلب والمشاعر والأفكار الإنسانية، فهو فعل تطهّر أو تطهير، وكذلك في المقابل هو فعل تلويث كذلك، أو فلنقل هو فتح للجروح المختلفة، لكن في كل ذلك، هو نتاج الفاعل لا الفعل نفسه، الشاعر لا شكل القصيدة، الكاتب المسرحي، لا نوع المسرحية.
وبقدر ما يبحث الشاعر أو المسرحي أعمق، ويقطع أكثر، بقدر ما يطهّر، نفسه، قارئه، شخصياته، أو أفكاره وعواطفه، وهو في كل ذلك ليس فعلاً قصدياً دائماً، إنما هو نتاج إما لشخصية الكاتب، أو للظروف المحيطة به، لذلك فهو يظهر في فترات تاريخية بعينها بشكل أوضح وأجلى، وقد يخبو في فترات أخرى، تبعاً لقدرة المجتمعات على فتح جروحها، أو على الأقل استقبال هذا النوع والشكل من الفعل الفني.
* على مدار أكثر من نصف قرن، لم تحصد أي جائزة أو تنال تكريماً بصفتك شاعراً، لكنك في المقابل حصدت عدداً من الجوائز والتكريمات بصفتك ممثلاً مسرحياً... كيف ترى تلك المفارقة؟
- يعود ذلك إلى مفهوم الجائزة فيما بين الشكلين، والخلل الكبير في شكل الجوائز الأدبية في عالمنا العربي، الجوائز لا ينبغي أن تُطلب، إنما تُعطى نتيجة لفعل ما أو جهد ما، هذا يحدث في المسرح الذي هو عمل جماعي، فالمؤسسة القائمة على المسرحية هي التي تتقدّم لمهرجان ما، أو جائزة ما. وعندها يحصد ممثل أو كاتب أو مخرج جائزة على جهده في هذا العمل بعينه، فيما على الكاتب أن يتقدّم بنفسه لطلب جائزة أو تكريم لديوان أو قصيدة، وهذا خلل بيّن في ضبط مصطلح جائزة، أو تكريم، أو حتى مسابقة. الأجدى أن تكون هناك مؤسسات، إما دور النشر، أو الوكالات الأدبية، هي التي تمحّص أعمال الكتّاب، وتنتقي منها ما يتقدّم للجائزة، أو المسابقة، وذلك من أجل ضبط عملية خلق المعايير في الساحة الأدبية، لكن وبما أننا في بيئة فاقدة للمعايير، فالتقدّم للجوائز الأدبية، يرافقه في أوقات كثيرة تشويه لدور الكاتب أو الشاعر، أين يبدأ وأين ينتهي.

* تقول في ديوانك «أخطاء بسيطة»:
«كل الذين لمست أصابعهم في الطريق
تماثيل شمع غدوا
كل من نمت في حضنهم خبتوا
واختفوا».
من أين يأتي كل هذا الإحساس العارم بالعدمية والخواء، وكأن الحميمية تعويذة ملعونة تلقيها الذات الشاعرة على الآخرين؟
- لا يمكن اقتطاع أبيات شعرية لتشكل معنى عاماً في تجربة ما، بالتأكيد هنالك عدمية تظهر أحياناً في أحد النصوص، لكنْ في مقابلها معان أخرى، قد تناقضها. الشعر فعل مستمر، تحليل دائم، وتدفق في مشاعر قد تكون متناقضة بقدر اختلاف أزمان الكتابة أو أزمان التجارب، لكن إن كنا نناقش هذه التجربة خاصة، هذا المقطع من هذا النص تحديداً، عندها فقط يمكننا أن نسأل، بالتأكيد ثمة لحظات في حياتنا نشعر خلالها بالانهزام، بالعدمية، بالوحشة، ونعبّر عن تلك اللحظات، ومن بينها تلك اللحظة في النص. ويأتي هذا الشعور بالتأكيد من الخسران، من شعور مغرق في الوحدة، وفقدان قدرة التواصل مع آخرين، إنها لحظات تنتابنا جميعاً، ليست دائمة، لكن التعبير عنها يشكّلها، بحيث نكون قادرين على مساءلتها، واختبارها، وهذا هو دور الشعر، لا البحث عن السائد، إنما وضع الإصبع وتمريره بحثاً عن النتوءات أو الحفر، لوصفها، لفهم كيف تحدث، وماذا تُحدِث.
* ينطوي عنوان ديوانك «غفوت بطمأنينة المهزوم» على مفارقة تبعث على الأسى، فهل أصبحت الهزيمة مدعاة للطمأنينة؟
- الهزيمة في معناها العام ليست فعلاً سلبياً دائماً، إنها التراجع كذلك، أو فلنقل العلوّ، رؤية المشهد بشكل آخر، من أعلى كما أراها، خلافاً للمنهمك فيه والداخل فيه. لذلك فإن الطمأنينة التي ترافق هزيمة كهذه هي طمأنينة المتأمل، أن تخرج من ذاتك أو تنهزم منها، لتحاول أن تجد طمأنينة ملاحظتها، والبحث فيها، وفهمها. أن تنهزم من تجربة ما وتتراجع عنها، لتجد لأسئلتها أجوبة، وأن يرافق هذا البحث طمأنينة الخروج والمغادرة، حتى لو كانت هذه المغادرة وقتية وليست تامة.
* في ديوان آخر هو «موت نائم، قصيدة مستيقظة»، هل أصبح الشعر المقابل الفعلي للموت؟
- ليس مقابلاً، إنما معطى آخر، ليس نقيضاً أو معاكساً، بل هو رفيق وصاحب يفعلان أفعالاً عكسية للتوافق والتوازن، وليست للمناكفة والمعاداة. تستيقظ القصيدة، لا لتلغي الموت، أو تنهيه، إذ لا يمكن إنهاء الموت، أو إماتته، لأن في موت الموت موت للحياة كذلك. لكنها تستيقظ في اللحظات التي يقف فيها في الخلف، تستيقظ لأجل أن ترى، وتبصر، وتصنع، وتحاول أن تتكامل معه من أجل الخلق نفسه، والولادة نفسها.
* كيف ترى الرأي القائل إن قصيدة النثر التي يكتبها غالبية أبناء جيلك استنفدت إمكاناتها الجمالية والفكرية، ولم تعد قادرة على تقديم الجديد؟
- ثمة تراجع حالياً نحو القصيدة العمودية، إنه واضح تماماً، أبناء جيلي والأجيال التالية، يعودون نحو روح العمود، حتى لدى كتاب قصيدة النثر، حيث الكتابة بوصفها فعلاً ليست فعل بحث واكتشاف إنما فعل إدهاش وتعال. لا، ليست القصيدة هي التي استنفدت إمكاناتها، بل كتاب القصيدة وشعراؤها هم الذين استنفدوا طاقتهم على المواجهة، الكتاب الآن يبحثون عن (صرة الدنانير) التي كان الخلفاء يلقون بها على شعراء المديح، هذا فقط تغيّر في روح الكتّاب، لا روح الكتابة نفسها.
* أخيراً، كيف تنظر إلى ما يقال عن تراجع تأثير الشعر في المشهد الثقافي مؤخراً وعدم ترحيب الناشرين بطباعة مزيد من الدواوين؟
- هذه حقيقة، وهي جزء من الأزمة ذاتها، التحوّل نحو الشكل العمودي من جانب، والنكوص نحو الذاتية المستنسخة من جانب آخر. تحوّل في فهم روح العصر، يأس من فعل الكتابة بوصفه عامل تفسير وتحليل وتفكيك وتغيير، تطويع الشعر ليعود إلى أدواره السابقة، فيكون صوت السائد الذي يُصفّق له. الشعر الآن في أي شكل من أشكاله، انعكاس للوجوه المتشابهة التي خضعت لعمليات التجميل التي نراها حولنا، هذا هو العصر، وأنت لا تريد تغييره، أو محاولة تغييره، أنت تريد الخضوع له وحسب. هذا هو ما يحدث.