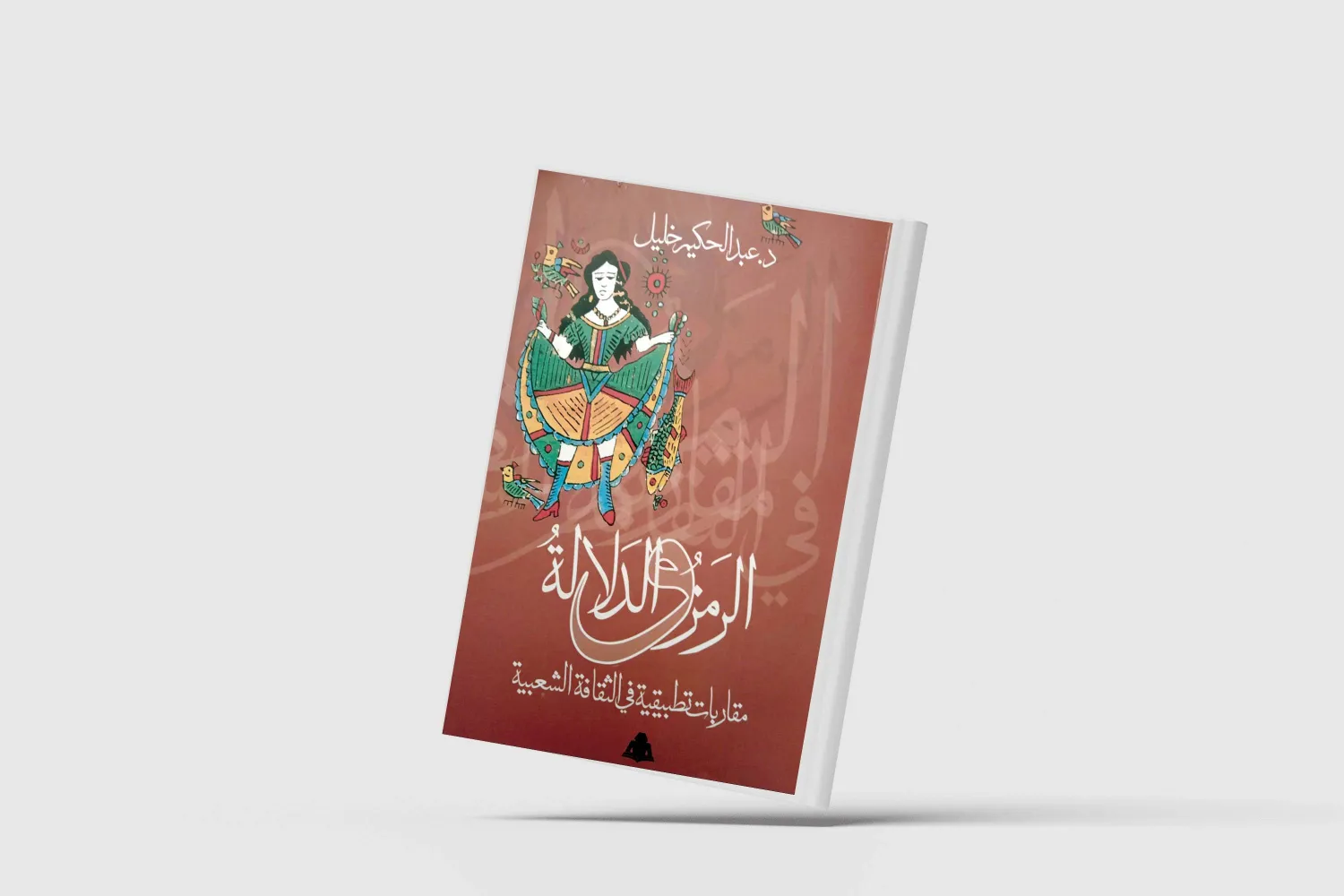يسعى كتاب «الرمز والدلالة» للدكتور عبد الحكيم خليل، الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، إلى دراسة أثر الرمز في فنون التشكيل الشعبي، باعتبار الرمز هو كل علامة تتجاوز دلالتها معناها القريب المباشر إلى ما لا حصر لها من دلالات ترتبط بسياقها النصي من جهة، وبمنتج العلامة (مؤلف النص)، ومستقبلها (القارئ أو المتلقي) من جهة أخرى، سواء كانت تلك العلامة: كلمة أو صورة أو لون أو حركة أو إيماءة أو غير ذلك.
ويولي المؤلف اهتماماً خاصاً بالخلفية التاريخية لنشأة الرمز كخط موازٍ للتعبير الإنساني البدائي، الذي كان يفسر الوجود كألغاز وأحاج، وصار تعليله له بقدر ما يصيبه من ضرر أو نفع، واتخذ الدلالات لتشير إلى عقائده وطقوسه، فنحت لها التماثيل، وصوّرها على جدران كهوفه، مما جعل «جميع الصور والتماثيل التي أنجزها البدائيون سواء منها الآلهة أو الشياطين، ومختلف أشكال الطواطم الحيوانية والنباتية، وكذا التعاويذ السحرية والأقنعة، وكل ما يتعلق بالإنتاج الفني لعصور البداءة إنما تتخذ طابعاً رمزياً، وبخلاف الرموز المرسومة، ارتبطت كذلك الرموز بالانفعالات، وما تثيره الأشكال من معاني الخير والشر، فحاكت المقاطع الصوتية الأحداث الطبيعية، فسُميت الحيوانات بما يصدر عنها من أصوات، كما هو في أصول اللغات، فصارت الأصوات نفسها دلالات رمزية عن الأشياء».
روح ثقافية
يُشير الكتاب لرأي عالم الأنثروبولوجيا الأميركي كليفورد غيرتز، الذي يرى الثقافة حواراً للمعاني، ونقاشاً يتعلق بالرموز المتضمنة لتلك المعاني، حيث إن فهم الثقافة لا ينحصر على مجرد التصوّرات والأفكار والجوانب المعرفية في عقول الأفراد، فتلك تصورات عامة وخارجية، تخضع للدراسة العملية، فالثقافة تكون متضمنة، ويعبر عنها في رموز عامة، وهذه الرموز العامة لا تشير فقط إلى الجوانب المعرفية من أفكار ورؤى وتصورات للعالم، بل هي أيضاً تشير إلى الجوانب الوجدانية والمعيارية، التي يمكن أن يُطلق عليها «روح الثقافة».
وإذا كان الرمز يمثل ملمحاً تكوينياً معروفاً في الأدب والأمثال الشعبية، فإن مؤلف الكتاب يرى عدم انفصال الدلالات الرمزية عن الدلالات الاعتقادية، فالأمثال الشعبية، على سبيل المثال، تعد داخل بيئتها الثقافية والاجتماعية بمضامينها الاعتقادية المختلفة أداة للتواصل في اللغة اليومية المتداولة، التي تعكس من خلالها تجاربها وخبراتها وعاداتها ومعتقداتها، المستمدة من التراث الشعبي الأصيل لهذه المجتمعات.
ويخصص الكتاب الذي يقع في (270) صفحة، فصلاً مركزياً حول التجليات الرمزية للوشم في المعتقد الشعبي، الذي حسب الكتاب يمثل شكلاً من أشكال التعبير الفني الشعبي الذي قلّ الاهتمام به في الثقافة الإسلامية بشكل خاص، ولكنه في الوقت نفسه انفرد بخصوصية في الثقافة الشعبية التي دفعت الأفراد المعتقدين في أهميته داخل الحياة العامة، كدق الوشم للتزيّن أو العلاج الشعبي ضمن أبعاد اجتماعية وثقافية ترتبط بالمعتقدات والعادات الموروثة لدى ممارسيه، ما يجعل الوشم فناً له دلالات عقائدية وفلسفية واجتماعية.
ويشير المؤلف لتعبير فاطمة فائز، الباحثة في أنثروبولوجيا الدين والثقافة الشعبية بالمغرب، بأن الوشم يدخل ضمن آداب السلوك الاجتماعي، يرتبط بحياة الجسد الموشوم ويموت بموته، كما يشكل جسراً للربط بين ما هو روحي ومادي في الجسد ذاته، وللوشم كذلك رمزية اجتماعية وسياسية، عندما يشير للانتماء الاجتماعي، والشعور بالهوية المشتركة داخل المجتمعات القبلية، شأنه في ذلك شأن الزخارف النسيجية المبثوثة بشكل خاص في رداء المرأة المعروف بـ«الحايك»، أو «تاحنديرت».
تميمة وزخارف
يمر الدكتور عبد الحكيم خليل، وهو أستاذ ورئيس قسم العادات والمعتقدات والمعارف الشعبية بالمعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون بالقاهرة، على أمثلة من تراث الوشم بدلالاته الثقافية، كوشم الوجه لدى نساء الصعيد، جنوب مصر، الذي يكون غالباً باللون الأخضر عند الذقن والشفة السفلى، وكثيراً ما يحمل الوشم علامة مميزة هي «نفر»، ومعناها باللغة المصرية القديمة «الجميلة»، كما وجد في بعض المومياوات المصرية القديمة، كما أن له مدلولاً جمالياً لدى المرأة اللبنانية الريفية، يتمثل في خط بسيط كالكحل لتزيين العين، ونجمة على الذقن، وسنابل على اليدين، وأشكال هندسية ونباتية على الذراعين والرقبة، وعند المرأة المغربية رسوم وزخارف تشغل كل أطراف الجسد.
أما لدى الرجال، فالوشم كان دلالة للشجاعة وعلامة انتماء الموشوم القبلي والبيئي، ويربط الكاتب بين الوشم كدلالة جمالية، أو عقائدية وبين المُخيلة الإبداعية التي اتخذت من الجسد فضاءً للتدوين، ولوحة للرسم والخط، ويستدعي من الشِعر العربي قول زهير ابن أبي سلمى عندما أراد للعرب البقاء والخلود وعدم الاندثار بسبب الحروب التي دارت بينهم، فقرنها بالوشم المُتجدد:
ودارٌ لها بالرقمتين كأنها
مراجيعُ وشم في مناشر معصم
ويُعلق مؤلف الكتاب هنا أن الوشم عند زهير في هذه الصورة هو بمثابة تميمة لصرف عوادي الزمن من حروب وغيرها، ويشير كذلك في هذا الصدد إلى عنترة بن شداد وما أراده لدار عبلة فقال:
ألا يا دار عبلة بالطوى
كرجع الوشم في رسغ الهدى
فالوشم، حسب مؤلف الكتاب، هو امتداد لعقيدة الطوطم في العصر البدائي مروراً بالفترات التاريخية المختلفة سواء في العصر المصري القديم، أو العصور المسيحية الأولى أو في فترة ظهور الإسلام التي كان لها تأثير في موضوع الوشم، كما تأثر الوشم وما شاع حوله من معانٍ ودلالات رمزية بالأساطير والحكايات الشعبية والمعتقدات حول الجسد والعلاج الشعبي والخوف من الحسد، مما جعل له دوراً مهماً في اعتقاد الأفراد الشعبيين لعادة دق الوشم.
ويرى صاحب كتاب «الرمز والدلالة» أنه رغم اندثار بعض أشكال الوشم بصيغته القديمة، فقد استحدثت له أشكال جديدة تؤدي وظائفه جعلته قادراً على مسايرة العصر الحديث من بوابة «الموضة».
وهكذا، يضع المؤلف في هذا الكتاب الشيق مختلف التمظهرات الشعبية، من أمثال وحكايات وطعام ومختلف ملامح هذه الثقافة تحت مظلة الرمز، الذي يرى أنه يصعب تفادي قيمته ودوره، فعلى حد تعبيره: «لا يمكن للإنسان أن يعيش في عالم فسيح دون نسق ثقافي يشمل الرموز والقيم، فالرمز هو الذي يربط الإنسان بعالم الموجودات المحسوس، وعالم الماهيات والماورائيات، لذلك يعد الإنسان رمزياً بامتياز، حيث أصبحت الرموز جزءاً من حياته لما تحقق من غايات كبرى».