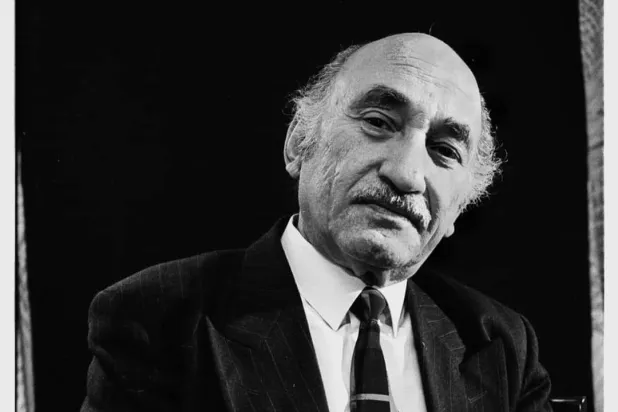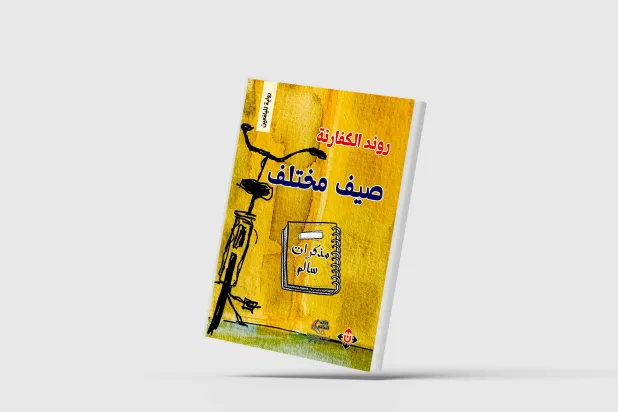في كتابه «سحر الموروث السردي - افتتان، واستلهام، وتمثُل للعجيب»، الصادر حديثاً عن الهيئة المصرية العامة للكتاب في 266 صفحة، يبحث الكاتب والأكاديمي المغربي الدكتور مصطفى يعلي في مستويات الاستفادة من التفاعل بين الموروث الشعبي والسرد المعاصر، حيث يرى أن حركة التجريب السردي المعاصرة استطاعت توظيف كثير من جماليات الموروث السردي المدهشة، مما أثراها بأنساق تخييلية واسعة.
يضع المؤلف تمثيلات لكيفية حفاظ الموروث السردي على حيويته بعيداً عن الوقوع في بئر النسيان، لا سيما في زمن تضاعفت فيه تأثيرات وسائل الاتصال، وتغلغلت رواسبها في أنسجة الإبداعات القصصية والروائية العربية الحديثة والمعاصرة. ومن ناحية أخرى استفاد حقل السرد الحديث والمعاصر من «بلاغة» الموروث السردي سواء في مرحلة التحوّل من السرد القديم إلى الجديد، أو في مرحلة النضج واجتراح أساليب جديدة، ودخول مرحلة التجريب بابتكاراتها المتجددة في التخييل. ويرى المؤلف أن غنى الموروث السردي الشعبي بمكوناته وتقنيات تخييله المدهشة مكنه من أن يتسرب إلى خريطة الآليات الملهمة لما وصفها بـ«فتنة التجريب الطليعية المهيمنة راهناً على الرواية والقصة القصيرة».

مورفولوجية الحكاية
يسعى الكتاب، إلى تبيان واستقصاء ما وصفها بـ«أنساق الغواية» التي مارستها السرود القديمة بسحرها وفتنتها على السردية الحديثة والمعاصرة، وقام الباحث المغربي بالاشتغال النقدي التطبيقي على عدد من نماذج الأعمال التي تنتمي للرواية والقصة القصيرة العربية والغربية، التي وقعت تحت تأثير سحر الموروث السردي، مغتنية ببلاغتها، مستعيناً بآليات منهجية للتطبيق على النماذج المختارة، أبرزها المنهج المورفولوجي، الذي يقدم الباحث مدخلاً له، مشيراً للتأثير الممتد لكتاب الأنثروبولوجي الروسي فلاديمير بروب «موروفولوجية الحكاية» في دراسة السرد الشعبي والحكايا العجيبة في الغرب، وصولاً لتأثيره في الحقل البحثي بالعالم العربي.
ويتوقف الباحث عند مظاهر تأثير «ألف ليلة وليلة» في كتاب «الديكاميرون» للإيطالي جيوفانى بوكاشيو (1313 – 1375)، من خلال مقارنة بينية أجراها بين حكاية من ألف ليلة وليلة وهي «المتلمس مع زوجته»، والحكاية التاسعة من الليلة العاشرة في مجموعة «الديكاميرون»، التي اختارها الباحث على سبيل النمذجة لتأثير «الليالي» في الأدب الغربي، يقول يعلي: «ثمة أمثلة كثيرة تلفت النظر إلى كم المنتجات الإبداعية في التغذي تخييلياً على ثمار مكونات وإحداثيات ألف ليلة وليلة العجيبة، بمختلف أمم الأرض، مثلما يتأكد من اعتراف كِبار الكتاب بانبهارهم بخيالها، وتأثرهم بحكاياتها الساحرة، وخاصة في الغرب الذي تحسس قيمتها الإبداعية مبكراً».
ويتبين بالدراسة التطبيقية بين نموذج «ألف وليلة» و«الديكاميرون»، أن حكاية بوكاشيو قد نهضت على ذات المتواليات الثلاث التي قامت عليها بنية حكاية ألف ليلة وليلة، ورغم ما حصل من تماثل بين الحكايتين، فإن حكاية بوكاشيو حملت بعض الاختلاف الذي لا يمس البنية المركزية لـ«حكاية المتلمس مع زوجته».

مكر سردي
يتوقف الكتاب عند البرازيلي باولو كويلهو، بوصفه نموذجاً آخر للافتتان بالموروث الثقافي الشرقي في عمله الذائع الصيت «الخيميائي»، حيث «منسوب غواية الثقافة الشرقية العربية مرتفع في عمق هذه الرواية» كما يقول المؤلف، وقادت المعالجة التي اقتفاها التشريح النقدي لسردية «الخيميائي» إلى أن الرحلة العجيبة الخطرة التي غامر بها البطل الإسباني الغربي من «طريفة» بأقصى جنوب إسبانيا نحو أهرامات مصر، عبر أقطار شمال أفريقيا، لم تكن سوى «مكر سردي» يتغذى على كيمياء الموروث المدهش بفلسفته الصوفية وتنويعاتها، مروراً بتطوّر الحدث وتشعباته عبر محطات الرحلة المختلفة.
يقول الباحث عن الرواية: «كأنها رحلة سندبادية عكسية، تنطلق من الغرب إلى الشرق، وليس من الشرق إلى الغرب»، متحدثاً عن الرواية التي ارتبطت في الذهنية العامة بفكرة «الوصول للكنز»، مشيراً إلى أن «ثيمة الكنز كانت مجرد تخييل رمزي ممتع، يموّه على المتلقي حقيقة الكنز الافتراضي».
ويُدرج الكاتب في هذا الصدد اسم كويلهو من بين الكتاب الغربيين الذين اختزنوا عوالم «ألف ليلة وليلة» وشبيهاتها، بينما يشير إلى أن هذا الموروث استفادت منه أسماء كثيرة من المبدعين العرب. وركزّ البحث على مقاربة العجيب في رواية «ألف ليلة وليلة» لنجيب محفوظ أو «هرم الرواية العربية»، كما يصفه المغربي مصطفى يعلي، الذي يتوقف بحثه في هذا الصدد عند مستويات التخييل في رواية محفوظ ومستويات العجيب فيها ما بين «العجيب الأدواتي السحري، والجني، والمغامراتي»، ليقدم رواية تعيد إنتاج ألف ليلة وليلة على صورة رواية تجريبية مُعاصرة ممتعة.
يتوقف الباحث عند البرازيلي باولو كويلهو، بوصفه نموذجاً آخر للافتتان بالموروث الثقافي الشرقي في عمله ذائع الصيت
إلى جانب توقف الأكاديمي المغربي في الكتاب عند نماذج لروائيين «وقعوا تحت تأثير الموروث السردي» مثل يوسف أبو رية، وخيري عبد الجواد، ومحمد أنقار وغيرهم، يتوقف أيضاً عند محطة القصة القصيرة، التي أسس فيها لمقاربات مورفولوجية كاشفة عن تجليات الموروث البانية لعوالمها التخييلية، كما توقف عند تقاطع الحكاية الخرافية مع القصة القصيرة جداً، التي يصفها بالضيف الجديد على أسرة السرد نسبياً، واختار التطبيق على مجموعة للقصص القصيرة جداً للكاتب الغواتيمالي الشهير أوغوستو مونتروسو، الذي تعود إليه أشهر قصة قصيرة جداً نشرت عام 1959 التي تكوّنت من سبع كلمات وهي: «حين استيقظ، كان الديناصور ما يزال هناك».
يصف الكتاب القصة القصيرة جداً بأنها «حفيدة الحكاية الخرافية»، ويرصد عدداً من تمثلات وأوجه التقاطع بين الشكلين، بداية من الكثافة المتناهية، واصطفاء المكونات الجمالية، والوعاء الزمكاني الذي يتشكل فيه الحدث بسرعة فائقة، والخاتمة بارعة الإدهاش، ويختار الباحث للتطبيق مجموعة مونتروسو «النجعة السوداء وحكايات خرافية أخرى»، ويرى أن أول ما يثير الانتباه لتجليات التقاطع بين هذه المجموعة وجماليات الحكاية الخرافية هو عتبة العنوان، وتمركزها حول شخصية حيوانية «النعجة»، موحية بأن قصص المجموعة تدور حول الحيوانات، من الحفر في عوالم الحكايا الخرافية واستيحاء أشكالها، لتشييد نصوص منتمية إلى القصة القصيرة جداً، التي يشير الكتاب إلى أنها تتقاطع مع الموروث إلى حد التناص المستنسخ، بخاصة في أجناسه شديدة القِصر مثل الحكاية الخرافية، والنكتة، والهايكو، والمقطوعة الشعرية، والمَثل، مُستفيدة من براعة شعريتها ومختلف مُكوناتها الجمالية.