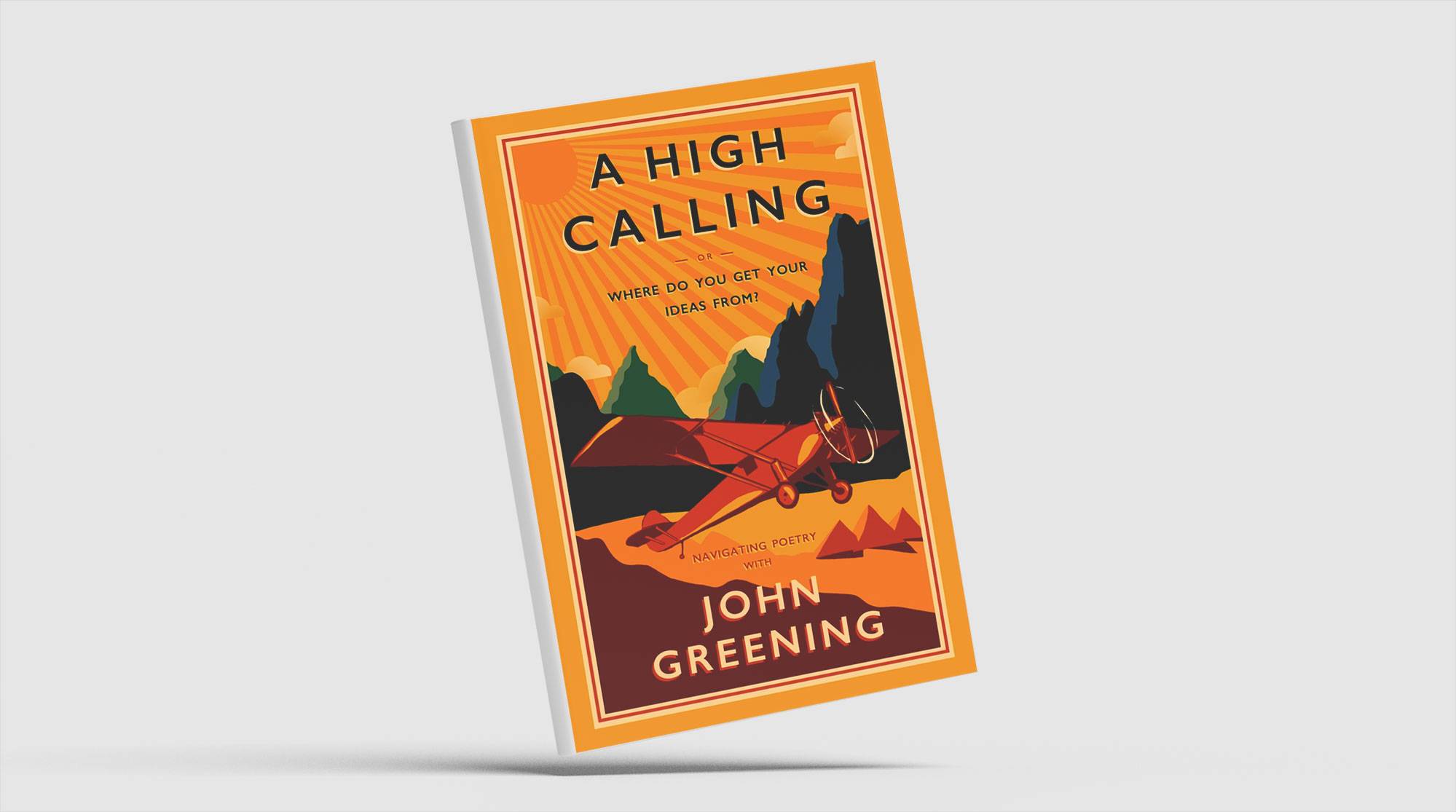تُشكل الأمنيات المعلقة ما بين الحلم والرجاء سؤالاً مؤرقاً في رواية «مُقامرة على شرف الليدي ميتسي» للروائي المصري أحمد المرسي، التي يطرح فيها مُعارضة مُبكرة مع مقولة للمُعلم الروحي الهندي برمهنسا يوغانندا: «إن الأمنيات التي لم تتحقق هي أصل عبودية كل إنسان»، وهي مقولة يُصدّر بها روايته.
الرواية صادرة عن دار «دوّن» للنشر بالقاهرة، وتقع في 350 صفحة، وفيها تتقاطع مصائر أربعة أبطال من أصول وخلفيات متباعدة، إلا أنهم يُراهنون على «الأمل»، فقد أخذ كل منهم في حياته حصته من الخسارات، وجمع بينهم القدر في لحظة مصيرية. تُغويهم المغامرة بتعويض الفقد، باحثين عن تعريف جديد للحياة، يدفعهم حول مضامير رهانات الخيول. وهنا، يخلق الكاتب عالماً موازياً مصغراً للعالم، بمختلف الأجناس من عبيد وأسياد، أفندية وفلاحين، أخلاط من البشر واللهجات، حيث: «الجري سِر، والخيل تجلب لصاحبها الفخار، عندما تفوز الفرس يحصد فارسها المجد، حتى لو كان فقيراً مُعدماً، الفائز يقوم له الشيوخ الكبار في المجالس إذا دخل ويباركونه».
ليالي البرد
زمن الرواية هو فترة العشرينات من القرن الماضي، بما يسودها من عواصف سياسية، وتقلبات اجتماعية وطبقية جامحة، طالت بطلها «سليم حقي» الذي يقترن ظهوره في السرد بمشهد هبوط العتّالين في بيته بجهاز «الجرامافون» المُطعّم بالنحاس المُذهب، وذلك تمهيداً لرهنه، وسط شفقة أهالي الزُقاق الذين صاروا يشاهدون قطع أثاث بيته وهي تهبط قطعة قطعة تجرها الحمير للسوق، وكان يؤجل رهن «الجرامافون» أملاً في معجزة تنتشله من حالته المالية العصيبة، فهو الشيء الوحيد الذي كانت تستأنس بصوته زوجته المريضة «عايدة» في ليالي البرد والمرض.
يبدو «سليم حقي» ضئيلاً مهزوماً أمام تبدّل الحال، نفدت حيله في تحصيل ثمن الدواء لأكثر من أحب «عايدة»، فصار عبداً لقروش «البيع» و«الرهن»، فنراه يهرع إلى «قهوة الديوك»، التي ترسم لها الرواية مسرحاً يعج بالزحام والتحلّق حول ديكين يتنافسان «وسط النقنقة والريش المتناثر حتى الموت، والمال يدور فوق جثث الخاسرين».
ويبدو هذا الجنون جزءا لا يتجزأ من الدراما التي صار جزءاً من دوامتها، وهو من كان ذات يوم برتبة «صاغ» في السواري، فتحوّل إلى واحد من «أبناء الشوارع»، الذين كان مُكلفاً بضبطهم والسيطرة على شغبهم، وهو يُطل بينهم بزيه «الميري» الأسود وأزرار نحاسية لامعة، إلا أنه يُعزل من الجيش بسبب تضامنه وهتافه لسعد باشا زغلول ضد الإنجليز، ووقوفه في صف المتظاهرين ضدهم.
يدفعه مرض زوجته العضال إلى التخبط بين نوادي الرهانات، حتى يتعرف على بطل الرواية الثاني «مرعي المصري» سمسار الخيول، الذي يبتكر له الكاتب لغة خاصة تميّزه به عن باقي شخصيات الرواية، فهو قادر على التلوّن من «الفهلوة» الدارجة الساخرة، إلى «الإنجليزية المُتكسرة» وهو يتواصل مع الأجانب «الخواجات» من زبائن نوادي رهان الفروسية حيث «الأغنياء يرمون أموالهم تحت حوافر الخيل»، إلا أن وجه «مرعي المصري» البارع في الخداع يُطمر خلفه عاطفة مشوبة، هو ما يجعله يتعاطف مع «سليم» في كربه المالي وأمنيته أن تنجو زوجته عايدة من الموت، فيقنعه بخوض لعبة الرهانات على الخيول، أملاً في أن ينتشل الفوز أحلام كل منهما من الغرق.
يقودهما هذا الهدف المشترك للارتحال إلى «جزيرة الخيول» التي تسكنها قبائل مُتفرقة، لكن يسودهم «عرب الطحاوية»، الذين يملكون ناصية سوق الخيول باختلاف أنسابها، والتي تُعدد الرواية أوصافها «السجلاوية، ودهمان، وهدبان» وغيرها، ويبدو الاستعمار الإنجليزي في الرواية، وكأنه أعاد ترسيم خريطة الخيل كذلك «الخيل الإفرنجي غرّق السوق أيام الحرب، والعسكر الإنجليز والأستراليون باعوا خيلهم للبدو، واختلط الحابل بالنابل، العربي بالإفرنجي»، فيما احتفظ عرب الطحاوية بنقاء عِرق خيولهم العربية، فصاروا مقصداً لمن يريد الخيل الأصيل.
أجنحة السِّباق
يحصل البطلان «مرعي» و«سليم» بعد مفاوضات عاصفة على فرس بمواصفات تليق بالمُقامرة، ويصطحبون معهم فوزان «الطحاوي» الصبي الذي يحمل مرارة موت الأب على يد عمه، وإرثاً من الإهانة على يد هذا العم مُفرط القسوة: «كم يكره عمه، يكره تفاصيله، ملامح وجهه العابس المغبر، الشارب الكث الضخم، السنة الفضية بين أسنانه، وشم السمكة الخضراء على ظاهر كفه، يكره كل تفصيلة من تفاصيله، يكره قسوته عليه، وعلى نسائه، فهو متزوج من أربع نساء يضربهن بالسوط كما تُضرب البهائم، إنه لا يشبه أباه أبداً».
رغم هذه الخلفية الفظّة، فإن فوزان الطحاوي شبّ على الرقة، يقتفي النجوم في السماء، ويُلاطف الفرس، ولا يحلم سوى بالدفاع عن أمه من بطش عمه الذي يُعد من أبرز مشايخ «جزيرة الخيول». تتصارع طبيعته الحالمة مع الرغبة في الانتقام، وسرعان ما تتفتح أمامه آفاق مُبهرة عندما يصل مع «مرعي» و«سليم» إلى مضمار الخيول في «هليوبوليس»، ويلتقي الثلاثة بالسيدة «ميتسي» التي تحمل الرواية اسمها، وهي السيدة الإنجليزية التي أتت إلى مصر لتعيش مفارقات يائسة، ولم تستطع تجاوز خسارة ابنها الذي مات طفلاً، وتجد نفسها أسيرة لعالم الرهانات، وتصبح من خلال الفرس الذي تُقامر به طوق نجاة «مرعي» و«سليم» و«فوزان» في أحلام الفوز وتقاسم الرهان، لتعويض ما يمكن تعويضه من خسائرهم المادية والوجدانية، فهم جميعاً لم يسبق لهم الفوز في شيء. إلا أن مُفارقات الرواية الجامحة، تُحجّم من فُرص فوز الفرس، وبعد إحباطات طويلة يكون فوزها حلقة في خسائر إنسانية أخرى، وكأن للأحلام طريقا مرسوما لا يمكن مُراوغته بمقامرات.
ورغم الوشائج الإنسانية التي تكشف عن سرائر أبطال الرواية الأربعة، وخبايا انكسارات حياتهم التي قرّبت بينهم، فإن مصيرهم كان الفراق: «لقد كانوا الأربعة مثل كرات البلياردو، تلاقوا في لحظة خاطفة من الزمن، تصادموا، تقاطعت حيواتهم، ثم ارتدَّ كل منهم في اتجاه. ولم يلتقوا ثانية أبداً».
اللافت أن الرواية تقارب بين الخيول التي لم تُخلق في الأصل من أجل السباق، بقدر ما خُلقت من أجل الحُرية والجمال، وبين الأمنيات التي تقترب كلما تخفّف التشبث بها، كما تقول الليدي ميتسي في نهاية الرواية: «أحياناً علينا أن نتخلى عن الأمنيات التي ترفض أن تكتمل»، وهي عبارة يسبقها مشهد الفرس التي ربحت السباق بعدما قام خيّالها بتخفيف قبضته عليها، فأزال عنها توتر السباق، وهي مُقاربات وجدت لها طريقاً متأنياً في السرد: فماذا لو كانت الأمنيات خيولاً؟ سؤال يطرحه الكاتب، ويُطلق سراحه في الرواية.