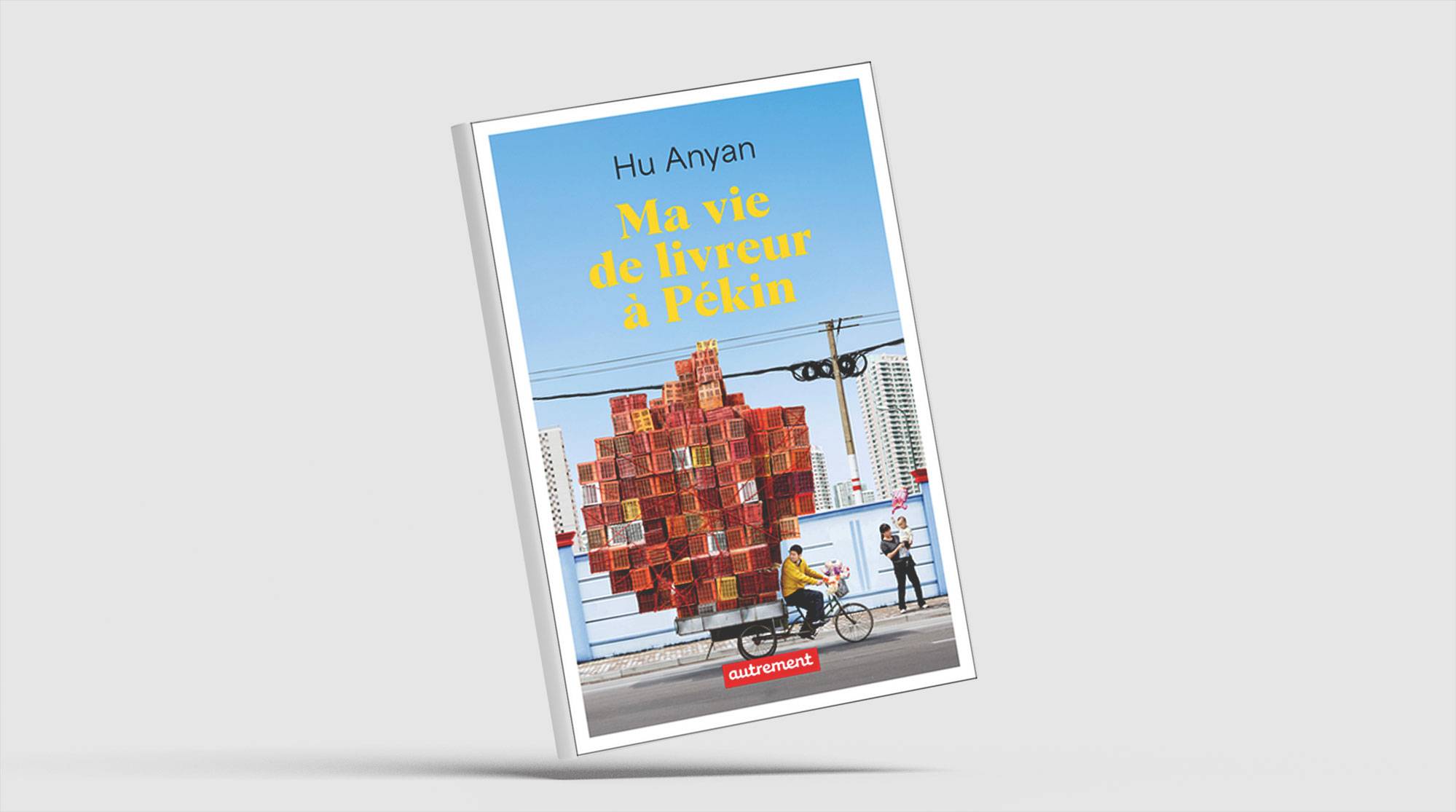بعد أكثر من خمسين سنة على صدور النسخة الأصلية لـ«رسائل شتاينبك لناشره»، أصدرت دار نشر «سيغرس»، ولأول مرة، طبعة مترجمة إلى الفرنسية بقلم المختص في الأدب الأميركي بيار غوغليمينا. الكتاب عبارة عن مراسلات من شتاينبك إلى ناشره باسكال كوفيتشي المدعو «بات». نوع من الروتين حافظ عليه الكاتب الأميركي الكبير من أول يوم بدأ فيه الكتابة في 29 من يناير (كانون الثاني) 1951 إلى الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) من نفس السنة. في كل يوم وقبل الشروع في العمل، كان المؤلف الأميركي يكتب لصديقه «بات» ما يعادل الرسالة.

في دفتر كبير من جزأين خصّ فيه اليمين إلى الرواية واليسار إلى الرسائل، خطابات لم يكن ينتظر منها إجابة بما أنه كان ينوي تسليمها لصديقه الناشر بعد الانتهاء من الكتابة كما أوضح له منذ البداية: «لن تتسلمها قبل عام... »، فهي لم تكن تُكتب بغرض التراسل، بل لتوثيق أهم خطوات العمل الإبداعي وكنوع من التحضير الجسدي والعقلي قبل الشروع في الكتابة. توثيق التجربة الإبداعية تقليد بدأه الكاتب الأميركي مع روايته الشهيرة «عناقيد الغضب»؛ إذ كتب «أيام العمل» أو (دايز أوف ورك) عام 1938، وكانت مذكرات دوّن فيها بدقّة بالغة تطور تجربته الكتابية من أول صفحة، بالتواريخ، وعدد الساعات التي كان يقضيها في الكتابة، والمشاكل التي واجهته لتطوير شخصياته وحبكته الروائية، إلى لحظات الشّك والعزلة التي كان يعيشها في فترة كانت فيها ميوله الاشتراكية المزعومة مصدر متاعب.
التجربة نفسها كرّرها مرة ثالثة مع «برقيات من الفيتنام» التي كتبها على هامش تحقيقاته خلال الحرب الأميركية في فيتنام عام 1966. في «رسائل شتاينبك إلى ناشره» التي كتبها بأسلوب أكثر إسهاباً من «أيام العمل» يخبرنا شتاينبك بأن الكتابة هي «نشاط جسدي مرهق»؛ أولاً لأنه يكتب بخطّ يده ولا يستخدم الآلة الكاتبة، وثانياً لأنه يكتب دون هوادة من الصباح إلى المساء ومن الاثنين إلى الجمعة، فارضاً على نفسه وتيرة عمل قوية، إلى رسم أهداف معينة كالوصول إلى كتابة 2000 كلمة في اليوم. فلا الجروح الكثيرة التي أصابت يده من فرط الكتابة ولا وجع الأسنان الذي أصابه فجأة قد نالا من «العزيمة الفولاذية» التي عُرف بها الكاتب الأميركي، التخلي عن شخصيات روايته ولو لمدة أسبوع أمر مرفوض تماماً، كما يكتب لصديقه. مثل هذا الانضباط في العمل كان قد مكّنه في الماضي من إنهاء روايته «عناقيد العنب» في وقت قياسي: مائة يوم فقط رغم عدد صفحاتها الذي يفوق ستمائة!
نحن في 1951، شتاينبك على مشارف الخمسين وهو متزوج منذ أسبوعين من إيلين، الزوجة رقم ثلاثة. في رسائله إلى صديقه الناشر «بات» يصف هذه الأخيرة بـ«الصبورة المتفهمة» وتمنى لو فاجأها برحلة استجمام جميلة: «حبذا لو أستطيع الحصول على شيء من الراحة...»، قبل أن يضيف واضعاً مشروع الرواية الجديدة نصب عينيه: «كل ما أعرفه هو أنه شيئاً فشيئاً سيتّسع الكتاب ويكبر حتى يصبح كالمنزل، فإما أن يكون بيتاً قائماً على أسس صلبة، وإما أن يكون بيتاً هشاً ينهار تحت وطأة ثقله... ».
«شرق عدن» كانت الرواية العاشرة لشتاينبك، بدأها بكثير من الحماس، «قد تكون... كما يكتب لصديقه (بات) رواية العمر... وهي بالتأكيد الرواية الأكثر طموحاً والأقرب إلى سيرتي الذاتية...»؛ ولذا فقد اختار رسم مشاهدها في مسقط رأسه بمقاطعة ساليناس بكاليفورنيا والاستعانة ببعض الشخصيات التي رافقت طفولته كشخصية سامويل هاملتون المزارع الفقير الذي هو في الواقع جدّه المهاجر الآيرلندي (من أمه).
بين السطور التي توثّق تعاقب الفصول وتطور الرواية وشخصياتها، يتجلى واقع الحياة اليومية بكل بساطته؛ فنقرأ عن مأدُبات العشاء، وبالأخص تلك التي ألهمته عنوان الرواية، فمن «وادي ساليناس» الذي اقترحه أول مرة على أحد أصدقائه فلم يعجبه، إلى «الوادي باتجاه البحر»، ثم «علامة قابيل»، إلى العنوان النهائي «شرق عدن». كما نقرأ عن الحفلات المدرسية لولديه التي سيحضرها أكثر؛ لأنه على وشك الانتقال إلى الشقة الجديدة بحي مانهاتن بمدينة نيويورك على بعد أمتار من مسكن طليقته غواندولين كونجر وأم ولديه توماس وجون.
عن هذين الأخيرين يكتب شتاينبك لصديقه الناشر: «ماذا لو كان إهداء الرواية الجديدة موجهاً إليهما؟ عندما يصلان إلى العمر الذي يستطيعان فيه القراءة سيتمكنان بفضل هذه الرواية من معرفة من أين أتيا ومن هما؟ سأروي لهما قصّة البلدة التي نشأت فيها، على امتداد النهر الذي أعرف والذي لم أعد أحبه كثيراً؛ لأني اكتشفت وجود أنهار أخرى. سأروي لهما قصّة الخير والشّر، القوة والضعف، الحب والحقد، الجمال والقبح...». الأحداث كشفت لاحقاً أن إهداء الكاتب لن يكون لولديه، وإنما لصديقه الناشر باسكال كوفيتشي.
من أطرف الفقرات وأغربها تلك التي يروي فيها شتاينبك لصديقه الناشر قصّة ولعه بأقلام الرصاص التي كان يستهلك منها يومياً نحو ستين! فنقرأ مثلاً أنه بحث طويلاً عن القلم «المثالي» الذي سيكون رفيقه في ساعات الكتابة الطويلة إلى أن وجد نموذجاً معيناً هو القلم من فئة «المغول 2 3/8 إف» الذي يعده بمثابة «سيد الأقلام»؛ فإن القلم في اعتقاد الكاتب هو أكثر من مجرد أداة عمل، هو المرآة التي تعكس نبض إنتاجه الأدبي، فإذا ما أحسّ بأنه رفيع وخفيف في يده، فهذا يعني أنه يكتب بسلاسة وسهولة، وأن يومه سيكون «يوماً جيداً»، وإذا ما انكسر، فهذا يعني أنه متوتر وعالق في مشهدٍ ما أو مع شخصيات معينة... لا يستطيع التقدم لدرجة تجعله يضغط على القلم بشدة وكأنه يطعن الأوراق طعناً، كما يكتب. وفي صورة شديدة الإيحاء يصف الكاتب مجموعة الأقلام التي يضعها على مكتبه كل صباح بـ«جنوده الصغار» الذين يقفون في الصّف بكل إخلاص وانضباط تأهباً لدخول المعركة. يصف شتاينبك مجموعة الأقلام التي يضعها على مكتبه كل صباح بـ«جنودي الصغار» الذين يقفون في الصّف
بكل إخلاص وانضباط تأهباً لدخول المعركة